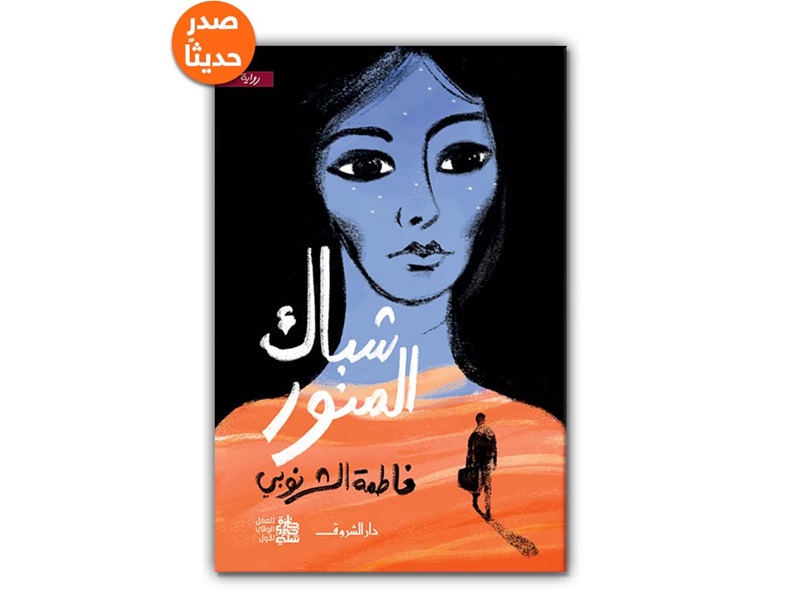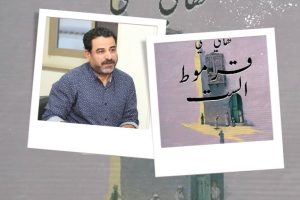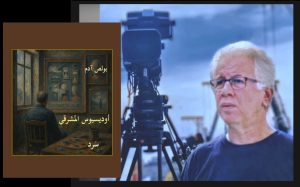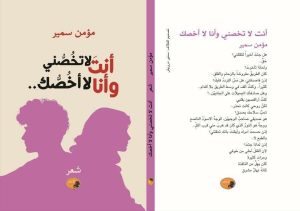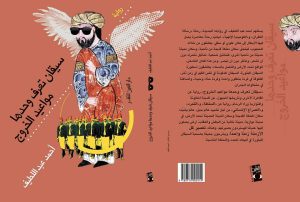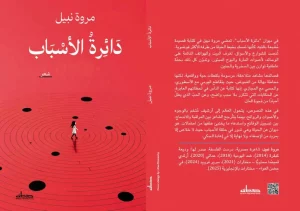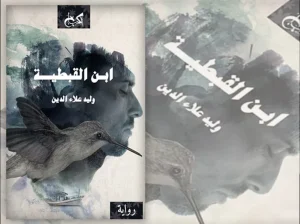دينا الحمامي
حينما يقرر الكاتب البدء في كتابة روايته، فإنه يعقد اتفاقاً ضمنياً مع نفسه الروائية على معالجة محددة لحكايته، وهذا يرجعنا إلى الطرح النقدي الذي تناوله في أكثر من موضع الناقد والروائي محمود عبد الشكور حول أولوية الاهتمام بكيفية التناول عن ماهية التناول ذاته، وبما أن التجربة الإنسانية بمفهومها الأعم والتجربة الفنية بشكل أكثر خصوصية تزخران بالغياب كتيما تختلف وسائل معالجتها والتعامل معها وتأثيرها.
في رواية “شباك المنور” الحاصلة على جائزة الأديب خيري شلبي في دورتها الأخيرة والصادرة عن دار الشروق بمطلع العام الحالي، حرصت الكاتبة فاطمة الشرنوبي على تصدير الغياب كبطل شريك لشخوص الرواية، يرافقهم في وحدتهم ويشاركهم تفاصيلهم الدقيقة، ولا يكتفي بدوره المعتاد كمرادف للفقد، ولكنه يتجاوزه ليبرز كبطل ضد للوجود في مواضع بعينها.
من يتتبع علاقة البطلة الملتبسة بوالديها، يستطيع أن يستخلص أن الغياب شريك أساسي وحاضر في كل تفاصيل الأسرة، فمثلا في الوقت الذي لا تفارق فيه الأم البيت بل وتمارس سلطة قهرية على ابنتها طوال الوقت، إلا أنها غائبة بكل ما تحملة الكلمة من معانٍ، لا تتحدث مع ابنتها إلا نادراً ولا تجمعهما مناسبات سعيدة تخفف من وطأة الحاجز الأسمنتي المصمت بينهما، بينما لا يغيب الأب (الغائب جسدياً) عن مخيلة الفتاة لحظة وحيدة، وهو ما يستدعي إحالة رمزية إلى قدرة الفن على خلق حيوات شديدة التكثيف تعكس حالة التناقض العبثية التي يكابدها الإنسان في حياته وتمتد إلى علاقاته حتى تلك التي تدور تحت سطح واحد.
تستمر حالة الغياب في الرواية في فقدان تواصل البطلة مع جسدها، ذاك الجسد الجاثم على روحها كعبء أثقلته اللامبالاة في البيت وزادت حالة التهميش في المدرسة من نفورها منه، فأصبح مع مرور الوقت كظل مشوه لروح تحاول النجاة عبر أبسط الطرق وأكثرها بدائية كقطعة حلوى أو الاستماع إلى صوت بائع يغنَي؛ بلغت علاقة البطلة رقية مع جسدها تمام التفسخ حينما فقدت عذريتها في حادث تحملت وحدها وبشجاعة مأساوية تبعاته، وحتى عندما لجأت إلى ترميم رتق بكارتها بعد عدة سنوات، كانت قد ارتقت إلى مرحلة من التصالح مع المحيط لم يعد مهماً بها إن كان الجسد حاضراً بكامل عنفوانه أم غائباً أو متنافراً.
لعل أحد أهم مواضع الغياب في النص، هو غياب اسمي شقيقي “رقية”، بينما حرصت على التركيز على أسماء زميلات في المدرسة كفاتن وأنيسة، حرص السرد على تهميش اسمي الشقيقين، مكتفيا بتعريفهما ب”ص” و”س”، تماماً كما كان دوراهما مهمشين وغير مؤثرين سواء في حياة شقيقتهما “رقية” وهي الشخصية الأساسية للعمل وحتى على مستوى سير الأحداث، لم يتم الاستعانة بذكرهما سوى كانعكاس باهت للبطلة وكحيلة فنية لتمكين الغياب كعنصر شريك في تحريك الأحداث أو توقيفها.
الأحلام كمناورة سردية
كما احتفى النص بالغياب كبطل ومحفز للسرد، امتلأت فصول الرواية بالأحلام كبديل عن واقع نفسي شديد القسوة تجزع تحت وطأته البطلة، وتحتمي بواقع موازٍ حتى لو كان من صنيعة إرادة لا واعية.
زخر الأدب منذ بداياته وحتى يومنا هذا بتيمة الحلم باعتبارها تقنية يمكنها البوح بما لا يقدر السرد على الإتيان به، كما اختلفت ظروف وملابسات عالم الأحلام في الفن الروائي، فأحلام ألف ليلة وليلة وملحمة جلجامش، وإلياذة هوميروس تختلف عن عالم الأحلام في “الحرب والسلم” لتولستوي والجريمة والعقاب” لدوستويفسكي، كما هو الحال بالنسبة لعالم الكوابيس فعوالم قناع الموت الأحمر الكابوسية لإدجار آلان بو والتي يمكن وصفها بـ “كوابيس يقظة”، تختلف عن كوابيس بطل رواية “شارع بن يهودا” لأيمن السميري والتي جاءت كمكمل لهواجس الشخصية وعطبها.
غالبا ما تلجأ الذات الراوية إلى الحلم بعتباره مهرباً تذوب به الفواصل الزمنية فيختلط الحاضر بالماضي بالمستقبل كما تندمج به المسافات والزمن المنطقي لعبورها، على عكس الكوابيس التي تأتي ثقيلة في إيقاعها وفي تأثيرها على الحالم الذي غالباً ما يجد نفسه مكبلا لا يستطيع الهرب أو معقود اللسان فاقداً لأي قدرة على الصراخ والاستغاثة.
في روايتها الأولى اعتمدت الشرنوبي على عالم الأحلام كركيزة سردية أساسية مكملة للسرد، إذ اختلف توظيف هذا العالم الشاسع من الرؤى والكوابيس وأحلام اليقظة وفقاً لحضور الشخصية وعلاقتها بالبطلة، فمثلا أنيسة وهي الصديقة التي لا تقل بؤساً عن البطلة جاء حضورها كابوسياً في أغلبه، فبالرغم من المحبة التي تكنها رقية تجاه أنيسة، إلا أنها طاردتها في مناماتها بعدما فشلت في الاستحواذ على محبتها في الواقع؛ حضر الأب في عالم الأحلام كحضوره في حياة البطلة الواقعية: كطيف ليس بعابر ويأبى أن يغادر الذاكرة حتى وهو في كامل غيابه، عبرت رؤيا البطلة مع أبيها عن حالة النكران التي تعيشها، ففي الوقت الذي تحاول فيه بشتى الطرق أن تقدم لنفسها تبرئة من ولائها لأب لا يهتم لأمرها، تأتي أحلامها كشاهد نفي يجهض كل المحاولات العبثية للشفاء من هذه المحبة المبتورة والعليلة.
على امتداد عالمي الرؤى والكوابيس تطل الجدة بذكراها عبر تقنية جمعت بين الفلاش باك وأحلام اليقظة، كخط شفيف وفاصل بين الحنين المطلق والشوق الجارف، كردهة آوت إليها الذات الكاتبة- الراوية بعد أشواط لاهثة قُطعت في السرد، كبلة ريق في وسط حياة متصحرة، عقيمة، وجدباء، جاءت صورة الجدة في الواقع كمثيلتها بالحلم؛ حانية ورقيقة ورؤوفة للحد الذي بلغ السرد به قمته فاختلطت الذكريات بأحلام اليقظة عن وعي وعمد، إلى أن تهشمت أمنيات الطفولة بصخرة الواقع، فلا الجدة عادت موجودة ولا البطلة ظلت هي الطفلة التي كانتها في رحاب الجدة، عندما كانت الأحلام متاحة والدفء موجوداً ولو للحظات آمنة سرقتها يد القدر العمياء.
تنوع الرواة وموسيقية الإيقاع
تأرجح السرد في رواية شباك المنور بين الراوي العليم والراوي بصيغة المتكلم مع الحفاظ على لغة كل راوٍ منهما، اشتبكت التقنيتان في السرد مما أضفى ثراءً لغوياً ذا طابع موسيقي، ففي الكثير من الفصول تحدت الكاتبة نفسها بأن جمعت الراوي العليم بالأنا الراوية بالصفحة ذاتها بفارق لا يتعدى بضعة سطور، ولكنه قادر على إظهار وعي المؤلفة بصوت البطلة وصوتها الروائي؛ لا يمكننا الفصل أيضاً بين توظيف الفارق بين تقنيات السرد بهذا النص في إثراء لغته بشكل أكثر شمولية، إذ لجأت الكاتبة في الكثير من الأحيان إلى التقديم الموجز لحدث بعينه على لسان الراوي العليم لتعود لشرحه باستفاضة على لسان البطلة والعكس، ففي أكثر من موضع أسهبت اللغة واستفاضت بشاعرية يمكننا القول إنها موزونة وذات إيقاع لا يختل مهما طالت الفقرة أو تشعبت، ومن هنا تأتي جماليات السرد إذ يمكن للنص الروائي أن يكون بمثابة معلقة شعرية احتفظت للرواية ببنائها بما لا يخل بجماليات القصيدة.