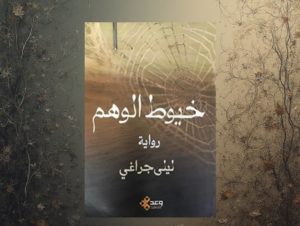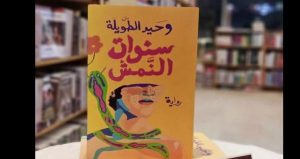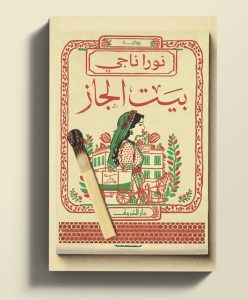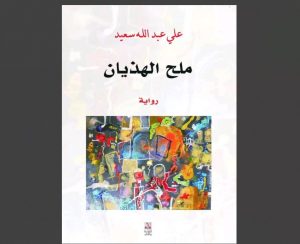د.نصر الدين شردال
يعدُّ الشاعر والإعلامي سمير درويش(*)، وجهًا شعريًّا وإعلاميًّا مهمًّا في الساحة المصرية والعربية، إذا يمثلُّ الموجة الثالثة من الحداثة الشِّعريَّة العربيَّة بمصر، والموجة الثَّانية من قصيدة النَّثر العربيَّة، الجيل الذي “اهتمَّ ببناء مشروع شعريٍّ متنوعٍ، من البساطة العميقة، إلى الصِّور المركبة”(1)، وقد ضمّ مجموعة من الأسماء الشِّعرية المهمة في مصر كـ: إبراهيم داود، فتحي عبد الله، عاطف عبد العزيز، إيمان مرسال، محمود قرني، فتحي عبد السميع، علي منصور، عماد أبو صالح.
إنَّ مقاربة المشهد اليوميِّ بتفاصيله الصَّغيرة في العالم الشِّعريِّ للشاعر المصري سمير درويش، جاء من نداء هذه الكتابة نفسها، ذلك أنَّها تنتصر للهامشيِّ والمنسيِّ واللامفكر فيه ببوهيميَّة رافضة، وتقدم اقتراحًا ميتاشعريًّا يفكر في القصيدة وما تفكر فيه، وتطمح إليه، مستعينًا في ذلك بكلِّ ما تتيحه الإمكانيَّة الهائلة للفنِّ السّينمائيِّ باختلاف تقنياته ووسائل تبليغه، ليسجل بكاميراته الشِّعريَّة إطارًا للمشهد اليوميِّ المتناقض، جاعلًا المقطع الشِّعريَّ لقطةً سينمائيَّةً غاصَّةً بالتَّفاصيل الصَّغيرة التي لا تقال إلا بلغة الهامش، وبلغة الكاميرا وتقنياتها، وفي نصوصه الشِّعرية نجد ما يمكن أن يمثلُ ميتاشعر/ أو تنظيرًا شعريًّا لما يكتبه، لذلك يرى أنَّ:
“القَصِيدَةُ ابْنَةُ لَيْلٍ
تَجْمَعُ أَشْيَاءَهَا مِنْ نَهَارِ الشَّوَارِعِ وَالمَيَادِينِ
مِنْ أَشْجَارِ الزِّينَةِ عَلَى الأَرْصِفَةِ
وَمِنْ وَاجِهَةِ المَحَلاَّتِ
وَمِنْ أَلْوَانِ الأَكْيَاسِ الَّتِي تَضَعُهَا الأَكْشَاكُ فِي وَاجِهَاتِهَا
بِتَفَانٍ اسْتِهْلاَكِيٍّ!”(2).
نجد الشَّاعر أكثر وعيًا بتداخل الفنون والأجناس الأدبيَّة، حيث يقول: “ضاقت المسافة بين الأنواع الأدبيَّة المختلفة، وبين الآداب والفنون، فأصبح الشَّاعر يستفيد من كلِّ شيء، إيقاع السِّينما، وحوار المسرح، وألوان الفنون التَّشكيليَّة، وسرد القصة القصيرة”(3).
في شعره وعي بالفنون السَّمعيَّة والبصريَّة، وخاصة السِّينما بمكوِّناتها وجديدها، كما له اهتمام ملحوظ بالسِّينما الأمريكيَّة الجديدة.
في معظم نصوصه نجد حضورًا طاغيًا للتقنيات السِّينمائيَّة وأسماء الأفلام والممثلين، بمعنى آخر، فإنِّ التَّوظيف السِّينمائيِّ في شعره يتَّخذ مظهرين اثنين، مظهر في اللُّغة وألفاظها، ومظهر في التِّقنية، ولعلَّ ما يثير انتباهنا في تجربته كثرة الأسماء الأمريكيَّة للأفلام والممثلين والمثلات الأمريكيات، كلُّ ذلك من أجل صياغةِ مشهدٍ سينمائيٍّ يعتمدُ السَّرد والمونتاج والإضاءة والتَّعتيم.
لكن، أيُّ نوعٍ من المَشَاهِدِ؟
إنَّهُ المشهدُ اليوميُّ الهامشيُّ القائمُ على تتبُّع التَّفاصيل الصَّغيرة والاستفادة من تقنياتِ الفنِّ السِّينمائيِّ، هذا ما يؤكده الشَّاعر إذ يقول: “أتصوَّر أنَّ إضافتي الرَّئيسيَّة هي شعريَّة “اليوميات”، أي تحويل اليوميِّ إلى شعر..”(4)، لكن الذي يهمنا، هنا، هو كيف يكتب الشَّاعر هذا اليوميِّ، هل هو نقلٌ ميكانيكيٌّ عاديٌ للمشاهدِ اليوميَّة، أم إبداع جديد يعتمد التِّقنيات السِّينمائيّة التي يتيحها عالم المرئيَّات الجديد؟
يمكن القول إنَّ أهمَّ تقنية سينمائيَّة يعتمدها الشَّاعر هي تقنية التَّصوير المشهديِّ، بحيث تبدو أغلب قصائده صورًا سينمائيَّة متحركة تؤسس للمشهد السِّينمائيِّ، هذا المشهد يؤسس بدوره لفيلم مكتوب في قصيدة، يمكن أن نسمِّيها بـ”القصيدة المشهديَّة”؛ القصيدة المشهدية هي ذلك النص الشعري “الذي يتكون من المشاهد التفصيلية المتتابعة التي تروي قصة الفيلم”(5)، وهذه “المشاهدِ المرئيةِ والمسموعةِ، يفضي كل واحد منها بعلاقة إلى الآخر، فينتجُ من تعالقهَا وتداخلهَا وتعاقبهَا قصةً أو حكايةً”(6)، أو بصورة أكثر دقة فإن المشهد السينمائي في الشعر هو: “قصة تُحْكَى بالكلمة والصورة، والشخصيات تنقل حقائق ومعلومات معينة إلى القارئ أو المشاهد”(7).
وإذا ما عدنا إلى شعره، فسنجده يطفح بمجموعة من المصطلحات والمفاهيم السينمائية في مقدمتها “المشهد”:
“احْتَجْتُ بِضْعَ دَقَائِقَ فَقَطْ
لِأَغْمُرَ المَشْهَدَ كَالبَارُودِ الذَي أَرَاهُ الآنَ
فِي الحَرْبِ الدْرَامِيةِ..”(8).
تجمع القصيدة المشهدية بين المشهد والدراما في بناءٍ نسقي جمالي “متكاملٍ يتساندُ بعضه على بعض، ويكمل جانب منه الجوانب الأخرى، وثمة علاقات خفية وظاهرة بين الكلمات والتراكيب النحوية، وكل ذلك ينتظم داخل إيقاع غير ملموس، لا تستطيع أن تصفه لكنك تحسه، ولا تستطيع أن تستمتع بالقصيدة دونه، المشهد اليومي إذن هو مادة القصيدة الجديدة، لكنه يظل المادة الخام التي يستطيع الشاعر إعادة إنتاجها ولا يستطيع غيره، وهذه المشاهد فيها كل شيء، من التفات شاب للتأكد من تفصيلة خايلته في فتاة تمضي في الطريق المعاكس، إلى نوم طفل تحت كوبري مشاة، وتسول امرأة عجوز في مترو الأنفاق، حتى الحريق والغرق.. إلخ..”(9)، وفي شعره ما يؤكد أنه يكتب عن الأشياء البسيطة، ويجمع بين التصور النظري والتطبيق الشعري:
“أَكْتُبَ عَنْ سَيارَاتِ الأُجْرَةِ
وَالطرِيقِ الزرَاعِي
وَالأُغْنِياتِ الهَابِطَةِ
وَعَنِ الوَلَدِ الذِي يَتَحَينُ فُرَصًا
كَي يَلْمَسَ أَصَابِعَ حَبِيبَتِهِ المُحَجَبَةِ
دُوْنَ أَنْ يَتَعَمَدَ إِهَانَتِي
وَأَسْتَطِيعُ أَنْ أَكْتُبَ عَنْ غُرْفَةٍ مُرَبعَةٍ
تَحْتَوِي وَحْدَتِي”(10).
إن القصيدة المشهدية الجديدة تسعى دائمًا إلى لفت الانتباه إلى ما لا يرى، إلى العابر والمتشظي والمنسي، إلى تلك الظلال في الزوايا المعتمة، وتلك الأضواء التي تتحرك في غفلة من الجميع، تلك الأشياء البسيطة التي لن يراها الناس العاديون:
“أَضْوَاءٌ تَتَحَركُ فِي صَدْرِي
لَنْ يَرَاهَا المَارونَ
لِأَنهُمْ يَقْطَعُونَ المَسَافَةَ عَدْوًا وَلاَ يَنْظُرُونْ
ثَمَّ حِوَارَاتٌ كَاشِفَةٌ يُمْكِنُ رَصْدُهَا
وَبَعْضُ أُغْنِياتٍ قَدِيمَةٍ”(11).
يتحرك الشاعر في نصه الشعري بين فضاءين متباعدين؛ بحيث يصور مشهدًا في مصر ومشهدًا في أمريكا، إما عبر استدعاء صور من الذاكرة (الماضي) أو صور من الحاضر (أمريكا) مفتونًا بتتبع الحياةِ الأمريكيةِ في تباينها الصارخ وعلاقاتها المتناقضة، فتنتقل بنا بكاميرته اللغوية وهي تتجول وتسجل المشهد باحترافية بالغة، وتركز على أدق تفاصيله.
إذا كان الفيلم يتكونُ من العديدِ من المَشَاهِد، والمشاهدُ تتكون من مجموعة من الصور، فإن القصيدةَ تتكونُ من صورٍ شعريةٍ تتشكلُ عبرَ اللغةِ، لكنها في باطنها تحمل صورًا سنيمائية متحركة لمشاهدَ معنية، تضم في تفاصيلها كائنات وألوانًا وأحداثًا وأشياء واقعية أو متخيلة، مرئية أو غير مرئية:
“يُمْكِنُنِي أَنْ أُصَورَ الأَشَعةَ
التِي تَفِيضُ مِنْ صَدْرِ امْرَأَةٍ سَمْرَاءَ
فِي فِيلِمٍ أَمْرِيكِي
وَقَدْ أَنْدَهِشُ لِأَن السَيارَاتِ تَطِيرُ
وَلِأَن الأَبْطَالَ يَسْتَقْبِلُونَ الرصَاصَ بِأَفْئِدَتِهِمْ
وَلاَ يَمُوتُونَ
كَي يُقَبِّلُوا النسَاءَ وَافِرَاتِ الصدُورِ
فِي نِهَايَةٍ مُفْرِحَةْ!”(12).
تختلف المشاهد المصورة في الفضاءات المفتوحة عن المشاهد المصورة في المشاهد في الفضاءات المُغلقة، فالأولى تتميز بكثرة الحركة والانتقال والتطور المستمر في الزمكان، والمشهدية العابرة، بينما تتميز الأخيرة، بالتدقيق في التفاصيل الصغيرة والنفاذ إلى جوهرها.
إن المَشَاهِدَ المصورة في الفضاءات المغلقة: المقهى، الحانة، البيت، ترتبط في مجملها بالإيروسية واشتهاءات الجسد، وتقلباته ورغباته، الجسد المشتهى، الجسد البض، فتتضح الإضاءة ويخفت الصوت، وتكثر المشاهد الحميمية، ويقل عدد الناس، فمن المشهد الذي كان يضم أكبر عدد من الشخوص، إلى المشهد الذي لا يتعد ثلاثة أشخاص، لنرى إلى مشهد مصور داخل حانة:
“حِينَ تَدْخُلُ:
تَسْمَعُ مُوسِيقَى كْلاَسِيكِيةً
تَرَى لَوحَاتٍ بِأَلْوَانٍ بَارِدَةٍ
تَرْقُصُ إِنْ أَرَادَتْ
تُغَني فِي أُذُنِي
تُوَارِي خَديْهَا مِنْ هَجَمَاتِي
وَتَبْدَأُ رِحْلَةَ الأَصْدِقَاءِ المُشْتَاقِينَ
كَأَنهَا “جينيفر أنستون” تَمَامًا”(13).
كما نجد المشهد الذي يضم شخصين: الشاعر وحبيبته متناغمين ومتفاعلين في الزمكان، وفاعلان في صناعة المشهد وتنامي أحداثه والدفع به نحو النهاية، وهي مشاهد تتميز بالصمت والهدوء، عكس ما يحدث في الخارج، إلا حركة الشاعر أو حبيبته، أو صوت موسيقى هادئة تناسب الأجواء الرومانسية:
“الشبَابِيكُ مُغْلَقَةٌ
لَكِننِي أَقْطَعُ المَسَافَةَ كُل حِينٍ
بَيْنَ غُرْفَةِ الاسْتِقْبَالِ
وَنَصْبَةِ الشايْ
وَأَسْتَمْتِعُ بِالقُبَلِ التِي يَتَبَادَلُهَا أَبْطَالُ الأَفْلاَمِ
وَأَتَكَلَمُ فِي الهَاتِفِ قَلِيلًا
وَلاَ أَنَامُ إِلا حِينَ يُولَدُ الضوْءُ
لَكِن بَطَلاَتِ الأَفْلاَمِ لاَ يَأْتِينَنِي أَبَدًا”(14).
وتتراوح هذه المشاهد بين الحركة والسكون، والرغبة في الاستمتاع بلحظات والتحرر من عين الرقيب:
“سَنُعَلقُ الستَائِرَ الثقِيلَةَ كَي نَصْنَعَ عَتْمَةً
تُحِبينَهَا عِنْدَ مُمَارَسَةِ الحُب
لَكِننَا سَنَتْرُكُ فُرْجَةً
يَدْخُلُ الضوْءُ الأَبْيَضُ مِنْهَا
لِأَننِي أُحِب المُوسِيقَى
وَالشايَ الأَحْمَرَ
وَالقَهْوَةَ الغَامِقَةَ
وَأَصْوَاتَ الرغْبَةِ، وَاللهَاثَ
وَالنفَقَ الذِي تَدْخُلِينَهُ قَبْلَ بُلُوغِ المُنْتَهَى”(15).
ومن البيت ننتقل إلى المقاهي والحانات، حيث:
“الفَتَياتُ اللوَاتِي يَتَقَلَبْنَ عَلَى الجَمْرِ
وَزُجَاجَاتِ النبِيذِ
وَضَحَكَاتٍ
وَرَغْبَةٍ عَارِمَةٍ فِي الصعُودِ
إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى؟!”(16).
ومن المشاهد المصورة في الفضاءات المغلقة إلى المشاهد المصورة في الفضاءات المفتوحة، باعتبارها إطارات سينمائية؛ ذلك أن “الإطار هو المجال الذي يحتوي الصورة ويوحي بأبعادها ودلالاتها.. ويحدد الإطار المجال المرئي أو المركبِ لها، كما يرتب محتوياتها ومعانيها كالتموقع النهائي للأشخاص داخل الديكور”(17)، وداخل هذه الإطارات تتحرك الشخصيات والكائنات، وتتحرك معها الظلال والألوان في فضاءٍ واسعٍ بحرية أكثر: وقد يتحول المشهد السينمائي -حينما تكتمل كل عناصره- إلى فيلمٍ سينمائي متحركٍ في القصيدة، فلنشاهد المشهدَ الوصفي لمكونات الشارع:
“المَحَلاَتُ عَلَى الجَانِبَيْنِ تُشِع ضَوْءًا صَافِيًا
وَالرصِيفُ مُمْتَد بَعْدَ الناصِيتَينِ
وَمَحَطةِ البَاصَاتِ
وَبَعْدَ البَارِ
وَالحِكَايَاتِ التِي أَحْمِلُهَا
وَمُوسِيقَى اسْمِي حِينَ تَفُوحُ”(18).
يتكون المشهد الذي وُضِعَ داخل إطار/ كادر، مجموعة من المشاهد الصغيرة والحركات والمكونات السينمائية الأخرى، لننصت إلى مقطع شعري آخر:
“امْرَأَةٌ تَجُر عَرَبَةً صَغِيرَةً
بِهُدُوءٍ يُنَاسِبُ بْلُوزَتَهَا الوَرْدِيةَ
شَاب يُبَادِلُ فَتَاةً قُبُلاَتٍ
فَتَيَاتٌ صَغِيرَاتٌ يَصْنَعْنَ صَخَبًا
فِي مَحَل الأَطْعِمَةِ السرِيعَةِ
بَيْنَمَا عَجُوزٌ تُنَظفُ الطاوِلاَتِ
بِزَيهَا الرسْمِي”(19).
يضم المقطع الشعري مشهدًا كبيرًا، يحتوي أربعة مشاهد صغيرة، لأربع شخصيات فاعلة فيه، المرأة، والشاب، والفتيات الصغيرات، والعجوز. وكل عنصر من هذه العناصر يقوم بحركة معينة تدفع المشهد للاستمرار، فالمرأة تجر العربة، والشاب يبادل حبيبته القبل، والفتيات يصنعن صخبًا، والعجوز تنظف الطاولات، وكل عنصر له أوصافه التي تجعله مختلفًا عن الآخر.. كما تشكل المشهدُ من العناصر التالية المؤثثة له:
– المكان: الشارع العام، محل الأطعمة السريعة.
– الزمن: الصباح، بداية يوم جديد باستعداد العجوز لاستقبال الزبناء.
– الشخصيات: المرأة، الشاب، الفتاة، الفتيات الصغيرات، العجوز.
– الحدث: جر العربة، تبادل القبل، افتعال الصخب، تنظيف الطاولات..
– الصوت: صوت العربة، صوت القبلة، الصخب..
– الديكور: العربة، مكونات محل الأطعمة، الطاولات، البلوزة، الزي الرسمي..
– الإضاءة: الصباح، (إضاءة عادية).
وفي مشهد آخر يتبع الشاعر نفس الطريقة، ليجمع في المشهد الواحد مشاهد متفرعة عنه ومستمرة في الحركة والبناء الدرامي:
“تَحْمِلُ امْرَأةٌ حَقِيبَةً وَرَقِيةً
بِهَا حِذَاءٌ بَدِيلٌ يُنَاسِبُ وَظِيفَتَهَا
وَيَجُر آسْيَوِي حَقِيبَةَ سَفَرٍ عَلَى الرصِيفِ
وَيَصْطَف الناسُ أَمَامَ عَرَبَةِ مَأْكُولاَتٍ
بَيْنَمَا أَوْرَاقُ الأَشْجَارِ مَغْسُولَةٌ
وَالإِشَارَاتُ تُبَدلُ أَلْوَانَهَا بِحِيَادٍ”(20).
تتغير زاوية التصوير ما بين البعد والقرب بالتناوب، ما بين التصوير العابر والتصوير المركز، بحيث ركز في التالي على الجزئيات الصغيرة الأقرب إلى كادر المشهد، وهي أورق الأشجار المغسولة بفعل تساقط الأمطار، ثم عادت الكاميرا إلى الجزء البعيد من المشهد، حيث الإشارات تبدل ألوانها بحياد، في هذا كله، نحس بالصورة المسجلة/ الفيديو تتحرك فـ”تحرك الصورة يعني انتقال الموضوع المعروض من حالة (أ) إلى حالة (ب) وهذا الانتقال يحقق خاصيتين: الزمنية، أي أنه يأخذ مدة زمنية؛ والتحول: حيث يأخذ الشيء المعروض تشكلات جديدة تنمو وتتطور أثناء عملية الانتقال”(21) والتصوير والتسجيل.
يقدم الشاعر في شعره “مشهدًا بصريًّا/ سمعيًّا بلغةٍ مرئيةٍ، تستعينُ بمعطياتِ الصورةِ السينمائيةِ من ديكور وإكسسوار وإضاءة وعتَمة وظل ولون وحركة وكادر، وما يقترن بها من عناصر صوتية، ويتم ذلك عبر تجوال الكاميرا الشعرية في الفضاءِ الموصوفِ، وتصويره من زوايا مختلفة، متتبعة أجزاءه، مستقصية كل محتوياته للإلمام بجميع عناصر المشهد”(22)، وفي معظم المشاهد يصف الشاعر الأشخاص البسطاء عكس التجارب الشعرية السابقة عليه، بحيث ما قبل جيل سمير درويش كان الشاعر المصري/ العربي يوظف الشخصيات ذات الحمولة التراثية والثقافية، أما مع جيله فقد بدأ الاحتفاء بالشخصية الهامشية في حواري وأزقة مصر وريفها البعيد، فنجد الإسكافي، والشحاذ، وسائق التاكسي، وبائع الورد، وباعة الأطعمة، والأهل والأصدقاء، والشباب، والأطفال الصغار، ورواد المقاهي البسيطة:
“قَبْلَ أَنْ أَنْحَرِفَ يَسَارًا بِنَاصِيتَيْنِ:
بَائِعُ وَرْدٍ مِكْسِيكِي بِوَجْهٍ عَرِيضٍ
وَشَارِبٍ كْلاَسِيكِي كَأَبْطَالِ الستِينِياتْ
ثَم إِشَارَاتٌ مُلَونَةٌ
فَسَاتِينُ قَصِيرَةٌ
مُرَاهِقٌ يَقْطَعُ الشارِعَ عَلَى لَوْحٍ أَرْضِيٍ
نِسَاءٌ وَرِجَالٌ فِي بَارٍ خَافِتِ الإِضَاءَةِ
وَأَرْبَعِينِي يُوَاجِهُ ثَلاَثِينِيةً فِي مَحَطةِ البَاصِ
يُودِعُ قُبُلاَتٍ بَطِيئَةً فِي فَمِهَا
دُونَ أَنْ يَكْتَرَثَ بِأَحَدٍ”(23).
نجد الشاعر شغوفًا بتتبع المشاهد المتحركة مصحوبة بأصوات طبيعية في فضاءات مفتوحة، فيتتبعها في مشهدٍ سريعٍ عابرٍ في الزمان والمكان:
“البَحْرُ مُسْتَأْنِسٌ
وَالأَلْوَانُ مُتَدَاخِلَةٌ
كَأَنهَا تَتَحَرَكُ فِي لَوْحَةٍ لِفَنَانٍ تِلْقَائِي
وَالأَصْوَاتُ شَرِيطٌ يُصَاحِبُ المَنْظَرَ
قُبُلاَتٌ، وَأَجْسَادٌ مَمْشُوقَةٌ، وَعُمَالُ صِيانَةٍ
وَكَلْبٌ أَلِيفٌ، وَحقِيبَةٌ ثَقِيلَةٌ
وَالفَتَاةُ تَجْرِي إِلَى البَحْرِ
وَاضِعَةً مُوسِيقَاهَا فِي أُذُنِهَا
بَيْنَمَا يَتَحَرَكُ جَسَدُهَا بِإيقَاعٍ يُنَاسِبُ شَغَفِي”(24).
إن وظيفة كل من الشاعر والمصور السينمائي هي التصوير سواء بالآلة الفوتوغرافية أو الكتابة، بغية إضاءة المادة المصورة، هكذا نجد داخل الكتابة الشعرية كاميرا شعرية تتحرك لترصد الظلال والزوايا المعتمة والفضاءات الواقعية والمتخيلة، متخذة في ذلك زوايا؛ من الأعلى، ومن الأسفل، من الجانب، ومن الخلف.. وقد تتغلغل الكاميرا في المشاهد الأكثر حميمية لتصف تفاصيل الجسد واشتهاءاته، وتموجاته بين الإضاءة والعتمة، بل حتى الأشعة المنبعثة منه:
“يُمْكِنُنِي أَنْ أُصَورَ الأَشَعَةَ
التِي تَفِيضُ مِنْ صَدْرِ امْرَأَةٍ سَمْرَاءَ
فِي فِيلِمٍ أَمْرِيكِي”(25).
يتبين لنا هوس الشاعر بتصوير التفاصيل سواء كانت في السينما أو في الواقع، يتتبعها ليسجلها بكاميراته الشعرية وإضاءتها من كل الجوانب:
“المِصْبَاحُ الصغِيرُ المُعَلقُ فَوْقَ السرِيرِ
يَنْحَتُ تَفَاصِيلَ جَسَدَكِ بِالضوْءِ وَالظِل.
أُحِب جَسَدَكِ حِينَ يَكُونُ مَنْحُوتًا بِالضوْءِ وَالظِل”(26).
كما يمكن أن يكون التصويرُ من الخلفِ في مشهدٍ عابرٍ دون الإلمامِ بتفاصيلهِ:
“وَغَادَةٌ تُعْطِي ظَهْرَهَا لِلْكَامِيرَا
بِفُسْتَانٍ أَزْرَقَ
مُوَشَى بِوُرُودٍ بَيْضَاءَ”(27).
كما يعمد إلى تصوير المشهد بشكلٍ مقربٍ مركزًا عدسة الكاميرا على الوجه، أو النصف العلوي للجسد، لإعطاء صورة أكثر تقريبية للشخص المصور:
“شَعْرُهَا نَاعِمٌ وَمَقْصُوصٌ حَتى كَتِفَيْهَا
فَتَاتِي التِي تُشْبِهُ Emily Blunt
عَيْنَاهَا تَضْحَكَانِ
وَمُرَاوِغَةٌ
تَرْتَدِي فُسْتَانًَا رَهِيفًا
أَسْوَدَ، وَنَحِيفًا، وَدُونَ أَكْمَامٍ
وَصَدْرُهَا يَتَكَورُ بِإحْكَامٍ يَلِيقُ بِانْدِفَاعِي”(28).
سبق وأن أكدت أن الفضاءات التي يجري فيها تصوير المشاهد الشعرية السينمائية تتوزع بين حارات مصر وبين شوارع نيويورك الأمريكية، ويتخلل هذه المشاهد المتحركة الضاجَّة بحركة الناس، مشهد صامت، فتخفت حركة السرد، ليبرز الصمت وشعرية الوصف وتفاصيل الأزياء وألوانها:
“ذُو الثيَابِ الرمَادِيةِ
الذِي يُنَظفُ سَيارَةً حَمْرَاءَ
أَمَامَ بُرْجٍ سَكَنَي أَبْيَضَ؛
يَنْظُرُ خِلْسَةً لِلْفَتَاةِ الوَاقِفَةِ أَمَامَ مَحَل مُقَابِلٍ
مَدْهُونَةٌ وَاجِهَتُهُ بِالْبُرْتُقَالِي
-يَبِيعُ أَشْرِطَةَ “فيدْيُو”-
تَلْبِسُ بَنْطَلُونًا أَمْرِيكِيًّا أَزْرَقَ
وَنَظارَةً سَوْدَاءَ كَاشِفَةً”(29).
وقد يتم الانتقال من الوصف والأزياء الخارجية إلى التفاصيل الصغيرة للجسد عبر تعريضه لمجهر العدسة والإضاءة الكاشفة:
“المِصْبَاحُ الصغِيرُ المُعَلقُ فَوْقَ السرِيرِ
يَنْحَتُ تَفَاصِيلَ جَسَدَكِ بِالضوْءِ وَالظِل.
أُحِب جَسَدَكِ حِينَ يَكُونُ مَنْحُوتًا بِالضوْءِ وَالظِل”(30).
أو مثل ما نجد في المقطع الشعري التالي:
“صُورَةُ امْرَأَةٍ فِي ثَوْبٍ أَبْيَضَ شَفَافٍ
تُدَاعِبُ التجَاعِيدُ تَفَاصِيلَهَا”(31).
ومن الأزياء، إلى تتبع حركات الشخصية في المكان الموصوف تتبُّعًا دقيقًا ملمًّا بكل تفاصيلها، وحركاتها، ومواقفها، وعلاقتها مع الغير، وفق بناء زمني متدرج ومتنام.
فلنرَ كيف يجسد لنا صورة شابَّة عشرينية منطلقة في الشارع العام:
“نَحِيفَةٌ وَسَامِقَةٌ كَأَنهَا “جينيفر أنستون”
هَكَذَا بَانَتْ حِينَ خَرَجَتْ مِنْ سَيارَةِ الأُجْرَةِ
بِحِذَاءٍ فِضِي
لَكِن عَيْنَيهَا تَضْحَكَانِ
وَوَاسِعَتَانِ أَكْثَرَ
وَمُحَددَتَانِ عَلَى خَيْطٍ نِيلِيٍّ عَلَى حَافَةِ جَفْنِهَا السفْلِي”(32).
بين لنا التصوير السينمائي الشعري هيئتها وبنيتها الجسدية (نحيفة، وطويلة، تشبه جينفر أنستون) وهي تتمشى، قادمة نحو الشاعر/ الكاميرا، من لحظة خروجها من سيارة الأجرة، إلى تقدمها نحو عين العدسة لتدخل في المشهد، فيمتلئ إطار الكاميرا مع استمرارها في التقدم، ويكبر وجهها وشكلها، وتتضح ملامحها أكثر، هكذا إذن تغيرت زاويا التصوير، وزوايا النظر إلى موضوع الصورة، من التركيز على القامة، إلى التركيز على الحذاء الفضي، فالانتقال إلى العينين الضاحكتين الواسعتين، ثم التركيز أكثر على عين واحدة مع التدقيق في خيطٍ نيليٍّ على حافة جفنها السفلي.
إذا ما سلمنا بأن الصورة السينمائية المتحركة “إطار جمعي ومتعدد له أبعاد مختلفة، ومتورطة في الواقع كموضوعات وأشياء وأجساد ورموز، وتورطها يعني أنها “تعكسه”.. ولا تكتفي بإظهار ما هو موجود بل تدخل ضمن التوتر الدلالي السائد في مجتمع معين، تتورط في صراع المعنى بحيث تصوغ بعض تفاصيله”(33) على شكل أنساق معلنة، فإن المشاهد السينمائية في الشعر تتضمن أنساقًا ثقافيةً مضمرة معيبة تنطوي عليها العقلية الأمريكية الزائفة، هذا ما يؤكده المقطع الشعري التالي:
“لَسْنَا مُمَثِلِينَ ثَانَوِيينَ فِي فِيلِمٍ أَمْرِيكِي
مَعَ ذَلِكَ تَجْرِي مِيَاهُ الأَمْطَارِ
بِمُحَاذَاةِ الرصِيفِ
وَتَحْمِلُ امْرَأةٌ حَقِيبَةً وَرَقِيةً
بِهَا حِذَاءٌ بَدِيلٌ يُنَاسِبُ وَظِيفَتَهَا
وَيَجُرُّ آسْيَوِي حَقِيبَةَ سَفَرٍ عَلَى الرصِيفِ
وَيَصْطَف الناسُ أَمَامَ عَرَبَةِ مَأْكُولاَتٍ
بَيْنَمَا أَوْرَاقُ الأَشْجَارِ مَغْسُولَةٌ
وَالإِشَارَاتُ تُبَدلُ أَلْوَانَهَا بِحِيَادٍ”(34).
يسعى الشاعر إلى تقويض المركزية الأمريكية والتنبيه إلى تغولها وتسلطها، مع التأكيد أن ما يحدث، أشبه بتمثيلٍ، نتخذ فيه نحن العرب الدور الثانوي “الكومبارس”، وننتظر دورنا أمام عربة المأكولات، وتلهو بنا الرياح كأوراق الأشجار المغسولة، وننتظر “الإشارة” في فيلم غير محبوك الصنعة والإخراج.
ومن المشاهد اليومية ينتقل بنا الشاعر -ضمن استراتيجية “الميتا مشهد”- إلى الاشتغال على المشاهد الفيليمة المأخوذة من أفلام السينما الأمريكية المعاصرة، شَاهَدَهَا في ما سبق، ثم عادت لتظهر في نصوصه، مما يدل على أن الشاعر متابعٌ جيدٌ لجديدها ولقديمها، وتصبح السينما في لحظات الغربة والوحدة الشبيهة بالاحتضار بلسمًا ومواساة:
“لَيْسَ ثم مَا يُحِيطُنِي فِي احْتِضَارِي
غَيْرُ عُلَبِ الأَدْوِيةِ البُرْتُقَالِيةِ
وَأَفْلاَمٍ عَتِيقَةٍ
وَصُورِ شَابيْنِ أَنْقَذْتُهُمُا
مِنَ السقُوطِ فِي لُجةِ الثلْجِ”(35).
وفي الليالي الطويلة، يجلس صامتًا أمام قناة الأفلام الأمريكية:
“أَسْتَمْتِعُ بِالقُبَلِ التِي يَتَبَادَلُهَا أَبْطَالُ الأَفْلاَمِ الأمريكيةِ
وَأَتَكَلَمُ فِي الهَاتِفِ قَلِيلًا
وَلاَ أَنَامُ إِلا حِينَ يُولَدُ الضوْءُ
لَكِن بَطَلاَتِ الأَفْلاَمِ لاَ يَأْتِينَنِي أَبَدًا”(36).
يوظف الشاعر مجموعة من أسماء الممثلين وأسماء الأفلام الأمريكية، كفيلم “الأب الروحي”(37):
“وَدُونَ أَنْ تَتَأملَ “آل باتشينو”
الذَي كَالطاوُوسِ
فِي “الأَبِ الروحِي”(38).
كما يوظف أسماء بعض الممثلات الأمريكات الأكثر شهرة -كالممثلة Emily Blunt- وتحريكهن في الحياة العامة، أو الربط بينهن وبين تطلعات الشابات العربيات وتقليدهن في الهيئة واللباس:
“شَعْرُهَا نَاعِمٌ وَمَقْصُوصٌ حَتى كَتِفَيْهَا
فَتَاتِي التِي تُشْبِهُ Emily Blunt
عَيْنَاهَا تَضْحَكَانِ
وَمُرَاوِغَةٌ
تَرْتَدِي فُسْتَانًَا رَهِيفًا
أَسْوَدَ، وَنَحِيفًا، وَدُونَ أَكْمَامٍ
وَصَدْرُهَا يَتَكَورُ بِإحْكَامٍ يَلِيقُ بِانْدِفَاعِي”(39).
إن تشبيه صديقة الشاعر بالممثلة الأمريكية Emily Bluntهو مظهر من مظاهر الانسلاخ الهوياتي، والانسياق وراء مغريات الحضارة الأمريكية الجديدة، ومحاولة الذوبان فيها، بعد التنكر للثقافة الأصل، نظرًا لتحكمها في المصائر والعقليات، وكبحها للحريات، والارتماء في الثقافة البديلة عبر ما تفرضه في الثقافة والأزياء طرق والتفكير..
تدين الأنساق السينمائية في شعر سمير درويش السينما الأمريكية التي تنشغل بالجانب الاستهلاكي بدل الجانب الإنساني، ولهيمنتها المستبدة بكل ما هو جميل:
“أَخْرُجُ، الآنَ، مِنَ المَشْهَدِ
تَارِكًا كُتُبًا عَلَى السرِيرِ، وَصُحُفًا عَلَى الأَرَائِكِ
وَبَقَايَا أَعْشَابٍ مَغْلِيةً فِي الأَكْوَابِ
وَالكْرِيمَاتُ المُلَينَةُ عَلَى الكَمود
وَبَصَمَاتُ أَصَابِعِي عَلَى صَدْرٍ يَخُصنِي”(40).
في نهاية هذا المبحث، سنخرج نحن كذلك من المشهد السينمائي في شعر سمير درويش كما خرج هو كذلك لتوه، تاركًا فيه وفي الشعرية العربية بصمة من بصماته.
خلاصة:
يتبين لنا من خلال تتبعنا تجليات المشهد اليومي والسينما الأمريكية في شعر الشاعر المصري سمير درويش أن اشتغال شعره -سينمائيًّا- على المشهد اليومي ليس شعرية مجانية أو اعتباطية، بل شعرية مواربة مخاتلة، تُظهر وتخفي، وكل مكون من مكونات مشاهدها هو علامة سميائية دالة، تلعبُ دورًا مهمًّا في بلورة قصيدة مشهدية منفتحة.
كما أنه يسعى إلى كتابة قصيدة مشهدية تجمع الكثير من الصور المركبة الملتقطة من حياة الشارع في مشهد شعري سينمائي يرقى إلى مصاف الفن التعبيري المتكامل والمنفتح، ومن تلك الصور البسيطة، تأتي الشعرية المدهشة، وذلك بتحويلِ اليومي إلى شعر اعتمادًا على التقنيات السينمائية.
يستعين المشهد البصري في شعر سمير درويش بمعطيات سينمائية أخرى كالموسيقى والإضاءة والعتمة والحركة والكادر.
تتعدد المشاهد السينمائية في شعره: المشاهد الصامتة والصاخبة، (حياة الريف بمصر/ حياة القاهرة ونيويورك) المشاهد القريبة (الراهن) والمشاهد البعيدة (الأفق والمستقبل) الفضاءات المغلقة (هواجس النفس) والفضاءات المفتوحة (الانفتاح على الآخر)، وتكشف أنساق المواد المصورة، بقدر ما تكشف عن حقائقها.
يقوم المشهد في شعره على تتبع أوصاف الشخصيات: هيئتها، حركاتها، ويتخطى ذلك إلى الكشف عن أنساقها وأنماط تفكيرها وتطلعاتها.
يبدو المشهد اليومي في شعر سمير درويش بسيطًا وعاديًّا، غير أنه يحمل في طياته أنساقًا مضمرة، لا يصل لها القارئ إلا بالتأويل، وما قمنا به من استخلاص للمعاني، لا يقبل وجهًا واحدًا، بل وجوهًا عدة، حسب كل قارئ ودرجة فهمه وقراءته ما وراء الكلمة والصورة المتحركة في المشهد، المشهد المتحرك في القصيدة السينمائية.
الهوامش:
* عمل الشّاعر المصري سمير درويش رئيسا لتحرير مجلة ميريت الثّقافية ومسؤولًا ثقافيًّا في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويقيم حاليًا في الولاية المتحدة الأمريكية.
1- سمير درويش، الشاعر لا يقيِّم تجربته وجيلي هو الأكثر حضورًا، حاوره أحمد اللاوندي، مجلة العربي، عدد 744، نونبر 2020، ص69.
2- سمير درويش، ديك الجنّ، منشورات ميريت الثقافية، ط1، س 2021، ص29.
3- سمير درويش، مرجع سابق، ص69.
4- سمير درويش، المشهد اليومي للقصيدة، حاوره شريف الشافعي، مجلة الناشر الأسبوعي الإمارتية، عدد أكتوبر 2021، ص22.
5- أحمد كامل مرسي، مجدي وهبه، معجم الفن السِّينمائي، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، س1973، ص202.
6- أميمة عبد السلام الرواشدة، التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر، منشورات وزارة الثقافة الأردنية، (سلسلة دراسات) ط1، س 2015، ص318.
7- فيلد سيلد، ورشة كتابة السّيناريو، مرجع سابق، ص183.
8- سمير درويش، يكيِّف جرائمه على نحوٍ رومانتيكيٍّ، منشورات ميريت الثقافية، ط1، س 2020، ص10.
9- سمير درويش، حاوره شريف الشافعي، مرجع سابق، ص22.
10- سمير درويش، مصدر سابق، ص13.
11- سمير درويش، مصدر سابق، ص12.
12- سمير درويش، مصدر سابق، ص17.
13- سمير درويش، مصدر سابق، ص87.
14- سمير درويش، مصدر سابق، ص11.
15- سمير درويش، مصدر سابق، ص37.
16- سمير درويش، مصدر سابق، ص33.
17- محمد اشويكة، الصورة السينمائية: التقنية والقراءة، منشورات الدار المغربية العربية، ط2، س 2016، ص33، 34.
18- سمير درويش، مصدر سابق، ص78.
19- سمير درويش، مصدر سابق، ص68.
20- سمير درويش، مصدر سابق، ص70.
21- عبد الرزاق الزاهر، السرد الفيلمي قراءة سيمائية، دار توبقال للنشر، ط1، س 1994، ص21- 22.
22- أميمة عبد السلام الرواشدة، المشهد السينمائي في الشعر العربي المعاصر، مجلة أفكار (وزارة الثقافة الأردنية) عدد 36، شباط 2019، ص16.
23- سمير درويش، مصدر سابق، ص76.
24- سمير درويش، مصدر سابق، ص71.
25- سمير درويش، مصدر سابق، ص35.
26- سمير درويش، مصدر سابق، ص12.
27- سمير درويش، مصدر سابق، ص68.
28- سمير درويش، مصدر سابق، ص90.
29- سمير درويش، مرايا نيويورك، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، س 2016، ص: 11.
30- سمير درويش، مصدر سابق، ص12.
31- سمير درويش، مصدر سابق، ص58.
32- سمير درويش، مصدر سابق، ص84.
33- محمد نور الدين أفاية، الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويل، منشورات عكاظ، ط1، س 1988، ص21، 25.
34- سمير درويش، مصدر سابق، ص70.
35- سمير درويش، مصدر سابق، ص102.
38- سمير درويش، مصدر سابق، ص11.
37- فيلم “الأب الروحي”: فيلم جريمة أمريكي صدر سنة 1972م من إخراج فرانسيس فورد كوبولا وإنتاج ألبرت رودي، وسيناريو كوبولا وماريو بوزو، وهو مقتبس عن رواية أمريكية.
38- سمير درويش، مصدر سابق، ص29.
39- سمير درويش، مصدر سابق، ص90.
40- سمير درويش، مصدر سابق، ص30.