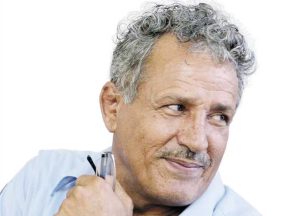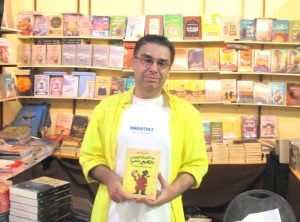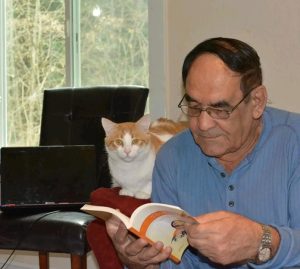حاوره: محمد زين العابدين
شاعرٌ كبيرٌ ومثقفٌ عضوي فاعل من جيل الثمانينات استطاع في خضم حركة شعرية مرتبكة موَّارة بالتغيرات أن يصنع لنفسه خطاً متفرداً وأسلوباً خاصاً به منذ أن أصدر ديوانه الأول “قطوفها وسيوفي” في عام 1991، ومروراً بدواوينه الغزيرة التي ترجمت جميعها، ومن أبرزها: “موسيقى لعينيها/خريفٌ لعينىَّ”-“كأعمدة الصواري”-“من أجل امرأة عابرة”-“غرامٌ افتراضي”-“أبيضٌ شفاف” والذي نال جائزة أفضل ديوان شعري عام 2016-“مرايا نيويورك”، وحتى أحدثها “ثائرٌ مثل غاندي.. زاهدٌ كجيفارا”، فهو-وإن كان أحد أقطاب قصيدة النثر-لم يلج إلى عالمها مجاراة للموجة الرائجة أو رفضاً للإيقاع الشعري في حد ذاته، وإنما لأنه رآها إضافة جديدة لجماليات الشعر العربي، وكشف لأرض بكر لم تطأها أقدام الشعراء من قبل، بل إنه في دواوينه الثلاثة الأولى كان شاعراً تفعيلياً، ومن هنا كان دخوله لعالم قصيدة النثر عن وعى وخبرة شعرية مكتملة، فامتلك أسلوبه الخاص الذي يتكئ بقدرٍ كبيرٍ على المشهدية المتمثلة في التقاط المفردات البسيطة والمشاهد العابرة، وتحويلها إلى ومضات شعرية مدهشة، كما استفاد من تكاملية الفنون، وهو من أكثر الشعراء احتفاءً بالأنثى في شعره، فهو يراها النصف الذي يكمل القصيدة، فالقصيدة نفسها امرأة مخاتلة كما يقول.
اشتبك سمير درويش مع الواقع الثقافي بإيجابية وتجرد فقدم أداء ناجحاً في كل المجالات التي خاضها مديراً عاماً بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومديراً تنفيذياً باتحاد الأدباء العرب، وعضواً باتحاد الكتاب، كما قدم نموذجاً مضيئاً في الصحافة الثقافية من خلال رئاسته لمجلس تحرير مجلة “الثقافة الجديدة”. حول شعره وانطباعاته عن الواقع الشعري والثقافي كان لنا معه هذا الحوار:
* قلت سابقًا إنك اخترت كتابة “قصيدة النثر” بعد تردد وتساؤل كبير.. هل يمنعك هذا الاختيار من التفاعل والتحاور مع الجيد من أشكال الكتابة الشعرية الأخرى؟
– “قصيدة” النثر” –في رأيي- إضافة جديدة إلى جماليات الشعر، وكشف لأرض بكر لم تطأها أقدام الشعراء القدامى، فالشعر العربي طوال تاريخه اعتمد على “التشبيه” في صنع صورة مدهشة، وتطور الشعر بتطور صناعة الصورة من خلال التشبيه الصريح، فالاستعارة: التصريحية والمكنية، ثم المجاز بدرجاته، وأصبحت قدرة الشاعر تتجلى عن نظرائه في المباعدة بين المشبه والمشبه به، أو –بتعبير آخر- إيجاد علاقة بين ما لا علاقة ظاهرية بينهما، وهو ما قاد إلى الغموض، بدءًا من تجربة جماعة شعر في لبنان، وفي تجربة محمد عفيفي مطر، ثم شعراء السبعينيات في مصر، إلى أن انسد الطريق ولم يعد ثمة أفق، وكانت “قصيدة النثر” هي طوق النجاة، لأنها تخلت عن الشكل الجمالي التقليدي القائم على صنع صورة من خلال التشبيه وتدرجاته، واعتمدت ما نسميه “مجاز النص” بالنظر إليه كوحدة مكتملة، يصنع المفارقة بين الأشياء داخل النص والأشياء ذاتها خارجه.
هذا لا يعني أن الأشكال الأخرى لا تصنع المفارقة الجمالية، لكنها تصنع مفارقة قديمة، لا تحتاج من الشاعر إلى كثير عناء ليشكلها لأنها متاحة على الطريق، فعلها الشعراء العرب لقرون طويلة، الفارق فقط في مسحة الآنية، سواء في اللغة أو الموضوع.
* كيف استفدت من تكاملية الفنون في كتاباتك الشعرية؟
– واحدة من أهم جماليات “قصيدة النثر” أنها “فككت” الجمود الذي أُدخل فيه الشعر قسرًا، سواء في الشكل أو المضمون، فلم يعد الشعر ضلفتين، ولم يعد ملتزمًا بالإيقاع الخليلي التراتبي ذي الوحدات المنتظمة، كما هجر تمامًا فكرة “الأغراض الشعرية”، مثل الهجاء والمدح والفخر.. إلخ، التي حبسته في موضوعات وطرائق تعبير بعينها، فضاقت المسافة بينه والفنون والآداب الأخرى، فالقصيدة الآن تستفيد من تقنيات القصة القصيرة، ومن أصوات المسرح، وإيقاع السينما، كما تستفيد من بناء الموسيقى ومن الفن التشكيلي والرواية، لأن القصيدة أصبحت إنسانية عامة، والديوان لم يعد مجرد تجميع قصائد مختلفة، بل تحكم قصائده وحدة في الموضوع وفي جماليات الكتابة ذاتها.
هذا موجود في تجربتي المتواضعة بكل تأكيد، فديواني الأول “قطوفها وسيوفي” الذي صدر عن هيئة قصور الثقافة عام 1991، عبارة عن قصيدة واحدة تتكون من مقاطع قصيرة، لكل مقطع عنوان ليس سوى عنوان جانبي، وقد وضعت أربعة هوامش على متن الديوان مستخرجة –بتصرف- من معجم مختار الصحاح، وبالرغم من أنه كان تفعيليًّا، إلا أن تلك السمات ميزته، حسب كلام النقاد وقتها، ووضعته ضمن الدواوين التي تحاول تقديم شكل جمالي جديد، وهو ما قاد إلى “قصيدة النثر” بشكلها الذي لا يتقيد بأي تعليمات ولا أشكال سابقة عليها، فكل نص جيد تجربة جديدة في ذاته.
* ركزت في شعرك كثيرًا على تجليات الجسد الأنثوي.. كيف تنظر لتجربتك في هذا الصدد مقارنة بتجربة نزار قباني؟ وما الذي تمثله لك الأنثى؟
– الجدل الشعري مع جسد الأنثى لم يبدأ مع “نزار قباني”، هذه فكرة عامة مغلوطة ساعد عليها جرأة بعض قصائده وخفَّتها التي ساعدت على انتشارها، فإذا قرأت “أبو نواس” مثلاً، وآخرين من القدامى والمحدثين، ستجد ما هو أكثر صدقًا وعمقًا وجرأة من كتابات نزار قباني، ومع ذلك فلا أعتقد –من وجهة نظري- أن ثمة علاقة بين التجارب القديمة وتجربتي، فالأنثى قديمًا كانت حاضرة من خلال نموذج عام، ليلى أو عبلة أو سلمى أو بثينة، تلك النماذج التي خلدها الشعر العربي القديم، لكن المرأة حاضرة في نصوصي بذاتها، بأوصافها وحكاياتها وتبدلاتها وشغفها، لا أستعيض عنها بنموذج تراثي، كما أنها النصف الذي يكمل الكون ويكمل القصيدة، والذي بدونه لا يمكن رؤية العالم بشكل صحيح.
القصيدة نفسها امرأة مخاتلة، تتبدل وتتنوع وتتشكل بشكل جديد في كل مرة، قد تأتيك كل ليلة وأنت تجلس وحيدًا في عالمك الخاص، وتكتب نفسها بأصابعك، وقد تخاصمك فتأتيك كل شهر، أو كل عدة أشهر، وقد تهجرك تمامًا ولا تأتيك أبدًا، النقاد يستخدمون مصطلح “جسد” لوصف النص لتأكيد أنثويته، وبالفعل هناك تشابه بين الجسدين، فحين أكتب قصيدة أجد نفسي -تلقائيًّا- أحافظ على تشكيل وانسيابية المكتوب بالنسبة إلى الفارغ في الصفحة ليأخذ شكلاً انسيابيًّا، فأحيانًا أعيد تقطيع الجمل ليصنع تتابعها موسيقى ما، لا تجرح العين، ولا تعطي للقارئ انطباعًا بالعشوائية أو بسيادة البياض، لذلك لا أتعاطف مع القصائد التي يتم فرطها طوليًّا، في كل سطر كلمة أو اثنتين أو ثلاثًا، مع ترك مساحات فارغة مبالغ فيها بين السطور، فهذا المشهد يؤلم عينيَّ وأحاول أن أتجنبه.
* باعتبارك مبدعًا في التقاط التفاصيل الصغيرة وتحويلها لمشاهد شعرية مدهشة، ألا تتفق معي أن الآلاف اعتبروا أن الكتابة عن أى أشياء ساذجة بطريقة سطحية لا يمكن أن تصبح شعرًا؟
– سأحدثك هنا عن شيئين: الأول أن الشعر العربي في تاريخه الطويل يُكتبُ عن اللحظات المميزة في الحياة، الناتئة التي لا تشبه غيرها ولا تحدث باستمرار، كرجل يأكل من القمامة، أو طفل ينام في الشارع، أو امرأة اضطرتها الظروف إلى الانحراف.. إلخ، ناهيك طبعًا عن الكتابة عن الحروب والموت والعشق، وهي مواقف تم تدويرها كثيرًا لتشابهها وندرتها، مع الاعتراف أنها لا تصف الواقع –الآن وهنا-، وأنها في الغالب تكون محملة بشحنة عاطفية فائضة عن الحاجة، ربما كانت مطلوبة في زمن ما، لكنها ليست مطلوبة الآن مع تعقد الحياة وتقدم وسائل الاتصال بما تقدمه للناس لحظيًّا من أخبار وتعليقات وصور وفيديوهات، جعلت دور الشعر يتراجع في وصف تلك الأشياء.
الثاني أن قدرة وموهبة الشاعر تتجلى في الكتابة عن هذه التفاصيل الصغيرة، فالشاعر حين يكتب مشهدًا “يبدو” محايدًا، أو هو “يوهم” قارئه بأنه محايد، يصف ما يدور بلغة بسيطة منسابة لا تسكب الدموع ولا “تتشحتف”، الوصف الحقيقي له هو “ادعاء الحياد”، أو كيف تقنع القارئ أنك غير متورط فيما تقوله، في حين أنك متورط فيه للنخاع؟ التورط يكون في اختيار الحالة أو المشهد، وفي طريقة التناول، وهو أمر في غاية الصعوبة، وهو –بالضبط- ما يفرِّق بين نص جيد وآخر رديء، بالتأكيد مع تحميل هذا “النص التقريري المحايد” بجماليات الشعر، حتى لا يكون مجرد كلام مرصوص يمكن أن يُكتب كمقال مثلاً.
* ترجمت كل دواوينك الشعرية إلى الإنجليزية والفرنسية.. فهل أنت راضٍ عن مستوى ترجمتها؟ وهل تحتاج ترجمة الشعر لمترجم له مواصفات خاصة؟
– أنا لا أجيد اللغات الأجنبية بشكل يجعلني أحكم على الترجمة إن كانت جيدة أم لا، في البداية –حين بدأت “سوسن فقيه” في ترجمة الديوان الأول إلى الإنجليزية- كنت أقرأ على قدر ما أفهم، وأدفع بالترجمة لآخرين ليقرؤوها، لكنني كنت مطمئنًا وما زلت، أولاً فهي ترجمت دواويني لأنها –كما قالت لي- مست شيئًا داخلها، وهذا جيد في العموم لأنه يجعل المترجم متوحدًا مع النص ومتواصلاً معه بشكل كبير، ولأن دار “أوستن ماكولاي” العريقة في إنجلترا قبلت الترجمة وشرعت في نشرها، ومن المعروف أنها دار كبرى لا تغامر باسمها ومكانتها وسمعتها، ولا تنشر ما لا ترضى عنه، وبالفعل فالمراجع لم يغير في النص، وفي كثير من حالات الخلاف كان يقتنع بما تقوله المترحمة.
النص الشعري روح عميقة، يتكون من شبكة من العلاقات والدلالات الثقافية والدينية والتاريخية واللغوية، كل كلمة فيه إشارة إلى أشياء خارجه، لذلك فهو يحتاج إلى مترجم يفهم هذه الروح، ويلتقط الأبعاد الثقافية التي تحفل بها الكلمات. هل تحقق هذا في ترجمات نصوصي؟ لا أعلم، لكن بلا شك فإن الشاعر المحظوظ هو من يتوفر له مترجم جيد، والمترجم الجيد ناقد ممتاز، إن لم يضف للنص فعلى الأقل لا يهمل أي من إشاراته.
* في عنوان ديوانك الأحدث “ثائرٌ مثل غاندي.. زاهدٌ كجيفارا”؛ هل قصدت من هذه المفارقة التعبير عن رؤيتك للثوري الحقيقي كما يجب أن يكون؟
– لا.. قد تعطي القراءة الأولى للعنوان هذا الانطباع، لكن عند القراءة ستكتشف المدلولات الحقيقية، وبشكل عام فأنا لا أميل للكتابة عن الأحداث الكبرى أو الشخصيات الإشكالية، تجربتي في معظمها ذاتية، وأنا لست بطلاً إشكاليًّا بقدر ما أنا شخص عادي يحب أن يتأمل من وما حوله ويغوص في أعماق ما يراه، ليكوِّن رؤية تخصه، ومن ناحية أخرى فإن اختيار عنوان لديوان شعر مسألة صعبة جدًّا، غالبًا أختار اسمًا بعد الانتهاء من الكتابة، وأحيانًا يفرض نفسه عليَّ من اللحظة الأولى، وفي كل الحالات أحب أن يكون جاذبًا نوعًا ما، ويصف التجربة بالكامل، لهذا لم أضع عنوان قصيدة داخلية عنوانًا للديوان ككل أبدًا، بل أختار عنوانًا جامعًا، غالبًا يكون سطرًا ما لافتًا في قصيدة، بنفس منطوقه أو ببعض التحوير.
* من خلال متابعتك وإشرافك على مجلة”الثقافة الجديدة”.. كيف تقيم المشهد الشعري الآن؟ وهل الشعر في رأيك يمر بأزمة فى النشر والرواج؟
– المشهد الشعري في مصر غني بالفعل، يظهر هذا من عدة أشياء: الأول أن هناك عدة أجيال تكتب القصيدة بتباينات واسعة، من أول حيل السبعينيات الذي يكتب قصائد مجازية عميقة، حتى جيل الفيس بوك الذي يكتب نصوصًا بسيطة كالكلام العادي واليومي. الثاني أنك تستطيع أن تحصي عددًا من الشعراء الجيدين في كل جيل، يكتبون باضطراد وينشرون، وقد ساعدت دور النشر الخاصة على سرعة نشر هذا النتاج المتنوع. الثالث أن هناك أنشطة متنوعة في شكل أمسيات وندوات لتقديم هذه “الشعريات”، مع متابعات نقدية تلهث وراء هذا الكم والكيف لتحيط به وتقرأ جمالياته، وهو مشهد ثري بالفعل لم يكن موجودًا من قبل بهذه الكثافة.
في “الثقافة الجديدة” ننشر خمس عشرة قصيدة في كل عدد، وعشر قصص، ووضعنا قاعدة أن المبدع لا ينشر نصًّا جديدًا إلا بعد مرور عام على الأقل، ومع ذلك فالمتاح أكثر من قدرتنا، خصوصًا أننا المجلة الوحيدة في مصر التي تصدر بانتظام، والتي توزع 100% مما تطبعه، وهذا بالطبع يضع على كاهلنا مسئوليات نحاول أن نكون على قدرها.
*في ظل تدهور الصحافة الثقافية كيف تمكنت من إعادة الحياة لمجلة الثقافة الجديدة؟وفي رأيك ما الذي يجعل المطبوعة الثقافية سلعة جاذبة؟
– تجربتي في “الثقافة الجديدة” واحدة من التجارب المهمة في حياتي، فقد آمنت منذ البداية أنني أستطيع –مع هيئة التحرير- أن أُخرج مطبوعة مهمة تعكس الواقع الأدبي في مصر، ولا تنحاز لأحد على حساب أحد، بل يكون انحيازها للجودة فقط، ومهمتها اكتشاف الأصوات الجديدة وإبرازها، خاصة أولئك الذين يعتقدون أنهم بعيدون عن العين والقلب، وبالفعل اجتهدت في البحث عنهم بمساعدة أصدقائي في الأقاليم، كما أننا أعددنا عدة ملفات في غاية الأهمية، تواكب الانشغالات الثقافية العامة لدى القارئ والمواطن المصري والعربي، كما ركزنا على مواجهة الأفكار الظلامية التي تؤدي إلى الإرهاب، وناقشنا توغل السلطة والانفراد بالقرار.. إلخ، وأتصور أنها رسالة أديناها بنسبة نجاح معقولة.
* كانت لك تجربة مميزة في بداياتك في ميدان الرواية.. هل استنفذت رغبتك في التعبير عن نفسك من خلالها؟
– حين بدأت في كتابة “خمس سنوات رملية” في أكتوبر 2002، لم أكن أقصد كتابة رواية، لكنني كنت –قطعًا للممل بعد انتهاء تجربة شعرية عميقة- أسجل على جهاز الكمبيوتر بعض الخطابات المهمة التي وصلتني وأنا أقيم في السعودية، خوفًا من ضياعها مع ما تمثله من ذكريات، ثم بدأت أسجل بعض الانطباعات حولها، فاتسعت المسألة حتى صارت على الشكل الذي خرجت به، وقد كتبتها في حوالي شهرين ونصف، وبعدها وجدت أن لدي ما أقوله أيضًا امتدادًا لتلك التجربة، وربما أردت تجريب شكل جمالي أعقد في الكتابة، فكتبت “طائر خفيف”، ورغم أنهما فازتا بجائزين، إلا أنني لم أشأ أن أكرر التجربة لأنني لست روائيًّا، أنا شاعر أراد أن يستريح قليلاً فكتب روايتين.. هذا كل ما في الأمر! وقد اعتذرت عنهما لاحقًا، وقلَّما أذكرهما، كما لا أحب أن أهديهما لأحد.
* في مذكراتك التي انتهيت من جزئها الأول هل انتهجت الصراحة التامة؟ أم أنه يظل هناك حاجز أمام الأديب في مجتمعنا يمنعه من الصراحة التامة؟
– في اليوميات كتبت عن شخصيات مازالت موجودة من قريتي ومن عائلتي، وكنت أعرف أن بعضهم يتابع ما أكتب حين أنشره على صفحتي في فيسبوك، وكثيرون من الشباب الأصغر الذين لم يعيشوا الفترة التي كتبت عنه –من 1965 إلى 1975- قالوا إنهم عرفوا حكايات عائلاتهم مما كتبت، وهي كتابة صادقة إلى حد الصدمة، لدرجة أن كثيرين من اصدقائي تحدثوا معي مشفقين، من خلال الرسائل الشخصية أو مباشرة، وقالوا: هل تجد ضرورة لهذا الكشف؟ هم طبعًا تفاجأوا بما كتبته عن صور الفقر والجهل التي عايشتها في طفولتي في قرية بعيدة عن الأعين، وهذا كان حال القرى جميعًا وقتها على أي حال.. لكنني واصلت بدافع رأيته –ومازلت- مهمًّا جدًّا، وهو توثيق شكل الحياة في القرية المصرية في الستينيات من القرن الماضي، ليكون مادة خام أمام الباحثين عن الحياة الاجتماعية في مصر، والتراث الشعبي في الريف المصري، طبعًا إلى جانب توثيق مشاهد من حياتي ومعاناتي الشخصية.
أنا أصلاً أكتب الشعر بنفس منظور الكشف هذا، على قاعدة أن القصيدة شهادة على زمنها، حين يقرأها شخص بعد خمسمائة عام –بفرض أنها عاشت-، يمكن أن يعرف أحوال مصر في فترة كتابتها، وهي رسالة فشل الشعر العربي في تحقيقها على مدى تاريخه، إلا قليلاً، فقد كانت هنالك مبالغات وأكاذيب وانتحال وتضخيم للأمور.. إلخ.
* يبدو أنك مرتبط جدًّا بمسقط رأسك في بنها بدليل أنك حتى الآن لم تجذبك نداهة العاصمة للإقامة فيها.. ماذا تمثل لك؟
– مدينة بنها قريبة جدًّا من العاصمة، ربما أقرب من المسافة بين حلوان ووسط البلد مثلاً، ما يجعلها جزء من القاهرة وليست من “الأقاليم” كالمدن البعيدة، وأنا أسكن في بنها وأعمل بالقاهرة طوال عمري المهني، أسافر منها وإليها يوميًّا دون عناء.. ومع ذلك فأنا مرتبط بها فعلاً، لأن نمط الحياة في المدن الصغيرة يناسب تكوين شخصيتي أكثر، فهناك ألفة أكثر وزحام أقل. أنا لا أحب الحياة في القرى لأنني عانيت من قريتي في طفولتي، ولا تستهويني الحقول وأشجار المشمش ولون البرسيم كما يستهوي سكان المدينة، لأنني انغرست في طينها صغيرًا، وحلمت بالخلاص منه حين أشتد، وقد فعلت. القاهرة مدينة كبيرة جدًّا لدرجة تفوق احتمالي، وعشوائية بشكل هستيري، فإن لم تكن قادرًا على الحياة في أحد أحيائها الهادئة –وبالتأكيد لن تقدر-، فإن المدن الصغيرة القريبة هي الحل.