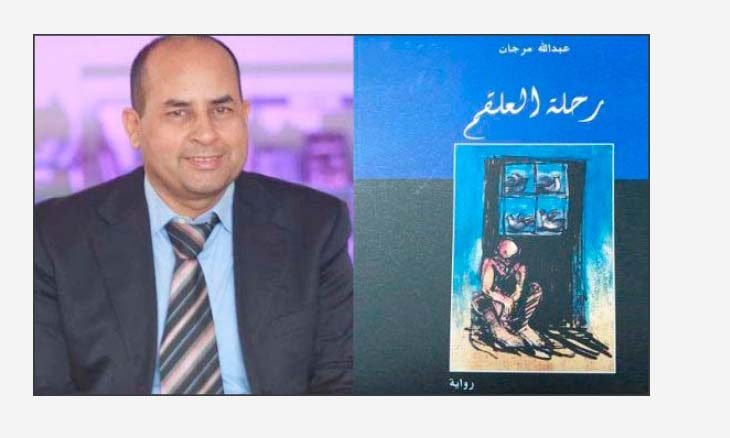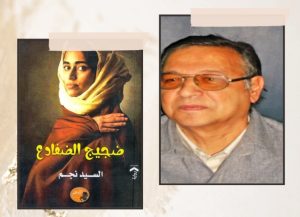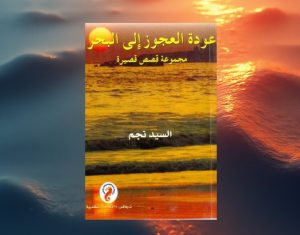إبراهيم الحجري
- تمهيد:
ينفرد النوع الروائي بكونه جماع تجارب إنسانية قد يعيشها الرواة والشخوص بقدر ما يعيشها أناس حقيقيون في المجتمع، حيث يعمل المحكي على تأسيس عوالم شبيهة بالواقع، مستنبتا فيها بنيات متخيلة تضيف إليه من الإدهاش والدراما الشيء الكثير، ليكون مرآة قادرة على إبراز الظواهر الإنسانية المثيرة التي تقض مضجع الكاتب؛ باعتباره كائنا واعيا بالمصائر والتحولات، ومشخصا عالي التصوير لما يعتمل في محيطه من تقاطعات مرئية ومخفية.
كانت هذه المقدمة ضرورية لإضاءة رواية “رحلة العلقم” التي تكاد تستضمر أنواعا سردية كثيرة، تتداخل وتتقاطع؛ صانعة إبداعيتها المتفردة في خلخلة المفاهيم والأسس المتحققة في النوع الروائي، مشيدة عوالمها بأسلوب خاص يمتح من البنية التخييلية قدر ما ينهل من تجربة شخصية للكاتب، الذي رأى في العامل الذات مرآة يمكن للمجتمع عامة، أو الجيل الجديد خاصة، التمظهر فيها، وتأمل وجهه عبرها، لأخذ العبرة وإعادة بناء العلاقات والعوائد والنظر إلى الآخر والتموقف منه.
- رحلات متوازية
وكما هو متضمن في العنوان، نصادف مقولة مفتاحا، بقدر ما تحمل من دلالة خفية، تكشف الفحوى، فهي تضع المتلقي أيضا، أمام إضاءة “جنسية” تومئ إلى نوع سرديّ متميز، يعلن من خلاله الباث عن نوايا تواصلية معينة، وهو أن النص يستضمر رحلة ما أو سفرا ما، له بداية ونهاية، وله مسار خاص، تتخلّله منعرجات ومفاصل، على اعتبار أن الرحلة نفسها ما هي إلا نوع سردي وسطي بين التاريخ والرواية، بحكم أنها تعالج، على غرار الرواية، مغامرات الأفراد، لكن بكثير مما لا تحتمله القصص من الدقة والموضوعية والحقيقة النسبية[1].
تتخذ رحلة البطل طويرة وجهة محددة؛ حينما ترتبط بمضاف (العلقم) يحدد طبيعتها، وهويتها. فالعلقم، وهو نبات الحنظل ذو الطعم الشديد المرارة[2]، يضيف إلى مفهوم “رحلة” ما يستشف منه معنى العناء والألم، أي أن السفر المنشود داخل المتن الروائي، هو سفر محفوف بالتحديات، والإخفاقات، والصعوبات الجمة التي صادفها الرحالة في مساره المحفوف بالأشواك والمطبات والعوائق، وذاك ما سيسفر عنه عوالم الرواية، فمن المحتمل أن تكون الرحلة مجازا كبير استعاره المتن ليكشف عن بعض جوانبه الغامضة عبر العتبات النصية الأولية، ومن الممكن أن يكون السفر جزءا من هذا العالم، ومكونا أساسيا من مكوناته، إذا ما استحضرنا أن الرواية تنفتح دوما على رحلة ما، يجتازها البطل بالضرورة، وهو يعبر المسالك المتداخلة بين نقطة الانطلاق (أ) أو الوضعية البدئية، ونقطة الوصول (ي) أو الوضعية النهائية، مرورا بمحطات تحول مفصلية، تمنح للمسار السردي إثارته، وإيقاعه المتذبذب بين لحظات انتشاء ولحظات انكسار، بين تفاؤل ويأس، بين فرح وحزن، بين صمود وتعثر، بين وعي وتيه… وغير ذلك من ثنائيات صدامية تمنح مسار البطل فحواه الإنساني، وتخلق، في النص، حلاوة التلقي، وطعم الغواية، وكأنّ الرّاوي العليم، بإصراره على تمثيل تلك الرّحلة العلقمية، يصنع قدر الشّخصية، ويرهن زمنها وفضاءها بتلك المتاهة الرحلية، وطبيعة نهايتها، وانعكاسها على سيرورة التحوّلات.
تتوزع رحلة الاستشفاء بين خطين متوازيين:
- رحلة استشفاء طبيّة عصرية قادته ووالده إلى مستشفى 20 غشت (ميريزكو) التي قضى فيها مدة طويلة دون جدوى؛
- رحلة استشفاء تقليدية كرّس الوالد، من خلالها، جهده للعثور على دواء تقليدي عند عشاب شهير بمدينة مازغان الساحلية، دون أن يفرط في عادة الأجداد، من خلال التبرك بأولياء الله الصالحين، أوتاد البلدة وحماتها مثل ضريح سيدي مسعود بن احسين بقرية أولاد افرج.
غير أن المتن الروائي متخلل برحلات ثانوية يقوم بها طويرة؛ بحثا عن الذات، بعد تصالحه مع جراحه وإيمانه بقدره، وثقته بجسمه وعقله، مثل رحلة العمل في سلك التعليم الابتدائي، وما صادفه خلالها من عراقيل وطرائف ومعاناة، مبرزا الوضع الاعتباري المزري لرجل التعليم بالبلاد، ومعريا هشاشة الظروف التي يشتغل فيها بقرى نائية تفتقر إلى أبسط المرافق، حيث يبيت ليله الحالك في الظلمة، ويقضي حاجته البيولوجية بالعراء، ويستعين على صعود الجبل بخدمات حمار، ويأكل مما تجود به عليه أيادي الجيران مثل شحاذ عابر. ولا ننسى أيضا رحلة النضال إلى الرباط من أجل العمل، ثم بعد ذلك من أجل الإدماج والترسيم، وما تعرض له طويرة ورفاقه من تضييق السلطة واعتداء بالعصي وخراطيم المياه الباردة، وكذا رحلة الدراسة إلى أولاد افرج وما تخللها من محن الإقامة في دار الطالب، حيث الجوع والقهر والاستغلال، ورحلة الجامعة التي شكلت منعطفا حاسما في تشكيل شخصية البطل، وتكوين مواقفه ورؤاه، وتثقيف ذاته، وانفتاحه على الآخرين، ونسج علاقات تسمو بالروح، وتضاعف من ثقته بنفسه، خاصة علاقات الحب العذري التي ربطته بطالبات من خريبكة وآسفي وسطات واليوسفية في مدينة بحرية تمتعت، آنذاك، بوضع كوزموبوليتانيّ.
- تجربة إنسانية حافلة:
لا يولي العمل الروائي كبير عناية للأساليب والتقنيات السردية وحيل الكتابة، وإن كان لا يخلو من كثير منها كالحوار والاسترجاع (الفلاش باك) والقفزة والفجوة والاستباق، بحكم أنه ينساق كليا للتركيز على فحوى الرسالة، وهو تبئير التجربة (تجربة طويرة) ما أمكن، بوصفها امتحانا بشريا قمينا بالتأمل والتمثل وأخذ المثال: (ضع في ذهنك أن الحياة رحلة بين جبل “ولد بوشتة” وقرية “بوسعيدة”، كلما صعدت جبلا وبلغت قمته يظهر خلفه جبل آخر، فإما أن تعود أدراجك، أو تواصل المسير لتبلغ قمة الجبل التالي… هكذا هي الحياة، مشقة وتعب لا ينتهي)[3]. وما طفا على السطح من أدوات سردية حصل بمحض الحاجة أو الصدفة، ولم يتم الزج به قسريا لإضفاء سمة التجريب على العمل. وبما أنّ (رحلة العلقم) هي العمل الافتتاحي والباكورة الأولى لعبد الله مرجان، فإن غايته الأولى التي ركز عليها، هي ترك جزء من هويته في السّرد، وإقحام شيء من الدم والألم والعرق والروح والدموع في جوهر النص، حتى إن المتلقي يستشعر نحيب الراوي، ويتلمس مرارة دموعه ودمائه تسيل بين الأسطر والأحداث والحكايات، وفي كلّ منعطف يترك طويرة جزءا منه، لا بد أن يتألم القارئ، متعاطفا معه، وهو يصارع معاول الهدم، مقاوما عواصف وسياط المحن، وهي تجلده بلا رحمة ولا شفقة. يقول الراوي: (يسترسل الفتى في البكاء وتحمل المشاق، وتجاوز كل الصعاب، ركب التحدي من جديد، أضحى يستفيق قبل موعد أول حصة دراسية بحوالي ثلاث ساعات، يستغرقها للوصول قبل موعد أول حصة دراسية بحوالي ثلاث ساعات، يستغرقها للوصول إلى “السكويلة” بمعدل ساعة في الكيلومتر الواحد، يحمل هم إعاقته وشغف مواصلة دراسته أملا في تأمين مستقبله، وأن ينسيه ذلك مرارة إعاقته، لكي لا يكون عالة على غيره”[4].
- محكي سير-ذاتي:
يحضر المحكي السير-ذاتي بقوة، وإن كان الحكي، في غالبية المقاطع، يتم بضمير الغيبة، استنادا إلى منظور التبئير الخارجي، بتعبير جيرار جنيت، إذ يستعرض السارد حياة الشخصية الرّئيسية “طويرة” منذ طفولته المبكّرة في قريته الصّغيرة المُطلة على وادي أمّ الربيع، مرورا بأهم حدث في حياته، وهو انزلاقه في حافة السفح العالي، وهو يعدو خلف قطيعه كمهر أطلق سراحه للتو من اسطبل مظلم. قلب هذا الحادث الأليم الذي أتلف أعصاب إحدى رجليه، مساره رأسا على عقب، موقعا الطفل البدوي الحركيّ في ورطة أجلت أحلامه، وعصفت بمواهبه في اللعب، وأفقدته الريادة في قيادة جيله، وتسيد تجارب الأقران ومغامراتهم في بادية موغلة في الهشاشة. شكل هذا الحدث أزمة النص، وحبكته المفصلية، ونقطة التحوّل في المسار السردي للبطل طويرة.
يضطر الطفل لتوقيف مساره الدراسي، ليغوص في تجربة مريرة (سفر استشفائي)، بحثا عن علاج مستحيل، رافقه في والده الراحل الذي ألغى كافة أشغاله، وصار همه مداواة ابنه بأي ثمن، وهو البدوي الفقير، لا حول له ولا قوة على مجابهة مسلسل الكشوفات والتحاليل الطبية والتنقل بين المدن والمستشفيات.
لم تذهب جهود الوالد المخلوطة بالأسى والدّموع سُدى، فسرعان ما تعافى الصبي فجأة، لتدوي زغرودة والدة أدمنت الحزن والنحيب، يروي السارد قائلا: (لاح بصيص أمل حين تلمس الفتى حائط البيت، ووقف وصاح بصوت مبحوح، أماه، أماه، لقد وقفت، سمعت الأم المسكينة صوت الابن، سرى في شرايينها سرور، طارت فرحا، هرولت إل داخل الغرفة، الابن واقف على قدميه والأم تطلق العنان لزغرودة طويلة اخترقت جدران البيوت واخترق صداها آذان الجارات، وكالعادة، وفود البدو لا يخلفون الموعد، يدفعهم فضولهم لمعرفة الخبر، الابن يدب بخطوات متثاقلة، ينتقل من ركن إلى ركن في زوايا البيت، تارة يسقط وأخرى يتوقف لامتلاك أنفاسه)[5].
يعود الطفل إلى مدرسته، مستعينا بخدمات دابة اشتراها والده له خصيصا ليتخذها ركوبة تقله يوميا بين المدرسة والبيت، سالكة طرقا ترابية وعرة تخترق التلال والسهوب مثل أفعى. ومع تغير وضع طويرة، وانهيار قواه البدنية، تتأجج قدراته العقلية والفكرية، ويتضاعف ذكاؤه، وتكبر رغبته في التحدي والإصرار على خلق فرص للانعتاق والخلاص، وإعادة الاعتبار بين أقران لا ترحمه نظراتهم المريبة.
يعرف الطفل الكسير مبكرا أن سبل تحقيق الأحلام لا ترتهن إلى القوة البدنية فحسب، بل هناك وجهة العقل التي لا زحام على أبوابها. وهذا ما جعله يتفوق على أقرانه، مواصلا سلسلة نجاحات قادته على الحصول على شهادة الإجازة في الآداب، ليبدأ مسلسل متاعب أخرى، تتمثل في الحصول على عمل محترم يقيه شر إثقال كاهل أسرة فقيرة.
مع مرور الأيام، يتصالح طويرة مع قواه، واثقا فيها، فيناضل على جبهات شتى، متغلبا على كثير ممن يفوقونه قوة جسمية، مثبتا لوالده وأسرته أن أحلامهم لن تضيع في ولد راهنوا عليه كثيرا، وشيدوا على مستقبله خلاصهم من هشاشة بادية قاسية. لكن الموت يغيب الوالد، متأثرا بجراح الخيبات، وآلام السنين، وتعب الحياة، وتظل الوالدة وحيدة في قرية منسية تحرس ما تبقى من الذكريات ومجد الطفولة، حيث يعود طويرة ليحضن مجدا طفوليا غابرا بدده الزمن، والالتزامات، وخيانة القدرات الصحية، وتراكم أعباء الحياة.
يتسع المحكي لاستضمار خطابات متنوعة تستجيب لحاجات فنية وأسلوبية، فضلا عن توالي طبقات لسنية وتعبيرية متوازية، تتشاكل في صيغة ثنائيات متقاطبة، أهمها: اللغة العامية واللغة الفصيحة، ثقافة البادية وثقافة المدينة، فكر العامة وفكر النخبة، الخرافة والعقل، والمحكي الساخر والمحكي المعقول… تماشيا مع خصوصية العوالم التي ترصدها الرواية، وطبيعة الشخصيات المؤثثة لها، والمغزى المراد تثبيته في النص السردي، كما أن المحكي استدعى شخصيات مرجعية كثيرة مستمدة من الواقع بصفاتها وأساميها ومساراتها وعلاقاتها ليضيء العالم السردي في شموليته، ويبرز شخصية طويرة في الصورة التي تتغياها بنية حكاية، والملاحظ من خلال تأمل المسارات التصويرية للعوامل والفواعل والشخوص والفضاءات أنها ترسم بطابع كاريكاتوريّ يبئّر البعد التهكمي للخطاب. يقول السارد مصورا إحدى شخصياته الملعونة في المتن: (أضحى أبو المعاصي يدب على أربع بخطى متثاقلة كبغل يحمل وقرا لا طاقة له به، يسير والذباب يتبعه كالضباب، يتطاير فوق وجهه الغائر، يرتشف ماء يسيل من عينين جاحظتين، يطلق العنان لضراطه الذي لا تكبحه فرامل، ينضاف إلى نتانة “بوطه” الملتصق بقدميه في كل الفصول، وصبية القرية ينادونه “والخانز”)[6].
- رؤية نقدية للواقع المزيف:
يستضمر المتن رؤية نقدية مبطنة تستكشف السّلوكيات الإنسانية المشينة في سعي لنقضها وتقويضها، إما عبر السخرية أو المفارقة أو المقارنة أو العتاب أو التعريض المباشر، إذ يعلن كل من الراوي والشخصية سخطهما إزاء الظواهر التي يحبل بها المحيط الاجتماعي من اخلف وتفسخ ونفاق وعهر وتفكّك، مُبدين أسفهم وحسرتهم، في كثير من المواقف، إزاء ما اعترى القيم الإنسانية الأصيلة من تّراجع مخيف، ناهيك عن نقد سلط تقليدية سخيفة ما تزال تكبل انعتاق الوعي الجمعيّ، وتحتجزه في القاع السفليّ من وحل الخرافة والجهل والتملك والاضمحلال والتنافر والانتهازية والاستغلال والأنانية، وغيرها من قيم بديلة تسلطت على الفرد والمجموعة، مجهضة كل مساعي التّحرر من جحيم التقهقر والتدني والتخلف على مستويات شتى.
لم يكن طويرة استثناء في مجتمع بدويّ منهك يمزقه الجهل والرذيلة والموت البطيء والفاقة، بل هناك عدد لا يُحصى ولا يعدّ ممّن عضّتهم أقدار تعسة، فلم تفلتهم كلّابتها الفولاذية، رامية بهم في هاوية سحيقة من التّهميش والمُعاناة والضّيم، يقول الراوي: “أتعلم أننا كنا كالعبيد، وكان “النصارى” يعتبروننا الصنف المزدرى من بني آدم، لم يكونوا يتورعون عن معاملتنا كالحيوانات، نأكل البقايا ونروث، لا يهم إن لم نلبس، أو لم نقرأ، كانوا يكلفوننا بمهام تقتل في المقبل عليها ما تبقى لديه من شعور بآدميته… كنا إذا خالفنا الفرنسيس، نعلق من أرجلنا على أبواب منازلهم الفخمة تحت لفح الشمس الحارقة، بلا ثياب ما عدا تبابين ممزقة تخفي أجزاء من أعضائنا التناسلية…)[7].
وإذا كان الحظ قد ساعد طويرة في تخطّي ما صادف من حواجز ومتاهات وحفر، بفضل ما توفر عليه من مؤهلات جوانية مثل العزيمة والإصرار والصمود في جبهات شتى، فإن آخرين خانتهم قواهم ولم يجدوا ظهرا يسندهم، فلاذوا بظل خيباتهم، مستسلمين لمصائر تعيسة تودي بهم إلى الموت أو الجنون أو الضياع أو المرض دون أن تجد معاناتهم صدى في أوساط محيطهم، أو يلفي أنينهم آذانا صاغية ضمن مجموعة بشرية أفرزتهم قبل أن تتنكر لهم، معمقة جراحهم ومآسيهم.
رواية “رحلة العلقم” صرخة المعطوبين في وجه مجتمع متهالك، نكّار للجهد، ورحلة تحدٍّ مستحيلة في طريق وعر متشابك المتاريس، موغل في التيه، ودرس بليغ لأجيال المستقبل، يستحق أن يدرس، بالنظر إلى روح المغامرة والإصرار المُستضمرين في روح “طويرة” المهيض الجناح، الذي لم يثنه جرحه وضعف قوته الجسمية على مواصلة صعوده التلال والجبال بحثا عن ضوء شمس، ولم يحل بينه وبين تحقيق أحلامه ومطامح أسرته عائق، متشبثا بسند العقل والذكاء والمعرفة، وكأنه يصرخ في القوم قائلا: إن العبرة بالفكر والعلم لا بالجسد والقوة البدنية. إنها رواية السيكولوجيا المكثفة التي تغوص في أعماق الشخوص حافرة في ندوبهم الخفية، وبصيغة أخرى، هي رواية “السلوك” بحكم أنها تسعى إلى إعادة صياغة المجتمع من حيث نقض عاداته وممارساته وأفكار عناصره، وعلاقاته المتشابكة المؤسسة على اللا توازن والاستغلال والانتقائية[8].
………………..
*- ناقد وروائي من المغرب
[1]– François Bertaud, Journal du voyage d’Espagne, Paris, Denys Thierry, 1699, p.17.
[2] – ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي: لسان العرب، باب (ع.ل.ق.م)، دار صادر، بيروت، لبنان، طبعة 1997م.
[3] – عبد الله مرجان: رحلة العلقم، مطبعة سليكي أخوين، طنجة، المغرب، الطبعة الأولى، 2021م، ص. 130.
[4] – رحلة العلقم، ص. ص. 49- 50.
[5] – رحلة العلقم، ص. 47.
[6] – رحلة العلقم، ص. 112.
[7] – رحلة العلقم، ص. 12.
[8]– الظاهر قحطان أحمد: تعديل السلوك، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2012م ص. 157.