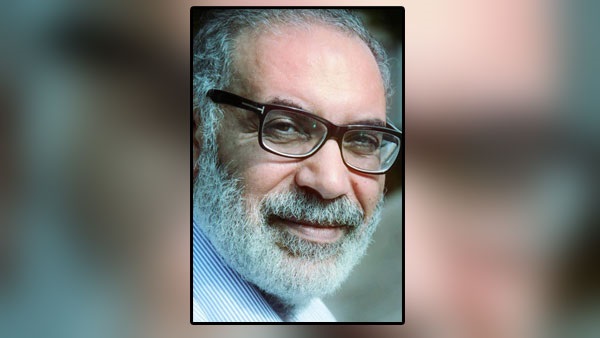الشربيني عاشور
اقترحت على عبد الله كمال (رحمه الله) أثناء رئاسته لتحرير روز اليوسف، وكان قد اتفق معي على العمل في المجلة، أن أجري حوارًا مع الدكتور سليم العوا.
نظر إليَّ كمال مبتسمًا ثم قال:
ـ وهل يقبل هو؟
قلت:
ـ سأحاول.
فقال:
ـ إذا قَبِلَ فلا مانع.
بعيدًا عن أيَّةِ تأويلاتٍ للموقف، وهو يحتمل التأويل، أو أنني لم أجر الحوار من الأساس، إلا أن هذه الواقعة تذكرتها في غَمْر واقعةٍ أخرى. فقد كتبت مقالًا أناقش فيها إمكانية إعادة النظر اللغوي في إعراب بعض الممنوع صرفيًا من الألفاظ الأجنبية التي دخلت اللغة العربية حديثًا، وغلبت على الاستعمال اللغوي، ويشكل منعها من الصرف قلقًا في الحساسية الموسيقية للغة، إذ تصبح كالنتوء نشازًا في جسد الجملة وانسيابها الجَرسي.
أرسلت المقال إلى جريدةٍ مصرية قومية كبرى فرفضت نشره بعد ركنه في مكتب رئيس التحرير لمدة شهر كامل! كانت حجة الرفض عاديةً ومبتذلة، وتمثلت في ضيق مساحة النشر الذي لا يضيق عادةً في مثل هذه الصحيفة أمام الحديث عن تورتةٍ جنسية، أو مؤخرة رانيا يوسف!
أرسلتُ المقال إلى صحيفةٍ عربيةٍ قوميةٍ أخرى فكان نصيبه الرفض كذلك، لكن الأمر لم يستغرق شهرًا كشقيقتها المصرية في البؤس الثقافي! وإنما استغرق ثلاثة أيامٍ فقط. وكانت حجة الرفض هذه المرَّة، أن كاتب المقال “ليس ذا صفة” ليكتب في مثل هذه الموضوعات. أي أنه ليس عالمًا لغويًا، وهي حجةٌ بقدر ما تضفي نوعًا من الفخامة الزائفة على الصحيفة بقدر ما تحض من شأن كاتب المقال!
احتلت على الثقة المفقودة في النشر القومي بالاستعانة بصديقٍ صحفي مسؤولًا في جريدةٍ حزبية خاصة، فنُشر المقالُ بالفعل، ولكنني لاحظت أنه نُشر في صفحة الفن. وليس في صفحة الرأي أو الأدب أو الثقافة التي هي مكانه الطبيعي. كان الأمر واضحًا أو هكذا فسرته، لقد رفض السيد المحرر الثقافي نشر المقال في صفحته، فجاء نشره في صفحة الفن نوعًا من الوساطة أو “الجدعنة” من جانب الصديق الذي أرسلت المقال إليه.
هذه الحادثة التي تخرج عن إطارها الخاص الآن؛ لتتموضع في إطارٍ عام كاشف، يعاني منه كثيرٌ من الكتاب (غير الأصحاب وغير المعروفين) تكشف بوضوحٍ عن تلك العقليات المتآكلة ذات البعد الأحادي لبعض المسؤولين عن النشر الثقافي في الصحف والجرائد، والتي يتاح لأصحابها التحكم في مصائر الفاعلين الثقافيين، فترفع في مواجهتهم بحكم الكرسي أو الأقدمية أو الحظ أو الحظوة صكوك المنع والإجازة. إمَّا خوفًا وإمَّا عجزًا عن إدراك القيمة، وإمَّا اختلافًا في الرؤية والموقف.
كما تكشف الحادثة كذلك عن ازدواجية المعايير بين ما يمضغه هؤلاء من أحاديث حول الديمقراطية والحرية والمساواة، والقوى الناعمة والخشنة والحراك الثقافي وغيرها من المفاهيم التي لم تعد تقصد لذاتها، وإنما لتجمُّل الذات وتجميل الواقع من جهة. وتنميطه وتطبيعه من جهة أخرى، بحيث يجري الاعتياد على الكلمات مفرغةً من معانيها وقطع صلاتها بأي مرجعية واقعية أو ممارسة فعلية، حيث يصبح انتشار المفهوم وترديده في مواقعهم الإعلامية بديلًا عن تحققه الفعلي في الواقع. أي أنه نوعٌ من الكذب حتى التصديق، ليسري نمط “اعطِ الإشارةَ يسارًا وانحرف بالسيارة يمينًا” بدلًا من “أشر يسارًا واتبع الإشارة” الذي تكشفه الممارسة العيانية والاحتكاك التجريبي.
والملاحظ أن هؤلاء الخطيرين على مواقعهم وواقعهم، لا يكفون عن الحديث حول تسلط الفرد وسيادة الرأي الواحد، وبث أشواقهم الملتهبة للتعددية وحرية التعبير والرأي الآخر بمبالغاتٍ تفضح زيفَ دعواهم، وتعري طبيعتَهم الإقصائية في التعامل مع معارضيهم أو مخالفيهم في الرأي، ولو في مسائلَ بعيدةٍ عن الشأن السياسي، الذي يشكل بالنسبة لهم بعبعًا يهدد أمنهم الوظيفي المبني في الأساس على نفاق السائد ومسايرته.
لقد استخدمت لفظ “الخطيرين” في وصف أصحاب هذه العقليات قصدَ المكان الذي يحتلونه، وعلاقته بالتنوير القائم على نقد السائد أو مناقشته. وهو مكان تمثل أهميته في مخاطبة الرأي العام مكمنَ الخطورة بحجب “إرادة الخلخلة” ولو في مسألةٍ لغوية، ناهيكَ عن مختَلف المجالات التي تعج بالإشكاليات الواجبة مناقشتُها، وطرحها للنقاش العام.
هؤلاء الخطيرون ـ بحكم عقلياتهم ومواقعهم ـ هم الأساس في مقاومة أي تغيير على مستويات ثقافية وغير ثقافية، سواءٌ بقصور ذاتي مثل العجز عن إدراك القيمة، أو رفض المبدأ أو إقصاء المختلف أو بقصور ظرفي بما يشكله من دوافع للخوف والممالأة. كما أنهم أحد وجوه مساءلة الواقع من جهة السبب عمَّا يعانيه من تردٍ وانحطاطٍ ثقافي.
وقد يقول أحدهم: ولكن، لا يجب النشر لكل من هب ودب.
وهو قول صحيح إذا تأملناه من زاوية المعيار التي لا علاقة لها بذات الكاتب وإنما بجسد الكتابة، أي ما يمكن الاحتكام إليه بغض النظر عمَّن يكون هذا الذي هبَّ أو ذاك الذي دبَّ. وهو معيار ـ في ظني ـ لا يخرج عن سلامة اللغة واتساق الكتابة في موضوعها أيًا كان محمولها باستثناء ما كان في ذاته تنمرًا أو فُحْشًا أو ازدراءً.
وأعود لمفتتح المقال فأقول لقد كان عبد الله كمال المنتمي لجمال مبارك مختلفًا مع الدكتور العوا أحد المعارضين لتوريث جمال مبارك، لكن اختلافه لم يمنع أن يَنشر حوارًا في موقعٍ إعلامي يتولى إدارته لمفكرٍ على نقيضٍ مع توجهاته. فمتى يدرك هؤلاء الخطيرين أن مواقعهم ليست عِزبًا يحكمونها، ويتحكمون فيها، وأن النشر لا يجب أن يتعلق بعقلية الناشر أو بذات الكاتب، وأن تعلقه الوحيد يجب أن يكون بجسد الكتابة؟ أي أن يصبح كالماء والهواء حق لكل قادر على الكتابة. وهو ما نجحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، فجرفت تلك العقليات ومطبوعاتها إلى تسوُّل الرَّاوج حتى على مواقع التواصل ذاتها!