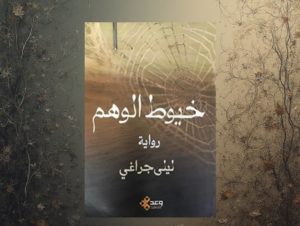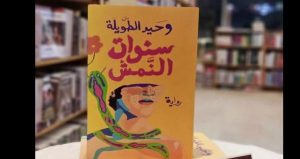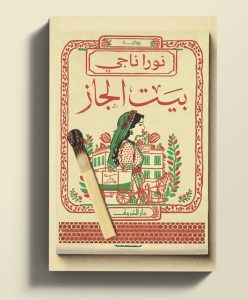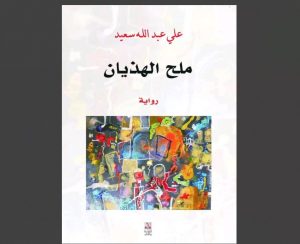د.إبراهيم منصور
يجوب سمير درويش أقطار الأرض، باحثًا عن الجمال، هاربًا من القبح، حتى لو كان القبح يرتبط بأرضه التي نبت فيها، في مدارج الصبا والشباب، فيقول سوف أسأل الله محتجًّا:
ما حاجتكْ للتراب النَّاعِم، وبِرَكِ الطِّين!
احتجاج آخر، على هيئة سؤال، سوف يقدمه الشاعر إلى العليِّ القدير:
لماذا لا تجعل الشبابيك تتحدث يا الله
ليتعرى الصمتُ الذي يحتلّني؟
ولماذا لا تتحول الأرائك الباردة.. تلك
إلى حدائق،
وقبلات مخطوفة، وعصافير
فللجمال الذي يبحث عنه الشاعر تجليات منها: الموسيقى، والوجوه والأجساد، ومنها الأشجار والورود، هي كل ما يدل على إبداع الخلق، وهندسته المغوية، حتى لو كان رصيفًا في شارع قد أُحسن بناؤه وتنسيقه، كما قرأنا له في يومياته التي يكتبها من نيويورك، على صفحته على Facebook خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠م.
أصبح سمير درويش (المولود ١٩٦٠) أكثر شعراء جيل الثمانينيات في مصر إنتاجًا، فقد أخرج ١9 مجموعة شعرية، أولها “قطوفها وسيوفي” ١٩٩١م، وآخرها “يُكيّف جرائمه على نحو رومانتيكي” (ميريت ٢٠٢٠) لكن هذا الديوان الأخير في النشر، لم يكن آخر ما كتب الشاعر، بل كان ديوانه “كامل الأوصاف” الصادر عن هيئة الكتاب في القاهرة ٢٠١٩، آخر ما كتب.
عَتَبَات
“كامل الأوصاف” نص شعري كتبه الشاعر على مدى عامين ٢٠١٧ و٢٠١٨، لم يضع فهرسًا لمحتوياته، ولا أثبت عناوين داخل صفحاته، فإذا أردنا الدخول إليه بدأنا بمداخله الطبيعية، وهي هنا ثلاثة مداخل: الأول العنوان، والثاني الإهداء، والثالث الهوامش إن وجدت.
هذه المداخل، ومعها الغلافان الأمامي والخلفي، يسميها النقاد “عَتَبات النص” هي علامات تشير إلى داخل النص وخارجه، فعنوان الديوان “كامل الأوصاف “جملة اسمية محذوف مبتدؤها” أصلها حسب النحاة “هو كاملُ الأوصاف” فمن “هو” المحذوف هذا؟
تشير عبارة العنوان إلى بيت شعر هو عنوان أغنية يغنيها “عبد الحليم حافظ” (١٩٢٩- ١٩٧٧) كتبها الشاعر الغنائي مجدي نجيب (١٩٣٦- ٢٠٢٤م) يقول مطلع الأغنية:
كامل الأوصاف فتنّي
والعيون السُّود خدوني
من هواهم رُحْت اغني
آه ياليل.. آه يا عين
لم يرد داخل نص الديوان ذكر لاسم لعبد الحليم حافظ، ولا لعبارة كامل الأوصاف، لكن الغناء والموسيقى عمومًا يحتلان مساحة في النص ففيه تُذكر أم كلثوم باسمها، ثلاث مرات، وبأغنياتها، آهاتها ولوعتاها، على أحبّة غائبين، ولاسيما القصائد، قصيدة “وُلِد الهُدى” لأحمد شوقي، وقصيدة “الأطلال” لإبراهيم ناجي، وكذلك ذكرت أغنيات الستينيات، وموسيقى يانّي Yanni.
كانت كامل الأوصاف من أغنيات الستينيات، فقد غناها عبد الحليم في جامعة القاهرة في يوم ٣٠ أبريل عام ١٩٦٧م. ويذكر الشاعر أغنية قديمة منسية، فيقول:
تضغطينَ أرقامَ هاتِفِكِ النقّال
كي تسمعي صوتَ رجلٍ قابعٍ في وحدتهِ
وهو يغنّي أغنيةً قديمةً لا يتذكرُها سِواه
سنعود لعبارة كامل الأوصاف كرَّة أخرى، لكننا الآن نحتاج لذكر الإهداء، فقد أهدى الشاعر ديوانه على هذا النحو “إلى سهيل وسيف.. الآن ودائمًا، وإلى الحزن الثقيل الذي يواري الفتنة، والحسن المؤجل”، سوف نرى قصة سهيل في الصفحة ٦٥ من الديوان، فسهيل وَلدُ الشاعر، وهو حقيقة وحُلْم، لم يكتب الشاعر إهداء هذا الديوان وحده لسهيل ولسيف، بل تقريبًا جميع دواوينه أهداها لهما، ففي إهداء ديوانه “يكيّف جرائمه على نحو رومانتيكي” نقرأ الإهداء: إلى سهيل وسيف، فرعان جديدان في شجرتنا المباركة أمدهما بطول أحلامي إلى السماء”. من الواضح أن اسم سهيل وسيف، هما ابنا الشاعر:
كل شخبطات الولدين على الجُدران انمَّحتْ،
بالطِّلاء الجديد
حتى ملابسهما القديمة تبرعتُ بها
هي ليست ذكريات محببة، لأنها مربوطة بالفقد والرحيل، ثم أصبح الاسمان حفيدين للشاعر، فتكررت الأسماء، بعد أن كان سهيل ابنه قبل نهاية الألفية يتوسط سرير نومه، غدا الآن حفيدًا تقرُّ به عينه.
حَوْليّات
يشغلنا الهامش الوحيد الذي وضعه الشاعر في نهاية الديوان، كما اشتغلنا بالعنوان والإهداء، فذلك كله انشغال بالنص نفسه، لفك مغاليقه، وفهم تعدد الدلالات فيه. الهامش يشير إلى أن قصائد الديوان كتبت بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨م، كما ذكرنا، ولو افترضنا أن الشاعر قد استغرق نصف العام الأول ونصف العام الثاني لا أكثر، فمعنى ذلك أن النص قد وفَّى عامًا بتمامه لكي يكتمل بين يدي الشاعر، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستغرق فيها الشاعر في كتابة نص واحد متماسك، فقد كان ديوانه “الزجاج” المنشور عام ١٩٩٩م، قصيدة طويلة كما يصفها الشاعر، واستغرق في كتابتها أكثر من ثلاث سنوات بين فبراير ١٩٩٢ ويوليو ١٩٩٥م.
النص في “كامل الأوصاف” به فواصل على شكل نجوم (***) وضعها الشاعر في نهايات كثير من الصفحات، وقد لفت نظري أن السطور بين صفحتي ٧٧ و٨٠ إنما هي مقطوعة لها بداية، ووسط، ونهاية، فتبدأ بقوله:
لم أكتبْ قصيدةً واحدةً منذ شهرٍ تقريبًا،
لأنني لسْتُ طائرًا يعشق التحليقَ ويخربش السماء،
ثم ينتهي نص المقطوعة بالسطر التالي:
لم أكتب قصيدة واحدة منذ شهرٍ،
ولا أريدْ.
قد يجوز أن نجعل من هذه القطعة قصيدة منفصلة، قائمة بذاتها، ومن هذا المنطلق نبحث عن مواضع تبدأ منها مقطوعات أخرى، ثم ننتهي إلى تقسيم الديوان/ النص إلى مقاطع، لذلك سألتُ الشاعر سمير درويش، هل كتبتَ هذا الديوان على هيئة قصائد؟ قال: لا، بل هو حالة واحدة وقصيدة متكاملة. وكلام الشاعر دقيق وصحيح، لأنه حتى هذه القطعة التي بدأت بعبارة ثم انتهت بها، فإن ما ورد داخل القطعة المذكورة ليس إلا جزءًا من الصورة التي يعطيها لنا النص في كليته، صورة المتسكِّع، وصورة المغترب المنقسم على ذاته:
هل تريدِني صريحًا؟
سأقول لكِ: أنا مكتئبٌ جدًّا، وحزين،
…
وأعددتُ وجبةً يأنفُ الكلبُ منها،
وتحدثتُ في الهاتفِ بضْعَ مرَّاتٍ،
وفي الليلِ تمشّيتُ في الشوارعِ بحثًا عن مصْلِ الإنفلونزا
الشاعر مع القصيدة يكون واضحًا وصريحًا، أكثر منه مع أية “موضوعة” أخرى، ولكنه يواصل سرد حياته اليومية، كما فعل من أول سطر في النص/ الديوان، حيث كان ابتدأ يكتب على النحو التالي:
سأقذفُ زجاجَ النوافِذِ بالحصَى
وأمسكُ المارَّةَ من خناقِهِم
آناءَ الليلِ
لأعدِّدَ المنافعَ الكثيرةَ للجنون
سوف يخاطب الشاعر عدة متلقين لنصه، القارئ المتلقي غير المحدد، والمعشوقة الحاضرة الغائبة، ونفسه المنقسمة المغتربة، وأحيانًا يخاطب العلِيَّ القدير نفسه، ثم يسير النص من أوله إلى آخره، يسرد الشاعر حياته الماضية متأملًا فيما وقع وما هو واقع، لكنه لم يسقط في فخ السرد، ولم يستسلم لغواية الحكي على حساب “القصيدة” لكن يبقى السؤال: كيف نجح في ذلك؟
بناءُ النصّ
كل مطوَّلة من مطولات الشعر العربي القديم كانت تقصُّ طرفًا من حياة صاحبها، في ذروة معاناته، وذروة نشوته، أو غضبه أو انتصاره، فعنترة يصف القتال لأنه مقاتل، وامرؤ القيس يصف النساء، والليل والفرس لأنه أمير، وزهير يصف الحرب، فينفِّر منها، لأنه رجُل صُلْحٍ، وداعية سلام، والأعشى الكبير يصف النساء والخمر لأنه جوَّاب آفاق، وهكذا، ولكنهم جميعًا لم يغفلوا وصف الرحيل والفراق، وكان وصف الأطلال لائقًا بهذا، في زمن الشاعر الجاهلي وبيئته.
فلما كان العصر الحديث، كتب الشاعر الفرنسي رامبو “فصْلٌ (= مُلاوة) في الجحيم” فكان ثورة شعرية أعيد إحياؤها بعد موت صاحبها، ولا شك أن شعراء قصيدة النثر العرب، قد تأثروا بـ”رامبو” وسابقه “بودلير”، اللذين اتفقا في التمرد، ووصف المعاناة، والاغتراب. كما أن الشاعر الأنجلو أمريكي “تي. إس. إليوت” قد وصف حياة الإنسان المعاصر ومعاناته مع الحضارة، في مطوّلته الذائعة الصيت “الأرض الخراب، أو اليباب” THE WASTE LAND التي أخذت الصبغة العالمية، وقد نقَّحَها الشاعر “إزرا باوند” بحذف نصف النص الأصلي، قبل نشرها، فجرت عليها سُنَّة “التّحْكيك” بمراجعة شاعر صناع.
هذه الطريقة في صنع المطولات الشعرية قد ارتادها محمود درويش في بعض دواوينه مثل “ورد أقل” لكن مثالها الأوفى كان في ديوانه “جِداريّة” لأن الشاعر راجع فيها حياته رابطًا إياها بحياة العصر، نافيًا عن الإنسان جهالة عبادة المال والسلطة، لذلك ذكر الفن ووعوده، وقدرته على تحدي الزمن، فكان هذا أكبر دواء لمرض الشاعر، وخوفه من الفناء. وسمير درويش، مثل محمود درويش، يخشى الفناء، ويرى الفن وتجلياته في الجمال مخرجًا من وطأة القبح ورذيلة تسلُّطه، لذلك سمى نصه “كامل الأوصاف”، وكامل الأوصاف هو المعشوق الغائب، لكنه أيضًا صفة للفن، الفن الخالد، والفن يتجلى في النص على عدة مستويات، فن الحب، حب النساء، وفن الموسيقى والغناء، وفن الشعر أيضًا الذي يريد الشاعر أن يبدع فيه أوفى صيغة، ثم يخشى أن يُظَن أنه قد حقق الإنجاز المطلوب فيموت، وهاجس الموت يقلقه:
فكرتُ أن أجلسَ في الشرفةِ وأكتبَ شعرًا صافيًا
يتعالَى على حالاتِ الاكتئابِ
لكنَّنِي لا أريدُ أن أكتبَ قصيدةً صافيةً بالكاملِ
كي لا أموتْ
فالشعراءُ يموتونَ حين يكتبونَ قصيدةً صافيةً
أظن أن الشاعر كان طوال الوقت يبحث عن نصه هذا ويريد أن يكتبه، وقد كتبه، وهو فيما يصف لنا هذا الخوف يذكرنا بمحمود درويش صاحب الجدارية، لكن خوف سمير درويش ليس خوفًا من القصيدة فحسب، بل خوف على القصيدة أيضًا.
لقد بدأ الشاعر سمير درويش كتابة الشعر وهو بعدُ تلميذ في المدرسة الثانوية، وفي دواوينه الأولى التزم بمدرسة الشعر السائدة، شعر التفعيلة، لكنه الآن عرف الطريق التي ظل يبحث عنها، فأصبح في طليعة شعراء الحداثة العربية في القرن الواحد والعشرين.
البناء المركَّب لنص القصيدة /الديوان “كامل الأوصاف” أساسه انسجام النص، فهناك نُسْغٌ يسري في سطوره، هو كما قلنا حياة الشاعر نفسه، لكن هذا الانسجام يرتكن على “البلاغة الجديدة” وقد تجلَّت تلك البلاغة في سطور النص كلها، لكننا نختار منها هذا المقطع:
نحرُها وسيعٌ كوردةٍ مغلقة على عِطْرها
نحرُها وسيعٌ كالشمسِ الناضجةِ
كلوَحَاتِ الرسّامينَ
كالطفلينِ اللذينِ ينهلانِ من حريتِهَا
كمَطْبَخهَا الذي يضجُّ بالمودَةِ
كالشوارعِ الواسعةِ التي تُشِعُّ هدوءًا ووحشةً
وكمئذنةِ المسجدِ القريبِ، البعيدِ
كترتيلٍ عميقٍ لآي الذّكْرِ
كنبوءَةِ أمّي التي رأتْ طريقًا أخضرَ
فهذه عشرة تشبيهات، ذُكرت فيها الكاف أداة للتشبيه، لكن هذه التشبيهات، لا تثقل على القارئ ولا تنفِّره، فلا هي نقلت من كتب البلاغة ولا جاءت على مقاسها، بل هي لا تعدو أن تكون سطرًا بارعًا، في الحكاية التي يحكيها الشاعر، عن حياته، عن معشوقته المفقودة، والحاضرة حضورًا طاغيًا في حياته، في صحوه وفي منامه، كذلك عن أمِّه، وعن الشوارع، والبنات الدارجات في طريق المدرسة، وعن الفقراء، وعن الأرض والسماء، عن القرآن، والغناء والموسيقى، عن حياة، هي حياة الإنسان المعاصر، فما الشاعر إلا نبيّ، فإن لم يكن نبيًّا، فهو متنبئٌ عتيد.
ديوان “كامل الأوصاف” مجاز عن ذات منقسمة، الأولى ذات تمشي في الأسواق، وتجاهد في سبيل لقمة العيش، وتعاني من زحام الشوارع، والروائح المنفرة، والعرق وزحام المواصلات، والتراب (ورد لفظ التراب في الديوان ٦ مرات) في الصيف، والطين في الشتاء. أما الذات الأخرى فهي تكتب القصائد وتحلم بعالم أفضل، وتهرب لتعيش في الخيال المجنّح:
وثمَّ مُنازلةٌ
بين رَجُل الأريكةِ وبيني
إن رَجُل الأريكة هو الشاعر نفسه (وقد ذكرت صورته في الديوان ٨ مرات) وعالم الذات الأولى، مربوط بعالم الذات الثانية، يربط بينهما إبداع الفن، فن الشعر وفن الأغنية، أغنية أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وإبداع الشعراء المتنبي وأبو العلاء ونزار قباني ومحمود درويش وجبران خليل جبران، ولا ننسى نجيب محفوظ، الذي لمسنا حضورًا خفيًّا لنصوصه المتأخرة ولاسيما أصداء السيرة الذاتية، وأخيرًا غناء الشاعر نفسه، سواء أكان دندنةً بما تجود به الذاكرة من أغنيات ملحَّنة، أم بما يخرجه للناس من شعر عامر بموسيقى الروح، والخيال المجنح. إنها سيرة شاعر من عصرنا، خطَّتها يدٌ صَنَاع.