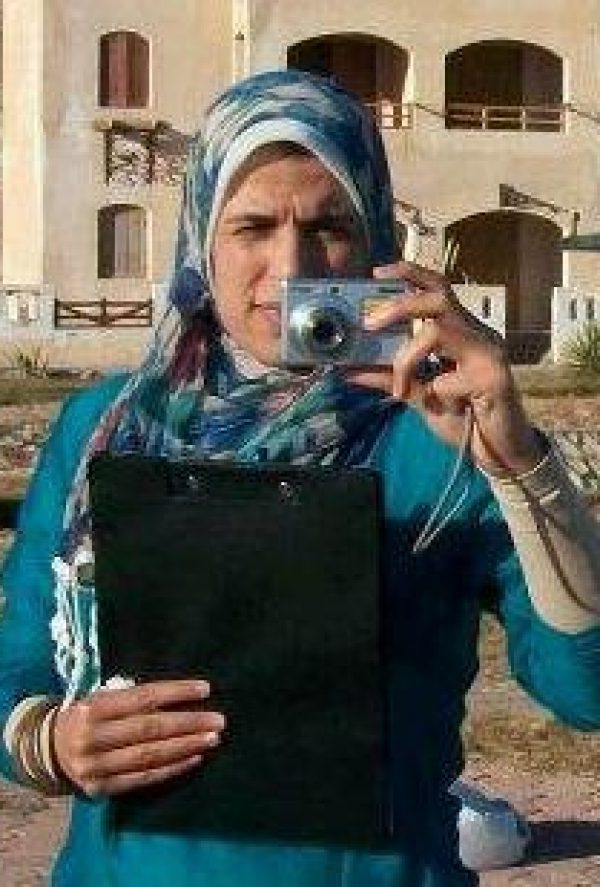سعد القرش
ما يشبه الشهادة
في يناير 1991 سألت يوسف إدريس عن أسباب هروبه من «الكتابة»، إلى مشاغبات ومعارك في مقالاته الأسبوعية بصحيفة «الأهرام»، وهي تزيد تقريبا إذا ما جمعت في كتب على حجم مجموعاته القصصية من «أرخض ليالي» إلى «بيت من لحم». قدرت أنه يهرب من مواجهة عنفوان ماضيه، حين تمرد على القصص السائد، وأنهى عصرا من الميوعة الأدبية، وأرسى مدرسة لسرد جديد لا يشبه إلا نفسه. قال لي في غير أسى: لو أنك تشارك في مظاهرة تتداخل فيها هتافات ومطاردات، فهل من المعقول أن تأوي إلى ركن بعيد، لكي تكتب قصة قصيرة؟ لم يدع لي فرصة للرد، وأجاب: حتى لو تمتعت بالحد الأقصى من «خلو البال» فلا بد أن يجذبك نداء الناس، ويشغلك عن «الكتابة».
في ذلك اليوم، قال لي أيضا: لست كاتبا حرفيا ولا محترفا، أنا أريد أن أغير العالم. ولكني أدركت أن الرجل ـ رغم يقينه بأن له دورا يتجاوز نطاق الأدب والثقافة بالمعنى النخبوي الضيق ـ يرى أن مقالاته الأسبوعية موقف حضاري، ورسالة يخاطب بها اللحظة، وليست «كتابة» تحظى بالخلود مثل أي إبداع إنساني.
نجحت ثورة يوسف إدريس الأدبية، ولكن صرخته، في المجال العام خارج نطاق الأدب، ما زالت تبحث عن مجيب، وقد حملت أكثر من عنوان ـ شعار لكتاب: «أهمية أن نتثقف يا ناس» و«فقر الفكر وفكر الفقر».
بعد يوسف إدريس خلت الساحة الأدبية من «الكاتب النجم»، باستثناء نجوم مؤقتين يصطنعهم ناشر رأسمالي لكي يلبي بهم حاجة «السوق»، وقودا لموسم أو موسمين، ثم يبحث عن غيرهم لكسر ملل القراء. كما خلت الساحة أيضا من ناقد كبير يحظى بالاحترام، «شيخ حارة» يمتلك جرأة تدعوه للمطالبة بمكافحة البطالة ـ التي ألْجأت البعض على سبيل الخطأ إلى سوق الكتابة ـ كما يمتلك نزاهة تؤهله إلى دعوة أنصاف الموهوبين للبحث عن عمل آخر، وكشف «عورة» الكتابة الضحلة أو الاستشراقية. لا أدعو إلى مصادرة حق أي أحد في النشر، وإنما إلى توعية نقدية تضع الكتابة الخفيفة ضمن الكتابة الخفيفة، لكي لا يختلط الأمر على القراء المبتدئين، فيحسبوا السراب ماء.
في مثل هذا السياق تصبح «الكتابة» شأنا شخصيا للكاتب، تمرينا على اقتراف الجمال والاستمتاع به. ولأني إنسان قدريّ لا يخطط لشيء، فهذه فرصة لأن أنظر ورائي، إلى طريق طويل، يكفي عدة أشخاص وعدة أعمار. أتأمل الطفل الذي كنته، وهو يقبض على عصا يقود بها الحمار، وتتيبس يده من شدة البرد، وينفخ فيها ليدفئها، لكي يتمكن من القبض على الشُّقْرُف (المنجل) لحش البرسيم للبهائم، ويؤخره شغل الغيط عن حضور طابور المدرسة، وكيف تعلم مصادفة، من دون أن يبالي به أحد، رغم حرص أمي، التي لا تقرأ، على أن أستمر في الدراسة. أتذكر ذلك الطفل وقد صار صبيا في بداية المرحلة الثانوية، تقريبا عام 1982، وكان الوصول إلى معرض القاهرة للكتاب حلما يتحقق بجنيه واحد، واستعصى.. الجنيه والحلم. أتأمل ذلك الطفل، وأنظر ورائي وأتنهد بعمق، كأنني عشت مئة عام، ولا أصدق أن ذلك الطفل الذي عاش حياة كالدراما، سيكون له عبر القارات أصدقاء من الأماكن والبشر.
دخلت عالم «الكتابة» متسللا، لعبت المصادفة دورا في أن أكمل تعليمي، كان بيني وبين التسرب من التعليم الأولي خطوة، لولا أمي التي أورثتني متعة الحكي. ثم دفعتني مصادفة تالية للتعبير عن الحكايات بكتابة قال من قرأوا مسوداتها إنها «قصص قصيرة»، وتحمس لها كثيرون بالنشر، منذ كنت طالبا في جامعة القاهرة. لم أخطط لشيء، كما ذكرت، ولا حلمت بتغيير العالم، ولا أزعم أن لي مشروعا أسعى لإنجازه. ولست مشغولا بالتوصل إلى تعريف للكتابة، يكفي أنها سحر يأسرني ويغنيني عن كل شيء، ويجعلني أشعر بأنني فوق الحياة، وأكثر غنى من أي أحد، وأكبر من أي منصب، وتثبت الوقائع هذا الأمر.
دخلت هذا العالم متسللا، وأحيانا أضحك من نفسي أو عليها، وأتخيل أن كاهنا ما سيأمرني بالمغادرة!
أنفر من الافتعال، ولا أحب الترهل أو المكياج في الكتابة أو الوجوه أو الأجساد، ولا أدعي إبداعا ولا ثورة، كتبت شيئا فقيل إنه أدب، وأحيانا سيرة لمدينة أو مكان، وشاركت في حدث كبير أراه ثورة، ولا أصادر حق الآخرين في أن يسمّوه ما يشاؤون. يقودني الاندفاع كثيرا إلى مهالك، ويستفزني البعض للقيام بأدوار تخصهم ثم ينسحبون أو يترقبون ردود الفعل، ولا أندم على نتيجة ولا أعتذر، وقد خسرت كثيرا وكثيرين، ولا أبالي بالمصائر. في «جمعة الغضب»، أكثر أيامي قسوة على الإطلاق وأجملها، التقط لي محمد عبلة صورة، في الساعة السابعة تماما. كنا قد نجحنا في الوصول إلى ميدان طلعت حرب، وأمامنا معركة صغيرة لاقتحام ميدان التحرير. ضحك وقال: «صورة للتاريخ، بجوار هذا الرجل العظيم»، وأشار إلى تمثال طلعت حرب. لم أر تلك الصورة، وكلما ذكرت بها محمد عبلة ضحك ووعد. وليس لي صورة في ميدان التحرير طوال 18 يوما أنهت حكم حسني مبارك، باستثناء صورة فاجأني بها عبد الرازق عيد، أرسلها إلي يوم 14 يونيو 2012، ويبدو أنه التقطها ذات فجر بعد «موقعة الجمل»، وتظهر ورائي دبابة فوقها جندي، وعتمة كثيفة تكسو بضعة مصابيح باهتة في شارع يطل على ميدان التحرير.
لم أكتب يوما، ولا قلت في برنامج، هذه الجملة الخالدة: «لما كنا في التحرير، …»، ولا دعوت أولادي للميدان طوال 18 يوما، إلا بعد تنحي مبارك. جاءوا يحتفلون، وصلوا مع بدايات اليوم التالي، كنا قد أصبحنا في 12 فبراير 2011. وطوال مظاهرات واحتجاجات واشتباكات تالية لم أكتب أنني في الطريق إلى كذا، ولا قلت بعد العودة إنني شاركت في كذا. أتذكر أبا ذر الغفاري وأحسده وأحبه. كنت أتفاءل كلما وجدتني في جمع لا يعرفني فيه أحد ولا أعرف فيه أحدا، ساعتها أثق أن الثورة مستمرة، وأنها ستنتصر؛ فهؤلاء طلاب ثورة وعدل وحرية، صادقون وليسوا جوعى للخبز أو الكاميرات.
يفسد الجوع للكاميرات أشياء كثيرة. كتبت بيان اعتصام المثقفين يوم الأربعاء 5 يونيو 2013 في مقر وزارة الثقافة، كنا نحو 20 شخصا، عرفت هذا في وقت لاحق، حين راجعت التوقيعات على البيان المخطوط الوحيد طوال الاعتصام، لم يكن هناك وقت لكتابته على الكمبيوتر. وقد حرصت على أن أصوغه في بضعة أسطر تلخص مطالبنا، واتسعت مساحة الصفحة للتوقيعات، ولكن النجاح السريع أغرى محسوبين على حكم مبارك وسياساته بتصدر المشهد. في ما بعد ستخترع أساطير، منها ما حكته لي سيدة بفخر، في احتفال بعيد ميلاد صديقة في مقهى ريش، أنها من الذين «اقتحموا الوزارة». لم أرها في اليوم الأول، وربما الثاني، وابتسمت وهي ظنت أنني أستحسن الكلام، وكنت في مقام يجمع متناقضين.. البيرة والجاتوه.
كالعادة، ليس لي صورة في الاعتصام، باستثناء صورة التقطها أسامة عفيفي بتليفونه، حين كانت سهير المرشدي تلقي البيان الذي انتهت لتوي من كتابته. ومع صخب وأضواء كاميرات تصاحب استعراض من يريد أن يسجل اسمه وصورته في سجل الاعتصام، كان الشارع اختبارا لمن يفضلون الظل، ويستأنسون بزحام المؤمنين بدين الثورة، ولا يتباهون بأنهم «اقتحموا». من جديد اعتصمت بالشارع، وتذكرت أبا ذر الغفاري، وذلك الشاعر السومري الذي قال قديما:
«نحن الشعراء مطرودون من هذا العالم»
الآن، وبعد أربع سنوات اكتشفت أنني كتبت كثيرا. كنت قد انتهيت من روايتي «وشم وحيد» في 8 يناير 2011، ثم تلاحقت الأحداث عاصفة في تقلباتها ومفاجآتها، ولم أتخيل حتى بعد خلع مبارك أنني سأكتب شيئا عن الثورة؛ فقد شاركت مثل أي مواطن، لا أدعي نبوءة بثورة، ولا وصلا بليلى، وقد سجلت في كتابي «الثورة الآن: يوميات من ميدان التحرير»، قبل سرد اليوميات، فصلا عنوانه: «الطريق إلى الثورة.. اعتذار إلى كل مصري»، استعدت فيه ما كتبته في صفحتي على الفيسبوك يوم الثلاثاء 25 يناير 2011: «في دولة هي الأقدم، ونظام إداري عمره 4600 سنة، يصبح النظام السياسي إسفنجيا، يمتص المظاهرات والاحتجاجات، بدليل أحداث 1977 و1986. لدي اقتراح أن يجمع العقلاء 10 ملايين توقيع مثلا مثلا، يتعهدون فيها للرئيس بخروج آمن، خروج من السلطة لا من البلد، خروج لا تتبعه ملاحقة قضائية ولا نكت.. في فترة حياته على الأقل. حل سهل لعله يخرجنا من هذا المأزق».
وأنهيت هذا الفصل التمهيدي بهذا الاعتراف: «أعترف أنني لم أكن حسن الظن، على نحو كاف، بقدرات الشعب المصري، المارد الذي ثار، لذا وجب الاعتذار!».
لم أنشغل بإغراء «الطلب» على كتابات الثورة. كتبت باستمتاع وصدق، واستعدت مشاهد كتبتها ولم أتمالك دموعي، لم أكن موظفا عند الثورة ولا عند الكتابة، كنت نفسي، وأرّخت لتقلباتي وآمالي وخيبات أملي. التزمت الصدق غير مبال بأفعل التفضيل التي تشغل البعض، أن يكون لهم أول كتاب يوثق أحداث الثورة، أول رواية تستلهم عظمة 18 يوما غيرت وجه مصر.
كنت مهموما باستعادة روح تلك الأيام، أيام البراءة، فكتبت شهادتي في كتاب «الثورة الآن»، بصدق جارح، هذا كتاب ـ شهادة للتاريخ، أفخر بأن أحمله بيميني. «الثورة الآن» تطوير لكتاب لم يكتمل، بدأته في أغسطس 2010، وضعت له عنوان «كلام للرئيس.. قبل الوداع»، وكان في ذهني كتابا «البحث عن السادات» ليوسف إدريس، و«يوميات بغداد: 1975 ـ 1980» لصافي ناز كاظم.
بدأت الكتابة قبل أن تتسرب روح أيام وحدت المصريين على هدف، قبل أن يكتشفوا أنهم فرقاء يتصارعون على السلطة. كتبته بقصد المحبة، فالكتابة عموما فائض أرواح المحبين، ولو افتقدت هذه الروح تصبح شيئا مصطنعا جافا، كلاما كالكلام. لم أستهدف الانتقاد ولا الانتقام؛ فالكتابة أسمى من تصفية الحسابات. أوصيت نفسي بالدقة، بتسجيل جانب أعرفه أو أراه أو أسمعه، وأنسب كل شيء لأصحابه، ولا أفتعل بطولة. تخيلت نفسي في حضرة الآلهة: ماعت وتحوت وأوزير وإيزيس. أغمضت عيني واعترفت، وسميت الأشياء والأشخاص بأسمائها وأسمائهم، وقلت لأصدقائي إن الشاهد في المحكمة لا يتقاضى أجرا، وإنني أستعجل نشر الكتاب حتى لو اضطررت إلى طبع مئة أو مئتي نسخة على نفقتي، وتوزيعها على الناس بالمجان، هنا والآن في حياة الذين يتناولهم. لست قاضيا لأصدر حكما على شخص أو موقف، وقد تركت ذلك للقارئ وللزمن، واكتفيت برصد ما أعرف من تفاصيل، شاهدا أقسم ألا يكذب، ونطق بالشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
ثم تأكد لي أن الله يحبني، ويحب كتابي، أكثر مما ظننت، فنشر الكتاب مسلسلا في حياة الذين بدأوا يموتون ممن كانوا شهود الزور في عصر مبارك، ثم نفدت طبعته الأولى في بضعة أيام نظرا لصدوره بسعر زهيد (أكثر من 400 صفحة بأربعة جنيهات، نحو نصف دولار)، ولكن طبعته الثانية تقول إن الكتاب لم يعد شهادة، بل أصبح سلعة ثمنها 40 جنيها، ثم ارتفعت إلى 50 جنيها.
اعتذاري لكل مصري أنني خفت، مثل كثيرين قبيل الثورة، أن يصاحبها، أو تكون هي نفسها، فوضى عاصفة لا تبقي علي شيء. وجاءت الثورة، في أيام البراءة الأولى، كاشفة عن جوهر حضاري أخفاه مستنقع أنبت فيه مبارك وعصره طحالب وعفنا ساما، فحاول كثيرون النجاة منه بالخلاص الفردي. كان التحدي أن تكون الكتابة لائقة بالثورة، قريبة من إبداعها وعفويتها، أن أكتب «في الثورة»، لا «عن الثورة» أن أرصد ما تابعه العالم «من فوق»، تفاصيل لا تتمكن الكاميرات من التقاط موجاتها وذبذباتها، الروح التي ألهمت الناس كيف يقتسمون الحلم والخوف والليل والسيجارة والرغيف وكوب الشاي والضحكة والأمل واللهفة على لقاء آمن، يأمن شاب على زوجته أو حبيبته في الزحام، لأنها بين أهله وأهلها وإن لم يعرف أسماءهم.
أغمضت عيني وكتبت. تيقنت أن الشاهد لا يجوز له أن يجري حسابات أو توزانات. لا أحب مقولة يطلقها بعض خائبي الرجاء من باب الشجاعة الزائفة: «ليس لدي ما أخسره»، وكان لدي كثير مما يمكن أن أخسره، «هي أشياء لا تشترى»، ولهذا كنت صريحا لدرجة قصوى.
اكتشفت الآن مع كتابة هذه الشهادة أنني كتبت كثيرا، وأنتظر يوما أكف فيه عن الكتابة في الشأن العام، وأعود إلى رواية كتبت فيها بضع صفحات في يناير 2014؛ فلست مشتغلا بالسياسة، ولكني مضطر للانشغال بتحولات تذهب العقل، ويصبح فيها من يملك يقينا أشبه بإله. ولا أملك من الترف، أو «خلو البال»، ما يجعلني ألوذ بمكان هادئ وسط عواصف شارع تتعرض فيه الثورة لإطفاء جذوتها، وتستعيد فيه الشرطة توحشها ثأرا لإهانتها وانكسارها في «جمعة الغضب».
كتابتي في الشأن العام آمل أن تكون صالحة للقراءة بعيدا عن تلبية الحاجة الآنية. لا أميل إلى تدليل القارئ أو تضليله، أحمل إليه شكوكي وأتعرى، فلست من «أهل اليقين» الديني والوطني والثوري والإنساني، إذ يمنحون أنفسهم حق إصدار فتاوى التكفير الديني والوطني والثوري والإنساني، في ظل هوس يجعل الناطقين بالإسلام يسارعون إلى التكفير، ومحدثي السياسة يتخذون منصات لإطلاق فائض الحكمة والأحكام، أولئك قال فيهم جورج ديهاميل، في كتابه «دفاع عن الأدب» 1936، وهو يحذرنا «شهوة السياسة»: «السياسة والحب في فرنسا هما لذة الفقير، اللذتان المجانيتان. والطلب في القهوة الصغيرة يكلف… أما السياسة فلا تكلف شيئا. وهي تثمل وتثير انفعلات وتجني مفاجآت… وهي تتغذى بكل الشهوات، وخاصة بأحطها، فهي غنيمة طيبة للنفوس الخاوية».
ما أراه الآن في مصر، وربما في العالم العربي، يذكرني بمقولة فرانسوا تروفو: «لكل إنسان مهنتان. مهنته والنقد السينمائي»، ورغم متابعتي لشؤون الثورات العربية وشجونها، فلا أملك أن أطلق حكما، وأعجب لمستشرقين عرب يحلو لهم التقاط أخبار أو شائعات، وقبل التحقق منها يملكون قوة إصدار الأحكام، بجسارة ويقين يحسدون عليهما، جسارة ويقين منقوصان إذا تعلق الأمر بحقيقة ما في بلاد ـ أو محميات خليجية ـ تمول منابرهم. كان ديهاميل (1884 ـ 1966) محقا حين دعا إلى وضع السياسة «في يد المحترفين… إن الشعب الذي يضطر راضيا أو كارها إلى أن يخصص خير وقته لمسائل السياسة ليلوح لي في حالة انحلال… الحمى السياسية قد وصلت إلى أناس كان من الواجب أن يظلوا بعيدين عنها بحكم أذواقهم… اختلال عميق خطر في حياتنا الاجتماعية»، إنه داء مخيف.
حين أكتب «في» الشأن العام، أتجنب التعليق على الأخبار، والأحداث العابرة، فهي وقود مهلك، يستهلك الأعمار والأعصاب. أتأمل الأفكار المؤسسة للظواهر، وأتجنب إهانة شعب أو شخص، حتى لو تكلمت عن آثار مدمرة لأشخاص أشعلوا الفتنة: محمد بن عبد الوهاب، وحسن البنا، وسيد قطب. ولا يمنعني الصدق أن أنتقد سعارا للسلطة أصاب غير المنتمين لليمين الديني.
هذا التشوه النفسي الذي أصاب الإخوان والسلفيين لم ينج منه أربعة من ممثلي الثورة من التيار المدني، ظن كل منهم أنه أحق بالرئاسة، وأخذتهم «الثورة» بالإثم، ورفضوا الجلوس والاتفاق على اختيار أحدهم مرشحا الثورة، فضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون «ثورة». خسروا جميعا، ولم ينصتوا إلى بيان «قبل فوات الأوان.. نداء إلي مرشحي اليسار والديمقراطية الأربعة»، وقد كتبه أحمد الخميسي، ووقعه أكثر من 500 مثقف ومواطن غيور على الثورة والوطن. حث البيان على ضرورة الاستقرار «على مرشح واحد من بينكم، لتحشد خلفه كل الأصوات الممكنة في مواجهة الظلامية، أو عودة الفلول. وإذا تم ذلك، ولم ينجح المرشح لأسباب أو أخرى، فسيكون بوسعنا على الأقل أن نقول إننا بذلنا كل جهدنا وأخلصنا وحاولنا… ندعوكم قبل فوات الأوان إلى الاستقرار فيما بينكم على مرشح واحد منكم، خاصة أن الفروق في البرامج المطروحة من كل منكم ليست فروقا ضخمة. فإذا لم تفعلوا… وإذا فضل كل منكم التشبث بالتطلع إلى كرسي الرئاسة، فإننا نرجو ألا تحدثونا بعد ذلك مطولا عن اليسارية والديمقراطية وهموم الوطن، لأن كل ذلك على المحك، ولأنكم تلقون بكل ذلك جانبا، ولا تعيرون أصوات الناس أهمية، ويغرق كل منكم في وهم أنه وحده ـ وبمجهوده، وبمعجزة ما ـ سوف يفوز. وهو ما لن يحدث. وسوف تسفر الانتخابات في حال عدم اتفاقكم على مرشح من بينكم عن فوز (أحمد شفيق) ممثل الرئيس المخلوع، أو (محمد مرسي) ممثل التيار الرجعي، وفي هذه الحال نحملكم المسئولية عن ذلك، ولن نسمع منكم مجتمعين أو فرادى أية دعاوى عن تزييف الانتخابات أو قوة رأس المال، أو شراء الأصوات، لأنكم منذ الخطوة الأولى انقسمتم، وضيعتم حقوقكم، ومعها حقوقنا… السادة مرشحي اليسار والديمقراطية الأربعة: أبو العز الحريري، حمدين صباحي، هشام البسطويسي، خالد علي.. طالما سمعناكم تتكلمون عن إنصاتكم المرهف لصوت الناس، وها هو صوت الناس يصلكم، فهل تسمعونه؟ وهل سيتكرم كل منكم بالرد علي هذه الرسالة؟».
وفي 13 مايو 2012 أرسل الخميسي إليهم نسخة من البيان، ولم تصل. لعلها وصلت، ولكن الخاسرين الأربعة ظنوا أنهم سيفوزون هم الأربعة. وفي 28 مايو 2012 أعلنت نتيجة الجولة الأولى، وحصل أبو العز الحريري على 40090 صوتا، وهشام البسطويسي على 29189 صوتا، و134056 صوتا لخالد علي، مقابل 5764952 لمحمد مرسي، و5505327 لأحمد شفيق. ومن المساخر أن يسارع أنصار صباحي، في مساء اليوم نفسه، وخالد علي أيضا ويده في يد كمال خليل، إلى ميدان التحرير. لم يخجل الخاسران، أن يعترضا على نتيجة خيبت آمال الملايين، وقضت على حلمها الرئاسي.
الاعتراض في حد ذاته مزحة، رفض صريح للديمقراطية، التي كشفت عورة اليمين الديني والمدني. أما الأعجب من العجب، وما لا يتصوره عاقل، فهو اقتراح يطالب محمد مرسي بالانسحاب لصالح حمدين صباحي، لتكون جولة الإعادة بين صباحي وشفيق!
يصعب على الكاتب أن ينجو من هذا الصخب. أراه مسخرة مست اليمين الديني والمدني، بقايا سلفية باختلاف أنواعها وأطيافها، ومن حسنات الثورة ـ وقد صهرت الشعب ومنحته وعيا كبيرا ـ أن أخرجت هذا «الخبث» والزبد الذي يذهب جفاء.
أنظر ورائي فيدهشني أنني كتبت «مقالات» أسبوعية تضع مسافة بيني وبين واقع يكسر القلب. تمنحني الكتابة هامشا يحول بيني وبين التورط في وحل السياسة. لم يحتمل أحمد مستجير فداحة العدوان الإسرائليل على لبنان، تموز 2006، فمات كمدا. وكنت قريبا من مدكور ثابت وقلبه يتمزق فاقدا الأمل في مصر، رآها تمضي في طريق لن تعود منه قبل عشرين عاما، قتله حكم الإخوان حسرة، فمات في يناير 2013.
أنتظر انتهاء مهمتي في رئاسة تحرير مجلة «الهلال»، أنتظر التخلي عن كتابة المقالات، أنتظر «عودة» مصر التائهة بثورتها، أنتظر العودة إلى «الكتابة». وإلى أن يتحقق ذلك لا أريد مصير خليل حاوي.
……………………
* (مجلة “فكر وفن” / يونيو 2015)