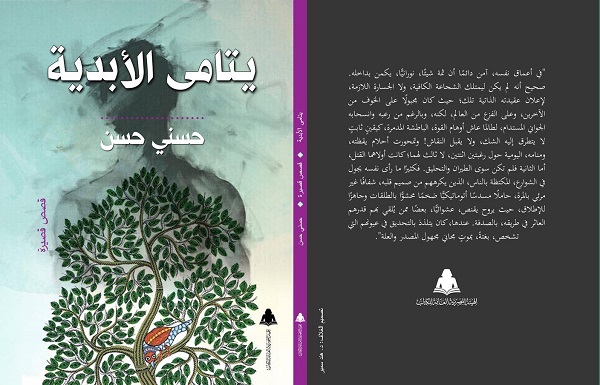محمد فيض خالد
من غير ميعاد
تتزاحم في رأسها مخاوف سوداء، حتى وإن رضيت من قسمتها بهذه العزلة، تجاهد نفسها فرارا من شعاع الذكريات المتدفق بالحيرة، صممت على ألا يربطها بمن حولها رابط، نجحت لسنوات في اسدال الستار عن المشهد، حتى ذاتها، غيبتها بين طيات ثيابها السود التي ترفض استبدالها.
” اعتدال ” جلبها الحاج ” مدكور ” تاجر المواشي الكبير من مسقط رأسه، فتاة ريفية ساذجة، على قدر وافر من الملاحة والصبا، قد غلف الفقر جمالها بغلالة كثيفة، كانت ابنة لصديقه ” عوض ” وعوض فلاح بسيط لا يملك غير فأسه وشرفه، وتلك ثروة الريفي ومدخره، رآها ” مدكور ” في أحد الأفراح، ساعتها لمعت عيناه، واشتد وجيب قلبه، ظل يشتهيها بكل جارحة من جوارحه، تفجرت في العجوز ينابيع غنية من الحب والوله، لم يهنأ له بال ؛ حتى ضمها إليه، عاشت الفتاة سنوات تنعم في عز باذخ، فتكشفت مفاتن جسدها الحارة، وبرقت طازجة تسر الناظرين، فبدت غزيرة الأنوثة، رأت من عطفه ما أنساها الفقر وأيامه، فانجذب قلبها إلى قلبه، رغم ما بينهما من فارق العمر.
لم تدم سعادتها طويلا، ولم يهنأ بالتنعم في بستان حبها الجني، غادر الحياة دون إنذار، تبخرت برحيله كل طمأنينة، وجدت نفسها وجها لوجه مع مصير تجهله، فكان منها ما كان.
وبين عشية وضحاها تبدلت أحوالها، شعرت وكأنها خلقت خلقا جديدا، رويدا رويدا انقشعت منابت الألم، انبسطت أساريرها، ولمعت عيناها، ألقت عنها السواد، واقبلت ثانية تعانق الحياة، والسبب في هذا ” محسن ” ابن جارتها ” عطيات “، و” محسن ” شاب لعوب طائش، أوتي قدرا من الملاحة والظرف، لا تفارق محياه ابتسامته الصاخبة، يمرح ويلهو وكأنما ليس في الحياة غير المرح والانطلاق، تسلل خلسة إلى حياتها، وفرض بصخبه نفسه عليها، زاحمها وسد عليها جميع مسالكها حتى استسلمت، أحست بأن مشاعرها لم تزدهر بهذه الطريقة من قبل، ما إن تلمحه وقد اقبل، إلا وتخف إليه في تلهف كمراهقة صغيرة، تتطلع نحوه في إحساس هائم لذيذ، يبادرها بالتحية في مشاكسة، فتصغي إليه منتشية، تلعقه بعيونها، نجحت في أن تجعل وسيلتها إليه ما بينها وبين أمه من صداقة، أما هو، فلم يدخر وسعا ليكسر الطوق الذي فرضته من حولها لسنوات، أن يخرج كوامن الأنثى المتشظية، حركت كلماته المعسولة شيئا فيها، نفخت الرماد من فوق جمرات لا تزال ملتهبة في جوفها، جعل منها كائنا آخر يسيل بالمشاعر ويهتف بالحب.
لم يدم الأمر طويلا، اسقطت في يده، لتتطور الأمور بينهما نحو المنحدر، لم تعد تسعه وحدها الكلمات، كانت وفي كل مرة تجلس إلى نفسها منهزمة، تمضغ القلق، تتوفى أن يطير خبر تعلقها بفتاها فيملأ الدنيا، لكنها مع هذه تكره الذكرات التي عصرت شبابها، تكره أن تعود إليها، ماذا تفعل وقد وجدت ما يؤجج عاطفتها، ويجدد ثقتها بالحياة، ” محسن “، وإن يصغرها، وإن ظنت فيه الظنون لا يهم، إنه فتاها الوفي، أنه محررها من قيودها الثقيلة التي كبلتها لسنوات، سريعا ذاب التحفظ بينهما، لتعطيه كل شيء كانت ترده عنه، اسلمت قيادها إليه يوجهها كيفما شاء، قالت يوما، وقد انتشرت أبخرة الرغبة تحجب كل تفكيرها :” لماذا أخاف الناس، هذه حياتي وحدي، والإنسان يعيش لمرة واحدة، يكفي ما ضاع مع تاجر البهائم “، التمعت عينها سرورا، عزمت من وقتها التحرر من هذا الهوان الذي تقاسيه، استجمعت أشتات نفسها، لتقول وآي الاهتمام ترتسم على محياها :” لنتزوج، نعم الزواج هو الحل الوحيد، لتخرس ألسن الناس، واحتفظ بحبي “، انتظرت مجيئه، هذا موعده لماذا تأخر ؟، حاولت أن تخفف من ثورتها، غاصت بسمتها الوليدة، اطرقت هنيهة حاولت فيها استجماع أشتات نفسها الموزعة، انفجر في رأسها خاطر، لتجيب بصوت محموم :” لأذهب إليه وليكن ما يكون “، توالت طرقاتها في توتر، انفرج الباب قليلا، اطلت والدة ” محسن ” بوجه كالح على غير العادة، وقد انفرجت أسنانها عن ابتسامة خبيثة، لتقول هازئة :” لقد سافر محسن فجرا، سافر إلى الكويت “، ثم أغلقت في وجهها الباب، دارت الأرض بها، قالت وقد تلون وجهها بجمر الغضب :” سافر؟!”، عادت تجر أذيال خيبتها، مشت في صمت مبهورة الأنفاس زائغة البصر، وفي الصباح كان ” عبده ” السمسار يعاين بيتها، لقد عرضته للبيع، بعدما قررت الرحيل.
**
ابن عمرها
تعوّدت أن تفتح باب بيتها وخيوط النهار تشق وجه الفضاء الراقد في ثبات، تزحزح عنها خمارها قليلا، تشرع يدها، وتبدأ في ابتهال ساذج، بما تفيض به قلوب الأمهات من حنان :” ربنا يهديك ويوقف لك أولاد الحلال ويكفيك شر نفسك “، حافظت على دعواتها الصباحية فلم تهجرها، أما هو، فلم يكن ليعبأ لهذا، ينفلت صوته المشروخ بعد نوبة سعال، يذكرها بعلبة الدخان، لم تذق ” سنية ” طعم الراحة منذ مات زوجها، خرج المسكين للسوق ذات خميس، لم يرجع يومها ” زكريا ” قال الشهود إن معركة حامية الوطيس دارت رحاها بين التجار، انجلت عن جثته، وثلاث طعنات، وتقرير يقيد الحادث ضد مجهول.
هو أكبر أبنائها، لكنها افرطت في تدليله كطفل غرير، تقول في ثقة، وبريق أخاذ يشع من وجهها المجهد :” هو ابني، ورجلي، وسندي في الحياة “، مع الأيام تركت له الحبل على الغارب، لم ترد طلبه، حتى بعدما نضج وبلغ مبلغ الفتيان، لم تتبع هواجس الأقرباء : ” إن ابنك لم يعد صغيرا، التدليل الزائد يفسد الصبيان “، بقيت على عنادها، بل وتمادت في أمانيها؛ فألقت بمدخرات البيت في يده، تردد في خضوع :” هو رجل البيت، لابد وأن يدير معاشنا “، رجع ” محروس ” قبيل الفجر في حالة مزرية يترنح، جعل يهذي في صراخ متصل، مرتميا على الأرض؛ يضحك مرة ويبكي مرة، تقدمت منه في استنكار، لم يكن ابنها الذي تعرفه، وجدت شخصا آخر تجهله، صرخ في وجهها بفم ملء برغوة كريهة، ارتدت خائفة، هذه ليلته الأولى، ولكنها لم تكن الأخيرة.
**
البرتقالي
كل شيء فيه مستفز، مرآه يحيطك بسحابة كثيفة من الضيق، لا اتحدث عن شعره البرتقالي الهايش، وسوالفه الطوال، وأنفه الضخم يلفها شارب كث، ولا وجهه البلاستيكي الأصفر، يكفيك صوته الغليظ وهو يجعر، ساعة يتوسط حوش المدرسة، وصافرته النحاسية الناشبة بين أسنانه المتآكلة تدوي بلا انقطاع، ما أثقله!، أخبرني صديق عن صفته، قال ذات مرة وهو ينفث غضبا :” مجدي، إنسان ثقيل الظل، انتهازي بمعنى الكلمة، جاء به خليل خالد مدرس الألعاب ليساعده في تنظيم طابور الصباح، والسيطرة على المدرسة “، اتحرق كي انصرف من أرض الطابور، اتجنب ملاقاته قدر المستطاع، رغم تودده الباهت لمن حوله، تصحبه نكاته المعادة، يتجول ” مجدي ” كذئب مراوغ بين جنبات المدرسة، تفضحه عيناه حين تبدي اكثر مما تخفي، يغرق المدرسات من تحت جفن ثقيل دون تحفظ، يشعرك بأن الحياة قد خلت من كل قيمة، تزداد كراهيتي لهذا المخلوق العابث عند كل صباح، يخنق صدري عادم دراجته النارية الداكن، وأزيزها المزعج، يقهقه في ضجيج، لا يسلم أحيانا من توبيخ الناظر وتقريعه لجرأته، لكنه قادر على تحويل الأزمة لصالحه، تعاود ضحكته تجلجل من جديد، تعلن انتهاء المشكلة، اغرم ” مجدي ” ” بعفاف ” مدرسة الفلسفة، و”عفاف ” أرملة أربعينية معتدلة القوام، ذات جسد مكتنز اللحم، يزينه ردف ثقيل، وصدر ناشب، وبشرة خمرية ملتهبة، وعينان مشبعتان بالأنوثة، ومن تحتهما شفاه حارة تقطر دائما بالحمرة، ربما أغراه هذا بها وجعل منها صيدا رخيصا، وربما كانت هي السبب، فهي موزعة النظرات بنهم فاضح لعيون الرجال كمراهقة صغيرة.
رأيته وقد اتخذ لنفسه متكئا، يرشف الشاي في توحش، وينفث دخان سيجارته في توتر، وبصره الجائع معلق بجسدها كلما مرت من أمامه.
حتى جاء صباح، لفحت وجهي فيه حرارة تدفقت من عين الشمس التي تنفجر خيوطها كالنار، كنت حزينا لا أعرف لحزني سبب، وكانت الطيور قد اتخذت لها مكانا فوق شجرة الكافور العتيقة، تصدح بنشيدها المعتاد، اقبل مندفعا في منظر كريه، يسيل لعابه، يحمحم في تجرئ، وكأنه يبحث عن شيء، توقف قليلا قبل أن يتوجه صوب حجرة المدرسين، كانت فارغة إلا من ” عفاف” خيم في هاته الساعة على المكان سكون مميت قاتل، وكأن الزمن قد توقف، واختفت الأصوات من حولي، كل شيء أصابه الخرس وتلاشى، إلا صوتا ثقيلا ينبعث من صدري، تلاحق خفقان قلبي، ظللت مشدوها هذه المرة لما يدور بالحجرة، أزاح عن المكان صمته، صوت ضحكاته المستفزة، جعل يضحك ويضحك دون توقف، هذا ما اتذكره، قبل ان يمتلئ المكان بأهله، تقدم الناظر في صرامه وتجهم، وإلى جانبه ” ممدوح ” أمين المخازن غريم ” مجدي ” الذي دس فمه في أذن الناطر، يلوح بيده في انفعال، انكب الشيخ ” طلبة ” مدرس الدين يهش الطلاب، الذين تسمروا أمام الباب يأكلهم الفضول، خرجت ” عفاف ” أخيرا، لكنها لم تكن كما عهدناها في هندامها المرتب وأناقتها المعروفة، بل كانت منهارة في فوضى عارمة، دامعة العينين، تقبض على فردة الحذاء تلوح بها متوعدة ” مجدي “، الذي خرج على إثرها مارقا بين الأجساد المتراصة، يكيل الشتائم منفعلا.
أخيرا أقدم الذئب على فعلته، تجرأ واقتحم الحرم لم يخيب ظني فيه، لا نعلم ماذا حدث بينهما، لكن الظاهر أنه راودها عن نفسها وهي استعصمت، اختفى ” مجدي ” بعد فترة، وبهتت جريمته، لكن لعنته ظلت تطارد ” عفاف ” في كل مكان، فعشرات أمثال ” مجدي ” أصابهم الهوس، وجرتهم الغواية لأن يلاحقوها دون تورع.