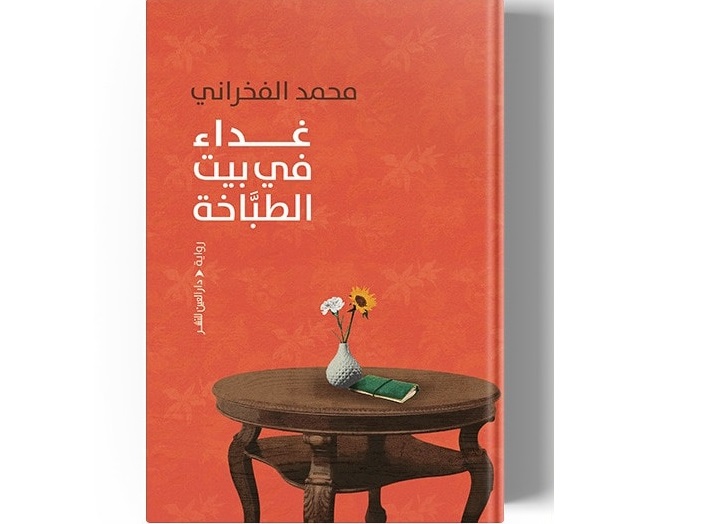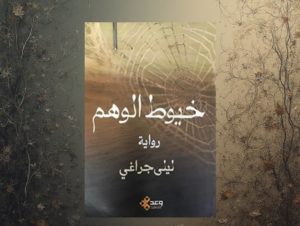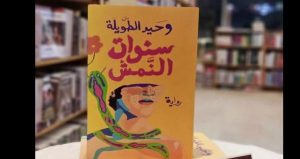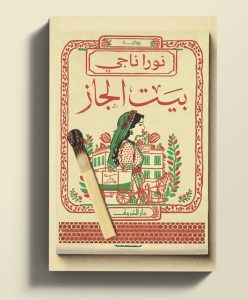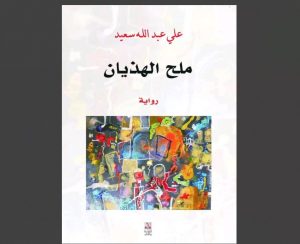بسمة حسن
تتميز الرواية بأنها جنس أدبي قادر على تمثيل القضايا الإنسانية الكبرى، واستيعاب التحولات الاجتماعية والثقافية والنفسية التي يشهدها الإنسان في مختلف البيئات والسياقات. ومن بين أبرز الموضوعات التي شغلت الخطاب الروائي المعاصر، تبرز النزعة الإنسانية بوصفها توجهًا فكريًّا وفلسفيًّا يقوم على تمجيد قيمة الإنسان، والتعبير عن معاناته في مواجهة الظلم والقهر والتهميش. وتتمثّل النزعة الإنسانية، في السياق الأدبي، في رسم شخصيات تعبر عن الانكسار الإنساني، وتقدم نماذج للضعف والتضحية، وتطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالهوية والوجود والعلاقات الإنسانية، وتدعو للانفتاح على الآخر.
وتأتي رواية “غداء في بيت الطباخة” 2023م للكاتب محمد الفخراني باعتبارها نصًا سرديًّا يعكس هذه النزعة من خلال استغلال أحداث يومية بسيطة تجري داخل فضاء مكاني محدود تحت مظلة حدث أكبر جارٍ هو الحرب، لتبرز من خلالها دلالات إنسانية عميقة تتصل بعوالم الطبقات المهمشة، كما توظّف الرواية تقنيات سردية وفنية متعددة، لتعزيز هذا المنحى الإنساني، وتحفيز القارئ على تأمل الظواهر من هذا المنظور، وتقع الرواية في مائة وواحد وأربعين صفحة مازجة بين الواقع والفانتازيا والخيال، وتدور أحداثها حول جنديين متناحرين كادا يقتلان بعضهما بعضًا، مجهولي الاسم والهُوية والانتماءات الوطنية والثقافية والدينية، تضطرهما ظروف حرب ما جارية غير محددة زمانيًّا أو مكانيًّا دائرة بين طرفين مجهولين للبقاء معًا في خندق صغير غير محدد لمدة خمسة أيام متتالية، وخلال هذه المدة نرى كيفية تحول العلاقة بينهما من عداء وكراهية إلى حب وصداقة.
وإذا أردنا تعريف الإنسانية (Humanism) فهي موقف فكري وفلسفي يؤكد على الإمكانات الفردية والاجتماعية وفاعلية البشر والوجود الإنساني، ويعتبرهم نقطة البداية للبحث الأخلاقي والفلسفي، وقد تغير معنى مصطلح “الإنسانية” بتعاقب الحركات الفكرية على مر العصور، فخلال عصر النهضة الإيطالية، أسهم مفكرون إيطاليون في نشأة الحركة الإنسانية مستلهمين الدراسات الكلاسيكية اليونانية، وخلال عصر التنوير، تعززت القيم الإنسانية بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي، ما منح البشر ثقة في استكشافهم للعالم. وبحلول أوائل القرن العشرين، ازدهرت الحركات الداعية للإنسانية في أمريكا وأوروبا وارتبطت بالعلمانية، وتوسعت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم.
وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، أصبح يشير المصطلح عمومًا إلى مركزية الإنسان وأهمية الخبرة والتجربة الإنسانية، ويدعو إلى حريته واستقلاليته وتقدمه وخلق سعادته، وعلى هذا فإن مفهوم “النزعة الإنسانية” يختلف عن “الشعور الإنساني”، الذي يعد موقفًا أخلاقيًّا ذاتيًّا، بينما التوجه الإنساني فيعبر عن موقف ورؤية للوجود.
ورغم الطابع الإيجابي المتفائل الذي تؤمن به النزعة الإنسانية وتدعو له احتفاءً بالإنسان وتحررًا من كل سلطة دينية كانت أو سياسية، فإنها على الجانب الفكري والعملي لا تخلو من بعض الإشكاليات، فهي تقوم على الثقة الزائدة في النوازع القيمية والأخلاقية والخيرية الداخلية للإنسان، وطبيعته الفطرية المنفتحة على المشاركة والتواصل وتقبل الآخر والحب والتسامح وغيرها من القيم النبيلة، وهي نظرة تحمل نوعًا من الرومانسية الفكرية والمثالية التي تبدو منفصلة عن الواقع الإنساني المعقد وطبيعة النفس البشرية، تخاطب المشاعر أكثر من كونها تقدم حلولًا عملية فاعلة للمشكلات التي تواجه الإنسان المعاصر في عالم مليء بالتناقضات والنزاعات والصراعات والاختلافات.
تتجلى النزعة الإنسانية في نص الفخراني بوصفها محورًا رئيسيًّا في بناء العالم الروائي شكلًا ومضمونًا، إذ يحتفي الكاتب بالإنسان بكل ما يحمله من تنوع وقدرة وثراء داخلي عابر لجميع الفوارق والخصوصيات الثقافية والاجتماعية والوطنية، وهي الفكرة التي في سبيلها استخدم التقنيات السردية التي ساعدته على توصيل هذا المغزى، فبدءًا من العنوان انشغل الفخراني على الفور بإرساء فكرته، التي نحَّت جانبًا موضوع الرواية الرئيسي وهو “الحرب”، فاختاره “غداء في بيت الطباخة” وهو عنوان بعيد تمامًا عن فكرة “الحرب” لكنه يحمل تكثيفًا لفكرة الرواية ومقصدها الإنساني، وهذا العنوان يشير إلى مشهد رئيسي متخيَّل داخل الرواية حيث تستقبل فيه والدة الطباخ جميع جنود الحرب من كلا الفريقين المتحاربين على مائدة واحدة، في مشهد يجسد الألفة والتواصل الإنساني العابر للفوارق الاجتماعية والدينية والجغرافية والثقافية والسياسية.
تلا العنوان جملة مفتاحية مكثفة تحمل مغزى الرواية وهي “في المكان رائحة إنسانية”، ليبدأ بعدها في عرض فصول الرواية التي تتكون من تسعة فصول، خمسة منها تتضمن حوارات بين بطلي العمل، والأربعة فصول الأخرى خصصها الفخراني للحرب بعد أن أنسنها وحولها لبطل مستقل أو شخصية تتحدث عن نفسها، وحملت جميعها الاسم نفسه (الحرب)، كما قصد الكاتب المساواة في عناوين الفصول بين المدرس والطباخ، فمرة يبدأها بالمدرس، والمرة التالية يبدأها بالطباخ، وكلها مقاصد دلالية واضحة على المغزى الإنساني الذي تقوم على أساسه الرواية.
اختار محمد الفخراني أيضًا أن يكون بطلا روايته مجهولي الأسماء والانتماءات الوطنية والثقافية والدينية، لأن كل اسم له ثراث خاص به يرمز إليه، لذلك فقد حرر الفخراني بطليه من اسميهما وانتماءاتهما، وكأنهما يدخلان هذا العالم لأول مرة، وكأنه سعى أن يكون لقاؤهما بدء خليقة جديدة لا تعرف لغة الكراهية والقتل والحرب بل السلام والمحبة والإنسانية.
وبرز ذلك بوضوح من خلال التفريق بين هويتي الشخصيتين عبر توصيفهما في البداية قبل التعريف بمهنتيهما باللونين الرمادي لـ”مدرس التاريخ” والبني لـ”الطباخ” وامتد هذا التجهيل إلى الأم (الطباخة) وزوجة المدرس وابنته، وهو ما عرض الشخصيات جميعها بشكل به نوع من التجريد ونزع الأبعاد الفردية عنهم لتصبح نماذج إنسانية عامة فتحول التشخيص إلى تمثيل رمزي، وهو ما يحمل في طياته الإشارة إلى بني البشر جميعًا على اختلاف انتماءاتهم وبلادهم وتوجهاتهم.
ولم يكن اختيار الكاتب لمهنتي مدرس التاريخ والطباخ أمرًا اعتباطيًّا بل كان مقصودًا أيضًا، فتكمن رمزية مدرس التاريخ في أنه مطَّلع على تاريخ الحروب البشرية وما تسببه من موت ودمار وقطيعة ما بين البشر، لذا بدت شخصية الجندي “الرمادي” أكثر تفهمًا ومرونة من شخصية الجندي “البني” الطباخ الذي بدا متحجرًا ومحتاطًا من “الرمادي”، الألوان أيضًا حملت دلالة على هذا الأمر فاللون الرمادي منفتح لا يحمل تعصبًا ما أو انحيازًا معينًا، بينما اللون البني فهو يرمز لحالة من الانغلاق والتحيز.
أما عن مهنة الطباخ، فلأن الطعام هو رمز للمشاركة الإنسانية، وتقديم الطعام للآخر هي دعوة للحب والحوار والتفاهم، ووسيلة للشعور بالسعادة، وهذا يحيلنا للرمز الأكبر في الرواية وهو “الأم” أو “الطباخة” بوصفها الرمز المثالي للإنسانية والعطاء.
امتد التجهيل في الرواية إلى البعدين الزماني والمكاني أيضًا، فلا يشير النص إلى مكان جغرافي محدد ولا إلى زمن معلوم لهذه الحرب، وبهذا فقد انفتح الفضاء السردي على أفق رمزي غير منسوب إلى سياق سياسي بعينه، بل قدمه الفخراني بوصفه حالة إنسانية عامة تتكرر على مدار التاريخ الذي يعيد أحداثه، وهو ما عزز الخطاب الفلسفي في الرواية.
وقد تجلت مظاهر التجريب الفني في الرواية، فعبر تقنية السرد الموازي وظَّف الكاتب “الحرب” بصفتها شخصية إنسانية تتحدث وتعبر وتشعر وتتألم وتعاتب غاضبة البشر وأفعالهم، وظهرت بمثابة حكاءة ذاتية عبرت عما يدور في خلدها من خلال صوت أنثوي رقيق يصف نفسه بالطفلة، ويتمنى حياة عادية وقصة حب.
ومثَّل كل من الطعام والنبتة والخندق مظاهر للتواشج والتشارك الإنساني في الرواية، فالطعام أساسه المشاركة وهو رمز حميمي لتقبل الآخر والانفتاح عليه والشعور معه بالسعادة، وقد وظف الكاتب الطعام في الرواية بشكل دافئ وحميمي وإنساني قرب بين البطلين وامتد لخط رمزي فلسفي يمحو الاختلاف ويجمع ما بين البشر في بيت الطباخة، وجسَّد الخندق برمزيته المكانية الأرض وفضاء الرواية للمشاركة الإنسانية، وكأن الكاتب يقول إن البشر بتنوعاتهم واختلافاتهم وصراعاتهم ونزاعاتهم في كل هذا العالم وعلى هذه الأرض هم جميعًا في خندق واحد.
وبعد طرح أهم الأفكار التي تناولتها الرواية، هنا يمكننا أن نبدأ بسؤال مفاده: هل تضمن أطروحات الفخراني التي تفترض نموذجًا إنسانيًّا يحمل خيرًا داخليًّا بالسليقة، منفتحًا على الحوار وتفهم الآخر وقف الصراعات والحروب البشرية؟ الإجابة بالطبع لا، ياحبذا لو كان الحوار فقط كفيلًا بذلك، ولكن الحقيقة أن بيت الطباخة لا يسع الجميع، ولكنه الآن أصبح يسع الأقوى فقط، خاصة مع ما نشاهده اليوم من موت ودمار وصراعات وحروب خرجت جميعها عن حدود العقل والحوار والمنطق، وغابت فيها العدالة المنتظر تحقيقها على يد الإنسان المتسبب في هذا الدمار، فالحل الذي طرحه الفخراني لبداية جديدة بين البشر، وهي الحوار، لن يكفي وحده لإقامة مجتمع تتحقق فيه المساواة والعدالة، لأن ذلك لا يتطلب الحوار وحده بقدر ما يتطلب تقبل وجود هذا الآخر وتشاركه في هذه الأرض واختلافه والاعتراف بهويته وخصوصيته ومغايرته، هذا هو الاختبار الحقيقي للإنسان، فليس شرطًا أن يكون الإنسان شبيهًا لأخيه الإنسان أو اختلافه اختلافًا حياتيًّا مقبولًا لكي يتقبله أو يتعايش معه وينعمان بجنة يصنعانها معًا على الأرض، فيمحون أسماءهم ويتجاهلون هوياتهم وخلفياتهم وانتماءاتهم، ولكن يكمن التسامح الحقيقي في احترام هذه كل هذه الاختلافات والتعامل مع هذا الآخر الذي تجمعني معه مشتركات إنسانية على هذا الأساس.
رمت الرواية أيضًا إلى تحول العالم لمجتمع إنساني واحد تنمحي فيه جميع الفروق العرقية، وتذوب فيه جميع المحفزات التي قد تثير العصبية والتحيز والعداء والعنصرية، فهناك توحيد للوطن والقيم يخلق علاقات إنسانية منسجمة داخل العائلة البشرية، بما يتجاهل التمايزات الهوياتية والخصوصيات الثقافية.
هنا الجميع منتمٍ لقيمة واحدة وهي الإنسانية، لذا يحدث ما يمكن أن نسميه انصهارًا للهويات والانتماءات بجميع أشكالها والخصوصيات الثقافية والتمايزات الفردية بين البشر، وهذا يحمل نوعًا من تبسيط مفهوم الآخر وكأن من السهل التماهي مع تعقيداته وتفكيكها، فها هو يقول على لسان الحرب:
“لاحظت أنها الرائحة الإنسانية، لا تظهر إلا في التجمعات البشرية الكبيرة، بشر يشتركون في عمل طيب، لا يعرفون أسماء بعضهم بعضًا، ولا من أين جاء أي أحد منهم، لا يهتم أي منهم ليعرف أي شيء عن أخيه”([1]).
ومن المستغرب أن يحصر الكاتب قيمة الاختلاف في الرواية في المتعة ودرء الملل وإثارة الدهشة والفضول والابتسام، وليس في احترام الآخر وتقديره والإفادة الثقافية المتبادلة الناتجة عن هذا الاختلاف، وأن يضفي خصوصية على مناحٍ عامة كالمشاعر والرؤى والأسلوب والذوق والأفكار !
“المدرس: تعرف؟ أفكر في الاختلاف بين البشر على أنه وسيلة للمتعة،
أقصد يمكن أن يستعمله أي منا ليستمتع…
فأنت باختلافك ستكون مثيرًا لفضولي”([2]).
ورغم تركيز الكاتب على تقديم فكرة فلسفية تُعلي قيمة التواشج الإنساني لمواجهة الحروب والصراعات البشرية والعنف، وتتجاوز أسباب الحرب وخلفياتها السياسية، فإنها بدت مغرقة في المثالية ما أضعف من واقعية السرد خاصة مع هذا المزج للخيال والفانتازيا داخل الرواية، ما أظهر الأحداث والشخصيات وكأنها خيالية وأقرب للحلم منها إلى الواقع، وأهمل أبعاده الاجتماعية والثقافية والنفسية، ونتج عن هذا نوع من تسطيح التجربة الإنسانية وتغييب الصراعات البشرية والتعقيدات النفسية وتجميل المعاناة وهو ما يؤثر في المصداقية السردية، فافتراض النزوع للخير والتسامح لدى كل البشر، هو طرح مثالي يبتعد عن الواقع أيضًا، ويؤثر في الصورة البريئة التي أخرج الكاتب بها الحرب، رغم أنها فعل إنساني، هذا الإنسان الذي يدافع عنه ويفترض فيه فطرة الجنوح للسلام وكراهية العنف والاعتداء.
كذلك غابت الحدود والمسافات بين القيم فاتسمت بالتعييم والحياد داخل الرواية، حيث تعامل الكاتب مع كل ما تسببه الحرب من مآسٍ وجرائم بروح من التسامح ذابت فيها الحدود بين الخير والشر والظلم والعدل، فلم نعد نفرق بين الظالم والمظلوم والجاني والمجني عليه والمعتدي والمعتدى عليه، ما أضعف الموقف الأخلاقي في الرواية.
هذا يحيلنا إلى نقطة أخرى وهي غياب البعد الروحاني عن الرواية، حيث لم يتطرق النص إلى أي إحالات روحية وغيبية تتعلق بوجود هذا الكون وصانعه، وهذه الرؤية تميل إلى السياق الغربي الذي يحتفي بمركزية الإنسان وقدراته وحدها بمعزل عن المرجعيات الدينية، هذه القدرات التي مهما علت تظل محدودة، وتحيلنا تلك النقطة من جهة أخرى إلى ضرورة عدم إغفال أن الغرب قوة عظمى اعتادت تاريخيًّا على فرض السيطرة على من رأتهم دائمًا أدنى وأضعف، هذه السيطرة التي تتنوع أشكالها عسكرية كانت أم علمية وتكنولوجية أم ثقافية وفكرية، ولكن تظل الرواية تجربة مبادِرة تقدم حلمًا نبيلًا أراه صعب التحقق، ربما يومًا تفتح بابًا للتأمل في سبل تحقيق التآلف والعدالة الإنسانية على هذه الأرض.
……………………………..
[1] – محمد الفخراني، “غداء في بيت الطباخة”، الطبعة الأولى، دار العين للنشر، القاهرة، 2023م، ص 121.
[2] – محمد الفخراني، “غداء في بيت الطباخة”، الطبعة الأولى، دار العين للنشر، القاهرة، 2023م، ص 46.