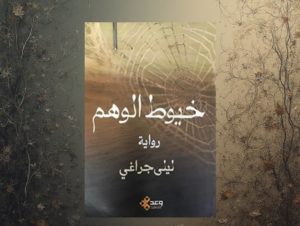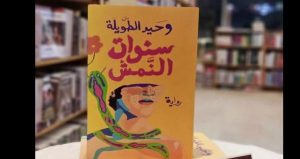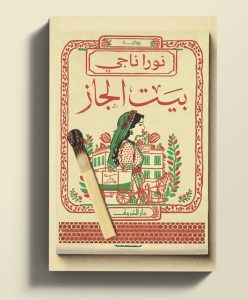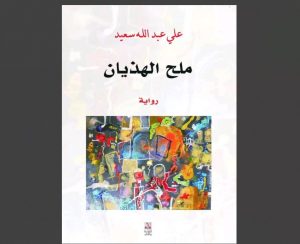د.أماني فؤاد
يتأسس ديوان “مرايا نيويورك” للشاعر “سمير درويش” في قصائده الإحدى والثلاثين على مجموعة من المشاهد المتنوعة، والصور التي تتشكل وفق منظومة إبداعية تتضمن مستويات من التجريب الإبداعي، وأنواعًا من المتخيل الشعري الذي يتم سرده وفق رؤى خاصة للوجود. ويتفرد هذا الديوان من إنتاج الشاعر الذي تجاوز خمسة عشر ديوانًا بأنه جدل مع الذات، وكشف لطريقة تلقيها للوجود المركب من حولها، وتعرية لأبعادها الوجدانية والعقلية.
وتحتل المرأة بالديوان مكانة محورية بحياة الشاعر وجدلية لا تنتهي، تهبه التوازن الوجودي، وتدفعه للتخلي عن نزعة الوحدة، وتظل واحة تخلخل القسوة بهذه الحياة، كما أن الديوان يقدم وعيًا مستوعبًا للكيان البشري “الإنسان” حيث يتشكل وفق تكامل الطبيعتين معًا المرأة والرجل.
وتتنوع المشاهد الشعرية في الديوان إلى:
1- مشاهد تلهو بعنصري الزمان والمكان وتلغي حدودهما وتقوم على لعبة الافتراضات باستخدام صيغة: “لو أنني..”، مشاهد تاريخية تُقدم بروح المعاصرة، وبأماكن مختلفة رغم الإطار الوهمي الذي حدده الشاعر بمرايا مدينة نيويورك.
2- مجموعة من الصور لامرأة جميلة وغامضة، يضفي عليها الشاعر خيالاته وتأويلاته الخاصة ليعوض تنائيهما، ويخلق عوالم متخيلة وصراعًا داخليًّا معها.
3- مشاهد أخرى يستدعيها من ذاكرته ويعاود بعث ما كانت تبثه في ماضيه من حياة وآمال. وتتضمن كل القصائد قدرًا من المزج بين المتخيل والواقع كل بحسب طبيعة التجربة الشعرية الخاصة به.
المتخيل في قصائد “لو أنني..:
يخلق الشاعر عددًا من الافتراضات في ثلاث قصائد، ويشيد بنيتها تأسيسًا على تخيله لو أنه بمكان شخصيات أو نماذج تاريخية موظفًا الحرف “لو” وهو ما يفيد في دلالة اللغة “امتناع الامتناع”، ويتوسل به ليعرض مواقف إنسانية تشبه سيناريو الأفلام القصيرة ذات التتابع المشهدي الغني بدلالته الرمزية أو الكنائية الساخرة غالبًا، تكوينات مشهدية تتضمن في دلالتها الكامنة رؤية إنسانية عميقة صارت أكثر تعبيرًا عن اقتناعات الشاعر الآنية، ولو أن سردية تلك المشاهد عادت لعقود مضت لربما اختلف موقف الشاعر إيديولوجيا من قضاياها، هذا الموقف المعاصر الذي يأتي إنسانيًّا منفتحًا على الآخر وعلى التواصل والحب، التسامح، أو الحياد على الأقل مع الوجود دون الرغبة في السيطرة على البشر أو إراقة الدماء، كما تتضمن المشاهد في عمقها أيضا نوعًا من افتقاد الرضا بالواقع وكأنها مبطنة بالهروب منه، كما لا تخلو تلك الصور المتحركة من رؤية خاصة للمرأة رغم أنها ليست شخصية المشهد المحورية، وإبراز لفاعلية وجودها على الرجل حيث تستطيع أن تحيل العنف والدماء والتقاتل إلى لحظات أكثر تواؤمًا مع الحياة وتقبلًا لها.
وتتضمن معظم المشاهد التي يتخيل الشاعر نفسه فيها بدلًا من أبطالها الحقيقيين بالتاريخ نوعًا من التفكيك والسخرية من إيديولوجيات الماضي وحكاياته الكبرى مثل الشيوعية في “قبر ستالين” أو الشيفونية النازية وقيادة الجماهير والسيطرة عليهم في “قلب جوبلز”، أو ترهات العواطف المفرطة ومظاهر الرومانسية والخنوثة في “مطرب العواطف”. والشاعر بخلقه لهذه العوالم الافتراضية كأنه يخلق مسافة بينه وبين الواقع والتاريخ معًا، يغادر الاثنين نسبيًّا ليعاود رؤية عوالم زمنية أخرى متلبسًا لكيانات شخوصها، يوهم أنه لا يعلو على الواقعي أو التاريخي ولا يريد أن يشكلهما مرة أخرى أو يتلبس دور المصلح أو النبي، حيث يصرح شعريًّا أنه لا يحمل أي مشروع إقناعي أو إيديولوجية جديدة، فقط يتراءى له أن يقرأ بعض ملامحه في ضوء بعض المقارنات العبثية بين الماضي والحاضر، بين الآخرين الذين ذهبوا وبين اقتناعاته المعاصرة، فالشاعر لا ينخرط بالعالم من حوله بالفعل، بل يتخذ موقع المراقب الذي يتلذذ بوحدته وخلق عوالمه الخاصة المفترضة، حيث المشاهد والصور التي حفزت الحيوية بها مدينته التي أحبها “نيويورك” فتراءت المشاهد على مراياها المصقولة الصافية، أو مرايا وعيه الذاتي التي فوقها تشف خيالاته وأحلامه؛ ليحركها بحيادية نسبية بإرادته أو دونها، ويهيئ لها تتابعات مشهدية مرسومة كفن السيناريو حيث التفكير بالصور المتتابعة والحوار، وتلقي العالم في لحظاته المتوترة الفيصلية، بحيث تبدو محفزات لمراجعة الماضي ودفع السخرية المبطنة في الجمل الشعرية المعبرة عن شخوصه.
تتراوح المشاهد بين الحيادية ورمادية الوقع والإيقاع في الغالب، وبعضها الآخر تظهر بها أحاسيس الشاعر وأحلامه. وهو إذ يصرح بأنه غير معني بتغير العالم أو إصلاحه يعبر عن إيديولوجية كائنة بالفعل بداخله وموقف من قضايا الوجود، لكنه يوهم قارئه أنه لا يكترث.
يفكك الشاعر بدم يوهم ببرودته وحياديته اليوتيبيات التي كانت والحكايات الكبرى، ويعبر عن وعي صار مثقلًا بمفهوم إنساني أكثر إدراكًا لمقولات الشيوعية وضجيج زعمائها في “قبر ستالين” حين يقول:
“لو كنتُ ضابطَ أمنٍ سوفييتيًّا
في خمسينيات القرن العشرين،
لا أظنني سألبس طاقيةً صوفيةً مستديرةً،
كي لا أبدو تقليديًّا،
وقد ألعنُ “ستالين” كلما حانتْ فرصةٌ،
/../
لو رأيتُ الدماءَ تجري على الأرصفةِ كنتُ سأغضبُ،
كسوفييتيٍّ حرٍّ” 7، 8.
وكأن الذات الشاعرة تكشف دموية وغوغائية أزمنة قد مضت بأفكارها، وأريقت بها كثير من الدماء.
كما يلعب المبدع على العناصر والتفاصيل الدقيقة بالصورة “المشهد”، مثل “طاقية صوفية مستديرة” تلك التي تكسب المشاهد دلالتها وهوية أفرادها؛ ليدلل على تغير المعتقدات ورؤى الحياة والخروج من النمط والنموذج الذي رسخ بالذاكرة، كما يحفز ذهن متلقيه على استحضار الزمن والمكان وأحداث التاريخ التي مرت من تلك المفردات التي تشكل عناصر الصورة والمشهد وتهبه أبعاده المكانية والزمنية.
يقول في قصيدته “قلب جوبلز”:
“لو أنني وزيرُ الدعايةِ في حكومة النازيِّ،
لن أكونَ بعيدًا ممَّا أنا عليهِ الآنَ
/../
لو أنني وزيرُ الدعايةِ لن أستمرَّ في موقعِي طويلاً،
لأنني سوفَ آخذُ “إيفا براون” لغرفةٍ مغلقةٍ،
وكأسي فُودكا،
وموسيقى تجعلُ الصخبَ يخفتُ تدريجيًّا
/../
ربما سأشاغبُ امرأةً وحيدةً،
وأغنِّي أغنياتٍ هابطةْ” 19، 21.
تظهر المرأة بالمشاهد كخلاص وملاذ للفرار موظفًا لشخصيات تاريخية يحوطها الغموض مثل “إيفا براون” عشيقة هتلر وزوجته ومصورته الخاصة، حيث يجدها الشاعر بديلًا لعوالم الوحدة والقسوة، كما يتيح حضورها أوقاتٍ أكثر متعة ودفئًا وحيرة أيضًا في تاريخ مضى مكتظ بالتوجس والدموية في قصيدتيه “قبر استالين” و”قلب جوبلز” وهو ما يرسخ لمكانة المرأة المحورية في شعرية هذا الديوان، وفي وعي الشاعر.
تستمر العناصر ومفردات المشهد وأسماء الشخصيات التاريخية وهي ما تكسب المشهد طقسه الخاص ومرحلته الزمنية وخلفيته العقدية.
وإذ تعلن قصيدة ما بعد الحداثة القطيعة مع الماضي ينقسم موقف الشاعر من هذا الماضي، فأما التاريخ والأحداث التي حدثت بالفعل يعاود الشاعر تشكيل مشاهدها وإعادة قراءتها، وفيما يتعلق بجماليات تيار الحداثة الصلبة والمحددة يحاول الشاعر أن يفلت من غوايتها المستمرة.
يمضي في إعادة مساءلة التاريخ ونماذج أحداثه. في قصيدته “مطرب العواطف” يقول:
” لو كنتُ مطربًا عاطفيًّا في التسعينياتِ،
سأرتدي قميصًا مفتوحَ الصدرِ،
أسودَ،
وحُلَّةً رماديةً داكنةً
/../
المطربونَ العاطفيونَ ليسُوا مسئولينَ
عن الاختناقاتِ المروريةِ،
وإشغالاتِ الأرصفةِ..” 15.
وهكذا يعري الشاعر مرحلة زمنية تمادى فيها أجيال من الشباب مع المظاهر الرومانسية واجترار الأحزان. وتظل الملابس وعناصر الصورة في إشارات مركزة وسريعة تسيطر على صياغة المشاهد وتكوين بنيتها وتحديد فتراتها التاريخية لتوليد السخرية في القصائد والتهيئة للطقس الزمني. كما يوظف الشاعر اليومي من أحداث والمتداول، ما يعانيه الإنسان اليوم “الاختناقات المرورية، وإشغالات الأرصفة” ليكسب قصيدته صبغة تياره الإبداعي.
فوق كيان حرف “لو” أقام الشاعر حيوات بديلة، عملية تلبس شخوص الماضي ونماذجه التي مثلت مراحل فكرية وثقافية عالمية، وإبدالها بذات الشاعر المعاصرة، وعلى ذات الحرف أيضًا قوض الشاعر كل العوالم التي شيدت من قبل، ففي نهجه هذا يبدو قابضًا على طبيعة الشاعر في تيار ما بعد الحداثة ورؤاه غير المكترثة، الساخرة بالحياة.
المرأة دال ودلالة محورية في ديوان مرايا نيويورك:
في مرايا نيويورك المصقولة الصافية، تتجسد الذكريات والصور وتعاود نبضها، فتتراءى للشاعر النساء اللاتي مررن بحياته وترك لهن خنادق آمنة لا تتآكل مع الزمن، يتذكر فتاته الشابة ويرصد لتغيرها في “غواية الفنار”، ويبقي على حب أخرى في “عاشق إلكتروني”، ويصف غواية جسد المرأة ونضج استداراته ووقعه على صاحبته الفلاحة الفطرية التي تشاهد نضج أنوثتها، ويلحظها معها الشاعر في “عيون بهية”، كما تخاتله غواية صور إحدى النساء في تجربة إشكالية تتضمن صراعها الخاص وتشكل ما يزيد عن نصف قصائد الديوان.
تحتل المرأة في هذا الديوان إذن مستويات وجدانية متفاوتة وكأنها تسكن طبقات متعددة عميقة من وعي الشاعر ووجدانه وغرائزه، لا تنفي إحداهن الأخرى، بل يتعايشن بداخله وقد تشكلت لكل منهن منطقة خاصة.
تعاود المرأة النفاذ من ذاكرته وعلى مراياه في بعض القصائد مثل: “عصفور النار، عيون بهية، غواية الفنار، عاشق إلكتروني” و”حور العين” فيحضرن الساكنات بالتاريخ النفسي للشاعر بالقصيدة، يقول في “عصفور النار”:
“على الجانبِ المعتمِ من ذاكرتي تقفُ وحيدةً،
في منطقةٍ وفرتُ لها أمانًا من تقلُّباتي “(10).
ويقول حاكيًا لامرأة الصور عن فتاته في “غواية الفنار”:
هل ترقصينَ على الحصَى عندَ الفنارِ؟
فتاتي الصغيرةُ كانتْ تترُكُ شعرَهَا
لريحِ الشتاءِ
تحضنُنِي
تأخذُنِي إلى كنوزِهَا المغلقةِ
وتضحكُ، وتراوغُ، وتجري
لمْ تكنْ صورةً بيضاءَ ناصعةً كالحليبِ
قبلَ أنْ تصيرَ أمًّا لشابينِ
وتغطِّي شعرَهَا” (40).
ولا ينسى الشاعر الساخر الواعي بالتغير الذي يمثل الحقيقة الوحيدة بالوجود أن يرصد التحولات التي طرأت على نسائه اللاتي مثلن لديه وقتها فتيات الأحلام في حس وجودي.
مستوى آخر يتبدى في قصيدة “عاشق إلكتروني” يقول:
“لعلَّنِي محظوظٌ لأن امرأةً ما في العالمِ
تنتظرُ وردةً إلكترونيةً في بريدِهَا
كلَّ صباحٍ
فأقولُ إنني أحبُّهَا
كما لم يحب أحدٌ أحدًا
فتبدُو فرحانةً أكثرَ مما تحتملُ ذاكرتي!” (67).
توفر المرأة في القصيدة قيمة التوازن النفسي، الرصيد الذي لا ينفذ ويتكئ عليه الشاعر في الحياة. ويدلل فرحها على استمرار قدرته على أن يهب السعادة وهو جانب إنساني رفيع الشعور.
الصور الصامتة سردية شعرية:
وتحتل المرأة صاحبة الصور في مستوى حائر غير متشكل نصف ما كتب من قصائد الديوان أو أكثر لأنه حتى بالقصائد التي لا تخصها كأنه يحاورها، يقدم لها بطاقة تعريف بشخصه، ومن خلال صورها يقص الشاعر عن ذاته والعالم من حوله. يشيد رغبات مؤجلة لمستقبل يفترض إمكان تحققه معها، ويراوده الشك واليأس أيضًا في إمكانية حدوثه ومن هنا يتشكل الصراع ويعاني تذبذبه، يقول في قصيدته “الفستان الأزرق”:
” لستُ متأكدًا أنني أنا
وأنَّ العصافيرَ التي على الأشجارِ هي العصافيرُ
وأنَّ النيلَ الذي يرافقُنَا هو النيلُ
وأنَّ القهوةَ قهوةٌ بالفعلِ، وبسكرٍ قليلٍ
لكنني متيقنٌ أن فستانَكِ الأزرقَ
الذي يمتدُّ على السجادةِ الحمراءِ.. هذا
صالحٌ لأكتبَ قصيدةً على ذيلِهِ
في آخر الليلْ.” (52).
يتخيل مشاهد تأسيسًا على الصور التي تبدو وكأنها أداة التواصل الوحيدة بينهما، ففي قصيدتيه “قهوة الصباح” و”الفستان الأزرق” وغيرهما، تعد الصور مرجعيته التي تثير الإبداع لديه، تحفز الصور القصيدة، فالأخيرة غايته الحقيقية، فتبعث الصور بالقصيدة النبض والحيوية رغم صمت المرأة وجمودها، يقول في قصيدة “الأرائك الصامتة”:
” أنا اليومَ كسولٌ بما يكفي لأحزَنَ، ومرهقٌ
ليسَ بي رغبةٌ لأفتحَ الشباكَ
ولن أراسلَ امرأةَ القصيدةِ،
حسبَ رغبتِهَا” (81).
القصيدة لا المرأة هي غاية الشاعر، المرأة وصورها مجرد الجسر الحيوي التي تخطو عليه التراكيب والجمل الشعرية التي ينتظرها الشاعر ويتشوقها.
وتسرد القصائد التي شيدت وفق الصور في مجموعها مراحل تلقي الشاعر لكل صورة، وكيف مثلت الصور تتابع تطور رؤية الشاعر لتلك المرأة، فبنظرة بانورامية للديوان يمكننا أن نلحظ مشروع سردي في إهاب شعري، فمثلًا تأتي قصيدة “أحمر شفاف” لتمثل لحظة المباغتة أو الشرارة الأولى، تحكي البدايات، ولذا يسميها بالقصيدة الطائشة، يقول:
“لماذا أحبُّ الأحمرَ حينَ يداهمُ امرأةً،
تبدُو شفافةً، وليِّنةً، ملساءَ، وأيقونةَ حزنٍ،
وعاشقةً كلاسيكيَّةً
/../
أو ربمَا أحبُّ المرأةَ التي تداهمُ الأحمرَ،
حينَ يكونُ مستكينًا في خزانتِهَا،
كي تبدوَ نمرةً، أو غزالةً، أو سورةً من القرآنِ،
أو حصانًا بريًّا لم يفلحْ تاريخُ الرجولةِ في ترويضِهِ؟
/../
القصيدة الطائشة – كهذه-
القصيدةُ الطائشةُ -كهذِهِ-
لا أكتبُهَا إلا حينَمَا أصحُو من النومِ،
مباشرةً، محمَّلاً بصورٍ بريَّةٍ قذفَهَا اللهُ في أحلامِي،
وتعمَّدَ -في تلكَ الليلةِ بالذاتِ-
أن يصبغَهَا بالأحمرِ،
جميعَهَا،
وأنْ يقولَ لي: “اقرأْ”، و”إنَّا أرسلناكَ”!(24).
كأن الأحمر بالقصيدة أصبح وحيًا، لم يعد لونًا فحسب، ربما اجتياحًا مزلزلًا استدعى انقلابًا بوعي الشاعر وأحلامه، واستدعاءً لقصيدته التي هي آلهته ومن أجلها يصطف الجميع قرابين هو والنساء والحياة، ولأنه لا يملك من المرأة سوى صورة -فيما أرجح-ـ جاءت صيغ بناء الجمل الشعرية كلها تشي بالاحتمالية، وتعدد الافتراضات التي يشيدها الشاعر في وصف المرأة “ربما، وتكرار حرف أو عدد من المرات”، وعبرت عن بعض التناقض أيضًا، كما تدلل صيغ التساؤل عن حالة ملتبسة على الذات الشاعرة نفسها، وعلى القصيدة أيضًا التي بوغتت بالصورة ولذا تأرجحت الاحتمالات والصيغ.
تتأكد تلك الحيرة والمباغتة في قصيدته “عروس البحر” لكن ببنية فنية مختلفة، يقول:
“القصيدةُ عاشقةٌ كأنَّهَا بحرٌ
والبحرُ عاشقٌ كأنَّهُ شمسٌ
والشمسُ عابثةٌ عاشقةٌ مجنونةٌ كأنَّهَا جنيَّةٌ
والجنيةُ كأَنَّهَا كوكبٌ دريٌّ
ترتدِي قميصًا ورديًّا مشدودًا كقوسٍ؛
فوقَ صدرٍ وافرٍ يعشقُ الشعرَ الذي يتوغلُ
باحثًا عن جنيَّةٍ عاشقةٍ
ليستْ قصيدةً فقطْ!” (32).
تأتي صيغ الجمل الشعرية دائرية لا تملك يقينًا، وتعود إحداها على الأخرى، حتى إن الشاعر لا يستطيع تمييز الحدود بين امرأة الصور، والأشياء والموجودات حولها: البحر والشمس والقصيدة والجنية وبين الشاعر نفسه والشعر، تلك التكوينات الدائرية التي تلتف تنبئ بنيتها الفنية عن حالة وجدانية تجتاح الشاعر، مباغتة لم تزل تتخلق بداخله ولذا تتكرر بها الصيغ التي لا تنمو بقدر ما تتعرقل في مفرداتها أو في صمتها لتعود لمبتدئها.
ويتلون شكل تشييد القصيدة وطريقة بنية تراكيبها لدى الشاعر، ففي قصيدة “عاشق إلكتروني” تأتي نهاية القصيدة وكأنها ملخص لمقطوعات القصيدة السابقة، نتائج نهاية البحث عن الذات، إجمال لما فصله في السابق، يقول:
” لعلَّنِي محظوظٌ لأن الموتَ المبكِّرَ أقلُّ كلفةً
ولأنَّ العفاريتَ تُغْنِي عن الناسِ
أحيانًا
ولأن هاتفي لا يرنُّ تقريبًا
ولأن الصورَ أضحتْ متاحةً إلكترونيًّا
ولأن ورودَ الديجيتال فاقعٌ ألوانُهَا
ولأنني أستطيعُ أن أقولَ “أحبُّكِ” ما زلتُ” (67).
فتتجمع تلك الجمل الشعرية لتلخص كل واحدة منها فقرة من مقطوعات القصيدة السابقة.
ويتأكد لا يقين الشاعر من شيء أو انطباع أو شعور لدى امرأة الصور حول الذات الشاعرة، حيث يظل صمتها حاضرًا، فتظهر في القصائد المتتالية مجرد جسد وافر وجميل يحمل غوايته للشاعر، ثابت لا يشي بمكنونه، يقول في قصيدة أوتار العود:
“ولا أضحكُ إلا نادرًا
ولا أقولُ لشيءٍ: كنْ
لأنني لستُ إلهًا كاملاً، حتَّى الآنَ
ولأنني لا أهتمُّ بالأشياءِ إن كانتْ أم لم تكنْ.
/../
ولأن السماءَ لم ترسلْنِي برسالةٍ لأحدٍ
(حتى لامرأةٍ تحتفظُ بمساحةٍ لأشواقِهَا)
وأظنها لن ترسلَني أبدًا” (77).
رغم هذا يستمر يخلق من الصور المشاهد والأحلام ويحاورها ويبثها مواقف متخيلة شتى، تتذبذب فيها مشاعره مستمتعًا بلعبة الصور في شكلها السطحي، وساخطًا على صمت المرأة في صراعه الداخلي، يقول في قصيدة “كونشرتو البيانو” محاولًا إقناعها باللعبة واستدراجها لساحته:
“يمكنُنَا أن نقسِّمَ الدنيا إلى مربعاتٍ متجاورةٍ
نضعُ بعضًا من نزواتِنَا فيهَا
ونتخيلُ -لأننا بعيدانِ هكذَا-
أننا نستمعُ إلى موسيقَى هادئةٍ لموزارتْ” (83).
ففي رحلة الصور التي بدأت بالمباغتة والاستحواذ على انتباه الشاعر، ثم الصمت الغالب على المرأة وحياديتها يقنع الشاعر بمجرد الأحلام وتصبح عوضًا في لاوعيه عن اللاتواصل معها، يقول في “يلضم المجرات”:
“وأنتِ تعاركينَ أمواجَ البحِر كجنيٍة تحبُّ الموسيقى
تذكري أنني أجلسُ على كرسيٍّ منعزلٍ
/../
وأنت تمشينَ نحوي بقدمينِ حافيتينِ
سيكونُ ثمةُ معنى لخوفي الفطريِّ
من التورطِ في تسجيلِ الحلمِ
سأحاولُ لملمةَ قطراتِ الماءِ قبلِ انزلاقِهَا
إلى الرملِ، بقسوةٍ
تناسبُ ارتطامَ مجرَّةٍ بقلبِ شاعرٍ
يلضمُ المجراتِ كمِسبحةٍ.
لستُ متورطًا حتى الآنَ بما يكفي جنوني
فقطْ أستقبلُكِ في أحلامٍ متتاليةٍ
وينسابُ كونشيرتو البيانو
من تلقائِهِ” (84، 85).
ويتسرب ضيق الشاعر بهذا الصمت، يضاف إليه إدراكه للمسافات الفعلية والمعنوية التي بينه وبين امرأة الصور وصمتها، وتوقعه لخوفها من تطورات القصيدة، ومساحة البوح والحرية التي يسبح بها خيال الشاعر، والتصورات التي تخلقها القصيدة، يقول في قصيدة “دم البكارة”:
“القصيدةُ تتخطَّى الحجبَ دونَ إرادتِي، فعلاً واللهِ
دائمًا أكونُ واقفًا في الجانبِ الآمنِ
أشربُ قهوةً عند مفترقِ الشارعينِ الكبيرينِ
وأفكِّرُ في أهوالِ السياسةِ، والحزنِ المجتمعيِّ، وأسعارِ الدولارِ
فتأخذُنِي إلى أماكنَ لمْ أفكرْ في اقتحامِهَا
ظاهريًّا على الأقلْ.
هل سنتوقفُ تمامًا عنْ لعبةِ الصورِ؟
هل ثمَّ قواعدُ لمْ نقلْهَا تخصُّ المدَى المسموحَ؟
وهل يكونُ الشاعرُ راغبًا في القطيفةِ
حينَ يحاولُ اختراقَهَا؟
الشاعرُ -صدقِينِي- يشربُ قهوتَهُ فقطْ
وينظرُ للناسِ بعمقٍ تارةً
وتارةً يتركُ إحساسَهُ للصورِ المتصارعةِ
التي تقودُهُ إلى عوالِمِهَا” (44).
في القصائد يتبدى الحس السردي الذي يطبع شعرية هذا الديوان ولذا يتخير الشاعر تكوين الجمل والمفردات في مستوى أقرب إلى الكلام العادي “فعلا والله”، وتطغى اللغة التقريرية غالبًا، وتأتي في مستواها التداولي اليومي ولا يلجأ الشاعر إلى الكنايات أو الاستعارة أو الرمز إلا حينما يتلافى التصريح ببعض المشاعر والرغبات الغريزية. يقول في قصيدة “عازفة الجيتار”:
“تدخلُ من البابِ بقميصٍ أسودَ، واسعٍ
مشدودٍ بإحكامٍ أسفلَ صدرِهَا
فيطيرُ نهداهَا كأوزَّتينِ برِّيتيْنَ
ويمتلئُ سريري بالقصائدِ
(ألمْ أُغلق البابَ من الداخلِ؟)
تضعُ الجيتارَ مائلاً على الحائطِ الذي بدا أخضرَ
تفتحُ ذراعيْهَا الأبيضيْنِ فينشقُّ القميصُ كبحرِ موسى
ثمَّ موسيقى إسبانيَّةٌ تصدحُ
وراقصاتٌ في قمصانٍ سودٍ -كقميصِهَا- يرقصْنَ
والأوزُّ يرفرفُ في سقفِ الغرفةِ
ويعودُ موسى إلى شاطئِهِ الأوَّلِ
/../
الأنبياءُ يتناوبونَ السهرَ حولَ قوائمِ سريري
والطيورُ تبيضُ، والعناكبُ تغزلُ أعشاشهَا
والثعابينُ تدخلُ الشقوقَ
والسحرةُ مربوطونَ من خلافٍ
لأنَّني قررتُ أنْ أنغمسَ في النغماتِ الإسبانيةِ
ومراقصةَ حورياتِ العينِ
وتدجينَ الأوزِّ البريّ” (56، 57).
تعد قصيدة “عازفة الجيتار” من القصائد التي حفلت بتقنيات الشعر المجازية الفنية المتنوعة، فتأخذ القصيدة شكل الحلم بتكويناته السردية، وتحفل بالتناصات مع الموروثات الدينية المقدسة التي يقتنص الشاعر طقسها السردي والغرائبي ليضفيه على حلمه مع امرأة حلمه، ووقعه على ذاته وسمتها المقدس لديه، مثل قصة موسى وانتصاف البحر، ويغزل من عجائب قصص الأنبياء ما يصور أساطيره التي يخلقها من وقع اختراق المرأة لغرفته بملابسها، والراقصات اللائي صحبنها وموسيقاها الإسبانية والأوز الأبيض الذي يغادر جسدها ليعلو فوق سقف خيال الشاعر وغرفته، تمثل الملابس والألوان بالقصائد محورًا تشكيليًّا مهمًّا يعوض صمت المرأة ويلعب على فاعلية الصورة وعناصرها في تشكيل الشاعرية في قصيدة ما بعد الحداثة والثقافة المعاصرة.
وتمضي قصيدة “عازفة الجيتار” في فقراتها الشعرية لتبدأ إحداها بكلمة (اقرأ) في استمرار للتناص مع النص القرآني المقدس، يكتب الشاعر وحيه الخاص، ويتنزل عليه جبريله ليقرئه هذا الوحي الذي يزلزل نفسه وقصائده وحلمه يقول:
“(اقرأْ)
ثمَّ ضوءٌ ساطعٌ ينفلتُ من فتحاتِ القميصِ
ونغماتٌ تتمشَّى على سجادةِ الأرضِ
(اقرأْ)
كيف ينفتحُ البابُ من تلقائهِ يا ربُّ
وكيفَ تساقَطَ الأوزُّ بغتةً من فتحةٍ بالسماءِ
(إني قد آنستُ نارًا)” (57).
في قصيدة “الموعد الأول” يتخيل ما قد يقوله لامرأة الصور:
“ما الذي سيقولُهُ شاعرٌ هَرِمٌ في موعدِهِ الأوَّلِ،
بينَمَا المرأةُ تتخفَّى خلفَ تاييرٍ كلاسيكيٍ
ووقارٍ يناسبُ موقعَهَا
/../
ويفكِّرَ -فقطْ- أن عليهِ تقبيلَهَا،
كي يمضيَا إلى طاولةِ الحوارِ مباشرةً!” (55).
طبيعة العلاقة الصامتة المتباعدة أوجدت صيغًا لغوية قائمة على الاحتمالية والتوقعات والتأويلات، أطلقت خيال الشاعر ليقيم هو عوالمه معها التي يشك أنها يمكن أن تحدث من الأساس، وهو ما أكسب هذا الديوان صراعًا له طبيعته الخاصة.
ففي نهاية الديوان في قصيدة “المصابيح الحمراء” يقول: “
“هذا الوقتُ مناسبٌ جدًّا كي أنامَ
دونَ دموعٍ مالحةٍ ومصابيحَ حمراءَ
ودونَ أفكارٍ مغروسةٍ بامتدادِ الأرصفةِ
ودونَ غرفٍ مظلمةٍ
تلكَ التي يزرعُهَا اللهُ بأجنحةٍ بيضاءَ
لا تناسبُ شاعرًا يغنِّي أغنياتٍ حزينةً
لنهارٍ، يعرفُ أَنَّهُ
لنْ يجيءْ!” (92).
يتعمد الشاعر أن تأتي قصيدته منقاة من أي تقص للشعرية الكلاسيكية أو التي تتغيا خلق عالم لغوي مجازي خاص بها، فيتوسل بلغة الحديث اليومي في رغبة لوضع قصائده في برنامج حمية غذائية يسلبها كل مقومات شعرية قصيدة الحداثة وتكويناتها الاستعارية وأساليبها المجازية وتركيباتها الخاصة.
ولا يلجأ الشاعر لهذه التكوينات اللغوية المجازية إلا قليلًا، وذلك لخلق رموز تهب دلالات تتعلق بمحاولة تصوير وتجسيد معان مجردة تنتاب الذات الشاعرة من وقع الصور، أو بعض استدعاءات ذاكرته لمشاهد تخص نساء أخريات بحياته في قصائد مثل “عيون بهية” أو “عاشق إلكتروني”.
كما نلحظ تعمدًا من الشاعر ألا ينفذ خلف سطح الصور، ألا يعيش سوى في الافتراضات التي يخلقها مكتفيًا بهذا، راصدًا من مسافة، أو عاشقًا افتراضيًّا، أو يخلق حياة وصراعًا من خلال مجموعة من صور امرأة لا يتعامل إلا مع بعد وحيد بها، سطحها الخارجي، شاعر تيار ما بعد الحداثة لا يرغب في فعل حقيقي، ينسحب من الانخراط بالوجود بالفعل.
ولذا تصبح تقنية الحلم بديلًا عن الواقع الذي لا يملك الشاعر أن يحياه.
المرايا في الديوان ليست لنيويورك، المدينة بطبيعتها المغسولة المنظمة محفزًا ليرى الشاعر مرايا ذاته وتأويلاته الخاصة، وعلى أسطحها المتعددة تتحرك مشاهده لتجسد انطباعاته حول العالم المحيط به وليس المنخرط فيه، كما أن قصائد الديوان كتبت معظمها في فترة زمنية متقاربة للغاية وكأنها دفقة حيوية شعرية حفزتها المدينة واحتضنتها.
كما تتميز شعرية ديوان “مرايا نيويورك” بالعديد من سمات الشعر في تيار ما بعد الحداثة مثل:
– محاولة إظهار اللااكتراث بالعالم والتخفف من الرغبة في حمل رسالة إصلاحية، والاحتفاء بالوحدة والانعزال، كما تسعد الذات الشاعرة بكائنات أخرى تخلقها وتعيش معها أقل إزعاجًا من البشر، وتعد تلك الرؤية مناقضة لنهج الشاعر في كتاباته الفكرية والاجتماعية، كما تخالف المشروع الذي يؤديه في مقالات تنشر مسلسلة بجريدة “المقال”، وفيه يتحلى بروح علمية منضبطة تقوم على تفنيد الكثير من المقولات والموروثات وتفكيكها دون استعداء مباشر وفج للمؤسسات الدينية في المجتمع المتزمت، ويتحرى فيها التحليلات الموضوعية والعودة للمراجع والمصادر التي اكتسبت قداسة رغم أنها من وضع البشر، ويقوم بتعرية الكثير من الأساطير التي صاحبت أعلام ورجال الدين وتأويلاتهم في وعي بظروف وملابسات كثير من مقولات التراث الديني وأعلامه ومفسريه. كما أن هذه الذات الشاعرة التي تبدو حيادية لا تضع خطوطًا حمراء وهي تتصدى للتحليلات السياسية في الكتابات الصحفية. وهو ما يشير إلى اختلافات وتناقضات الذات المبدعة في مستواها الشعري والفكري الحياتي.
كيف تجتمع النقائض؟ كيف يجسد ويسرد قصته التي احتدمت مع الصور برؤية حالمة رومانسية وهو الذات الشاعرة ما بعد الحداثية الساخرة التي لا تكترث؟ كما يضاف إلى هذه المتجاورات التي تشكل مجموع اقتناعاته قدرته على الكتابة الفكرية وهموم الشأن العام. وربما أيضًا تلك بعض الأقنعة التي تتكشف له عن ذاته بمرايا نيويورك.
– تحضر الأشياء المهملة وتحتل موقعًا في شعرية الديوان مثل أن يتحدث عن عوادم السيارات وأعمدة الإنارة وعلب المشروبات الغازية الفارغة في قصيدته “مطرب العواطف”، وتتبدى ثقافة السلعة وطغيان مظاهرها حين يرصد اللوحات الإعلانية. كما تتبدى طريقة تعامل خاصة مع الأشياء الصغيرة فلا يكتفي الشاعر بها لمجرد الرصد بل من أجل الرمز.
– الاحتفاء بالجسد حيث إنه الكيان المادي الإنساني الذي من خلاله تنتقل الكثير من قدراتنا وتلقينا للعالم، كما يشكل الجسد الصورة بهذا الديوان أيقونة صامتة تحمل غموضها وإثارتها في آن واحد.
– القصيدة هي المعشوقة أم المرأة؟ لا كيان يؤمن به الشاعر قدر حرصه على تدفق قصائده يقول: “ربما لأنني أبالغ في اعتناق دين قصائدي” (70)، هدف الشاعر الجوهري الحياة، وحياته في شعره، والمرأة هي الطاقة التي يدفعها بالقصيدة.
في النهاية ماذا لو أن هناك إمكانية لاستنطاق المرأة الصامتة في الديوان، المرأة التي اكتفى الشاعر بسجنها في الصور والألوان، يقرأ ما تومئ به أزياؤها أو تخفيه، نظرتها أو ملامح جسدها، المرأة التي وصفها بأنها المكتفية، والمغرورة، التي لا تعد بشيء، وتحتار أين تضع يديها مثل نساء لوحات موديلياني؟
تحاور الذات الشاعرة صورها فقط، وترسم مشاهد لهما معًا متخيلة دون أن تكون شريكًا حقيقيًّا، ويحلق معها بمشاعره ورغباته، فيتبدى نزق قصائده المستند إلى الأحلام والمتخيل، وتحتفي قراءة الصور بالجسد ليس بالمفهوم المادي، بل جسرًا لعوالم أكثر تحررًا ونورانية، فيرسم عوالم سحرية تحتفي بكائنات أخرى أسطورية يستدعيها الحلم وما وراء الصور من حيوات مأمولة تغري بها صور معشوقة كلاسيكية شفافة. ويتوالى بالقصائد صراع بداخل الرائي الشاعر لا تدري المرأة عنه شيئًا، فمنذ الإهداء يقر الشاعر بأن نصف ما كتبه مهدى إليها وله هو رغبة مؤجلة. أتراها ارتضت حصرها في مجرد تأويل الشاعر لمجموعة من الصور ذات البعد الواحد؟!
أتصور لو أنها نطقت بعد تأمل تجربة الصور والقصائد لشعرت بالغبن، فالتجربة بالأساس ملك لشاعر قلص كيانها في مجموعة صور دون أن يداهم حقيقتها وأبعادها مكتملة، واكتفي برصدها من مسافة تضمن له ألا ينخرط ويحافظ على حياديته، فالشاعر ليس إلهًا كما أنه لا يحتمل صراع الأنبياء. أو ربما احتفظت بهم بخزانتها مجموعة من اللآلئ المشغولة بعناية تذكرها بشاعر يراها امرأة تحتار في أي مكان تضع يديها، وتلك صورة من سيولة تيار ما بعد الحداثة وحياديته.