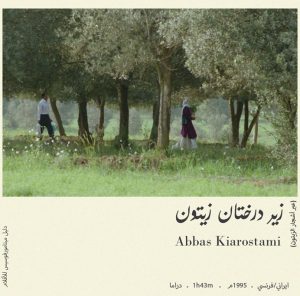مازن حلمى
جاء تيار ما بعد الحداثة إعلانًا عن سقوط السرديات الكبرى، ولامركزية الإنسان، وعدم الإيمان المطلق بالعقل بعد فشل مشروع الحداثة في بناء مجتمع إنسانى حر، لذا شاع في مظاهر الثقافة والفن ظاهرة التجزيء، والتشظى، ومنطق التجاور لا الخطية في السرد تحطيمًا لقواعد كلاسيكية، ونسفًا لحقائق كنا نعدها من المُسلَّمات.
في السينما مثلًا لم نعد نشاهد أفلامًا عن عصر بكامله، أو مناقشة قضايا كالعدالة، والحرية. إنما تغلب الأفكار الجزئية، والموضوعات الهامشية فى محاولة لفهم العالم عبر تفكيكه إلى وحدات صغيرة بالبدء من الورقة حتى نصل إلى الشجرة.
فيلم “بلاش تبوسنى” نموذجًا لسينما ما بعد الحداثة شكلًا، ومضمونًا. الفيلم أنتجته شركات ميدل وست، و ويكا للإنتاج والتوزيع عام 2018م، تصوير حسام شاهين، موسيقى تصويرية عمر فاضل، وإخراج أحمد عامر في أولى تجاربه الإخراجية.
السينما والأخلاق
يُحيل عنوان الفيلم إلى أغنية شهيرة للمطرب “محمد عبد الوهاب” وسحر الأبيض والأسود، ورومانسية الماضى، بينما يتمسك المضمون بمعناه الحرفى، فالقصة تدور حول بطلة إغراء ترفض أن تُقبَّل، ومدى توقف العمل على هذه القبلة.. العنوان ذكى، مراوغ يحمل مفارقة، ومرثية لحال السينما المصرية، وما آلت إليه مقارنة بعصرها الذهبى.
يبدأ السيناريو من ذروة الدراما، يضع المتلقى مباشرة أمام المشكلة دون مشاهد تمهيدية؛ للتركيز على جوهر القضية، ثم تدريجيًا يأخذ شكل التحقيق حيث يعرض وجهات النظر مابين المؤيدين للقبلات على الشاشة، والرافضين لها، أو ما بين الاتجاهين: المحافظ، والليبرالى رغم أن الفريق المعارض هما “فجر” البطلة، وتُجسد دورها الممثلة “ياسمين رئيس”، والشيخ الداعية “أحمد سليم” في مقابل كل صناع الفيلم. لا أحد ينتصر في النهاية. كلاهما يكمل طريقه بناءً على قناعاته. تُمثِّل فجر بالحجاب الباروكة، ويصنع المخرج أفلامه على هواه؛ لأن التطرف الدينى صارت له أرضية شعبية في الماضى كان يمكن السيطرة عليه حيث يظهر ويختفى، ويخص فئة بعينها. أما الآن فقد أصاب العطب عقلية المجتمع. تَحكُم الأغلبية على الفن بمعيار أخلاقى. تدعو إلى ما يُعرف بالسينما النظيفة من ثَمَّ تُعيدنا إلى عصور محاكم التفتيش، وهو مؤشر واضح على تراجع مناخ الحرية، وغياب الأفكار المستنيرة. يُترجم ذلك من خلال معادل موضوعى في أحد المشاهد البديعة الساخرة. ترفض الأم المحجبة “سوسن بدر” محاولات ابنها العائد من السفر تقبيلها، أو احتضانها مكتفية بالسلام. هكذا يجب أن تكون السينما من وجهة نظر الأصوليين.. سينما خالية المشاعر بلا روح.
تشريح الصناعة
يُعرِّى الفيلم الواقع السينمائى. يكشف عن ذهنية أفراده وضحالة ثقافتهم خاصة الممثلين. هم يجهلون أبسط أبجديات السينما، فالعمل لديهم قائم على الهواية لا الاحتراف، و وسيلة لجلب المال والشهرة ليس إلا. يُبرز سمة التناقض في الفنان المصرى حيث يلعب كل الأدوار في بداية مشواره الفنى، ثم عند منتصف الرحلة ونهايتها يلجأ إلى التدين، والاعتزال، أو العمل المشروط كالتمثيل بالحجاب؛ تكفيرًا عما اقترفه.
عندما تعلن فجر عدم هجرها الفن تفاجئ جمهورها بتقديم برامج للطبخ، وشتان ما بين العالمين. يظهر هذا التناقض أيضًا في ألوان ملابسها التي تجمع بين الأحمر والأبيض في تنافر صارخ.
السينما فن جماعى بقيادة المخرج، يحدد من خلال رؤيته دور كل فرد، وأهميته في خلق سيمفونية بصرية سمعية متناغمة. تأتى الأولوية للمونتير الذى يضبط الإيقاع، ويعيد ترتيب المادة الفيلمية خالقًا أسلوبًا ومعنى يتفق مع نظرته. مثل غالبية صناع الفيلم لا يعرف المونتير “مصطفى أبو سريع” خطورة عمله، يضع قططًا في البناء الدرامى ليس لغرض سوى متعته وحبه لها. تتواصل ثيمة السخرية والاستهجان، تتضح في مدى استخفاف الممثلات الجدد بالمهنة معتمدين على جمالهن وغنجهن في مشهد اختيار الدوبليرة.
ثمة بعض الإسقاطات على شخوص حقيقية، فالمنتج حسن البطاوى، ” بطرس غالى” منتج شهير معروف بأفلامه الهابطة. أما الشيخ فهو أحد الدعاة المشغولين بجسد المرأة، تم استدعاؤهما بتلك الصورة التهكمية كأنه ينتقم من كل مخربى العقول والفنون. لا ينسى في لوحته مصممة الأزياء، والفنيين، والعمال، حتى المهووسين بالفنانين، وحرب الإشاعات التي تلاحق السينمائيين، ودور الصحافة في تضخيم النجوم في مقابل تهميش من وراء الكاميرا. كما يقسم الجمهور نفسه إلى شرائح، فالسينما مكان النوم لبعض الناس، وشريط أخلاقى للبعض الآخر، وقطعة فنية حية لفئة يبحث عنها الفنان، ويحلم أن تتسع كى يصير العالم أكثر جمالًا.
اعتبار المخرج
هذه القبلة الإشكالية ما هى إلا ثقبًا نرى من خلاله خفايا العمل السينمائى، وصعوبات المهنة، وما يواجهه المخرج من إحباط بداية من إعادة المشهد الواحد عشرات المرات، مرورًا بعلاقته بالممثل النجم، وضرورة تلبية رغباته وأهواءه، ولعبة القط والفأر بينه وبين المنتج، رأس المال الجاهل، وليس انتهاءً بالجمهور، الضلع الثالث في عملية الإبداع، وكيفية فرض رؤية مغايرة على جمهور يميل إلى التقليدية والمحافظة.
يُعبِّر أحمد عامر عن معاناته في إخراج فيلمه الأول للنور، يتجلى بصريًا في أحد التكوينات المتكررة ملصق فيلم شارلى شابلن الأخير “أضواء المسرح”، ناقلًا تجربته من الخاص إلى العام؛ ليثير أزمة الفنان في العالم، وإهدار طاقاته في معارك جانبية بعيدة عن الإبداع ومدى محدودية الحرية المسموح له، مما يُحدث نوعًا من التماهى والشفقة عند المشاهد يدفعه لإعادة التفكير في مُسلَّمات، وقيم مجتمعية، وضرورة مواجهة القيود الدينية، والاقتصادية الرأسمالية المفروضة على المبدع.
يظهر المخرج تامر تيمور “محمد مهران” بهيئة مزرية. لا يثق بنفسه. لا يسيطر على ممثليه. تتجاهله البطلة. تطالب المذيعة بطرده في مشهد لقاء تليفزيونى مع أبطاله، لكن الإلحاح على إغفال المخرج في مشهدين متتالين أدى إلى تكرار الفكرة. يستعيد المخرج أناقته، واتزانه بعد اتخاذه قرارًا بنشر مشهد القبلة الحقيقى على الإنترنت، وإقدامه على تقديم فيلم آخر. إنه ينتصر لذاته، يحفظ كرامة الفنان داخله، ولو من خلال عمل تخييلى؛ حتى يتحقق ذلك على أرض الواقع.
ظواهر ما بعد الحداثة
عادة ما يلجأ المخرجون في أفلامهم الأولى إلى استعراض مواهبهم، وقدراتهم الفنية؛ للحصول على الاعتراف، و وضع أقدامهم على أول الطريق. يستخدم عامر أساليب ما بعد حداثية في لغته السينمائية، لكنها من بنية الدراما، وليست من خارجها، منها:
– المزج بين الروائى والتسجيلى: بينما نتابع أحداث الفيلم نرى فيلمًا تسجيليًا عن الأخير، أى أن هناك نوعان من السينما، وذلك يسمح بتوظيف إمكانات التسجيلى؛ لإلقاء الضوء بشكل واقعى على مشكلات السينما الحالية. يستحضر المخرج رموز الصناعة والعاملين فيها؛ لتلقى بشهادتها مثل المخرج “محمد خان”، ورفيقه “خيرى بشارة”، والمصور “كمال عبد العزيز”.
– التغريب وكسر الإيهام: هناك اتفاق ضمنى بين المُشاهد والمؤلف أن ما يشاهده على الشاشة عالمًا خياليًا لا يمت للواقع بصلة. يخرق المخرج هذا العقد الخيالى؛ ليضع المشاهد في أتون منغصات حياته، يدعوه للتفكير، ويحرضه على التمرد. وفقًا للمفهوم البريختى يصنع سينما الفعل لا الفُرجة. يخرج المتفرج حاملًا همومًا فكرية وإنسانية بدلًا من أن يلقى همومه الخاصة.
– النوستالجيا، أو الحنين إلى الماضى: التركيز على قيم وأخلاق إنسانية ماضية يُراد استعادتها، نراها في القبلة بما تحمله من دلالة، تُعرض القبلات دفعة واحدة عبر مشاهد متتالية من أفلام الأبيض والأسود تأكيدًا على شيوع الحب، وممارسة مظاهره علانية في الزمن الماضى، وانحساره بل محاربته ليس في السينما إنما في حياتنا عمومًا. النوستالجيا هنا للمعارضة وإبراز الماضى في صورة طوباوية.
– استخدام تقنيات تكنولوجية: من خلال عدة حيل سينمائية منها تصغير الشاشة على فجر؛ حتى يُبيِّن صغر عالمها، وضيق الأفق الذى تحيا فيه، فالخلل ليس في الصورة فقط بل في معنى ما تقدمه، وعرض عناوين المجلات والصور يوظف مفردات مختلفة؛ لإبهار وجذب المتلقى، وتوضيح رؤيته الذاتية بطرق عديدة.
– الشكل المسرحى: يأخذ السرد شكلًا مسرحيًا من خلال وحدة المكان. جميع الأحداث تدور في الأستديو، ووحدة الزمان فى الزمن المضارع، ووحدة الموضوع في مناقشة قضية والانتهاء بحل العقدة عبر مناقشات طويلة خفف منها الطابع الكوميدى؛ حتى لا تتحول إلى تنظير جاف. يمكن أن نطلق عليه فيلم المشكلة، أو القضية، وهو يذكرنا بالفيلم الأميركى “خمن من سيأتى على العشاء” للمخرج “ستانلى كرامر.
– استخدام الرمز: توجد علامات بصرية كالشباك المكسور، عين المخرج أو كاميرته المحطمة، و وقوفه أمامها مهمومًا. بالإضافة إلى الحصانين المقيدين بسلسلة وأمامهما تجلس فجر، استعارة رمزية عن تقييد روحها، وجسدها عبر التأويل الدينى المغالى.
– استخدام أسلوب التحقيق التليفزيونى: يتحدث الممثل إلى الكاميرا مباشرة، إلى جانب الكادر المهتز، وتعدد زوايا التصوير، واللقطات السريعة.
اتخذ البناء شكلًا دائريًا. المشهد الأول لزوجين على الفراش الزوجية، بينما المشهد الأخير رجل يجلس وحيدًا على السرير. تنغلق الدائرة بانفصال العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة، واستحالة التواصل بين الكائنين نتيجة التطرف في فهم الدين.
جاء التحول الدرامى لشخصية فجر الرافض للتمثيل عبر سماعها صوت الآذان غير منطقى. تلك حيلة نمطية قدمتها السينما المصرية القديمة مرارًا في حين السبب فقر الإنتاج، وعوازل الصوت غير الجيدة.
برع الممثل “محمد مهران” في دور المخرج بتعبيرات وجهه ونظرات عينيه المعبرة عن قلة الحيلة، بينما لم تقدم الممثلة “ياسمين رئيس” جديدًا. كان أداؤها مكررًا لأدوارها السابقة. أما “سلوى محمد على” فحيويتها، وعفويتها في دور الأم رغم مشاهدها القليلة تبرهن أن الممثل بالحضور والتوهج، لا بعدد المشاهد. أجاد “شريف الخيام” في دور كامل بخفة ظله، وينتظر منه الكثير. كذلك “مصطفى أبو سريع” في دور المونتير، وبقية فريق التمثيل. كما أضفى حضور المخرجين الكبيرين خان وبشارة بشخصياتهما بهجة، وثقلًا على العمل، وتوصيل رسالة مفادها الوقوف وراء شباب المخرجين، ودعم التجارب السينمائية الجادة. كانت موسيقى عمر فاضل مرحة، وقليلة حتى لا تشوش على خطورة الموضوع. كادرات مدير التصوير “حسام شاهين” الرائعة المبنية على اللقطات المتوسطة، والقريبة نجحت في خلق حس التأمل، والحميمية لدى المشاهد. فيلم “بلاش تبوسنى” خطوة على طريق الكوميديا الراقية، تعيد إلى الأذهان سينما الريحانى، وعاطف سالم، ودراميات شكسبير الخالدة.