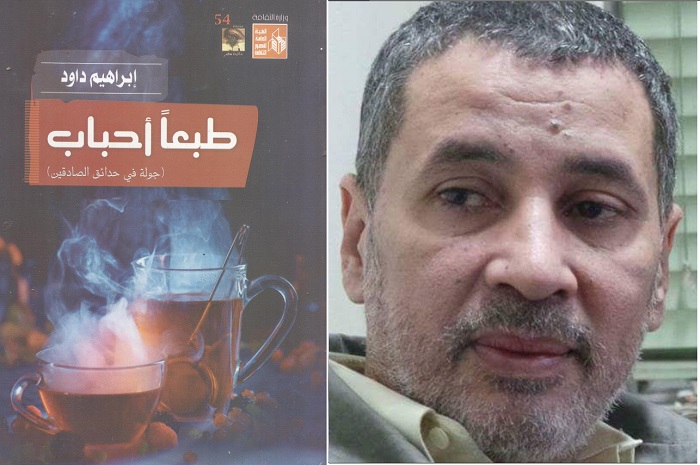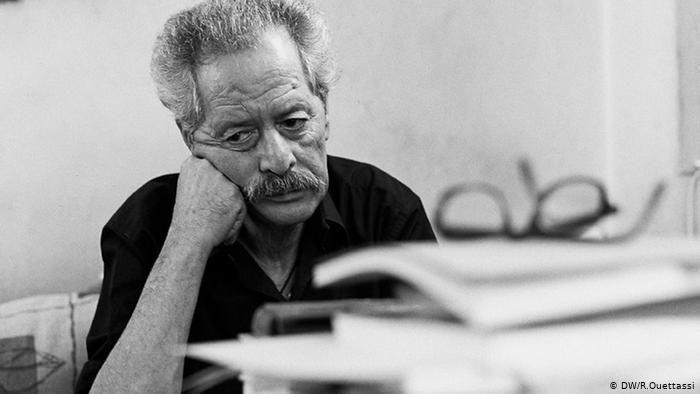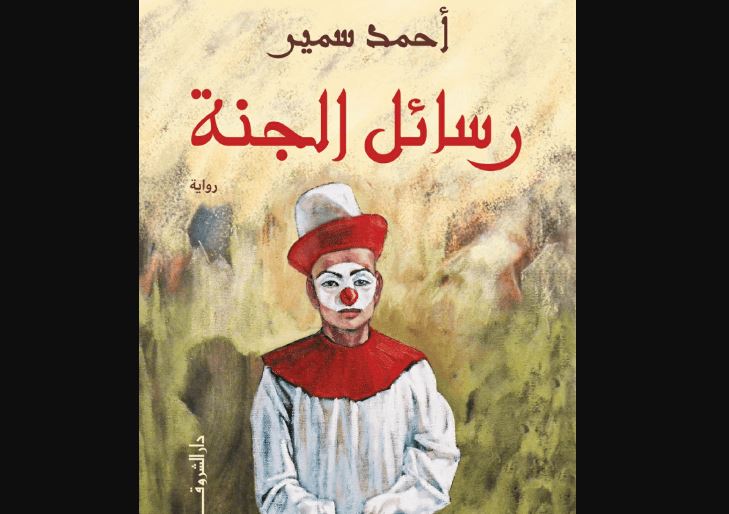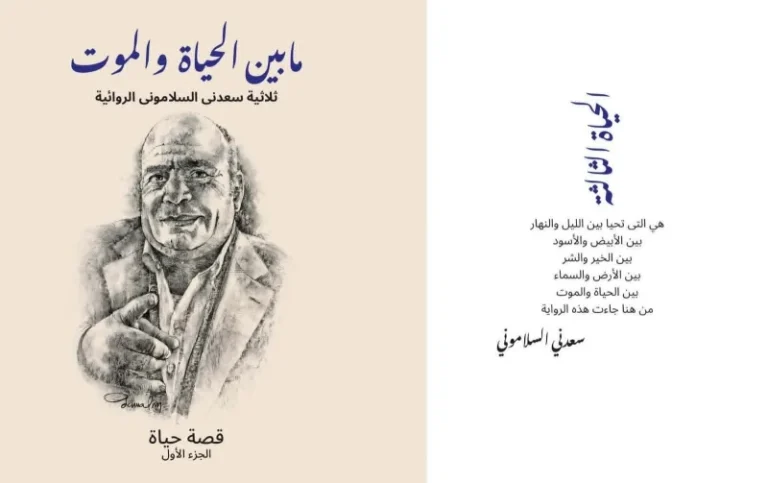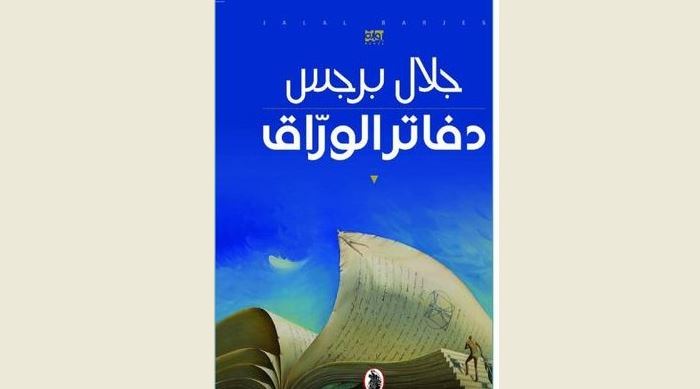شوقي عبد الحميد يحيى
على الرغم من أن قصصا كثيرة تضمها مجموعة “بقع القلب” سهلة التناول، واضحة المعالم، ويصبح التعبير فيها عن الطبقات التحتية، هو الرؤية الأقرب، التى يعبر عنها الكاتب، عبد المنعم الباز، حيث تميل القصص –فى المجموعة-إلى التتابع المنطقى، والاقتراب كثيرا من المباشرة، خلال قصص “قرطاس ترمس” حيث يظل العريس الفقير، الذى تستدرجه الأنثى ليقع فى المحظور، بينما الأب والأم لا يختفيان، حيث يظلا بوجدهما الرمزى. وحيث تظل الموانع الدينية التى لم تتخط الكلمات، هى محور قصة “تفاحات النور”. كما يستمر التعبير عن الطبقات التحيتة، ومعاناتها خلال قصة “الأجنحة بلاد العصافير”. غير ان الصورة تتغير قليلا فى قصة “خطوات الصباح”، حيث تتسع الدائرة ويصبح ذا المستوى المحدود إجتماعيا، يفقد الحب، ويتعادل مع الكلاب والقطط، ويصل به الأمر لأن يصنع من شهادته مركبا يلقى به فى النيل.
إلا ان الكثير أيضا يأتى ليس سهل الهضم، خاصة على القارئ غير المتمرس فى البحث وراء السطور، حيث تمتد القصة كثيرا، فتتسع مساحات الزمان والمكان، ويتوه القارئ-غير المتمرس- بين عديد التفاصيل، والإشارات التى تأخذه أبعد مما توقع. ويأتى من بين هذه النوعية من القصص، القصة التى منحت المجموعة اسمها “بقع القلب” التى يمكن أن ننظر إليها أنها لم تمنح نفسها للمجموعة إعتباطا، حيث أنها تنطوى القصص كلها تحت جناحها، وتوضح رؤية الكاتب وإتجاهاته نحو الحياة، ونحو السياسة، خاصة أنه –مثلما كانت الغالبية من الكتاب فى وقته- قد دون تاريخ كتابة كل قصة، حيث تعطى للقارئ مساحة التأمل فى زمن القصة من الوجهة السياسية والحالة الاجتماعية، وكذك تحدد مدى تطور الإبداع عن الكاتب، وهو ما يساعد فى السير معه إلى ما خلف السطور. فإذا كانت قصة “بقع القلب” مؤرخة 25 /12 / 1992. فإنها تحيل القارئ إلى ما كان من أحوال المجتمع فى تلك الفترة.
فتبدأ القصة بهذه الإشارات الدالة{ “تعبنا يا رب” قالها رجل عجوز وهو يعرج وسط العربات المتسارعة فى ميدان التحرير. .. “تعبنا يا رب” قالتها بائعة تجرى ببضاعتها من شرطة المرافق… “تعبنا يا رب” قالها إثنان يبحثان عن شقة صغيرة بمقدم صغير… “تعبنا يا رب” لم يقلها الولد الذى يحب نيللى والنفرى، لم يقلها ولم يذهب هذا العام لصلاة العيد، لم يقلها ولم يفتح هذا الخميس مجلة البلاى بوى القابعة خلف الكتب، لم يقلها ولم يغادر البيت هذا الصباح}.
لنتأمل أن من يقدمون شكواهم إلى الله، أولئك الذين لم يجدوا من يشكون إليه من الحكومة، بل إنها تطاردهم وهم يبحثون عن لقمة العيش، والتى لا يجدونها إلا (بالشقا). بينما لم يتوجه بشكواه إلى الله، من يحب نيللى، (الممثلة) والنفرى (المرجع للجماعات المتأسلمة)، ومن يعيش بالجنس (مجلة البلاى بوى) ولا يصلى العيد. فالبحث هنا عن الطبقات (الكادحة). والخطاب موجه إلى (الحكومة). ثم نتابع من قاموا بالمظاهرات والخروج منها إلى المطار، والمدرس الذى ورطته الجارة، والأب الذى أحرق كل كتب ابنه الذى كان يحب لينين، ثم من ربى ذقنه استعدادا للسفر إلى السعودية. وهنا تظهر عمليات التناص مع القرآن {سآوى إلى بلد يعصمنى من الفول} { لا عاصم اليوم من البنك الدولى والأسطول السادس} { ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} ليقة –هذا التناص- الضوء على الحالة المجتمعية، والتى لا يجد فيها المرء وسيلة للدعاء، أو الشكوى سوى الله. ثم ياتى النداء الخفى، لهجر الصمت والخوف{الصامتون يستحقون هذا الجهول المغرور، ونحن سنجلس جانب الحيطة إلى أن نسمع الزيطة} فى إشارة (خفية) لشخص الرئيس.. إلى أن يقولها بما يشبه التصريح به، عند ما يقول{قال الرجل المصنوع عام 1927….} حيث نعلم أن مبارك من مواليد (4 مايو 1928) أى انه المصنوع فى العام 1927، ولتحصر الشكوى إلى شخص الرئيس. حيث تم الإشارة إلى السجن، الذى ضم الكثير من البشر فى تلك الفترة {أنت محوت أمية تسعة سجانين فى طره وشاركت فى تشييد مسرح الواحات وزرعت أشجار الليمون فى القناطر…. ورفضت ان تطالب بأى تعويض عن شهور سجن الاستئناف}- ولنلحظ أن المذكر محى أمية تسع سجانين، ولم يق مسجونين، إشارة إلى نوعية من ينفذون الأوامر.كما نلحظ- من القصة- أن كلها إشارات إلى سجناء الرأى او المثقفون. ثم تكاد العوة أن تكون صريحة{هيا يا رفعت تكلم، اكسر هذا الصمت بأى نكتة، نحن ننصت أكثر مما تظن، أكثر مما يبدو علينا، قل اى شئ} وهى تحريض عل السكون والجمود الذلا ساد القصص كلها –تقريبا-ويشكل الكاتب الشكل الإدريسى للقصة القصيرة حيث تنتهى القصة من حيث بدأت فيعلن أحد الحضور، انه كان يقوم بدور فى المسرحية المعروضة { انا كنت بالفعل أعرج وسط العربات فى ميدان التحرير, أجرى ببضاعتى من شرطة المرافق وأبحث عن شقة صغيرة بمقدم صغير……} الى أخر المقدمة/ المؤخرة. لينبئنا الكاتب بأنه يعلم حدود القصة القصيرة، وأنه من خلالها استعرض عصرا، طال زمنه، ويفكر فى عملية التوريث التى تناولها فى قصة ” تمتمات المساء”
ففى العام 1991، عندما كانت الأعماق فى النفوس تئن، وتُعلن عن الثورة المكتومة فى الصدور، حيث كانت أصوات التوريث قد بدأت تخرج للعلن فى مصر.. كتب عبد المنعم الباز قصته ” تمتمات المساء”، ليخرج بعض الأدخنة من الصدور إلى سطح الحياة، فقد غاب الفعل المعين فى القصة، وامتد الزمن، إلى ما يشبه الدائرة التى تناولها الكاتب- فى القصة- للإشارة إلى حالة التوريث الذى يشبه الدائرة، غير انه لم يستخد الدائرة فى طى الزمن، وإنما جاءت نهاية القصة، هى النتيجة لمقدمتها، فانحصرت القصة فى تلك اللحظة التى تعيدنا إلى مفهوم يوسف إدريس للقصة القصيرة، وهى (الطلقة). والطلقة يخرجها الكاتب هنا، باندفاع اللحظة الساخنة، فنرى اسم مصر لأول مرة فى قصص الباز، ونقرأ اسمى يوسف إدريس، بثوريته، و نجيب محفوظ باسئلته التحذيرية، حيث اختار لمحفوظ تلك الروايات التى تعلن عن قدوم الكارثة، “القاهرة الجديدة”، و”خان الخليلى”، وثرثرة فوق النيل”. وكأن الكاتب يؤكد صدق رؤية هذه الأعمال، ويقول (هأنذا أُحذر). فجاءت القصة، تستدعى نهج كتاب الستينات (عندما استفحل الأمر ووقعت الواقعة). باستخدام تيار الوعى. كما بدأ الغموض من أول القصة {كهفا بعد كهف يدخل القلب. ليست الأشياء ملونة كما كانت، مختلفة كما كانت، مستفزة كما كانت، ليست الأشياء…}. حيث الكهف يقودنا إلى المجهول، والترقب، والحذر. وليست الأشياء ملونة، فإذا كان الربيع يوحى بتعدد الألوان، وزهزهتها، إلا أننا هنا أمام، ليست الأشياء ملونة، فقد استقرت على حال واحد، ولابد أنه السواد الذى توحى به كلمة الكهف والكهوف. وليست الأشياء.. ليتوقف الكاتب عندها، وكأنه يدعو القارئ لاستكمالها (كما كانت). فالأمور ليست، بصفة عامة، مستقرة. وكأنه يصنع ثرثرة جديدة فى بداية التسعينيات، مثل تلك التى صنعها محفوظ فى الستينيات (1966). ويستعرض الكاتب تاريخ حياته، ليبدأ منذ أن كان صغيرا، ولا يفهم الأشياء، فتبدو الدنيا فى وجهه ظلام وكهوف، ولم يكن أمام الطفل- والإنسان العربى عامة- سوى اللجوء إلى القوى الأمرئية، إلى طاقة القدر {لعل طاقة القدر تبصر صيام السنوات وتتفتح. ما الذى سيطلبه ساعتها؟ الرحمة أم العدل؟ الفرحة أم النزيف؟ الظلمة القديمة أم النور الجديد؟ يا طاقة القدر، يا اله طاقة القدر.. انه لا يعرف} وما كان للطفل أن يعرف، فى ظل التحذيرات التى لُقنها منذ تلك الفترة، بأن يتجنب ..لا… ولن. {فالجنون هامش ضرورى للعقل، لكن .. على المرء أن يكون عاقلا فى زمن يسحق المجانين – حيث المجانين هم الثائرون. على المرء التوقف عن التدخين لأنه يضر بالصحة ويبدد النقود، على المرء أن ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا ليلحق التوقيع فى دفتر الحضور ثم يعود للبيت، يفطر ويشرب الشاى ويشاهد برامج الأطفال قبل أن يحين دفتر الانصراف}.
وفى المدرسة، أوهموهم بأن غرفة الفئران جاهزة لمن يفكر فى العصيان{ لقد عمل الواجب ولم يكن شقيا فلماذا وضعوا غرفة الفئران داخله}. وتتسع الدائرة من البيت ثم المدرسة، إلى المجتمع ككل، وكلها تقف فى وجه من يفكر فى الإعتراض على الروتين التقليدى، حيث حال البلد التى تعبد الفرد، فمهما كان من حوله، ومن يزينون له الحياة، ويحاولون تخليد اسمه {الأن يدرك قيمة الدقائق السيالة من أصابعه، يدرك ثمن التلكؤ والتردد، وأن القطار يمشى والمحطة المفاجئة تقترب رغم كل التمائم والتمتمات ,و لن يتوقفوا عن لعب الطاولة ومشاهدة مسلسل المساء، لن تسقط ورقة واحدة من أجله، مهما حفر اسمه على جذوع الأشجار. المجد إذن للرقص والقفز والمشى}. وجراء كل ذلك، تكون النهاية الحتمية، الاستسلام للدعة، والاستسلام للأمل{ثم تتنفس الظلام شهيقا وزفيرا ويستقر القلب فى كهف جديد.. يهادن الخفافيش، ويحاول النوم على وسادة ناعمة ليست تحتها كتب. أحيانا يجذب الغطاء ويقول”سوف”، وأحيانا يرفس الغطاء ويقول “لن” … لكنه دائما يفتح الشبابيك}، وليؤكد الكاتب حقيقة أن الإبداع رسالة، توقظ نيام المجتمع.
يعيش الإنسان على الأرض بوجهين، وجه يعرفه الآخرون، ووجه لا يعرفه إلا هو. والإنسان منذ بدأ يدب على الأرض، وهو يسعى لمعرفة نفسه، ولماذا هو هنا، وإلى اين المصير، فكان المجهول هو الشمعة المضاءة فى آخر النفق، والنفق لا يعرف أحد متى ينتهى. لذا سعى الأدب، الجاد، أن يستكشف ملامح ذلك النفق، فسعى للبحث عن المجهول، لذا قيل أن الإبداع، ليس نقل الحياة، فالحياة يعيشها كل الناس، فما حاجتهم لأن يقدم إليهم من جديد؟.
وقد ادرك عبد المنعم الباز، الذى للأسف انشغلتُ بكل جديد فى عالم الرواية والقصة، بعد أن مرت مرحلة المسرح، ولم أكن اعرف عبد المنعم الباز، ولكن المصادفة، وحدها، هى التى قادتنى لقراءته، وعلمت أنه قدم للمطبعة العديد من القصص القصيرة، منذ تسعينات القرن الفائت، فرأيت –كما كان يقول لى أبى- ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله. وعندما يمر القطار، يجرى الإنسان ليلحق به، فلا يلحق إلى العربة الأخيرة، وقد وجدت أن العربة الأخير هى مجموعته “بقع القلب” والتى صدرت ضمن المختارات القصصية، التى كانت الهيئة المصرية العامة للكتاب تُصدرها، فصدر العدد 106 يحمل هذا العنوان “بقع القلب” الذى يفتح آفاقا واسعة داخل الإنسان، خاصة أن القلب هو مخزن الأسرار، ومخزن الألام، والأفراح، وكلها أشياء كثيرا مالا يعلمها إلا الشخص ذاته، وقد تتضح الصورة إذا ما تأملنا الحديث الشريف الذى يقول {إنهم لثمرة القلوب، وقُرَّةُ الأعيُن} وهو ما يعنى قيمة القلب وما وعى. فإذا كانت البقع، هى مدخل للكثير وعلامة على الكثير من الأمراض، التى قد لايفصح عنها الإنسان، وهو يتألم، فلم أعجب أن علمت أنه هو د عبد المنعم الباز، فلابد أنه إطلع على الكثير من تلك البقع، داخل القلب، ولا بد أنه يحافظ على أسرار مرضاه، لذا جاءت كتابته –كلها- قليلة، لكنها نوافذ تفتح على الفضاء، فتترك للقارئ أن يتأمل تلك الإشارات، ويتأمل ما يراه وراءها، فالقارئ هو شريك صناعة القصص، وما الكاتب –هنا- سوى صانع للإشارات التى بالضرورة تفتح النوافذ، وتدعو القارئ، للنظر منها، والبحث من خلالها.
فإذا ما أخذنا أول قصة فى هذه المجموعة، والمعنونة “الولد والحوائط”، ونحن نعلم أن الحوائط هى حاجز مانع لمعرفة ما وراءها، كما أن الولد، وهى تعنى صغير السن، أو صغير الخبرة، فنحن أمام عملية كشف لتلك المرحلة، التى يمكن أن نأخذها على الحالة الفردية التى يسوقها الكاتب، كما يمكن أن نرى فيها تجربة الإنسان عامة، حيث كان فى بداياته، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنه يعرف الحب، ويعرف الجنس، دون أن يدله أحد عليها، ولنا فى قابيل وهابيل، العبرة، حيث قتل قابيل هابيل، من أجل الحب ، ومن أجل الجنس. ولم يكونا قد عرفا شيئا بعد، عن الحياة من حولهم.
فالولد تعرفه الأرصفة، وهو لا يعلم الأرصفة {الولد يبص ويبص ولا يجد أسماء} والأسماء هنا لا تعنى الإسم الذى يُنادى به الشخص، وإنما هى المعرفة{ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)(البقرة 31). إذن فنحن أمام الإنسان فى مرحلته البدائية، الى حركته فيها، الغريزة، وليس العلم، لتنفتح أمامنا طاقة واسعة تشمل البشرية جميعا، فرغم ما وصل إليه العلم حتى الآن، ورغم مرور كل تلك القرون، هل تراجعت الغريزة، مع تقدم العلم؟ الذى يحيلها إلى المرتبة الثانية؟ أو العاشرة؟ كل الشواحد، والتاريخ يقول بالنفى، حتى لو أخفاها الإنسان لوقت، او خرجت عليه بعض مفاهيم البوح بها، فإنها فى الحقيقة، تظل المرأة والغريزة، هى المحرك الأول، والمصيدة الحقيقة وراء الكثير من عمليات الصيد، ويأتى المال من ورائهما، وكلها أشياء مادية، لا معنوية.
فإذا ما أكملنا العبارة التى وأردتها القصة عن الولد{فيمشى ثم يتعب فيمسح بأصابعه حافة الرصيف ويجلس ثم يعود، فيملآ بطنه بالماء} فالولد يمسح باصابعه حافة الرصيف، أى التراب، خاصة أن الأصابع هى التى يتناول بها الإنسان الطعام. غير أن الكاتب تخير {فيمسح الرصيف بأصابعه حافة الرصيف ويجلس ثم يعود} وهو ما يخدعنا الكاتب به، ويسير مع القصة بمعناها المباشر والفردى، أما إلى نظرنا إليها من شباك كلماته، سنجد أن الجلوس هنا، هو الوصول بالجسد إلى التراب، ثم يعود، ليس بشخصه، وإنما بنوعه، يتبين ذلك من الجملة التالية{يملأ بطنه بالماء} لنعود للقرآن مرة أخرى {وجعلنا من الماء كل شئ حى)(الأنبياء 30) لنعلم أنه ملأ بطنه بالماء، أى دبت فيه الحياة من جديد، وأيضا ليس بشخصه، وإنما بنوعه. فإذا كان الكاتب قد وضع تلك العبارة فى مقدمة قصته، فكأنما أراد أن يفتح الآفاق أمام قارئه، ليتسع برؤيته، ولا يتوقف بها إلى الرؤية المحدودة فى شخص، وإنما هى مسيرة الإنسانية. فإذا ما انتقلنا إلى الفقرة التالية سنجد{الولد فى أول النوم يلصق كلمات المدرسة بكلمات الراديو ويرسم خريطة جديدة للدنيا} فهنا يبدأ الإنسان التعلم، او ظهور العلم، بتلك الكلمات من المدرسة، ومن الراديو، ونلاحظ أنه لم يذكر مثلا التليفزيون، وكأننا نتدرج فى مسيرة الإنسان على الأرض، حيث يبدأ العلم فى تعليمه كيف يرسم خريطة (جديدة) للدنيا. {و فى آخر الحلم يجد لنفسه مكانا ظاهرا على الخريطة}. أى أنه تحقق وجوده كإنسان، غير ان هناك ما يخشاه، ويقض مضجعه، ويقلقه فى مستقبله ف{لايخاف إلا من الضرب والنار والعربات والطوب) وكأنه يشير هنا إلى الحروب على الأرض، أو من {النار} بعد الموت. حيث تبدأ البقع تنغص عليه حياته الجديدة، والتى تنبع كلها من الخوف مما يتهدده، أو يخشاه.
إلا أن الكاتب لا يصنع ألغازاً، ولا يكتب رؤية فلسفية للحياة، وإن كانت الحياة-كلها- ألغاز، وسعى فلسفى لتصور الحياة، إلا أن كل ذلك ينبع من الإنسان، ومن الحياة، فتعود إلى الحياة، والحياة الشخصية، مرة أخرى، لنعلم كم هو أجاد الحبكة، والصنعة، والدقة فى صناعة القصة، المفتوحة، والمنغلقة فى آن. فنتعرف على أن الجارة الجديدة {أصبحت تنادى الولد ليشترى لها الأشياء، وأبوها المسكين أعمى{رغم أن عندهما بوتاجاز ومروحة} أى أنهما يعيشان عصر الكهرباء، أى أن الزمن مر ألاف السنين، ورغم ذلك ظلت الفطرة، والغريزة هى المسير للحياة، فبينما كانت تستدعيه ليشترى لها الأشياء، إلا أنها بدأت تستدعيه دون شراء الأشياء.. وتلمس يديه، فيتوه، وتصيبه السكرة، وبينما كانت تبوسه على خده، فيمسحها بسرعة، فإنه بعد أن لمست يديه، لم يمسح القبلة، وبدأ يشعر بها و{فى أول النوم يجدها فى الخريطة} أى أنها بدأت تحتل مرتبة فى اهتماماته، وتسأله { وهى تبتسم “بتحبنى”؟! والولد يقول باعتراف “آه” وتسأله وهى تضحك “تتجوزنى؟” فيقول متورطا “آه” ثم تنتهى الابتسامة وتسأله “وأبويا؟!” والولد لا يعرف ماذا يفعل بأبيها}. حيث يمثل الأب هنا السلطة الفارضة سطوتها على الإنسان. وإذا كان الأب فى القصص التقليدية لا تجعل الأب (أعمى)، فهو هنا جعله أعمى، وكأننا أمام السلطة الحاضرة الغائبة، وكأننا أمام تلك السلطة الحاضرة بفعلها، وغير الحاضرة بجسدها. وكأن (الولد) يقف الآن أمام الموانع التى تحول بينه وبين ما يحب ويرغب، {وهى تترك يديه وتترك دموعها.. والأسماء كلها تضيع فلا يجد فى أول النوم خريطة}. حيث تقف الموانع، الدنيوية، أو (النار)، ويصنع كل ذلك فى قصة الولد والحوائط المانعة من حريته وانطلاقته، وتصنع البقع فى القلب، فتنغصه. فضلا عن أننا أمام جوهر الإنسان، حيث نجد المرأة ترغب فى الولد، ولكنها (تتحجج) بالعقبات التى تمنعها، فهى كما يقال “يتمنعن وهن الراغبات”. فنحن إذن أمام قضية الإنسان والحواجز التى يضعها، حتى وهى غائبة، استطاع الكاتب أن يفرشها أمام نوافذ الكلمات، فى قصة قصيرة.
وهى نفس الرؤية –تقريبا- التى تتناولها قصة “أربع حكايات غير مرتبة” حيث تتواجد الحوائط المانعة من انطلاق الإنسان نحو ممارسة الحياة. فتتكون القصة من أربع وحدات سردية، تتناول كلها حياة الطفل والشاب، اى فترة التكوين للإنسان. ففى الوحدة الأولى، يسعى الطفل لتمييز الأبيض عن الأسود، بحثا عن الحصان الذى وضعه فى المكان القاتم(الأسود)، ثم حمل الحصان الأسود ووضعه فى المربع الأبيض، وكأن الحياة ليست سوى أبيض أو أسود، وفى النهاية {انتزع الحصان الأسود من مربعه الأبيض وألقاه فى الصندوق الخشبى وهكذا بدأ الدور رغم كل شئ}. حيث يمزج الكاتب بين رؤية الطفل، وبين الحياة العامة، الأشبه بلعبة الشطرنج.
وفى الوحدة الثانية تتوالى عليه الموانع، الأوامر، ممثلة فى تعليمات الأم والأب، والكمسارى والناظر والمعلم والشيخ والطبيب. كل يلقى باوامره.. إفعل ولا تفعل. وكأن الطفل مجرد آلة ليس له أن يختار ويقرر هو ما يريد، وكانت النتيجة أن سخر منه الأطفال الآخرون، فى الوحدة السردية الثالثة، عندما وضع الكاب على رأسه، والنجوم على كتفه، فاختطف الأطفال كابه وألقوه فى بركة مياه قذرة. فألقى الطفل المسدس، وعاد منكس الرأس.
وفى الوحدة السردية الرابعة، يخرج الطفل عن دور الطفولة، ويبدأ فى ممارسة الحياة، وذهب بفتاته إلى الغابة التى ليس فيها أحد غيرهما، ويقفا تحت الشجرة، فيجدا أن آخرين سبقوهم إلى ذات المكان وحفروا اسميهما على جدار الشجرة، وعندما يبدآن فى ممارسة القبلة، تبرز الأسماء المحفورة لتنظر إليهما، فتتوقف القبلة، ويذهبا لشجرة أخرى وحين يبدأ تناول القبلة تفاجئه الحبيبة بالسؤال عمن نظر إليهما من بين الأسماء المحفورة أهى سعاد أم نجلاء او سهير؟ فانتابه شعور بانها تشير إلى انه يفعل مثل حسن أوعلى أو محسن، لتتوقف القبلة مرة أخرى، فتشير إلى أنه عليها أن ترحل. وكأن الحوائط ما زالت تقام، والموانع ما زالت قائمة، لممارسة الإنسان لفطرته، وممارسة الحياة.
وهكذا أيضا يشير الكاتب فى قصة قصيرة ما يمكن أن تضمه رواية بطولها، لتعيد إلى الذاكرة رواية “الحريم” للمبدع حمدى الجزار، والتى تتناول ذات الرؤية، ولم يكن بها ما يمكن إعتباره زائدا عن الحاجة.
وتسير قصة “ثلاثة أقنعة حقيقية” فى نفس الأجواء، ونفس التقسيم لوحدات سردية ثلاثة. تبدأ السردية الأولى {حين كنا نتلاكع فى تنفيذ الأمر، أى أمر، كانت أمى تشتم وأبى يصفع وأخى يضرب بالمسطرة، وحين كنا نبكى كان الضرب يزداد، وحين كنا نغضب عن الأكل نجوع} فهكذا كانت الطفولة، فلما خلا البيت من أبيه وأمه وأخيه، مارس نفس العملية على أخته الصغيرة، عندما رفضت إطاعة أمره، فضربها على يدها بالمسطرة وأمرها برفع يديها للأعلى دون أن تلامس الحائط ( وانا احرسها بإتقان غبى، أنقل المسطرة من يد إلى يد، وأهددها وأشتمها متسائلا: ثم ماذا؟} وكأنه يسأل عما يمكن أن يفعله مع أخته الصغيرة، من صنوف التعذيب، او يبحث عن نوع آخر مُرس عيه ليطبقه. وفى الوحدة الثانية، يعانى صاحبنا الكبت الجنسى، حيث يعيش على التلصص على شباك الجيران.. يعانى صاحبنا من الصمت الذى يعانيه، بينما هى تتحدث ولها صديقة، هى أمها، لنصبح أمام المقابلة، فأمه تشتم، وأبوه يضرب، بينما هى تحكى كل شئ لأمها. فكان الوقت{ليلا وكان الظلام جميلا ودافئا وكنت أريد أن أمسك يدها وأن أقطف شفتيها وأنا أضمها فى سرير واحد ليلة واحدة ثم أقتلها فى الصباح لكنها كانت تحكى لأمها} وكأن الحكى للأم أو الصداقة والألفة هى التربية المانعة من الخطأ.
وقد استخدم الكاتب كثيرا القصة التى يستدعى فيها صياغة القصة المقسمة لوحدات، وإن كانت تستقل كل وحدة منها بمكان أو زمان واحد إلا انها بمجموعها تشكل رؤية واحدة، تغلب بها الكاتب على تغير الزمان والمكان- ففكرتُ: لماذا لم يستخدم هذه الوسيلة كل من يحاول كتابة ما يسمى بالق ق ج؟ إذ ربما استطاعوا أن يشكلو قصة ما-. فاستخدم الباز فى مجموعته، حكم الزمن فى قصة “ظرف زمان” التى استخدم فيها الوحدات السردية، معطيا كل وحدة منها عنوانا مستقلا، وليجمعها كلها العنوان الرئيس للقصة. فعبر فى الوحدة الأولى (غناء) عن فترة الصبا وسماع المغنى القديم. وفى الوحدة الثاني (جلوس) حيث تتحدث عن السير كثيرا، وعندما تعب .. جلس، بينما ظلت العربات تجرى. وكأن الكاتب يعبر عن أن الحياة لا تتوقف بتوقف الفرد. وفى الوحدة الثاثلة (تلامس) يعبر السارد فيها عن تقاعد الإنسان عن الفعل، أو التواصل مع النصف الثانى، فيلجأ للحلم، لا للفعل، مكتفيا بمجرد التلامس. وفى الوحدة الرابعة (فى الركن) حيث يجلس السجين- إشارة إلى سجن الإنسان فى الحياة- فى الركن، ويتأمل كم من الأبواب طرق، حيث تتحول الأبواب هنا إلى وسائل للحياة بتنوعها. ولتتواحد الوحدات الأربع فى تشكيل رحلة الإنسان على الأرض.
وتستمر الحوائط الصادة تقف فى طريق الإنسان العربى، فتتناول قصة “الحائط القديم” ما يترسخ فى ذهن الصبى، مرسخا لكراهية الآخر، والنظر إلىه كأنه عدو. فيدعو الصديق صديقه، لفرح أخته، ولما يذهب، يجده مجرد خطوبة، ولم يُدع إليه غير أفراد الأسرة، وعندما يذهب، يجد أمام الباب الحاط الذى قيل بأنه يمنع قنابل اليهود من الدخول إلى داخل البناية، ليعيد ذلك للأذهان حرب السادس من يونيو، وما تم بعدها من إقامة الحوائط أمام البيوت، ولتتحول هذه الحوائط إلى موانع من التواصل بين عنصرى الأمة، المسيحى والمسلم، فضلا عن تفتيت الأمة بين المذاهب، فهذا شيوعى (كافر) وهذا ليبرالى (ملحد) وهذا مسيحى لا يحب المسلمين، ويترسخ هذا الإسلوب من التربية بمقولة الأب للطفل وهو صغير{إن المسيحيين يتمنون الأذية للمسلمين دائما وأنهم خبثاء يخربون البيوت العمرانة ويحرصون على التعليم الجامعى ليمسكوا البلد} حتى لو كان الطفل يرى غير ذلك، حين كان يراهم فى الفصل {غلابة جدا ولا يلعبون مع العيال الحجلة ولا يضحكون بصوت عال ولا يتخانقون مع أحد ولا يخطفون السندويتشات.. ولا .. ولا ..}. وليقول الشاب لنفسه “لقد أركبناهم البغال فترة أطول من اللازم”. فكرت للحظة أن أحد أجدادى لابد قد تحول إلى الإسلام ليركب حصانا أو ليهرب من الجزية أو يظل كاتبا فى الديوان السلطانى}. فكانت النتيجة، هروب المسيحيين إلى أمريكا، وتعلم اللغة الأمريكية، وعدم التحدث باللغة العربية، فضاعت الهوية، وانقسمت البلد إلى قسمين، يكره كل منهما الآخر. فكأننا بذلك وضعنا حائطا جديدا أمام وحدة الأمة. وأن الدين لله، والوطن للجميع.
وحائط جديد يحول بين المرء وممارسة الحياة، فى قصة “مخلوقات السيد جوتنبرج” حيث يجتمع الرجل والمرأة التى ترددت كثيرا فى الاتصال به { وقالت أنها كانت تطلب نصف الرقم ثم تتراجع وتضع السماعة حتى تشجعت اليوم}. بينما هو لابد أن نيبل أخبرها أنى أحب أية فتاة تحادثنى بانتظام}. فكلاهما لا يشعر انه يمارس الحياة بطبيعية، وإنما بتردد، ولم يجدا غير وسيلة وحيدة تبرر لهما أن يجتمعا فى كازينو إلا الكتب، ويدور الحديث عن الكتب والكُتاب، ولا شئ غيره، حتى عندما يأتى الولد بائع الفل، تخبره أنه أخوها. وكان يضع أصبعه أسفل المنضدة. فاختفت الحياة، وأصبحت العلاقة جافة.
ونوع آخر من الحيطان، الأهل وما أورثوه للجالس بالحجرة فى قصة “الجالس”. فقد نشأ صاحبنا فى أسرة فقيرة، بينما هى حذاؤها أبيض مفتوح. وفى لحظة يتأمل المرآة ، ويؤنب نفسه، بل يؤنب تلك الجالسة معه، بينما الصمت كان ثالثهما، ويسأل نفسه {لماذا لا تساعدنى وتتجاوز كبرياءها؟ لماذا تخبرنى إذا كانت حقا تحبنى؟ لماذا لا تختار هى؟} فقد أصبح الإحساس بالدونية يسيطر عليه ويُلجم لسانه، منذ أن كان يخجل أن يذهب ليكتب استمارة البحث الاجتماعى مثل خالد وعلى وحسين؟ ومنذ أن كانت أمه تتركه عند الجيران كى تعمل، و(أم محمد كانت تضربك لأنك تسرق لعبة محمد وتجعله يبكى. محمد كان أصغر منك وكان ابنها. وكانت لا تعلم أنك لا تلعب فى بيتكم إلا بكوب زجاج تجعله تليفون ومصيدة للذباب} . فهكذا النشأة المتواضعة، ولدت لديه الإحساس بالدونية، فألجمت لسانه، فضاع الحب أمام الصمت المشحون بالماضى وأفاعيله.
وتنهى المجموعة بقصة “هكذا تحدث الأمور” حيث تنتهج نهجا جديدا، فنرى قصة داخل القصة، ونجد التخلى عن الجهامة وظهور خفة الروح ، والتى تخبؤ رسالتها وراء السطور والكلمات، ليستنبطها القارئ. وللدخول إلى القصة بحثا عن تلك الرسالة نتأمل قول السارد عن نفسه، وإن خبأها مرحليا، وادعى أنه يتكلم عن شخص آخر، حيث يتبين ذلك فى جملتين مختلفتين {كان المفروض أن تبدأ بشاب في الثانية والثلاثين يصاب كثيرًا بالزكام ويهمل لحيته أحيانًا لكنه يمسح حذاءه كل يوم } و {ثم اتضح لي أنها نهاية بشعة لقصة بشعة لا أجرؤ على كتابتها قبل أن أمتنع عن مسح حذائي} فاستعمل ضمير الغائب (هو فى الأولى بينما استعمل ضمير المتكلم فى الثانية، فالسارد لا يهتم بالأعلى، او بالواجهة (الفم والذقن) بينما يهتم بالأسفل (الحذاء). حيث يقال أن كثيرا من النساء ينظرن أول ما ينظرن للرجل، إلى حذائه، فالاعتناء بالحذاء هنا يشير إلى سعى السارد إلى لفت نظر حبيبته. لذا عندما يجد أن كتابة القصة، بل كتابة حياته، تتطلب نهاية غير طيبةٍ، اشترط ليكتبها أن يتخلص من الاعتناء بالحذاء، خاصة وأننا نتبين أنها جارته {ويمكنها أن تصعد لنشر بعض الغسيل في شقتهم، ولاقتراض الملح والسكر والزيت والسمن والهون والمخرطة، وأن تستعير المجلة التي يشتريها، وأن تفتح شباكها المطل عليه}. فالكاتب يبحث عن وسيلة لكتابة القصة، قصة حياته هو، لكنه عندما يتبين أن كل السناريوهات، لاتفيد، يقرر فى النهاية أن يتخلى عن تردده، وخشيته، وأن يلجأ للحل العملى {إنه في الثانية والثلاثين وهي في السابعة والعشرين، ليسا صغيرين ولا يستحقان مني أية شفقة أو مساعدة. ثم أصلاً كيف يسمحان لي أن أكتب قصتهما وهي قصتهما؟! وهذا طبعًا لا يعجبكم ولكنه سيعجب الناس الذين غيركم}. وكأن السارد جمع كل مراحل الرغبة، والفترة التى معها تطاول الزمن، واصبح فى الثانية والثلاثين وهى فى السابعة والعشرين، ولا يحتمل الأمر المزيد من المحاولات الرومانسية، فقرر أن يخطو خطوته، وأن يتجاوز اللحظة الرومانسية إلى الخطوة الواقعية. وقرر أن تكون هذه اللحظة هى بؤرة قصته، ورسالتها
فإذا كانت مجموعة “بقع فى القلب” للمبدع دعبد المنعم الباز، تأتى من الماضى، فإنها تؤكد أن كثيرا من الماضى يحمل عبق الجمال، فالمجموعة تحمل المتعة القرائية، والمتعة الفكرية، وتؤكد على أن الإبداع، هو رسالة وسعى للتنوير، فقد اندمج الكاتب فى الحياة المعيشة، واستخلص جوهرها، وصاغها فى قصص قصيرة، تحمل رفض الحاضر بأساليبه القائمة على الأمر بالفعل وعدم الفعل، والمناداة بالحرية والإنطلاق، حتى تتكون الشخصية التى تستطيع قول لا.. فى وجه من سلبه حريته. وكانت كلماته فى قصصه مجرد نوافذ تفتح على تلك البقع التى تصيب القلب، فتجعل الإنسان مريضا.