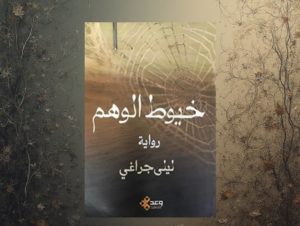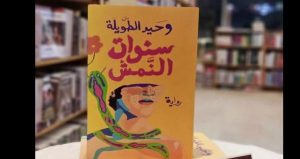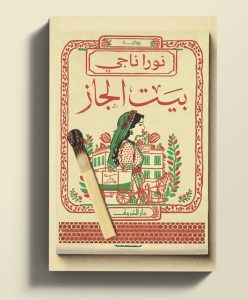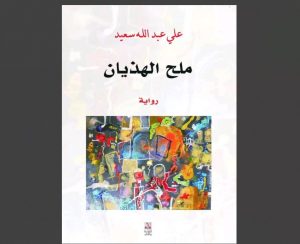بولص آدم
في زمنٍ تتكاثف فيه الأعباء اليومية، وتثقّل الحكايات بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة على حد سواء، تأتي مجموعة الروائي والقاص المصري محمد الفخراني، حفلة الإنس والشياطين (دار العين، 2025)، لتفتح أمام القارئ بابًا مختلفًا على القصة القصيرة. هذا الباب ليس مجرد مدخل إلى سرد محكم أو حبكة مغلقة، بل إلى مساحة واسعة تشبه الساحة الاحتفالية، حيث تتقاطع أصوات البشر والشياطين، ويختلط الهزل بالرغبة، والعابر باليومي، والفانتازي بالفلسفي، ليبدو العالم كله كأنه مسرح كبير لحفلة مستمرة، يشاركنا فيها نحن القراء بوعي أو بلا وعي، لنصبح جزءًا من اللعبة الكبرى التي يصنعها “الفخراني”.
قصص المجموعة أشبه بمقطوعات موسيقية قصيرة متجاورة، كل منها يعزف على وتر مختلف، لكنها جميعًا تصبّ في لحن واحد: لحن الحب واللعب، ولحن التفاصيل الصغيرة التي تكتسب معناها حين تُروى ضمن سياق متسق. العنوان، إذن، ليس مجرّد وصف خارجي، بل يرمز إلى البنية الداخلية للقصص نفسها؛ ليست منفصلة بقدر ما هي أجنحة متجاورة في وليمة سردية واحدة، حيث يتحرك القارئ بين فضاءات مختلفة، كما لو كان يشارك في حفلة متصلة من دون توقّف.
الموسيقى اليومية:
من يقرأ قصصًا مثل “أغنية التسكّع” أو “بالمناسبة، ما الذي تتكلّفه حفلة؟”، يلاحظ سريعًا أن سرد الفخراني يعتمد على سلسلة من المشاهد العابرة: شخص يسير في شارع ضيق، عابرون يتركون جملة عابرة، امرأة تمر بابتسامة خاطفة، شاب يرقص فجأة، وردة أو فنجان قهوة يغيّران المزاج في لحظة عابرة. هذه التفاصيل الصغيرة تتحول إلى نغمات متصلة، كأن كل قصة هي مقطوعة موسيقية أكثر من كونها حكاية مكتملة.
التكرار في هذه القصص يلعب دورًا مشابهًا للّازمات الموسيقية: عبارة تتكرر بشكل مختلف (“ما الذي تتكلّفه حفلة؟”) أو حركة تعود في سياقات جديدة. السرد هنا يتحرك باللعب، لا بالمنطق الخطي، وكأن كل قصة تختبر فكرة أن الحياة نفسها لعبة متغيرة الإيقاع، وليست سردًا متوقعًا دائمًا. يمكن هنا استدعاء ما يذهب إليه المؤرخ الثقافي الهولندي يوهان هويزينغا في الإنسان اللعوب (1938): اللعب ليس نشاطًا ثانويًا أو ترفيهيًا، بل هو أصل الثقافة ذاتها، ومنه انبثقت الطقوس، والفنون، والسياسة، والدين. اللعب عنده فعل حر، يمارس ضمن حدود مكانية وزمانية محددة، وفق قواعد مقبولة إراديًا، بلا غاية خارجية، لكنه قادر على إنتاج عوالم رمزية تسمح للثقافة بالنمو والتطور.
إذا أخذنا هذا المنظور إلى عالم حفلة الإنس والشياطين، نجد أن الفخراني يعيد اكتشاف هذه الحقيقة في السرد: قصصه ليست سرديات خطية بقدر ما هي مساحات لعب حرة، تمارس داخل قواعد متخيلة، وتنتج “عوالم مؤقتة” يعيشها القارئ كما لو كان داخل ساحة لعب. في قصة “اللعب مستمرّ”، على سبيل المثال، تظهر هذه الفكرة بوضوح:
“لكني أيضًا أحبك، ولا يمكن توقّع إلى أين يمكن للّعب والرعب أن يَصِلا، وأفكر في تلك الرغبة الغامضة لمشاركة اللّعب، ولو للحظة، مع مجموعة نصادفهم يلعبون في شارع أو مَمَرّ…” (ص. 37)
العبارة السابقة تؤكد أن اللعب هنا ليس مجرّد فعل ترفيهي، بل تجربة وجودية، ومفتاحًا لفهم الحياة اليومية، حيث يصبح الحب والرغبة والرعب جزءًا من تجربة واحدة متكاملة، تجمع بين الطفولة والفانتازيا والنضج.
هناك علاقة بين مفهوم “الكرنفال” كما طرحه ميخائيل باختين ومجموعة القصص بعنوان “حفلة الإنس والشياطين”. الكرنفال عند باختين يشير إلى لحظة ثقافية وأدبية يتم فيها قلب المراتب الاجتماعية وتبادل الأدوار، مما يخلق فضاءً مؤقتًا يتساوى فيه الجميع. هذا المفهوم يتجسد بوضوح في “حفلة الإنس والشياطين”، حيث يتم التلاعب بالأدوار الاجتماعية والرمزية، وتُفتح مساحات للتعبير عن التوترات الثقافية والاجتماعية. يتم تصوير التفاعل بين الإنس والشياطين في سياق يتحدى التوقعات التقليدية للأدوار الاجتماعية والرمزية. هذا التبادل بين الإنس والشياطين يمكن أن يُفهم كنوع من “الكرنفال” الذي يعكس قلب المراتب الاجتماعية والرمزية، مما يخلق لحظة من المساواة المؤقتة والحرية من القيود التقليدية. لذلك، يمكن القول إن “حفلة الإنس والشياطين” تتبنى وتُجسد العديد من عناصر مفهوم “الكرنفال” عند باختين، مما يجعلها مثالًا أدبيًا على هذا المفهوم.
ترتيب القصص: النص كرحلة احتفالية مستمرة
يمكن أيضًا تجربة المشاركة في “الحفلة” عمليًا من خلال ترتيب عناوين القصص أفقيًا، كسطر ممتد، لتكوين نص واحد يوحي بالاحتفال:
حفلة الإنس والشياطين – أغنية التسكّع – بالمناسبة، ما الذي تتكلّفه حفلة؟ – اللعب مستمرّ – ستاند أب، حب – بقدونس – لا تدفعوا الحساب – في بيت سلوى لطيف – أوضاع للحب والطيران – ماشية على حلّ مشاعرها.
هذا الترتيب يحوّل العناوين الفردية إلى نص موحد، يحكي رحلة احتفالية تبدأ بالفضاء الكرنفالي العام للمجموعة، مرورًا بالتسكّع كبداية لعب عبوري، ثم التساؤل عن معنى الحفلة، وانطلاق اللعب، وصولًا إلى الكوميديا والرومانسية في “ستاند أب، حب”، و”بقدونس” كرمز للبساطة اليومية، و”لا تدفعوا الحساب” كرمز للحرية والتمرد على الأعراف. يُختتم النص بـ “ماشية على حلّ مشاعرها” التي تمثل الانفتاح المطلق واللاختم، فيتضح أن الفعل القرائي هنا ليس مجرد متابعة للحكايات، بل المشاركة في حفلة ثقافية وسردية متكاملة.
الإنس والشياطين: لقاء الظل بالنور
العنوان نفسه يفتح باب التأويل: لماذا الإنس والشياطين معًا؟ يبدو الأمر للوهلة الأولى مجرد فانتازيا، لكنه استعارة عميقة. الشيطان في هذه المجموعة ليس خصمًا مطلقًا، بل شريكًا خفيًا في التجربة اليومية: يتذوق القهوة، يحضر حفلة حب، يعشق الشيكولاتة كما أي إنسي. هذا التداخل يطرح أسئلة فلسفية: هل الحب نفسه حفلة بين الإنسان وظله؟ هل الشيطان هو جانب النفس المنفلت، الذي يشاركنا الرغبة والضحكة بعيدًا عن الأعراف المجتمعية؟
هنا يمكن استدعاء مفهوم “الظل” عند كارل يونغ، الذي يرى أن وعي الإنسان لا يكتمل إلا بمواجهة ظله، أي الجانب المكبوت والمظلم من النفس. الفخراني يجعل هذه المواجهة ممكنة عبر السرد، لكن دون موعظة ثقيلة؛ بل عبر لعب مشترك وحفلة مستمرة. الجدالات الساخرة في القصص، مثل من اكتشف “التسكّع” أولًا أو من اخترع القهوة، تكشف كيف أن كل هوية تحتاج دائمًا إلى “آخر”، مرآة تعكس نفسها، فيتحول الحوار بين الإنس والشياطين إلى جدل وجودي بلغة الدعابة واللعب، لا الصراع المباشر.
التفاصيل والحب: الميتافيزيقا اليومية
من أبرز قدرات الفخراني، تحويل التفاصيل اليومية العابرة إلى معنى ميتافيزيقي. تبدأ القصص غالبًا بمشهد صغير: رجل يأكل مع شيخ غريب على الرصيف، فتاة تبيع عطورًا، شاب يتأمل غزالة ظهرت فجأة. التفاصيل العابرة تتحول إلى لحظات وجودية كاملة، فتذكّرنا بكلمات الشاعر الإيطالي تشيزاري بافيسي: “نحن لا نكتب عن الأشياء الكبيرة، بل نعيد اكتشاف الصغيرة”. لا شيء هنا تافه تمامًا؛ حتى وردة في يد عابر تصبح أيقونة لحب لم يكتمل لكنه حقيقي بما يكفي.
الحب في هذه المجموعة ليس ملحمة مكتملة، بل حالة متجددة، تظهر في شذرات: قصة حب تمتد عشرين خطوة على الرصيف، زوجان يمران بأعمار مختلفة عبر اللعب والرغبة، شاب ينتظر نظرة من عازفة ترومبيت صغيرة لا تكبر أبدًا. الحب يتفتت إلى شذرات، لكنه يظل متجذرًا في اللحظة اليومية، الممزوجة باللعب والضحك والخطر الخفيف، كما في قصة “اللعب مستمرّ”، حيث يمتزج الحب بالرعب، فيتحول بيت الزوجية إلى لعبة جنسية وبيت رعب في الوقت ذاته.
الأسلوب: بين الحكواتي والشاعر
أسلوب الفخراني يجمع بين الحكواتي الشعبي والشاعر الحديث معًا. اللغة شفوية أحيانًا، محكية أحيانًا، لكنها تنقلب فجأة إلى جملة شاعرية تلتمع كالبرق. التكرار استراتيجية مركزية، ولازم مثل “ما الذي تتكلّفه حفلة؟” تتحول إلى إيقاع داخلي يوحّد النصوص. الجمل القصيرة، والحوار العابر، والتوصيفات الدقيقة للأشياء العابرة تتحوّل كلها إلى موسيقى سردية، تجعل القارئ يرقص مع النص ويشارك في الحفلة.
حفلة الإنس والشياطين تجربة وجودية، دعوة للعب والفكاهة، والتأمل في الحب والظل والرغبة. إنها نصوص قصيرة تحمل في طياتها الموسيقى اليومية، والتكرار الاحتفالي، واللعب الحر، وتعيد اكتشاف كل الأشياء الصغيرة في الحياة.