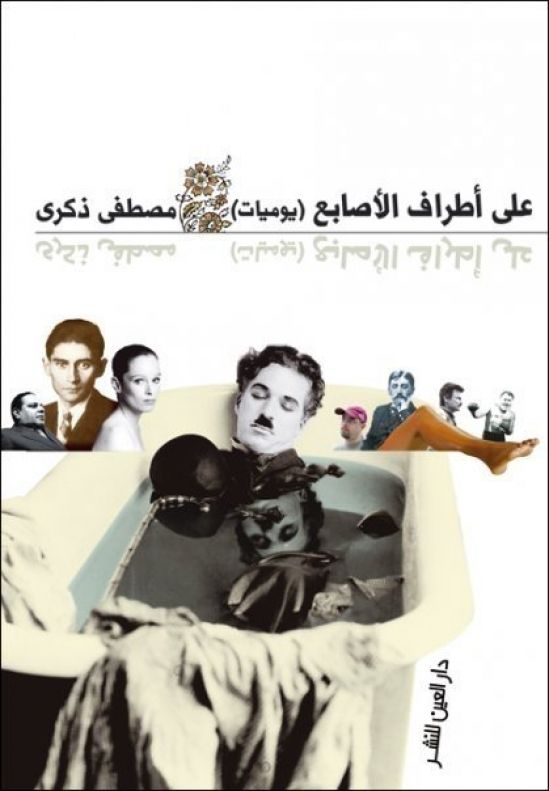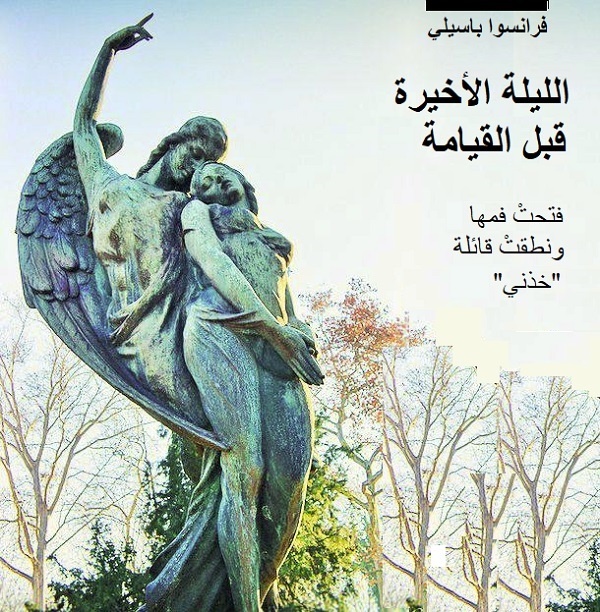نهى محمود
تحتاج مشاعر غامضة مثل الحب والغضب لوعي جمعي، لبشر يكتبون عنها كثيرا، ويتكلمون في حلقات حميمية أو جلسات علنية تذاع عبر وسائل التواصل وغيرها، ليعرف البشر كيف أن غيرهم أيضاً يشعر بما يملأ قلوبهم، وأن الأمر لا يخص واحدا سيء الحظ وإنما لعنة جماعية تصيب الجميع.
أحيانا أو طوال الوقت اضيع سنوات من عمري أخبط رأسي في الباب المغلق ذاته، ولا يجيء على خاطري أية فكرة أخرى سوى الاستمرار في الطرق، حتى يمر عابر بالصدفة ويشير لي على مقبض الباب. أنظر نحو المقبض بدهشة، أديره وأخرج.
يحدث ذلك في أمور تافهة لكنها تسبب لي معاناة حقيقية، أو اشياء كبيرة تكاد أن تنهي حياتي، لكني في لحظات كثيرة وببساطة لا أجد الحل، أو لا أراه.
أظن أني قوية، وأعتز بكوني قادرة على تحمل الكثير، لا أقف حقا إلا عندما أصبح غير قادرة فعلا على المشي خطوة واحدة أخرى، لذا فأنا لا أشعر بالغضب إلا نادرا. هو من المشاعر التي أعرفها لكنها لا تتلبسني إلا نادرا، نادرا ما اكون غاضبة. أعرف الغضب واختبرته كثيرا، لكننا لسنا اصدقاء. أتفرج عليه وهو يمشي في العالم يلمس كتف البشر، تحتقن وجوههم، يتشابكون بالأيدي، يتبادلون السباب، أحيانا يتطور الأمر ويقرر أن يبقى فترة فينادي صديقه “الحقد” تبدو الصور التي أشاهدها معتمة ومؤلمة، فأحاول أن أتوقف عن
المشاهدة أو أدير جسدي كله وأمشي في اتجاه آخر، وأنا أضع يدي كلها في كف رغبتي في الهدوء والسلام الداخلي، ويقيني الذي يكبر كلما تقدمت في العمر بأن كل شيء يمضي، وأن لا شيء يستحق أن نغضب أو ننادي لرفيق الغضب الحقد..
يمكننا طوال الوقت أن نتغاضى عما يحدث ونسلم اقدامنا وقلوبنا للطريق ونمضي ونتجاوز، كل ذلك لم يمنعني من التوقف أمام فيلم Demolition أو “التدمير”، بطولة جيك جيلنهال، وهو عن شاب ناجح يعمل في مجال الاستثمار، متزوج من ابنة صاحب عمله ويحبها، وبينما هما في طريقهما للبيت، تطلب منه زوجته أن يستخدم صندوق العدة الذي أهداه له والده منذ سنوات ليصلح لها العطل الذي أخبرته عنه مرات عدة في الثلاجة، يقع حادث وتصدمهما سيارة جاءت من ناحية زوجته التي كانت تقود السيارة، تموت زوجته بسبب الحادث وتبقى آخر نظراتها له وكلماتها هو طلبها أن يصلح العطل، يصاب هو بخدوش بسيطة، يخبره والد زوجته بينما ينتظر في طرقة المشفى أنها ماتت، ينهض من مكانه ويضع ربع دولار في ماكينة الحلوى ليحصل على كيس منها، لكنها لسبب ما لا يخرج كيس الحلوى ولا الربع دولار، يقضي البطل مشاهد كثيرة تالية من الفيلم في مراسلة الشركة التي تصنع هذا الجهاز مطالبا إياها باسترداد الربع دولار، وبينما يكتب المزيد من الشكاوي، يكتب قصته مع زوجته، وكأنه رغب أن يعرف أحد، لم يره من قبل ولا يعرفه قصة الفقد تلك، كتب إنه لم يحب زوجتها وإنما تزوجها لأنها بدت رائعة، لم يبك أبدا منذ موتها، بدا غريب الأطوار بشكل أثار قلق الجميع، وذات نهار عاد للبيت، وبحث عن صندوق العدة وفتح الثلاجة التي فككها تماما، حولها إلى قطع صغيرة منفردة، ثم بدأ طوال الأيام التالية في تفكيك كل شيء في البيت، حتى أنه فكك مصابيح الحمام في بيت والدي زوجته عندما لبى دعوتهما للعشاء، تطور الأمر أكثر فذهب للمتجر واشترى مطارق ومنشاراً كهربائياً واستمر في التدمير، ثم استأجر سيارة هدم وحطم جدرانا عديدة من البيت..
أمور أخرى كثيرة حدثت في الفيلم، بشر حاولوا تقديم التفهم والدعم والحب، لكن الخط الرئيسي الذي لفت انتباهي كان ما حمله عنوان الفيلم “التدمير”، الغضب الذي تحول لمطرقة في يده، كسرت كل شيء حوله. فكرت أن الغضب همس في أذنه: هيا نهدم كل شيء، لم يكن لديه ولا لدى الغضب فكرة، هل نهدم كل شيء لتستطيع العودة من جديد، أم لتسد كل طرق مواصلة العيش!
بعدها بأيام وبصدفة أخرى، شاهدت الفيلم الإيراني “الحرب العالمية الثالثة” للمخرج هومن سيدى، بطولة محسن تنابنده الذي قام بدور “شكيب” وندى جبرايل، يتحدث الفيلم عن صعوبة الحياة والفقر، أفكر الآن كيف جاء الحب وسط كل هذا البؤس.
شكيب العامل الذي فقد بيته وزوجته وطفله الصغير في زلزال، فقد كل شيء، يعمل باليومية، يبيت في دكان أحد أصدقائه، يتردد على بيت دعارة، يصادق فيه فتاة واحدة صماء يتيمة لا تعرف أحداً في العالم سوى قوادها الذي رباها. تقود الصدفة شكيب للعمل في موقع تصوير فيلم سخيف عن “الطغاة” ويبدأ بشخصية هتلر ومحرقته، يصاب الممثل الذي يقوم بدور هتلر بنوبة قلبية يسندوا الدور للعامل في الموقع شكيب، يسكن البيت الخشبي المعد للتصوير بدلا من النوم في المخزن البارد الذي تسقط منه المياه طوال الليل.
يتحدث البطل مع صديقته عبر الهاتف، مكالمات فيديو يستخدم لغة الإشارة يفرجها على البيت، يعجبها فتهرب من قوادها وتلجأ لشكيب، يخبرها أنه لا يستطيع استضافتها وأن البيت ديكور للفيلم وممنوع عليه مرافقة أحد داخله، لكنها يبقيها، يخفيها في النهار أسفل البيت وعندما يغادر الجميع الموقع تخرج، يأكلان معا ويتحدثا ويحلمان، الأحلام الغالية البعيدة المستحيلة بالسعادة. تتعقد الأمور، ويضطر شكيب لمغادرة موقع التصوير للذهاب للمدينة، يتركها في المخبأ تحت البيت، وتطلب منه ان يشتري لها حلوى في طريق عودته. يفجر عمال الوقع البيت الخشبي في مشهد تصوير. يرى شكيب النار ويسمع التفجير في طريق عودته. يصاب بهياج يبحث عنها تحت الردم يخبر المخرج الذي يعده بمساعدته في البحث عنها، قبل أن يتواطأ هو والمنتج وكل من في موقع التصوير بإزالة آثار البيت حتى لا يجد أحد أثر لسيدة ميتة ويتورطون في المشاكل. الكثير من الصراخ والدماء والتشابك بالإيادي والبحث عنها، هل ماتت أم غادرت!
يتأكد بطريقة ما أنها كانت هناك واحترقت، المسكينة التي لم تسمع أي صوت بسبب عاهتها، تموت تحت البيت الخشبي في انتظار حلوى شكيب الذي يسرق السم من خزنة دكان صديقه ويقتل صديقه عندما يعرف ويحاول استرجاع السم، يدخل مطبخ موقع التصوير يفرغ السم، ويشاهد الطاقم وهم يأكلون، ثم يتقيؤون دما ويسقطون واحدا تلو الآخر. وينتهي الفيلم.
فكرت كثيرا في مأساة شكيب، سالت دموعي في الحقيقة، لم أستطع أن أدينه وهو يقتل العشرات، نظرت نحوه بحزن وتعاطف وأخبرته أني أفهم مشاعره تماما، أنا التي أعرف كيف من الممكن أن تتحول نشابة العجين الطيبة الممتلئة بالبهجة المستعدة دائما لتدوير عجين البيتزا، في لحظة أس وغضب إلى أداة لتهشيم عظام ورأس بشر آخرين، أعرف يا شكيب ما الذي يمكن أن يفعله الفقد والحزن، أتفهم متى يمكننا بإرادة حرة، ودون أن ينفى ذلك الطيبة واللطف داخلنا أن نغضب حتى نشعل الحرائق وندس السم ونعرف أن الحياة انتهت والضوء تلاشى.
بعد مشاهدتي لكلا الفيلمين، أضاء الغضب في ذهني بشكل مختلف، كأننا نتعرف من جديد، غضب مرادف للحزن. بعد يومين من ذلك، في لحظة صباحية هادئة سمعت صوت عصفور أو يمامة تتدحرج داخل مدخنة السخان في الحمام، صمتت لحظة ثم أصدرت صوتا يشبه
الأنين، بدت كقط في مأزق، فكرت كيف أساعدها، فتحت درج الأدوات، فكرت ان أطرق على أنبوبة المدخنة لأدلها على طريق الخروج.
ثم لمعت فكرة غريبة في رأسي، ماذا لو فتحت يد الغاز وأشعلت النار فيها، بدا ذلك رقيقا وطيبا، قلت لنفسي لا شيء أسوأ من السقوط في مصيدة وفقدان الحرية، ربما يساعدها الموت على الخلاص من ورطتها. لم أفعل ذلك، لأن أبي أخبرني أنها ستنجو لو تركتها وستعرف طريق الخروج، لكن الفكرة ظلت تراودني لأيام، ماذا لو أشعلت النار؟
ثم راودتني الفكرة الأخرى كيف فكرت أن أحرق عصفورا، فتشت داخلي عن أي رفض للفكرة، فوجدتني راضية عنها تماما وأراها منطقية.
خرجت اليمامة كما قال أبي، ولم تعد لأنها ربما تعلمت أن فخ أو قرأت افكاري، وبقيت أنا في مواجهة فكرتي الشريرة وصورتي الطيبة عن نفسي التي خلخلها الأمر.
هل كنت أرغب في خلاصها فعلا حتى ولو بقتلها، أن هي طريقتي في التعبير عن غضب ما خفي داخلي!
نظرت في المرآة وابتسمت مثل الأشرار في الأفلام، وتركت الأمر على حاله دون تفسير.
لم يتملكني أبدا ذلك الغاضب اللذيذ المرعب، يؤلمني الحب أكثر، تسري في عروقي دماء ساخنة توجعني، تلهب يدي من الأصابع حتى الكوع، أشعر بها ساخنة، أسمع صوت تكتكتها داخلي وأحتمل.
لكن الغضب تقتله دموعي التي تسيل بينما أمشي لمسافة طويلة في شوارع أحبها، أبكي حتى تنطفئ النار، ثم أقف في مكاني، أتلاشى قليلا، ثم أعود.
أحيانا أتمنى لو أجد براحا كافيا خاليا لأصرخ حتى يختفي صوتي، لكني مؤخرا فكرت ماذا لو حولني الغضب لديناصور ينفث نارا، أقف في حديقة البيت الخلفية، تلك التي أحبها ممتلئة بضفادع تتزاوج بلا هوادة، تحمل نسيما سحريا خاصا بها، صوت الشجر ولونه الأخضر، أقف وسط تلك اللوحة الرائعة وافتح فمي لتخرج نار تأكل كل شيء وتحول الحديقة للون يشبه ثمرة موز عطبة وميتة.
أحب أن أكون ديناصورا غاضبا، كما كنت دائما إنسانا يحب ويتألم.