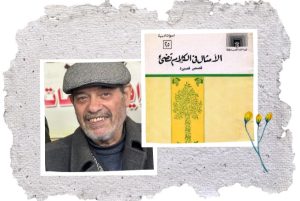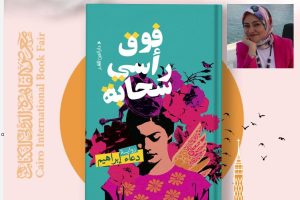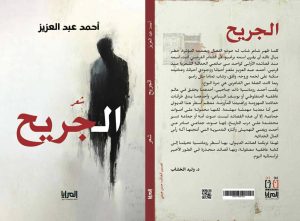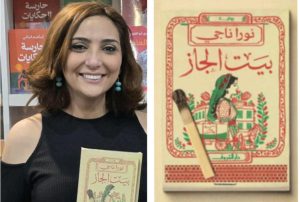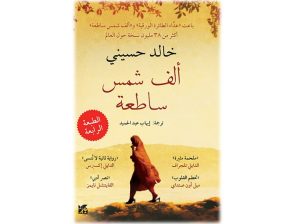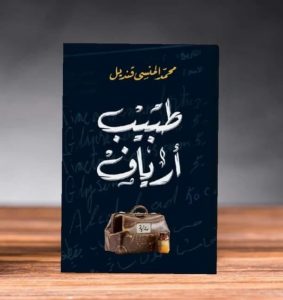سناز داودزادهفر *
قراءة تحليلية في شعر إلهام الإسلامي من منظورٍ اجتماعيٍّ وهويّة المرأة الإيرانية
لم تَعُد أدبيّات النساء في إيران اليوم مجرّد صدى للمشاعر الفرديّة أو الرومانسيّة المنزليّة، بل غدت أداةً للكشف عن هويّةٍ متعدّدة الطبقات، مقموعةٍ ومقاومةٍ في آنٍ واحد. وشعر إلهام الإسلامي من أبرز النماذج التي تجسّد هذا التيار.
إنّه شعرٌ يبدأ من عمق البيت، لكنه لا يتوقّف عند جدرانه؛ بل يمتدّ إلى الشارع، إلى المجتمع، وإلى الذاكرة الجماعيّة. في هذه الدراسة أتناول إحدى قصائدها التي تصنع من صمت المرأة صرخةً شعريّة. إنّ شعر إلهام الإسلامي فعلٌ شعريٌّ وسياسيٌّ معاً، يعبّر عن مواجهة المرأة منذ ولادتها لهويّةٍ محدودةٍ ومشروطةٍ ومراقَبة. فالاستبداد لا يتجلّى في السياسة وحدها، بل يتسلّل إلى تفاصيل الحياة اليوميّة، إلى المكان، إلى الصوت، إلى الجسد، وإلى اختيارات المرأة التي يُحاصرها في كلّ الاتجاهات
نصّ القصيدة
في أيِّ زاويةٍ من البيت كنتُ أجلسُ ذلك اليوم
حتّى استطعتُ أن أقولَ كلَّ هذا الشعر؟
أيُّ مصباحٍ كان مضاءً؟
أريد أن أقولَ من الشعرِ ما يكفي
حتّى إذا متُّ غداً
لن تستطيعَ إنكاري!
أريد أن تنتشرَ قصيدتي كإشاعةٍ في المدينة
وأن تُضيفَ النساءُ إليها شيئاً في كلِّ مرّة.
لن تنتهي هذه الليلة
يجبُ أن تقولَ إحدانا الشعرَ الليلة
وأن تبكي الأخرى
لا مكانَ في قلبي للاختباء
لقد أرهقتُ كلَّ الزوايا
وحانَ الوقتُ ليأتي الموت
ويغرسَ قرونه في قلبي.
البيت: فضاءٌ محدودٌ داخل محدود
تبدأ القصيدة بسؤالٍ بسيطٍ لكنه عميق:
«في أيِّ مكانٍ من البيت كنتُ أجلسُ ذلك اليوم؟»
البيت في المخيّلة الإيرانية رمزٌ مزدوج: هو الملاذ والأَسْر في الوقت نفسه. بالنسبة للشاعرة، كان البيت في لحظةٍ ما مصدرَ إلهام، لكنه الآن لم يعُد مكاناً آمناً حتى للكتابة. البيت الذي يحتضن المرأة يبتلع أيضاً قدرتها على الخلق.
تحوّل البيت من ملجأٍ آمنٍ إلى زنزانةٍ متمدّنة، إلى عزلةٍ مزخرفةٍ بأيديولوجيا الطاعة. لقد ضيّقت السلطةُ حدود الحياة إلى درجة أنّ الانتقال من غرفةٍ إلى أخرى يحتاجُ إلى يقظةٍ وحذر. هنا لم يعُد البيتُ موئلاً للراحة، بل وجهاً مروَّضاً من وجوه السجن.
الرغبة في البقاء: مقاومة المحو
في المقاطع الوسطى من القصيدة، تعبّر الشاعرة عن رغبةٍ عارمةٍ في الخلود داخل الذاكرة العامة:
«أريد أن أقولَ من الشعر ما يكفي
حتى إذا متُّ غداً
لن تستطيعَ إنكاري!»
في نظامٍ يرى المرأة قابلةً للإخفاء، قابلةً للمحو، وقابلةً لإسكات صوتها، يصبح الكلام بحدّ ذاته فعلاً سياسياً. أكتبُ لأنّهم أخرجوني من الحياة الاجتماعية والسياسية والقانونية، لأنّ مكاني الوحيد أصبح الكلمات. في مجتمعٍ يُهمَّش فيه صوت المرأة، يتحوّل هذا الشغف بالتثبيت والاعتراف إلى ردٍّ على تاريخٍ طويلٍ من الإلغاء.
هنا يصبح الشعر وسيلةً للبقاء، مقاومةً للنسيان. قصيدة إلهام الإسلامي بيانٌ شعريٌّ لإثبات الوجود في وجه سلطةٍ جعلت من المحو أداتها الأولى للهيمنة.
الإشاعة: لغة النساء غير الرسمية
تقول الشاعرة في أحد أكثر مقاطعها توهّجاً:
«أريد أن تنتشرَ قصيدتي كإشاعةٍ في المدينة
وأن تُضيفَ النساءُ إليها شيئاً في كلّ مرّة.»
كلمة الإشاعة تحمل عادةً معنى سلبياً، لكنها هنا تتحوّل إلى أداةٍ ثقافيةٍ أنثوية: لغةٍ غير رسميةٍ تنبع من المطابخ، ومن طوابير المخابز، ومن المجالس النسائية الحميمة.
ترغب الشاعرة أن تُتداول قصيدتها في نفس المساحات التي يتجاهلها النظام الرسمي. اختيارها واعٍ ومقصود: إنّه فعلٌ سياسيٌّ لنشر الحقيقة في الخفاء. في غياب المنابر الرسمية، ومع استحواذ الرجال والسلطة على الإعلام، تُهرّب الشاعرةُ صوتها في هيئة إشاعة، كي تنفذَ من بين أنياب الرقابة.
البكاء والشعر: طريقتان للمقاومة
«يجب أن تقولَ إحدانا الشعرَ الليلة
وأن تبكي الأخرى»
هنا يرسم النصّ مواجهةً حادّة بين الفعلين الأنثويّين الأكثر صدقاً: البكاء والكتابة. واحدةٌ تبكي (استسلاماً أو تطهيراً)، وأخرى تكتب (تعبيراً أو بقاءً). في عالم الشاعرة، القصيدة هي سلاحٌ للمقاومة، حتى لو كانت مقاومةً خاسرة.
الموت بقرونٍ: عنفُ المجتمع الرمزي
تختتم القصيدة بصورةٍ داميةٍ وموجعة:
«لا مكانَ في قلبي للاختباء
لقد أرهقتُ كلَّ الزوايا
وحان الوقتُ ليأتي الموت
ويغرسَ قرونه في قلبي.»
«لا مكانَ في قلبي للاختباء» — جملةٌ بسيطة، لكنها ثقيلة بالمعنى النفسي والاجتماعي.
في الثقافة الإيرانية، القلب هو موضع الحب والملاذ الداخلي معاً. حين تقول الشاعرة إنّه لم يعُد فيه مكانٌ للاختباء، فهي تعلن أنّ حتّى مساحتها النفسية الحميمة لم تَعُد آمنة.
من منظورٍ نفسيّ، حين تعجز الذات عن كبتِ أو إخفاءِ ما في داخلها، تدخل مرحلة الانهاك والانفجار العاطفي.
اجتماعياً، تقول هذه الجملة: لقد ضاق بي المجتمعُ حتى لم أعد أجد مأوىً داخل نفسي.
أما قولها «لقد أرهقتُ كلَّ الزوايا»، فالزاوية هنا استعارةٌ لفرص العيش والهروب. كلُّ زاويةٍ كانت ركناً للتنفّس، مكاناً مؤقتاً للنجاة. لكن بعد أن تَرهقَ كلَّ الزوايا، لم يبقَ للمرأةِ طريقٌ للانسحاب ولا حتى للبقاء. إنها استنزافٌ كاملٌ لطاقتها النفسية تحت ضغطٍ بنيويٍّ متواصل.
«ليأتِ الموت ويغرس قرونه في قلبي»
القرنُ في الثقافات القديمة رمزٌ للموت حين يتجسّد في صورة الحيوان الوحشي.
لكنه هنا علامةُ عنفٍ خامٍ، وغرسٍ فجٍّ في الجسد والروح.
ليس موتاً هادئاً ولا خلاصاً، بل اقتحامٌ قاسٍ لداخل الكينونة.
القرون ليست مجرّد رمزٍ للموت، بل أدواتُ توغّلٍ عنيفٍ للمجتمع، وللتاريخ، وللذاكرة الجماعية في روح الشاعرة.
إنه موتٌ مهين، يمثّل اعتداءً على الذات الأنثوية من قِبَلِ منظومةٍ تُمعن في سحقها.
وهذا المقطع لا يتحدّث عن انتحارٍ فرديٍّ فحسب، بل عن:
- موتٍ تدريجيٍّ لامرأةٍ تحت وطأة التكرار القمعي.
- موت الإبداع في مجتمعٍ لا يسمح للمرأة أن تكتب أو تقول أو حتى تبكي.
- وفي النهاية، عن استعارةٍ كبرى لانهيار المقاومة وبدء العُري الكامل أمام القهر.
خاتمة
قصيدة إلهام الإسلامي ليست مجرّد بوحٍ شخصيٍّ لامرأةٍ شاعرة، بل مرآةٌ دقيقةٌ لحال المرأة في مجتمعٍ ما زال عالقاً بين التقليد والحداثة، بين القمع والرغبة في الحياة.
إنّها محاولةٌ لرفع الصوت بحيث لا يستطيع أحدٌ تجاهله.
ورغم بساطتها الظاهرية، فإن القصيدة مشبعةٌ بإشاراتٍ إلى أوضاع النساء التاريخية والجندرية والاجتماعية في إيران المعاصرة.
صوتي في هذه القراءة هو امتدادٌ لصوتها، لأنني – مثلها – أكتبُ كي لا أُمحى، وأجعل من الشعر إشاعةً تُقال في وجهك، أيها الرجل، حين تصمتُ أنت ويُراد لي أن أصمت.
……………………….
* شاعرة ومترجمة من ايران