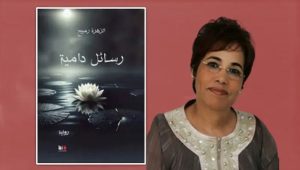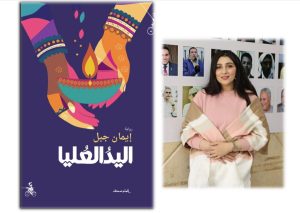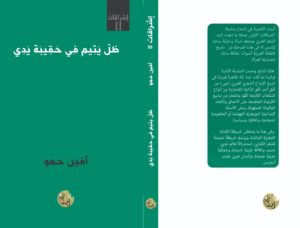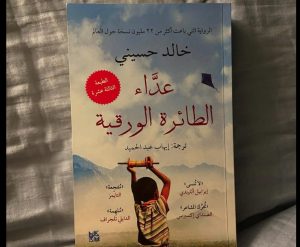د. مصطفى الضبع
إنه السيد نجم المنتمى تاريخيا إلى جيل السبعينيات والمنتمى فكريا إلى الإنسان، والمنتمى أيدلوجيا إلى الوطن، والمنتمى عقائديا إلى الكلمة تلك الساحرة التى تعقد بينك وبينه رابطا إنسانيا، يصعب أن تتجاوز تجربة الكاتب إبداعيا دون إدراك تجربته الإنسانية ودون أن تكون واعيا بهذا النموذج الإنسانى الهادئ، المفعم بالقدرة على الهدوء واستيعاب العالم بكل تفاصيله، عندما تعرف السيد نجم سيكون عليك (أو) ستجد نفسك مدفوعا لأن تضع النص جانبا لتتعرف هذا الرجل المفعم بالإنسانية والمفتون بمقاومة كل ماهو ضد الإنسان.
تدرج مشروع الكتابة لديه من القصة القصيرة إلى الرواية ومنهما إلى الدراسات الأدبية والنقدية محافظا على الأرض التى كاشفها سابقا فلم يترك الكتابة السردية لصالح الدراسة النقدية وإنما مدد خيوطا متوازية تشكل عناصر المشروع وتوطد أركانه وتكشف عن تفاصيله بقدر يحدد ملامح المشروع لدى القارئ العربى بعامة والمصرى بخاصة، وقبل أن يصبح للانترنت انتشاره الفعلى وتأثيره المباشر على الكتابة والتلقى كان للكاتب انتشاره عبر الدوريات العربية، ولم يتوقف الكاتب فى التواصل مع قارئه العربى عند الوسيط الورقى وإنما سعى إلى تطوير قناة الاتصال حيث أفاد من شبكة الانترنت متداخلا مع تقنيات العصر ومشاركا بفاعلية ليس فى النشر الالكترونى فقط وإنما تجاوز ذلك إلى المشاركة فى أول مشروع مدنى لنشر الثقافة الإلكترونية عربيا (اتحاد كتاب الانترنت العرب) وتبلورت فاعلية مشاركته بتوليه نائب رئيس الاتحاد فى مشروع من شأنه تفعيل الثقافة الالكترونية على المستوى العربى مما يعنى نوعا من أنواع مقاومة الثقافة التقليدية لصالح الثقافة الأكثر تحضرا باعتمادها على تقنيات العصر.
يجمع مشروع الدكتور السيد نجم بين ثلاثة عناصر فى الكتابة: الكتابة للأطفال وكتابة السرد وكتابة الدراسات الأدبية، وليس ثمه فواصل بين هذه الثلاثية فكلمة السر الجامعة بينها والرابطة بين تفاصيلها هى: المقاومة، تلك الفكرة التى باتت تخصصه الأثير وأصبحت العناصر الثلاثة بمثابة الأضلاع الثلاثة لمثلث الإبداع عند الكاتب وكلمة السر هذه تستدعى الهدف الأسمى الذى يستهدفه الكاتب: الحرية: تقع “المقاومة” بين “الحرية” و”العدوان”.. حيث الحرية هي المسعى الواعي للتخلص من “الأضرار” (فالعطس مسعى بيولوجي, ولا إرادي للتخلص من أضرار مسببات الأمراض في الجهاز التنفسي.. بينما الفعل الحر يتسم بالإرادة الواعية لمواجهة تلك الأضرار). وحيث أن العدوان يبدأ من التهكم والاحتقار حتى الإرهاب بكل أشكاله والحروب النظامية. فالفعل الواعي الحر المناهض للفعل العدواني هو الفعل المقاوم” (ص18) ويرجع الكاتب ذلك إلى السلوك البشرى مرجحا طريق البحث العلمى الذى يرجح الفعل الحر طريقا للمقاومة: “إذا كان سلوك الإنسان يحدده الخصائص الوراثية التي تعود إلى تاريخ تطور الجنس البشرى, والى البيئة التي تعرض لها بوصفه فردا.. فان البحث العلمي يرجح كفة السبب الثاني. وإذا كان الوعي الإنساني بمفاهيم الحرية والعدوان معززا للاستجابات الصحيحة, فستكون هي “المقاومة” (ص18).
لقد جعل السيد نجم من فكرة المقاومة مشروعه الأثير وقضيته التى وجدت طريقها وفق مشروعية الإبداع إلى نتاجه الأدبى من قصة ورواية ودراسات أدبية وقصص للأطفال وحتى فى حواراته الخاصة ومشاركاته الأدبية والفكرية، تلك التى جعلت منه واحدا من المتخصصين فى مشروع صار علامة عليه، وعلى الرغم من عمومية الفكرة واتساعها حتى لكأنها تكاد تشمل الكتابة فى معظمها فالكتابة فى جلها نوع من المقاومة، مقاومة تردى الواقع بتعرية أسباب التردى، ومقاومة تحدى الموت بإنتاج فعل الخلود، ومقاومة الأنظمة المستبدة بإنتاج المدينة الفاضلة، على الرغم من هذا كله يمكن للكاتب أن يقدم نموذجه الخاص المقاوم القادر على إنتاج وسيلته الفاعلة فى طرح مشروعه.
وتنحصر الدراسات الأدبية عند الكاتب فى عدد محدد من الموضوعات تتبلور فى:
- أدب الحرب والمقاومة .
- أدب الطفل .
- الثقافة الالكترونية .
وإذا كان العنوان الأول صريحا فى طرح المقاومة وفق مفهوم الكاتب لها كما تبلورت فى دراساته المختلفة، فإن العنوانين التاليين ليسا بعيدين تماما عن الفكرة ذاتها فقد جاءت الدراسات جميعها ذات طابع تنويرى، تقف درسات أدب الطفال فى جانب مقاومة الجهل بإنتاج معرفة حضارية للأطفال تتناسب والمرحلة العمرية التى يجتازها الطفل العربى، وتقف دراسات الثقافة الالكترونية فى جانب مقاومة الجهل بإنتاج معرفة عصرية تتناسب والمرحلة الحضارية التى يتجاوزها الإنسان العربى، وجميعها نوع من الكفاح فى سبيل حرية الإنسان، وهو ما يعبر عنه الكاتب فى قوله : “إن الكفاح في سبيل الحرية هو نتيجة إغراءات أو معززات اجتماعية عندما يصل التحدي إلى أقصاه وربما إلى حد الحروب, وقد يكون الكفاح بلا معززات اجتماعية مباشرة, فيسعى المرء إلى التمرد أو إلى حياة الاكتفاء الذاتي. لذلك تمثل “المقاومة” الرابط الموضوعي بين العدوان والحرية. فلا مقاومة غير مدعمة بمفاهيم الحرية لمجابهة العدوان, ولا حرية بلا مقاومة في مواجهة عدوان ما .يزداد الصراع كلما قويت المقاومة, لكن هذا الفعل القوى قد يعبر عن نفسه بالعنف إذا اتجه هذا العنف إلى “الذات” أو “الأنا” أساسا: تكون المقاومة السلبية, وإذا اتجه العنف إلى “الآخر” أساسا.. تكون المقاومة الإيجابية. ولكليهما دوره وتأثيره” (ص18)، والكاتب فى هذا السياق ينفذ قراره الداخلى بألا يكون سلبيا فى مقاومة عوامل الجهل والتخلف مدركا أن دوره بوصفه مثقفا يفرض عليه أن يكون إيجابيا فى التعامل مع أدوات العصر وأفكاره ومفرقا بين نوعين من المقاومة، كاشفا أن المقاومة فى جانبها الإيجابى أسرع منها فى جانبها السلبى و لا يخفى أن السرعة فى حد ذاتها تمثل نوعا من أنواع التوافق مع لغة العصر: “فالمقاومة السلبية هي أقرب التشبيهات إلى تجربة الزعيم الهندي “غاندي”, بينما المقاومة الإيجابية هي الأقرب إلى الأذهان, وهى الجانب الإيجابي والمرغوب من “العدوان”. إن الفعل المقاوم هو.. فعل العنف, المدعم بالوعي, والنابع عن إرادة موجهة (دفاعا عن قيم عليا) موجها إلى الآخر العدواني بكل السبل حتى يتحقق الهدف الأسمى. وقد يتجه هذا الفعل المقاوم العنيف الواعي إلى “الأنا” أو إلى “الآخر العدواني”.. وفى الحالتين بهدف الدفاع عن حق ومواجهة باطل وإلا أن الموجه إلى الأنا أساسا تكون حجم الأضرار المباشرة السريعة نحوه أقل حجما.. لذا تحتاج المقاومة السلبية إلى زمن أطول لتحقيق الهدف..(أحيانا)” ( ص 19)
لقد اجتهد الكاتب –لكونه غير مسبوق– فى وضع التعريف الإجرائى لأدب المقاومة مؤصلا لأفكاره ومؤسسا فكرته بصورة علمية تقوم على تأسيس المصطلح ووضع أركانه: “أدب المقاومة هو الأدب المعبر عن الرغبة في مواجهة الآخر العدواني, من خلال إبراز القوى الذاتية وتنمية عنصر “الانتماء” والرغبة في “الفداء” من أجل الجماعة والوطن” (ص 22) ويحسب للكاتب سبقه فى وضع الفكرة والعمل على تطبيقها وإبرازها تاريخيا ومعرفيا، والسبق هنا للمؤسسة الأكلديمية التى لم تختبر المفهوم من قبل عبر دراسات متعددة فى الأدب لم تنشغل بالقضية ولم تقاربها على مدار تاريخ الأكاديمية العربية وخاصة فى مصر.
لم تكن المقاومة طرحا فكريا تبلور فى تجربة الكاتب البحثية والنقدية وإنما كانت سياقا فكريا فرض نفسه على تجربة الكاتب فى مجملها والفكرة نجد بدايتها وإرهاصاتها الحقيقية فى تجربته السردية، ويمكن للقارئ المتأنى، الباحث، المستكشف أن يدرك بسهولة هذه الخيوط الضاربة فى تربة التجربة السردية للكاتب ، وهو ما يمدنا بثلاثة خيوط للمقاومة فى تجربة الكاتب على إجمالها:
- القصة القصيرة
- الرواية .
- الدراسات الأدبية .
تشكلت تجربة الكاتب فى القصة القصيرة من ست مجموعات قصصية كتبت ونشرت على مدار قرابة نصف القرن تشى عناوينها بقدر من الإشارات لمضامينها أولا ولفكرة المقاومة ثانيا وهو ما يمكنك معاينته فور قراءة عناوينها بوصفها عتبات أولى قادرة على تقديم قراءة أولية لعوالمها:
- السفر – دار الثقافة الجديدة- القاهرة 1984.
- أوراق مقاتل قديم – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة 1988.
- المصيدة- الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة1992.
- لحظات في زمن التيه – الهيئة العامة لقصور الثقافة -القاهرة1993.
- عودة العجوز إلى البحر- دار الوفاء للنشر- الإسكندرية2000.
- غرفة ضيقة بلا جدران– الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة2006.
ولكن الفكرة تبلورت قبل ذلك بسنوات عبر تجربة سردية تجلت فيها المقاومة من خلال عدد من الخيوط والتوجهات المتباينة التى تتكشف فى مجموعة مبكرة من قصص الكاتب “أوراق مقاتل قديم” تلك المجموعة التى كانت فى مجملها وفى استعادة كاتبها لنصوصها مستعيدا ذكريات قديمة، تمثل نوعا من أنواع المقاومة فقد كتبت نصوصها ما بين عامى (1972 – 1986) وتتخذ المقاومة فيها شكلين:
- مقاومة ذاتية: تعددت صورها وطرحها نور (أحد شخصيات قصة “الطيور الفزعة” من مجموعة “أوراق مقاتل قديم”) طرحها صراحة فى خطابه إلى محبوبته: “السويس 1/5/1969 قطتى الحبيبة، الرفض والمقاومة سلاحك يجب أن يتحول رفضك للزواج من هذا “السعيد” إلى مجابهة، مقاومة” ( ص 36) والمقاومة الذاتية هنا ليست وعيا داخليا للمحبوبة ولكنه الدعم النفسى والمعنوى الذى يمدها به من يمتلك هذه القدرة على المقاومة بقدر لا يتوافر إلا فى المحاربين والأبطال
- مقاومة جماعية: تطرحها القصة عبر “الطيور الفزعة” بوصفها تعبيرا رمزيا عن الجنود الذين يقاومون اللحظة التاريخية والهزيمة وظروفها ويقاومون عدوا ظاهرا وأعداء خفيين والسارد حين يزاوج بين العصافير المجتمعة على أعمدة الضغط العالى، والجنود المجتمعين على خطوط النار حيث المواجهة فإنه يضع الفريقين على المحك ، محك الخطر ومقاومة الفناء وخطوط الضغط العالى بما تمثله من موجبات الخطر هى فى حقيقتها عنصر له رمزيته على اللحظة الإنسانية الجامعة بين الطيور والجنود فكلاهما هنا فى غير موطنه وإن اجتمعا فى وطن واحد ولكنهما بعيدان عما يجمعهما بذويهما ومن ثم كانت الذكريات التى يبثها السارد معلنة عن نوع من أنواع مقاومة الوقت لدى الجنود فى محاولة منهم للانعتاق من مشهد الفناء المطروح على الجبهة وفى عمق خط المواجهة، عبر محاولة استعادة بعض التفاصيل ذات الدلالة بالنسبة للجميع وهو ما يتبلور فى الشاى الساخن بوصفه علامة على حياة أخرى هناك يعبر عنها طقس شعبى له دلالاته الإجتماعية والثقافية والإنسانية، طقس يرقق المشاعر فيفك عقدة الألسنة، ويحرك سواكن القلوب: “كل منهم يذكر تجربته مع رشفات الشاى الساخن حتى جاء دور على الذى قال: أحببت ومازلت. آخر من أحببت منذ ثمان شهور وحتى الآن لم أقبلها ” (ص 29).
ولا يكتفى السارد بطرح الطرائق السابقة فى طرحها الأساليب المباشرة وإنما ينضاف إليها طريقته الرمزية التى تتجلى فى النصوص القصيرة جدا فى مجموعته ذات النسق المغاير “لحظات فى زمن التيه” فى قصة “التعلق” يضع السارد الأب وابنه فى مواجهة زجاج الفترينة التى يتعلق الابن باللعبة داخلها فيما يتعلق الأب بالذبابة الحبيسة الحائرة الخائرة القوى ليشهد صورة مقاومته مجسدة فى الذبابة بوصفها معادلا موضوعيا للأب حال مقاومته الظروف الاقتصادية التى تلزمه بتلبية متطلبات طفله الصغير، وفى محاولته تحرير الذبابة محاولة لتحرير نفسه لذا يسعى إلى القيام بحركة مزدوجة “الأب تحرر من قبضة الصغير، ظل يضرب بأصابعه العشرة على الزجاج، عله ينجح فى تحرير الذبابة.. أن يرشدها إلى ثغرة صغيرة تخرج منها” (ص 95)، علينا أن نلاحظ التضخيم فى التعبير عن يد الطفل بالقبضة واضعين فى الاعتبار أن القبضة هنا مجازية الطابع فليست هى قبضة الطفل بقدر ماهى قبضة متطلبات المستقبل فإن من يشعر بشعور العاجز ليس مرد شعوره الإحساس بما مضى بقدر ماهو خوف من المستقبل، يضاف إلى ذلك التعبير بالأصابع العشرة فى دلالتها على الجهد المبذول بالقوة الكاملة للأب، قوته المختزلة فى قوة الأصابع العشرة بوصفها أداة للعمل ولكن النهاية تحمل تصاعدا طرديا بين صراخ الابن والإحساس بالحبس “بدأ الطفل فى الصراخ بينما تعلق الأب بكليته أكثر بمشهد الذبابة التى هى حبيسة.. مازالت !!!” (ص 95) معلنا أن نهاية النص لا يعنى نهاية مشهد المقاومة فالنص عمل على تسجيل المشهد والمشهد عمل على تطوير فكرة المقاومة عبر تحريكها من المشهد المباشر مشهد الأب فى مقاومته الفقر إلى مشهد الذبابة فى مقاومتها ليرتد فى النهاية على الأب مصورا حالته بطريقة أكثر قدرة على التصوير من مجرد طرح الأمر بصورة مباشرة
والفكرة ذاتها تتبلور فى قصص الأطفال التى لم تبتعد كثيرا عن هذا السياق، فى قصة “القلم الساحر” التى تدور أحداثها فى العصر الفرعونى، يرسم الكاتب صورة لحياة جماعة بشرية فى مدينة طيبة عاصمة الدولة، تتضمن فريقين من الناس: أهل البلدة الواقعين فى قبضة اللصوص الذين يسطون عليهم، واللصوص الذين لا يتورعون عن السطو علنا أو سرا على الآخرين وبينهما توما حامل القلم، ممتلك المعرفة والذى يقدمه السارد مقترنا بنور الصباح فى رمزيته على الحق والخير: ” ما إن تستضاء الأرض في مطلع كل نهار, حتى ينهض “توما” من النوم, ويمسح بجبهته التراب, تحية لله, ثم يجمع أدوات الكتابة.. القلم المصنوع من أعواد الغاب, وأحبار سوداء صنعها من نبات النيلة,وملف كبير من أوراق البردي.
بعدها يذهب إلى مدخل سوق القرية, فيكتب للفلاحين الشكاوى والمظالم, وما جعل الجميع يحبونه كثيرا, كما أحبهم” يشير النص فى بدايته لمؤهلات تميز توما وهى مؤهلات لا يقف دورها عند مجرد الإشعار بالتميز ولكنها مقومات رجل تؤهله الأقدار (أو يعده النص ويجهزه السارد) ليكون مقاوما أو منتج المقاومة فالقلم وأدوات الكتابة والأحبار جميعها علامات لها دورها فى إنتاج المعرفة ولأنه لا مقاومة دون معرفة بالفعل، فعل المقاومة ومبرراته فإن الرجل الوحيد المؤهل لإنتاج المقاومة هو ذلك الممتلك للمعرفة (راجع مفهوم الكاتب للمقاومة “الوعى بالهوية ” على حد تعبيره)، ولكن هذه الأدوات وما تنتجها من معرفة داعية للتميز لا يمكنها القيام بالمقاومة دونما فعل بشرى يراهن النص على ترسيخ قيمته لدى النشء ولابد من أن يكون هناك عنصر بشرى يمكنه القيام بهذا الفعل المنتج والمستثمر هذه المعرفة، لذا يمنح السارد هذه العناصر قيمتها عبر فعل الإنسان الذى يطرحه النص عبر صيغتين متتاليتين: الاستكشاف والتحقيق فى إشارتهما للفعل ورد الفعل أو كسر التوازن لإنتاج توازن متجدد: “في صباح كل يوم جديد, يتربع “توما” في جلسته فوق المقعد الحجري. فهو صاحب لقب “حامل القلم”, بعد أن درس الحكمة وفنون الكتابة في “بيت الحياة” وهو الملحق بمعبد مدينة “طيبة” عاصمة الدولة. في هذا الصباح بالذات, شاف “توما” علامات الفزع على وجوه الناس, علم أن اللصوص هاجموا كل حظائر القرية في ليلة الأمس, وسرقوا البهائم وأيضا القمح والشعير من المخازن.” (كتاب قطر الندى ع 204 الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة 2009)، هنا تتحول المعرفة فى مواجهة فعل العنف واللصوصية ، وهنا تكمن القيمة التى يسعى الكاتب إلى غرسها فى نفوس النشء منتجا من المقاومة قناة للتوصيل يمكن مكاشفتها عبر آليات التوصيل وعلوم التواصل الإنسانى 0
وتطرح التجربة الروائية سياقا آخر للمقاومة يكون بمثابة جانب التنويعة المختلفة لطرح فكرة المقاومة خارج سياق الحرب والمعركة، ويمكن للمتابع إصدارات الكاتب الروائية الخمسة الوقوف على هذا الجانب:
- أيام يوسف المنسي- مطبوعات نصوص90 – القاهرة1990.
- السمان يهاجر شرقا – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة 1995.
- العتبات الضيقة – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة 2001.
- يا بهية وخبريني (أربع روايات قصيرة) – نادي القصة -القاهرة2006.
- الروح وما شجاها- الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة 2008.
مكتشفا تجليات المقاومة عبر مجموعة العناوين ذات النسق الفاعل فجميعها (تقريبا) تضم مكونا فاعلا (يوسف– السمان– بهية– الروح ) بما تتضمنه من طاقات رمزية تتصدر النصوص طارحة فعل الإنسان فى محاولته تجاوز مشكلات عصره ومنتجة دلالة التوالى فى تدرج الدال من المشخص (يوسف+ النسيان) إلى المعنوى ( الروح – ماشجاها ) مما يؤكد هذا التدرج الذى يطرح بدوره صيغة من صيغ الوعى لدى الكاتب فى طرحه أسس مشروعه الفكرية والمعرفية وفى رصده لواقع يقارب مساحات دالة زمانية ومكانية فى سياق المجتمع المصرى محل المراقبة والرصد .
فى الرواية الأولى التى جاءت فاتحة التجربة الروائية فى طرحها يوسف المنسى تلك الشخصية فى تماسها مع يوسف النبى المنسى: “وأنا فى الجب ياعواد ناديت على كل الناس بالاسم” (ص 15) ، وإذا كان يوسف القديم مشكلته فى إخوة محددين سلفا وفى جب وضع فيه تخلصا منه فإن يوسف الجديد كان له جبه الخاص الناتج عن انهيار المنزل ودخوله عالم المشردين فى مساكن الإيواء، وكان له إخوة غير محددي العدد، إخوة فى الإنسانية لم يكونوا محددين سلفا ليستطيع مجابهتهم ومن ثم كان عليه أن يمارس المقاومة المطلقة لكونه يتعرض لضغط دائم ليس محددا بفعل مؤقت كسابقه، إن يوسف يمثل وجها مقابلا لرجال المعركة فالباحث فى وقوفه على تجربة الكاتب السردية يتوصل إلى نوعين من الشخصيات تطرحها النصوص القصصية والروائية تتوزع من خلال فضاءين أساسيين:
- فضاء المعركة أى ساحة القتال المعروفة أو المتعارف عليها، حيث الصراع يرتبط بمكان محدد له طبيعته الخاصة، وتتبلور فيها فكرة المقاومة المباشرة المقترنة بالعمل العسكرى فى الغالب وتجدها فى مجموعة “أوراق مقاتل قديم ” وفى ” السمان يهاجر شرقا ” .
- فضاء الحرب وتتبلور فيه الفكرة عبر أمكنة خارج أرض المعركة فالحرب أوسع من المعركة التى هى جزء من كل فالحياة بكاملها ساحة للحرب المستمرة تتغير فيها أدوات الصراع وأهدافه وتتبلور فى “أيام يوسف المنسى ” و “عودة العجوز إلى البحر” و”العتبات الضيقة” “والروح وماشجاها” وغيرها من الأعمال التى تخرج عن نطاق ساحة القتال إلى ساحة الصراع الإنسانى، وهى أعمال تتواشج عبر زاويتين أساسيتين تمثلان روابط جامعة للنصوص جميعها: زاوية الرؤية وكيفية رصد المشاهد شديدة الدلالة على واقع يمثل مرجعيتها، وزاوية العلامات الرابطة بين النصوص وليس من السهل تجاوزها، ويكفى التدليل عليها بنموذج الاسم المتكرر عبر تنويعاته المختلفة:
- يوسف فى رواية ” أيام يوسف المنسى ” 1990.
- عرفة السايح فى رواية ” العتبات الضيقة ” 2001.
- يوسف عرفة فى رواية ” الروح وماشجاها ” 2008.
لك أن ترى الشخصيات الثلاثة بمثابة العلامات الثلاثية على مرحلة تاريخية واحدة متعددة الوجوه، ولك أن تراها شخصيتين تتبادلان طرح وجهات النظر يظهر يقدم يوسف رؤيته الأولى ثم يفسح المجال لعرفة أن يقدم وجهة نظره ولأن خط يوسف القديم الجديد حاضر فى كل زمان ومكان يظل ليوسف حضوره وليكون لنموذجه الكلمة الأخيرة (ألا ترى أن قصة النبى يوسف هى القصة الأكثر استلهاما فى الأدب قديمه وحديثه؟) يوسف المقاوم أولا والمقاوم أخيرا.
لقد فرضت المقاومة نفسها على مشروع الكاتب بشكل صريح فى كتابه المنشور (2001) وفيه طرح مفهومه لأدب المقاومة صراحة: “أما “أدب المقاومة” فهو.. ذاك الأدب المعبر عن “الذات الجمعية” الواعية بهويتها, والمتطلعة إلى الحرية.. في مواجهة الآخر العدواني. على أن يضع الكاتب نصب عينيه جماعته/ أمته ومحافظا على كل ما تحافظ عليه من قيم عليا.. وسعيا للخلاص (ليس الخلاص الفردي, وإنما الخلاص الجماعي) والحرية.
لعل أهم ملامح “أدب المقاومة” هي: التعبير عن الذات الجمعية والهوية.. أدب الوعي والتخلص من الأزمات (اضطهاد- قهر- حروب…).. كما يتسم بالسعي لمعرفة الآخر العدواني وكشف أخطائه وأخطاره.. هو الأدب المعبر عن الذات من الوعي بالذات الأصيلة والهوية.. للفظ العدوان وإقرار استرداد الحقوق.. إنه أدب إنساني من حيث هو أدب تعضيد الذات الجمعية في مواجهة الآخر العدواني” .
إن خطين أساسيين للمواجهة أولا والمقاومة ثانيا اعتمدهما الكاتب للتواصل مع متلقيه ، أولهما يؤسس فيه لمقولات المقاومة فكريا ويؤطر لها بالقدر الذى يكشف عن تفاصيلها المعرفية ، وهو خط يتجلى فى القائمة التالية المنشورة عبر عقدين من الزمن:
– الحرب: الفكرة-التجربة-الإبداع – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة1995.
– المقاومة والأدب- الهيئة العامة لقصور الثقافة- القاهرة 2001.
– طفل القرن الواحد والعشرين- دار الوفاء للنشر- الإسكندرية2002.
– المقاومة والحرب في الرواية العربية- كتاب الجمهورية – القاهرة 2005 .
-“المقاومة والقص في الأدب الفلسطيني،الانتفاضة نموذجا- اتحاد كتاب فلسطين-غزة2006.
-الثقافة والإبداع الرقمي.. قضايا ومفاهيم- الدائرة الثقافية-أمانة عمان الكبرى-عمان2008.
– النشر الالكتروني والإبداع الرقمي- الهيئة العامة لقصور الثقافة- القاهرة2010.
– الطفل والحرب فى الأدب العبرى- دار “اى كتب” لندن- 2011.
وثانيهما يتوازى مع الخط الأول، يقدم نماذج قادرة على الكشف عن هذا الإطار الفكرى وتعميقه فنيا عبر شخصيات رسمها الكاتب بعناية لتقديم هذا الإطار الفكرى والمعرفى.