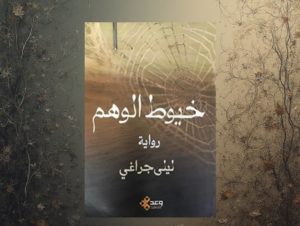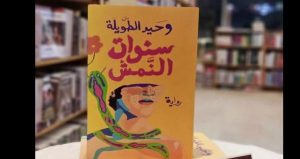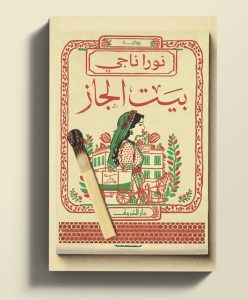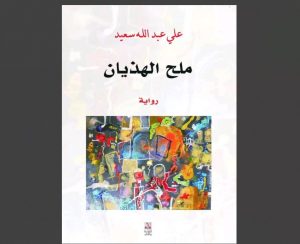د.رشا الفوال
مقدمة:
إذا كان النقد السوسيولوجي منهجًا يعمد إلى ربط الأدب بالمجتمع، وتنطلق فكرته من النظرية التي ترى أن الأدب ظاهرة اجتماعية وأن الأديب لا يُنتج أدبًا لنفسه، إنما ينتجه لمجتمعه منذ اللحظة الأولى التي يفكر فيها بالكتابة(1)؛ فإن الإحاطة بالقيمة الفنية والدلالية للأدب بوصفه تعبيرًا وإبداعًا لجنس فني ضمن سياق تاريخي وظرف اجتماعي(2)، هو ما يُمثل جوهر اهتمامنا في هذه الدراسة، ربما لأن النقد السوسيولوجي هو الأقرب إلى قراءة النصوص في اتصالها الوثيق مع تُربة الواقع الذي أنبتها وجعلها تبدو في صورة هذ الجنس أو غيره(3).
في رواية “ليس بعيدًا عن رأس الرجُل- عزيزة ويونس” الصادرة عام 2024 عن دار بتانة للنشر والتوزيع للشاعر سمير درويش هناك علاقة متبادلة بين حياة البطل النفسية وحياته الاجتماعية، بمعنى أن البنى النفسية للشخصية المحورية لا يمكن فهمها بمعزل عن البنى الاجتماعية. وعلينا أن نتفق قبل الدخول إلى عالم الحكاية، أنه إذا كانت الروايات التقليدية تتلخص وظيفتها في التعليم والوعظ والإرشاد، وأنها لم تفقد حضورها وهيمنتها، فإن الرواية التي نتناولها الآن تُجسد رؤية وثوقية للعالم دون إغفال أثر التراث الشعبي، اتضح ذلك بداية في (التصدير) “تمت الاستفادة من رواية الشاعر الشعبي السيد حواس في رواية السيرة الهلالية، والالتزام بنفس أحداث روايته وشخصياتها، وترتيب الأحداث”، ثم (المقدمة) التي تشبه تمهيد الحكواتي الذي يقص السير الشعبية، ويمكننا اعتبار هذا التمهيد من عناصر القص التراثي. التراجيديا هنا هى أكثر صنوف الأدب تأثيرًا في نفوس القراء؛ لأن المشاكل الفردية لا يمكن عزلها عن الواقع المجتمعي أو عن حدود الزمان والمكان(4)، ولأنها تسمح بحتمية سقوط البطل، بوصفه سقوطًا إنسانيًّا من دون رعب، وكأن الواقع المجتمعي يسحب البساط دائمًا من تحت أفكاره المختالة بنفسها.
ولأن الخطاب ليس واحدًا، لكنه متعدد في أصوله المعرفية ووظائفه وأشكاله وترجماته، نضيف إلى ذلك أن التشكلات السردية في الخطاب الميتاسردي المعاصر ليست مجرد أشكالًا خطابية تتسم بالحياد، وتستخدم لتمثيل الأحداث الواقعية، بل تنطوي على سيرورات معرفية دالة على الدوافع الطوباوية للتحولات المجتمعية، تلك التي تنطوي بشكل عام تحت مفهوم ما بعد الحداثة. وعليه فإن بنية الخطاب أكثر شمولية تضم صلات النص العضوية وسياقاته الاجتماعية والثقافية. بالتالي فإن قراءة العمل الأدبي من منظور سوسيولوجي تُعد ابتكارًا وبحثًا وتأويلًا؛ تُشكل تركيبًا جديدًا بين البنى التحتية والفوقية وبين الفرد والعالم وبين الأشياء المتوارثة(5)، يتفق ذلك مع اعتبار السرد خطاب السارد إلى من يسرد له داخل النص؛ فالسرد هو الطريقة، معنى ذلك أن المهم عند مستوى السرد ليس ما يُروى من أحداث، بل المهم هو طريقة الراوي في إطلاعنا عليها. وهو الأمر الذي يدفعنا إلى تناول الرواية من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: أساليب الحكي وعملية التذوتن
“اجعل بينك وبين الواقع مسافة حتى لا ينكسر قلبك”..
على اعتبار أن عملية التذوتن Subjectivation تعني خلق الذات الفاعلة للبطل، تلك الذات التي تقاوم كل ما يمكن أن يؤدي إلى استلابها، ولأنه لكل عمل أدبي -بغض النظر عن كونه قديمًا أو معاصرًا- معادلًا مفهوميًّا، تعددت أساليب الحكي حاملة في طياتها ملمح التجديد في كتابة الرواية، ذلك التجديد الذي يعكس إحساس الكاتب بضرورة تحريض المتلقي على تحليل الواقع من أجل التفاعل معه أولًا ومحاولة تفسيره ثانيًا.
فنجد أسلوب الحكي المباشر القائم على رصد المواقف الاجتماعية، وتقديم الشخصيات الرئيسية والفرعية في إطارها الزمكاني(6) وأسلوب تيار الوعي للكشف عن دوافع الشخصية المحورية وانفعالاتها من خلال العلاقات الواقعية أولًا والأحلام التي تنوعت بين أحلام النوم والأحلام الطيفية ثانيًا، فكل ما يستحق الاهتمام من وجهة نظر علم اجتماع النص هى الفكرة التي مفادها أن البنى الدلالية (الاستبدالية) الكامنة خلف الخطاب هى التي تُحدد الاتجاه العام لمسار الحكاية؛ فالاستبدالي هو الذي يُنظم التركيبي(7)، وأسلوب الدراما الذهنية الذي تجلى من خلال (المونولوجات) أولًا، يقول البطل: “أتخيل نفسي عبد الحليم حين قابل ماجدة في شارعٍ خالٍ إلا منهما، يرتدي بدلة برابطة عنق، وترتدي فستانًا أبيض دون أكتاف وتستند إلى جذع شجرة عتيقة” و(الانطباعات الحسية) ثانيًا، مثال لذلك تماهى الشخصية المحورية بالأشياءعندما تذكر فيلم الجمال الأمريكي American Beauty، حين عَرَضَ (وس بنتلي Wes Bentley) لحبيبته فيلمًا صوره بكاميرته، الفيلم لكيس بلاستيك يتلاعب به الهواء على الرصيف وسط أوراق الشجر الساقطة الحمراء يقول الراوي: “كأن هذا الكيس هو جسده الآن”. بالتالي نجد أن غالبية ملفوظات الخطاب في الحكاية لا يمكن أن تُدرك إلا في سياق الديالوجات التي تتضمن الردود الإثباتية والتعليقات السردية أو المونولوجات الذهنية المثيرة لانتباه المتلقي.
وأسلوب التحليل الداخلي (التعليق السردي)، حيث يقول الراوي عن الرصاصة التي اخترقت رأس الشخصية المحورية: يونس “قدر المتخصصون بعد ذلك أنها جاءت من فوق إحدى المباني العالية، من بندقية قناص مُدرّب”.
المبحث الثاني: بناء الحدث الرئيسي وتوظيف الموروث الشعبي
“يوووونس.. آخر صوت سمعه على الأرض قبل أن يصعد”..
على افتراض أن (النسق) هو النظام البنائي للأحداث حيث ترتيبها وفق تتابع زمني سببي(8).
فبناء الحدث الرئيسي في الرواية (مقتل يونس برصاصة قناص) تم من خلال:
أولًا: نسق التناوب الذي يقتضي عادةً تشكيل البناء الروائي من خلال عدد من القصص بأزمنة وأمكنة مختلفة، غير أنه يُلزم تشارك الشخصية المحورية في تلك القصص(9)؛ فنجد أن قصص السيدات (مليكة عمراني/ نجوان سيف/ ماهيتاب/ وئام سلطان/ صفاء/ الأم/ الست سارية/ الغجرية/ آية عبد الرحمن/ سميحة النجار/ الكسندرا) تتناوب في الظهور مع أحداث حياة الشخصية المحورية الثانية: عزيزة عبد الفتاح عبر تنقل شخصية يونس بين الماضي والحاضر ومعايشة أجواء الحكاية. فالشخصية المحورية الأولى: يونس لها الدور الأكبر في تمثيل الحدث السردي، أما شخصية: عزيزة فلها وجوه متعددة باعتبارها من رموز الهوية والحياة، والجذور التي تعيد البطل لتاريخه عبر الحلم والخيال، وباعتبارها أيضًا المثير الذي ما زالت آثاره ممتدة في جسد الرواية، وهى منذ البداية تمثل الفتاة نافذة البصيرة التي رأت فيه رجلًا.
نسق التناوب تجلَّى أيضًا بين (الأحلام/ اليقظة)، وبين سيرة يونس وحبيبته: عزيزة، والسيرة الهلالية، وكأن الكاتب يبحث عن نقاط التلاقي واكتشاف المفارقات.
ثانيًا: نسق التضمين
نعني بنسق التضمين الخارجي أن يُضمِّن الكاتب روايته حكايات مستقلة لكنها مرتبطة بالشخصية المحورية، وعادة ما يتم الاستناد في مثل هذا النسق على الموروث(10)، ومن سمات نسق التضمين تحقيق قدر كبير من الحيوية والتنويع في بناء الحدث الرئيسي، إضافة إلى ما يقدمه من متعة يجلبها استحضار الموروث الشعبي الذي يتمتع بقيمته المعنوية والرمزية في نفس المتلقي، مع ملاحظة أن استحضار الموروث الشعبي وتوظيفه من أهم التقنيات الفنية التي عالج بها الكاتب الرواية، والتي تمكن من خلالها من تحويل العلاقات المألوفة إلى أحداث عميقة التأثير، من خلال الراوي الحكواتي الذي يروي لنا السيرة. مرتكزًا على الاستفادة من رواية الشاعر الشعبي السيد حواس في رواية السيرة الهلالية، هذا وتعرف القصص الشعرية الغنائية بالبالادا، وهى قصص لها حيزها المرموق بالنسبة لكل مهتم بالآداب الشعبية، وهى أغنية ملحمية أقرب إلى الابتهالات البكائية، يشيع فيها الحُسن النسائي “الذي هو الملمح الأكثر أصالة للجسد الفولكلوري العالمي بأكمله”(11)، و(البالادا) في أحسن حالاتها قصة عائلة، بمعنى أن العصب الفلكلوري فيها قبائلي، حيث لا مهرب من ثقل الوعد أو القدر، ففي المقابل الروائي نجد المواجع مثل إصابة عزيزة بالمرض ثم موتها، وإصابة يونس بالسحر وموته أيضًا، وكأن الفواصل من السيرة الهلالية تمثل أجزاء انتقالية يتم بعدها العبور لحالة أخرى.
ولأن السيرة الهلالية من أبرز السير والملاحم العربية التي استقلت عنها أعمال شعرية وقصصية تصوغ مدى عشق عزيزة ابنة سلطان تونس معين بن باديس ليونس ابن السلطان حسن ابن سرحان الهلالي سلطان الهلالية الغازين، فقد قام الكاتب بتمثُل واستدعاء الشخصيات التاريخية.
ولأن العلاقات السببية من سمات الذات الفردية، فالحب والموت كل واحد منهما يمثل حدثًا منفصلًا في الحكاية، لكنهما يرتبطان من خلال الحكي الاسترجاعي الذي يطمح إلى إدخال المتلقي في دائرة تحديد الصلات عبر تتبع الأثر بين الأحداث الماضية والأحداث التالية، بالتالي يمكننا أن نبدأ الرواية من نهايتها حيث موت المحبوبة: عزيزة، وصولًا إلى بدايتها حيث موت المُحب: يونس، وكأن الكاتب وضع الحياة بين موتين، بالتالي تم إيقاف كل الشخصيات عن الدخول من الخارج، أو نفيها.
المبحث الثالث: الأيروتيكية والبطل التراجيدي
“الشياطين نساء في الأصل”..
(الذات) هى ذروة الوجود النفسي، لا يبلغها المرء إلا بعد نمو مقدرته النفسية على مجابهة المعاناة(12)؛ فإذا افترضنا أن الكتابة الأدبية في حقيقتها تُعبر عن (الذات) بحسب التوصيف السابق، حين فرق: كارل يونغ بين (الأنا) و(الذات)، فزعم أن (الذات) تُعبر عن كمال الحياة النفسية، في حين أن (الأنا) تعبر عن غرائز الإنسان، هذا وإن اتفقنا على اختلاف التراجيديا الحديثة لدى الإنسان المعاصر عن التراجيديا القديمة، كنتيجة حتمية لتأثر الإنسان بالحضارات وزيادة المعارف، وتعدد الثقافات وتنوعها أيضًا حتى في المكان نفسه، تبقى إثارة الإحساس بالشفقة وصولًا إلى التطهر الذاتي هي الهدف الأساسي للكتابة القائمة على فكرة المأساة. بالتالي فتراجيديا حكاية البطل: يونس وتعدد علاقاته النسائية بداية من موت محبوبته: عزيزة وصولًا إلى موته، يمكننا اعتباره دراماتيكية جنسية فيها محاكاة وتشابه ظلي.
ولأن أول اهتمام حقيقي للعلاقة بين الأدب والمجتمع ترجع إلى الفيلسوف الفرنسي: تين الذي عاش في القرن التاسع عشر، والذي نظر إلى الأدب بوصفه انعكاسًا للمجتمع، يرى في كتابه: تاريخ الأدب الإنجليزي الذي نُشر عام 1863م أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في الأدب هى: الجنس والبيئة والزمن(13)، ففي الرواية الحالية كُتبت الحكاية وفق سلسلة رأسية حادة من الموت إلى الموت بشكل عكسي من خلال تقنية (القلب)، وكأن لحظة الكثافة السردية هى نقطة التحول إلى النقيض؛ فالرواية تبدأ بموت يونس، يقول الراوي: “كانا سيلتقيان بعد تسعة أيام فقط، لكنه يصعد الآن”، وتنتهي -أى الرواية- بموت عزيزة، يقول البطل: “وصلتُ إلى دارنا أخيرًا، كان باب جيراننا المقابلين موارَبًا، ليس مفتوحًا عن آخره كالمعتاد. نظرتُ نظرة خاطفة لعلني ألمح طيف عزيزة، رأيت أشباحًا تتحرك ببطء، ترتدي ملابس سوداء، فانقبضتُ.. ثمة كآبة تحيط بالمكان وناسه، ثمة شيء غير معتاد هنا!”. تقنية (القلب) يعرفها أرسطو بأنها تغير تتحول بمقتضاه الأفعال إلى نقيضها، الفعل الأصلي هو مسار الشخصية المحورية يونس في الفرار من الواقع المجتمعي الضاغط، لكن دائرة الفعل تعود إلى أصلها في النهاية إلى القبر- الرحمي Womb–Tomb.
ولأن موت البطل التراجيدي يونس لعبة سردية اعتمد عليها الكاتب لانتزاع النصر من بين فكي الهزيمة، يمكننا اعتبار موت عزيزة هو المأزق الإنساني الأقصى، وغياب ولاء سلطان ما هو إلا أنثوية تم تمجيدها وفق قانون البطل الخاص؛ فهى كما يقول: “الجسد الماستر الذي يحتل خياله“، معنى ذلك أن الأيروتيكية في الرواية تمثل التقاطع المعقد بين الطبيعة الاجتماعية للشخصية المحورية وبين الثقافة التي اكتسبها، “فهو ابن قرية ريفية هادئة تقع على أطراف الشريط الأخضر الذي يحيط بمجرى النيل، وتعانق الصحراء، وعاش أهم عشر سنوات في حياته في ضاحية أستوريا في كوينز بنيويورك”، وكأن ذلك التقاطع وسيلته لتحقيق الفردوس على الأرض، ربما لذلك لاحظنا أن العلاقات الأيروتيكية في الرواية لا يعقبها شعور بالذنب، ولا تنطوي على خطأ، وكأن هناك نوعًا من التكامل بين جسد الشخصية المحورية: يونس وذهنه، ولأنه ضحية الصعود والهبوط في تلك العلاقات، تمكن من الحصول على ذاتية أحادية فردية Selfhood. ولأن الجنس ضرب من الشيطنة daemonic، ذلك المصطلح الحاضر في الدراسات الرومانتيكية خلال الخمس وعشرين سنة الماضية، والذي اشتق من الكلمة اليونانية daimon وتعني: روح الإله الأقل منزلة من الآلهة الأوليمبيين، كانت كل علاقة أيروتيكية تقود إلى (الكبت)؛ فشخصية: عزيزة نموذج المحرك البدائي للطبيعة First Mover الذي يظهر عند كل إحساس بالألم أو الإحباط أو العجز، لذلك مع الوقت بدأ يلاحظ الشبه الذي بين ماهيتاب وبين عزيزة، وشخصية إيزابيل ستذكره دائمًا بأستاذته سميحة النجار الوحيدة التي تعرفه من الداخل، ونرجسية ولاء سلطان تحالفت مع الطبيعة الأرضية لتشكل القيد الذي يهيم فيه يونس المفعم بالقلق، والجسد الأنثوي الذي تمتعت به نجوان سيف آلة أرضية، بالتالي يمكننا اعتبارها نموذج المرأة النداهة التي تتمتع بعدم اكتراث لا أخلاقي، لامبالاة خالصة، تراقب ببرود عاطفي وهى تختبر قوتها. فإذا اعتبرنا أن المرأة هى الشخص المغوي في التراجيديا الكونية للبطل؛ فالنساء في الرواية ظلال؛ لا يعوق وجودهن بحثه عن الهوية، حتى تظل عزيزة هى الأنثى المثال، وتظل ولاء سلطان هى هالة الوجدان والخيال، ويظل يونس هو الرجل النداه الذي يتقن الزوغان والتملص من الطبيعة الأرضية.
المبحث الرابع: البطل العصابي والتحولات المجتمعية
“هو في النهاية يرسم هذا البرزخ الذي يعيش داخله الآن”
وعلى اعتبار أن النقد السياقي Contextuel هو ذلك النوع من النقد الذي يبحث في السياق التاريخي والاجتماعي والنفسي للأدب(14)، فهناك من يرى أن المنهج السوسيولوجي نشأ لحفظ المنهج التاريخي من خلال استيعاب فكرة تاريخية الأدب وارتباطها بتطور المجتمعات وتحولاتها(15)، في ذلك يرى توماس وارتون أول مؤرخ حقيقي للشعر الإنجليزي أن للأدب فضيلة تخصه وهى التسجيل المخلص لسمات العصر، وأنه مرجع لتاريخ المجتمعات(16).
قام الكاتب بوصف وضعية مجتمعية منفتحة على المستقبل وخاضعة للتبدل دون أن ترتبط بمفهوم صراع الطبقات، الهدف من ذلك أن يقرأ المتلقي من أجل استخلاص المتعة والتعبير عن العلاقات الاجتماعية القائمة بالفعل، وكشف العلاقات الخفية من أجل تصدير التشويق والإثارة للمتلقي، بدلًا من أن يتحول النص إلى مادة أيديولوجية.
أدب ما بعد الحداثة نفسه قد اكتسب شرعيته ووجودة بفضل التحولات المجتمعية، مثل علمنة المجتمع، وأفول الأيديولوجيات الكبرى، والانتقال من مجتمع زراعي إلى مجتمع يقوم على ازدياد هيمنة الاقتصاد وسيادة قوانين السوق. فإذا حاولنا تفسير العلاقة بين خطاب الكاتب وبين المجتمع باعتبار الأخير ميدان الصراع؛ لوجدنا أن البطل: يونس أبو جبل يرفض الخطيئة المجتمعية الأصلية، وهى المتمثلة في الحرمان الاجتماعي. وأن فرديته تنذر بتداعي وأفول الشبكة الكثيفة للروابط المجتمعية، ربما لذلك كان عليه اختراع واقع بديل يمنحه وهم الحرية.
فإذا اعتبرنا أن أكثر المراحل العمرية التي يكون فيها المرء عاجزًا، هى مرحلة الطفولة؛ لأنها ترتبط بأقوى حالة للروح وأنقى حالة للوعي، لفهمنا إحساس يونس الطفل بعدم الأمان والكفاح في هذا العالم المحفوف بالمخاطر، وفهمنا أيضًا كيفية تبلور تحركاته الأساسية من خلال ثلاثة خطوط رئيسية: التحرك نحو الناس، أو ضد الناس، أو بعيدًا عنهم.
الجدول التالي يمكننا من فهم تلك التحركات:
| التحرك نحو الناس | التفسير | التحرك ضد الناس | التفسير | التحرك بعيدًا عن الناس | التفسير |
| “أنا الذي يكره أي مسافة بين نقطتين، دائمًا أتمنَّى أن أطير في غفلة من الزمن، بحيث لا يفوتني شيء” | في ذلك دليل حاجة واضحة للاستحسان من رفيقته: عزيزة لتحقيق كل آماله، هذا التحرك يولد قلقًا حينما يواجه بالإحباط | “لا ينغمس في أي شيء لدرجة التعلُّق، يجعل بينه وبين الناس والأشياء مسافة آمنة” | التحرك ضد الناس يتجلى من خلال شواهد متناقضة؛ لأن الحياة تمثل بالنسبة له نضالًا من قبل الجميع. | “من صغري لا أحب القرية، لا أحب حياة القرى عمومًا، لا أحب الفقر القاسي، وانفتاح أبواب الدور أمام بعضها، بحيث يكشف الكلَّ الكُلُّ” | ليبقى بمعزل، ويشيد عالمه الخاص؛ فالتحرك بعيدًا عن الناس هو الوجه الحقيقي للصراع وأساسه الحاجة إلى العزلة. |
| “الآن هو من يتحكم في سير الأمور ويوجهها، وهو الذي عليه أن يتخذ خطوة للأمام” | البطل العصابي يقوم بجهد كبير في سبيل إنكار وجود الصراعات. | “أعرف أنه مستيقظ، لكن قلبي الأسود منعني من لمسه، أو -حتى- التحدث إليه من بعيد” | من هذا المنطق تصبح حاجته إلى السيطرة من خلال الذكاء. | “بحكم تكويني النفسي أميل للانعزال والخصوصية” | العزلة عصابية كوسيلة للتخلص من الصراعات التي تنشأ عن الاحتكاك المباشر بالآخرين. |
| “ينجز لوحات فنية بأسلوبه، عاكسًا الروح التي يعايشها في نيويورك، التي تعدُّ جديدةً تمامًا عليه” | يحاول تلقائيًّا الفوز بحسن ظن الآخرين، حاجته الانفعالية للمودة تجعله تواقًا إلى الاعتقاد بعدم وجود فجوات بين ذاته وبين الآخرين. | “حين خرج من مقابلته مع الضابط قرر ألا يعود إليه مرة أخرى، لأنه أدرك أن الصغار فقط هم الذين يذهبون” | الميل نحو الاستبطان والانسحاب دال على تعلق البطل بمشاعره الشخصية وأفكاره. | “غالبًا لا يسمع الحوارات التي لا تخصه” | يرجع ذلك إلى الخبرات المبكرة التي لا يُستهان بها والتي وضعته في نمط متصلب. |
جدول رقم (1) تحركات البطل العصابي
البطل العصابي بغض النظر عن مثاليته، إلا أنه يمتلك إحساسًا ما بالضعف والعجز والضياع، يتضح ذلك من خلال مأساوية الأحلام، ويمكننا اعتبار الاغتراب الذي يعانيه ناتجًا عن فقدان الحس بالنسبة للخبرات العاطفية والنظر إلى ذاته بنوع من الاهتمام الموضوعي، دلالة ذلك إدراكه لرموز تلك الأحلام التي يراها.
كما أن إقامة حاجز عاطفي بينه وبين الآخرين، وردود أفعاله التي تتسم بالقلق حينما يتطفل العالم عليه، تُبرهن لنا على أن لديه حاجة رئيسية لعدم التورط أولًا، وحاجة إلى الكفاية الذاتية والاحتفاظ بوهم الحرية تجاه ضغط الوقت ثانيًا؛ لأنه “مصارع حصيف، يجيد قراءة الآخر ويعرف نقاط قوته وضعفه، يعرف متى يتقدم ومتى يتراجع”، وكأن فرادة الخبرة الشخصية تبحث عن نمط كي تنتظم فيه، أولًا: من أجل تأمين البقاء اقتصاديًّا وانجاز العمل الخاص، بدلًا من الكلام عن الموضوعاتية أو المضامين أو رؤيته للعالم أو أيديولوجيته.
ثانيًا: الدخول الحذر في عالم العلاقات مع الآخرين (علاقات العمل/ والصداقات/ والممارسات الأيروتيكية).
تلك الفرادة تصبح مؤرقة في سياق ما بعد الحداثة، ربما لأن وصف الحياة اليومية ترك المتلقي عالقًا تمامًا في التحولات المجتمعية والتاريخية التي أنتجت هذا السياق النصي، ثم الإطار الخارجي بعقلية الشخصية المحورية والأدلة المتعلقة بطبيعته النفسية وكيفية التجاوب مع وتيرة التغيير الاجتماعي والفوضى الظاهرية المزعزعة لجميع المعتقدات، ربما لذلك لاحظنا أن الانتقال من اللغة الاجتماعية إلى اللغة الثقافية صحبته طفرة سببها التنامي السريع في علاقة الذات الفاعلة للشخصية المحورية: يونس بذاتها.
برع الكاتب في الإسقاط المرحلي الذي يساوي تجسيد المصاعب الشخصية للبطل: يونس.
مع ملاحظة أن آلية الإسقاط المرحلي تعمل بشكل خاص على تهدئة التوتر بين الذات والصورة المثلى؛ فمهما كانت الظروف المعاكسة لا تُقهر أثناء مرحلة الطفولة؛ فإنه البطل المقتدر الذي تغلب عليها، ذلك التوافق المصطنع والميل نحو الضبط الذاتي تتمثل وظيفته في كونه يؤلف سدًّا ضد إفاضة العواطف المتناقضة. ليدرك المتلقي في نهاية الحكاية أن المجتمع هو الفك المظلم الذي فر البطل خارجه والذي سيبتلعه مجددًا.
المبحث الخامس: السرد النرجسي وشعرية الحكاية:
“أنا يونس الذي سُمِّى باسم النبي، الذي أخذ اسمه من اسم شيخ الجامع القريب”..
على اعتبار أن الروايات التي تتضمن إشارات تفضي إلى تقديم رؤيا نقدية تسمى: رواية النص وتعرف بالسرد النرجسي الذي يتضمن تعليقًا على السرد والهوية من خلال ضمير المتكلم؛ فالاستهلال السردي في الرواية الحالية زمكاني يمهد للأحداث، وهو استهلال ما بعد حداثي متماهي مع السرد السير ذاتي من بداية التصدير، يشير إلى المسافة الفاصلة بين الشخصية المحورية والكاتب والراوي العليم، مع ملاحظة أن الحكي بضمير المتكلم الموجه للمتلقي، لا ينفي أن يكون الراوي: يونس نفسه في الفصول التي اتخذت ترتيبها وفقًا للحروف الأبجدية، يقول البطل: “ذهبتُ إلى المحطة ظهر الخميس مبكرًا، كانت مجموعة صغيرة تنتظر قدوم الأوتوبيس لتضمن مكانًا للجلوس، قبل أن يكتظَّ -كعادته- بالتلاميذ العائدين إلى قراهم في نهاية الأسبوع، ليس بينهم من أعرفه، وإن كانت وجوههم مألوفة”، وقد يروي بضمير الغائب في الفصول التي اتخذت أرقامًا، يُخبرنا الراوي العليم: “لم يتحمَّس لفكرة الزواج لأنه لم يجد المرأة التي تجعله يضحي بحريته، يضحك حين يتصوَّر شكله وهو عائد إلى البيت حاملًا الخُضار والبقالة”، ثم تأتي الرواية في مواضع محددة بضمير الجمع؛ لأن الذات دائمًا في شبكة متقاطعة مع الآخرين؛ “في الشهر الأخير قبل الامتحانات، نحمل أثاثنا الفقير ونعود إلى القرية المظلمة، تأتي الحمير وعلى ظهورها الرجال، تحمل الكنب الاستامبولي والمراتب والغطاءات، سلال الخوص الفارغة، والكتب والكراسات، نعود مشيًا كما أتينا، نجر أقدامنا بخشوع وراء مواكب الحمير”؛ ولأن قوام الذاتية ليس الوجود للذات بل الوجود للآخرين ومعهم وبينهم، قد يكون الهدف من الرواية بصيغة الجمع التأكيد على المشاركة في الفعل.
بدأ الفصل الأول من الرواية بمرحلة التأريض: أى علاقة: يونس بالمجتمع الذي نشأ فيه، وكذلك بسنوات الدراسة، ولأن التأريض أيضًا يعني الوقوف داخل الذات والتصالح معها، حاولت رؤية الكاتب التأسيس لخلق حكاية إنسانية أرضية تُعزز أهمية الحواس وانحلال الانتماء تدريجيًّا بإرادة حرة وحياد اجتماعي، مع ملاحظة أن انحلال الانتماء جاء كنتيجة حتمية للفضاء الروائي الأول الذي يشير إلى الأوضاع المجتمعية المتردية.
أيضًا ذكر اسم البطل: يونس ونسبه يدفعنا لاستقصاء الزمن الشعري الذي استحضره الكاتب بوصفه شاعرًا في لحظة الإلهام؛ “أسماه أبوه يونس، تيمنًا باسم شيخ الجامع في القرية التي ولد وتعلم وعاش فيها حتى الثانوية العامة، قبل أن يأتي إلى القاهرة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، عائلته فقيرة تعمل بالزراعة، وكان يعمل في الغيط بيديه قبل أن يترك القرية”؛ فإذا افترضنا أن نقطة التحول في الحكاية بدأت بموت عزيزة نجد أن البكاء على الطلل ثم النسيب يمثلان رؤية الكاتب الوجودية لفكرتي الحياة والموت، أيضًا رسم الديار والقرية وشوارعها ثم خلوها من المحبوبة يمكننا اعتباره استلهامًا لمعايير عمود الشعر، مع ملاحظة أن الخاتمة الطللية للرواية وليدة الموروث الأدبي للكاتب، شعرية الحكاية كذلك تكمن في انفتاحها واستعصائها على تحديد المكان الذي نشا فيه البطل أولًا، ثم الموت وهو في حال امتزاج تام بالثوار ثانيًا، وفي ذلك دلالة الاتساع وقسوة الحياة وتشابه المصائر.
المبحث السادس: آليات الحكي
“سمع من أحد أساتذته أن الأغبياء فقط هم الذين يُقتادون إلى هذه الأماكن، ويدفعون فاتورة جلوس الأذكياء على المنصات وفي استديوهات البرامج الليلية، وفي المؤتمرات الرسمية”..
إذا اعتبرنا أن الدراسات السوسيونصية تُفيد من إنجازات سوسيولوجيا النص الأدبي وتحاول البحث عن دلالته انطلاقًا من داخله(17)؛ فإن بناء الرواية الحالية لا يرتكز على حدث سردي مركزي تتفرع منه أحداث ثانوية، إنما تم توظيف أساليب فنية حديثة مثل التداعي الحر والاستدعاء. هذا وقد انصب هدف الكاتب في الكشف عن الذات الجماعية، مرتكزًا على السرد الذي يعتمد على البداية والذروة والنهاية حتى وإن كانت معكوسة، ورصد الترابط بين الأحداث والشخصيات من خلال التماسك النصي. ثم التوالد الحكائي، إذ ينبثق من رحم الحكاية الكبرى الأساسية حكايات مختلفة.
– الراوي العليم يروي ما حدث وما سيحدث، تلخصت وظيفته في: الإخبار والتعليق السردي والتفسير أيضًا، إضافة إلى ذلك فالعمليات الواعية للراوي العليم التي تضمنت (الفهم والتصور والتيقظ والفكر والتواصل المقترن بأنشطة الحياة اليومية)، تآلفت مع التفاعل المنفرد للشخصية المحورية: يونس ومع تاريخها العائلي وسياقها الاجتماعي.
اختلفت شخصية الراوي عن شخصية البطل، فوظيفة الراوي تلخصت في: انتقاء الحدث الرئيسي والأحداث الفرعية، وترتيب الزمن السردي والأسلوب التعبيري واتقان الحبكة، والتعليق السردي والتعليل للأحداث، والتوثيق من خلال إدراج فصول من السيرة الهلالية، والوظيفة الإيديولوجية للحكاية ككل التي اتضحت من خلال: تجربة الشخصية المحورية في العمل الثقافي المصري والتواصل مع القيادات وتوازي ذلك مع حياته في نيويورك، والوظيفة الجمالية التي اتضحت من خلال: تصوير الحياة الواقعية في لقطات معبرة، بينما انعكس الحس الإيديولوجي للكاتب على سمات شخصية البطل: يونس عبر مجموع خبراته وتوجهاته الفكرية وقناعاته ومنطقه في النظرة لقوانين العالم(18).
– الرواية عبارة عن صور متجاورة متصلة من خلال الشخصيات المحورية، بالتالي يمكننا التقديم والتأخير والحذف دون أن يتأثر بناء الرواية.
– الإشارات اللغوية تمت من خلال:
أولًا: التكرار على مستوى الخطاب (العلاقة البينصية مع السيرة الهلالية) يُعبر عن وعي الكاتب الثقافي بأهمية ترسيخ الإرث الثقافي الشعبي.
ثانيًا: التكرار التقديمي لشخصية عزيزة وشخصية يونس مرتبط بالاستدعاء من الذاكرة أولًا وبالمونولوج الذهني ثانيًا.
ثالثًا: التناص مع الموروث الشعبي فيما يخص الزار وعلاج السحر، وفك الربط يعكس اهتمام الكاتب بالثوابت لدى المجتمع الريفي والجوهر وجذور الشخصيات ورصد العلاقات من الداخل.
رابعًا: التحول من لغة الاستبطان الداخلي إلى لغة تحمل ظلال الثقافة المختلفة التي التحق بها يبدو الصيغة المهيمنة على الخطاب الروائي من حيث كونه بنية سردية تكلف البطل بأداء مهمة معينة تفضي إلى الخلاص.
خامسًا: حيوية اللغة جاءت بفضل الصراع المتنامي بين ذات الشخصية المحورية وذاتها، جاءت أيضًا من التعارض بين خطاب اللامبالاة والحيادية الاجتماعية وبين خطابات الإيديولوجيا.
سادسًا: خلق سرد بوليفوني متعدد الأصوات (الراوي العليم/ الشخصية المحورية/ الشخصيات الفرعية/ شخصيات السيرة الهلالية).
– الرواية تقيم علاقة بينصية مع السيرة الهلالية، وهو الأمر الذي سمح بالتداخلات بين عناصر كل من الأحداث والحكاية الشعبية. فالكاتب بداية من المقدمة التي تشبه تمهيد الحكواتي، والتصدير الذي جاء به: “تم الاستفادة من رواية الشاعر الشعبي السيد حواس في رواية السيرة الهلالية، والالتزام بنفس أحداث روايته وشخصياتها، وترتيب الأحداث” قبيل الدخول إلى عالم الحكاية يسعى إلى إبراز التعالق النصي بين الرواية والسيرة الهلالية، واستكمالًا لذلك التعالق النصي تعمد -أى الكاتب- تضمين فصول من السيرة الهلالية داخل الرواية.
– إسقاط الزمن الموضوعي المدرك على الأحداث في الرواية يتضح أكثر إذا قسناه نسبة إلى المكان؛ فإذا كان زمن الحكاية هو الزمن الذي وقعت فيه الأحداث وفقًا للتسلسل المنطقي، وزمن الخطاب هو زمن إعادة صياغة الأحداث بواسطة امتزاج الحديث النفسي ومكون الوصف، وتعليق الراوي العليم ومحاولة فهم أفكار الشخصيات؛ يخبرنا البطل عن شخصية: نجوان سيف الدين قائلًا: “في لا وعيها، تريد إذلال كل العيون المربوطة بجسدها، التي لا تطرف كي لا يفوتها أي تفصيلة مهما صغرت، تريد مرمغتها في الوحل”، فإن الاستغراق الزمني يشير إلى التفاوت النسبي الذي يصعب قياسه بين زمن الحكاية وزمن الحكي، ربما لذلك كان التلخيص الذي يشير إلى تكثيف الشهور والسنوات على مساحات نصية قصيرة، لا يتم فيها الالتفات إلى التفاصيل اليومية.
وكان الحذف الذي يشير إلى المرور على فترات زمنية دون ذكر ما وقع فيها من أحداث، مثال لذلك قول البطل: “في صباح يوم حارٍّ صحونا ولم نجد صفاء في بيت أهلها، سألنا عنها قالوا إنها سافرت إلى الإسكندرية في زيارة لخالتها، سافرت مع أخيها الكبير” مع ملاحظة أن للحذف في الرواية أنواع: أولها: الحذف المعلن الذي يشير إلى المدة الزمنية المحذوفة، يقول الراوي: “مرت سنوات ثلاث منذ موت عزيزة، وموت أمه وأبيه، انقطعت صلته بالقرية تقريبًا، لم يعد يزورها إلا في المناسبات الكبرى”. وثانيها: الحذف الضمني الذي يفهم المتلقي مدته من السياق، يقول: “لم يخرج هذا اليوم من الشقة رغم أن لديه محاضرات مهمة، فضَّل أن يستريح في سريره أطول فترة ممكنة، ويرتب الفوضى قدر ما يستطيع”.
وإذا كانت الوقفة تعني إيقاف وتيرة الحكاية ورصد حركة الشخصيات ووصف الأشياء وتحليل التصرفات؛ فقد تعددت أنماط الوقفة أيضًا من أجل رصد الأبعاد الخارجية أو التأملات الداخلية التي يمتزج فيه الحلم بالواقع. مع ملاحظة أن الإيقاع الروائي ناتج عن توظيف تقنية الحلم، وكأن الحلم يستحضر الدراما استحضارًا داخليًّا.
– في ظل التبعثر يتضح منطق الحبكة القائم على ترابط أجزاء الرواية من خلال التعبير عن حدة الأزمات المصيرية والغموض الذي يعتري تحركات الذات الجماعية، والاعتماد على اللغة التصويرية الإيحائية، والاهتمام بتصوير نثريات الحياة والتي على الرغم من تشظيها تخضع للتفسير والفهم بفعل الراوي العليم.
– ارتكز الكاتب على الانحرافات السردية حيث الانتقال من حدث إلى حدث آخر، من أجل التمرد على فكرة التسلسل الزمني، والاعتماد أكثر على مبدأ السببية في بناء أحداث الرواية.
– السرد المهجن: تدخل في تكوينه بصورة أساسية الأساليب الفنية السردية القديمة مثل المقامة والسيرة والملحمة، ربما لأن السير الذاتية غالبًا ما تُكتب وتدور حول الشخصيات العظيمة، دلالة ذلك أن خط سير الأحداث يتخلله الاسترجاع من الذاكرة، ثم حكاية داخل الحكاية، والانتقالات الزمكانية بين الماضي والحاضر.
– اعتمد الكاتب على أسلوب تيار الوعي الذي يجسد التوتر الناتج عن التضاد بين الواقع المعاش بضغوطه وتفككه وبين ما يدور في نفس الشخصية المحورية: يونس، إضافة إلى أن كشف الشخصيات الفرعية منذ البداية، ثم كشف المسكوت عنه وتعرية المجتمع الذي يضج بالطبقية المميتة من خلال الذاكرة الاسترجاعية “يوجه الانتباه إلى علاقات التقاطع ما بين الحكاية كإبداع ذاتي والموروث كوجود سابق على الحكاية ولاحق بها ومحيط بكل تحولاتها”(19)؛ ولأن هناك شيئًا لم يمُت في البطل يمكننا تسميته بالوعي المطلق؛ فأسلوب تيار الوعي جعل الحكاية تتضمن الوقائع كما حدثت، مع ذكر الانفعالات والخيالات والأحلام والهواجس التي صاحبتها.
– اتسمت الرواية بالحلقات السردية المتداخلة: فالأوضاع المجتمعية متشابهة، والأماكن محددة وثابتة، ذلك أن تداخل حلقات السرد هو الذي ساهم في توليد الحركة السردية التي تشبه إلى حد كبير (المراوحة في المكان) هذه المراوحة فرضت تكرار الشخصيات النسائية لتنقسم الحلقات إلى:
الحلقة السردية الأولى: يونس/ عزيزة وظلالها من السيدات
الحلقة السردية الثانية: يونس/ الأم
الحلقة السردية الثالثة: يونس/ التحولات المجتمعية
وقد تخلل تلك الحلقات الانتقال إلى فصول من السيرة الهلالية. مع ملاحظة أن زمن الحكي في الرواية تم من خلال تداخل الحلقات السردية (الذي تتقاطع من خلاله الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل) والسرد المضاد للسيرة الهلالية (الذي تداخل مع زمن السرد نفسه لتبديد وهم مرجعي لدى المتلقي وظفه الكاتب من أجل الإيهام بواقعية الانفعالات).
– قلة الحوار وغلبة الحكي؛ إذ تتولى الشخصية المحورية: يونس دور البطولة في معظم مشاهد الرواية، وإن كان الكاتب حاول هدم التتابع الاعتيادي للأحداث من خلال تقنيات الاسترجاع والمونتاج الزماني، مع ملاحظة أن استرجاع الذكريات يُشبه قصص الاعترافات، والاسترجاع في الرواية نوعان: استرجاع خارجي بالعودة إلى ماضٍ سابق بعيد عن زمن الحدث الرئيس، واسترجاع داخلي بالعودة إلى زمن سابق قريب(20)، والمونتاج الزماني اعتمد على تجميع الصور المستقلة في صور مركبة من خلال تثبيت الأماكن وتحرك الشخصية زمانيًّا.
– استخدم الكاتب تقنية الدعم الدرامي للحدث(21)، تجلى ذلك في الصراع الذي يتضح من خلال المفارقات والتصادمات بين شخصية البطل وبين الشخصيات الأخرى، توظيف الحلم أيضًا ساهم في تحقيق درامية الحدث.
– الخطاب الميتاسردي في الرواية تم من خلال التناص الأدبي مع السيرة الهلالية، ومناقشة شخصيات الأفلام السينمائية والتحدث عن أفعالهم وكيفية إدارتهم للصراع، أدى ذلك إلى كسر الإيهام أولًا، وتحفيز المتلقي على معايشة حكايات فرعية- الشخصية المحورية طرف أساسي فيها ثانيًا. أيضًا كتابة تاريخ الانتهاء من الرواية ومكانه مظهر من مظاهر الوعي الميتاسردي.
– الاستبطان الداخلي تقنية فنية تعتبر امتدادًا لمكون الوصف في الرواية؛ لأن الوقفات السردية تأخذ على عاتقها إخبار المتلقي بالمشهد الذي يصفه الراوي(22)، كما أن التنويعات بين الاستبطان الداخلي واللقطات الخارجية أثناء الوقفة الوصفية أدى إلى إبراز المونولوج الذهني.
– إذا افترضنا أن علم اجتماع النص يهتم بربط الأدب بالمجتمع بواسطة اللغة، معتبرًا أن النص ليس جوهرًا منعزلًا عن غيره، إنما هو تقاطع حواري لنصوص أخرى؛ فالكتابة الأدبية ترُد على كل وضعية اجتماعية بالمحاكاة أو المعارضة أو بالكولاج النصي. في الرواية محل الدراسة نجد أن فن الكولاج من الوسائط التعبيرية الفنية الحديثة التي تم توظيفها، وهو طريقة أساسها التوليف بين بعض المواد بوضعها في سياق معين للحصول على إيقاع فني عن طريق التوافق والتناسق بين مختلف هذه المواد، إذ يعتمد الكولاج على البعد التشكيلي والبعد الفني في رسم الصورة الكلية للشخصيات، وبين الكلمات والجُمل والمقاطع التي تحمل للمتلقي حالة من الرومانسية، المكان في الكولاج السردي يجمع بين الوصف التسجيلي باعتباره الخلفية التي تقع فيها الأحداث، والوصف التعبيري الذي جاء في شكل حلقات سردية مختلفة يجمعها حس واحد هو الشخصية المحورية، وساهم في نقل مشاعر وانفعالات الشخصية المحورية، والوصف التصنيفي الذي تجلى من خلال ذكر الأماكن في صورتها الواقعية مثل الأحياء والجسور والشوارع، مع ملاحظة أن اللغة في الكولاج السردي تحمل البعد الفني الوظيفي والبعد الدلالي الذي يشير إلى خصوصية الحكاية، الجدول التالي يوضح ذلك:
| أسماء الشوارع والمحلات | الأفلام السينمائية | اللوحات واللافتات | وسائط أخرى |
| شارع استانواي في أستوريا بنيويورك | – فيلم الجمال الأمريكي American Beauty
– فيلم المشبوه |
لوحة وئام سلطان | – فصول من السيرة الهلالية
– تمثال سعد زغلول – التماثيل على واجهات عمارات وسط البلد – قطعة النحت لحيوان في حجم القطة – مجسم بوذا |
| شارع محمد محمود | – فيلم البنات والصيف
– فيلم حسن ونعيمة |
لوحة إيجون شيلي | – التليفون الآي فون 3G
– مقال أليكس في النيويورك تايمز – إعلان مكتب العلاقات الثقافية – المواقع الإخبارية CNN, BBC |
| شارع الدقي | – فيلم أبي فوق الشجرة
– فيلم أميرة حبي أنا |
لوحة زهرة الخشخاش لفان جوخ | – غنوة ظلموه
– غنوة أى دمعة حزن لا – غنوة موعود – سيمفونيات بيتهوفن الشهيرة – غنوة الشيخ إمام |
| شارع النيل | – فيلم شقة في وسط البلد
– فيلم الكرنك
|
زخرفات مايكل أنجلو | – كلمة ناظر المدرسة في ميكروفون الإذاعة
– خطاب الرئيس المخلوع |
| شارع البرازيل | – فيلم The dreamers
– فيلم موعد على العشاء |
لوحة تشير إلى جزيرة روزفلت Roosevelt Island، | – شطر أبو نواس
وداوني بالتي كانت هي الداء – كلمات أحمد فؤاد نجم |
| شارع البوابة الرئيسي | – فيلم شلة الأنس
– فيلم شفيقة ومتولى |
اللوحة المعدنية التي تحمل اسم نجوان سيف الدين | – المثل الشعبي: الجواب بيبان من عنوانه”!
– نداء العرافة: أبيَّن زين واشوف الودع |
| شارع كريزنت Crescent St | – فيلم الراعي والنساء
– فيلم إشاعة حب |
لوحات من النحاس المدقوق | – قصة: لك يوم
– جوجل وتدوينات فيسبوك وتويتر – كراسات الرسم |
جدول رقم (2) الوسائط التعبيرية في الرواية
فإذا كان اغتراب الشخصية المحورية: يونس يعني أنه قد قام بنفي نفسه وكف عن تصورها كمركز للنشاط؛ فإن الطريقة التي قدم بها الكاتب روايته قائمة على فكرة الوعي الباطني بالزمن التي تتلخص في الإدراك، والتذكر، الترقب ومحاولة البحث عن عالم أفضل، حتى وإن انتهت تلك المحاولة بالأفول.
——-
الهوامش:
1- بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط1، 2006، ص65.
2- رومولو رونتشيني، سوسيولوجيا الأدب، مجلة الاتحاد الإماراتية، الملحق الثقافي، 2016.
3- هويدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب: قراءة سوسيوثقافية، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2015، ص11.
4- إيليا الحاوي، في النقد والأدب، دار الكتاب، بيروت، ط1، 1979، ص89.
5- عثمان موافي، مناهج النقد المعاصر، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، الأزاريطة، ط1، 2008، ص87.
6- عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط7، 1978، ص 178.
7- A.J. Greimas, “dans: H.G.Ruprecht Ouvertures. Metasemtiques: Entretien avec Algirdas Julien Greimas” RSSI, Vol. 1(1984), P. 9.
8- أ.م.فوستر، أركان القصة، ترجمة: كمال عياد، مراجعة: حسن محمود، تقديم: ماهر فريد، تحرير: محمد عناني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، 2001، ص50.
9- حسن الحازمي، البناء الفني في الرواية السعودية: دراسة نقدية تطبيقية، ط1، 1427- 2006م، ص804.
10- رينيه وليك، وأوستن وارن، نظرية الأدب، تر: عادل سلامة، دار المريخ، الرياض، ط3، 1992، ص306.
11- شوقي عبد الحكيم، الرجل والمرأة في التراث الشعبي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2014.
12- كارل غوستاف يونغ (1997)، علم النفس التحليلي، تر: نهاد خياطة، ط2، دار الحوار، اللاذقية.
13- يوسف خليف، مناهج البحث الأدبي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2004، ص25.
14- جيروم ستولنيتز، النقد الفني (دراسة جمالية)، ترجمة: فؤاد زكريا، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط1، 2007، ص667.
15- صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، ط1، 2002، ص39.
16- رينيه وليك، وأوستن وارن، نظرية الأدب، مرجع سابق، ص116.
17- عبد الوهاب شعلان، من سوسيولوجيا الأدب إلى سوسيولوجيا النص: قراءة في تجربة حميد لحمداني، المركز الجامعي، سوق أهراس، 2015.
18- سعيد بنكراد، نحو سيميائيات للأيديولوجيا، دار الأزمان، الرباط، 1996م، ص33.
19- رولان بارت، نقد وحقيقة: مقدمة عبد الله الغذامي، ترجمة: منذر عياشي، ط1، مركز الإنماء، 1994م، ص11.
20- حسن البنداري، فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط2، 1988، ص78.
21- ميجان الرويلي، وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي: إضاءة لأكثر من خمسين تيارًا ومصطلحًا نقديًّا معاصرًا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 2000، ص198.
22- سيزا قاسم، بناء الرواية، مكتبة الأسرة، 2004، ص92.
——
المصادر:
1- زيجمونت باومان، الحياة السائلة، ترجمة: حجاج أبو خير، تقديم: هبة رءوف عزت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، سلسلة الفقه الاستراتيجي، ط1، بيروت، لبنان، 2016.
2- تود سلون، حياة تالفة: أزمة النفس الحديثة، ترجمة: عبد الله بن سعيد الشهري، دار الروافد الثقافية- ناشرون، ابن النديم للنشر والتوزيع، ط1، وهران، الجزائر، 2021.
3- كارين هورني، صراعاتنا الباطنية: نظرية بناءة عن مرضى العصاب، ترجمة: نور ياسين، منشورات نصوص، ط1، 2022، لبنان.
4- بيارف. زيما، النص والمجتمع: آفاق علم اجتماع النقد، ترجمة: أنطوان أبو زيد، مراجعة: موريس أبو ناضر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 2013.
المراجع مرتبة أبجديًا:
1- أ.م.فوستر، أركان القصة، ترجمة: كمال عياد، مراجعة: حسن محمود، تقديم: ماهر فريد، تحرير: محمد عناني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، 2001.
2- إيليا الحاوي، في النقد والأدب، دار الكتاب، بيروت، ط1، 1979.
3- بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط1، 2006.
4- حسن البنداري، فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط2، 1988.
4- حسن الحازمي، البناء الفني في الرواية السعودية: دراسة نقدية تطبيقية، ط1، 1427- 2006.
5- رولان بارت، نقد وحقيقة: مقدمة عبد الله الغذامي، ترجمة: منذر عياشي، ط1، مركز الإنماء، 1994.
6- رومولو رونتشيني، سوسيولوجيا الأدب، مجلة الاتحاد الإماراتية، الملحق الثقافي، 2016.
7- رينيه وليك، وأوستن وارن، نظرية الأدب، تر: عادل سلامة، دار المريخ، الرياض، ط3، 1992.
8- سعيد بنكراد، نحو سيميائيات للأيديولوجيا، دار الأزمان، الرباط، 1996.
9- سيزا قاسم، بناء الرواية، مكتبة الأسرة، 2004.
10- شوقي عبد الحكيم، الرجل والمرأة في التراث الشعبي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2014.
11- صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، ط1، 2002.
12- عبد الوهاب شعلان، من سوسيولوجيا الأدب إلى سوسيولوجيا النص: قراءة في تجربة حميد لحمداني، المركز الجامعي، سوق أهراس، 2015.
13- عثمان موافي، مناهج النقد المعاصر، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، الأزاريطة، ط1، 2008.
14- عز الدين اسماعيل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط7، 1978.
15- كارل غوستاف يونغ (1997)، علم النفس التحليلي، تر: نهاد خياطة، ط2، دار الحوار، اللاذقية.
16- ميجان الرويلي، وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي: إضاءة لأكثر من خمسين تيارًا ومصطلحًا نقديًّا معاصرًا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 2000.
17- هويدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب: قراءة سوسيوثقافية، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2015.
18- يوسف خليف، مناهج البحث الأدبي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2004.
19- A.J. Greimas et J. Courtes, Semiotique; Dictionnaire raisonne de la theorie du langage(Paris; Itachette, 1979).