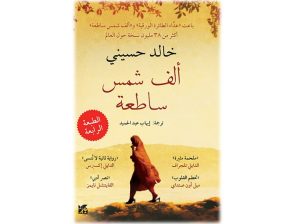وتمتاز هذه النظرة بهذه الكيفية أنه إذا ما استعرضنا التغيرات الاجتماعية للمجتمع المصري وفقا لتناولها في الرواية الجديدة – في مرحلة ما بعد الألفية – فإننا سنكون قادرين على تقديم تحليل للرؤية الاجتماعية. سمته أنه مغاير ومخالف عن تلك التي تستعرض الوقائع الاجتماعية بالتوثيق المباشر ودراسات الحالة، أو عن تحليل الوقائع التاريخية بمعزل عن تأثيراتها الإنسانية، إن المُقدَّم هنا بالأساس هو دراسة “للوعي” الاجتماعي المتضمن في النصوص الأدبية، إنها قراءة لمظاهر التغيرات الاجتماعية وتطوراتها ليس كيفما حدثت في الواقع، وإنما كيفما يتم ادراكها وتأويلها وتقديم وجهات النظر حولها عبر النص الأدبي.
ولعل الملاحظة العامة في نصوص الروايات التي صدرت في الألفية الجديدة أن الأكثرية منها تتموقع زمنيا في حقب سابقة عن الألفية، وتميل لتناول وقائع وأحداث الثمانينيات والتسعينيات، بل ربما عادت لما هو أقدم، لكنه ليس ميلا محايدا من حيث “الوعي” و”الادراك”، وإنما ميل بما تم اكتشافه من خبرة إنسانية جاءت بعد كل هذه المتغيرات والصدامات المجتمعية في المجتمع المصري، حتى أننا سنرصد إسقاطا تاريخيا لأحداث حدثت فيما بعد الألفية وقدمها المؤلف على أنها حدثت في تاريخ سابق، ومحور اطلالتنا في هذا الكم الهائل من الموضوعات المتاحة للدراسة هو “علاقة الابن بأبيه”، و”علاقة المتعلم بمعلمه”، وسنرى كيف أن هذه الصيغة كانت في النهاية معادلا موضوعيا لعلاقة “الشعب” بـ”السلطة الحاكمة” والربط بين علاقات المجتمع ووعيه، متأثرة بالحراك المصري وتوظيف التحولات المجتمعية لتبدو كاشفة عن أخطاء كثيرة في واقعنا الراهن أكثر من كونها أخطاء وقعت في الماضي.
يقول الراوي في «حقيبة الرسول»[3] لـ(محمد صالح البحر): «لم يكن أحد يعرف الجبل مثل أبي»صـ7 هذه الافتتاحية التي تُضفي على صورة الأب المهابة والجلالة والوقار، وطوال الفترة التي سيكون فيها الأب على قيد الحياة في ثنايا الرواية سيكون الوصف المعطى للأب مهيبا كأنما ترسم صورة لبطل أسطوري، حتى في أخص تلك اللحظات الدرامية التي ستشهد تضاربا بين مطالب الابن ورؤية الأب، يقول الراوي: «بدا فوق سريره كما فوق سن الجبل مهيبا وجليلا، تختلط ملامحه بمزيج من العظمة والكبرياء والتواضع وخشوع رائع يطلع من عينيه، وحين تتفجر الكلمات في شفتيه تتزلزل أركان الغرفة…» صـ64، ورغم أن هذه الحادثة هي بوادر الشقاق الأول بين الابن وأبيه وتمرده على قرارات الأب متسلحا بحبه لـ«مريم» إلا أن مهابة الأب وسطوته وحضوره في أعماق وقرارة نفس الابن عميقة لأقصى درجة، حتى أنه يحاول أن يتلمس الدنيا على هَدْي والده، ففي موضع آخر يقول: «أحببت الجبل كما أحبه أبي، ولما كان الجبل كل حياة أبي فقد أضحى كل حياتي من بعده…» صـ29.
ورغم أن التأويل يميل ناحية اعتبار الأب هنا معادلا موضوعيا لصورة «عبد الناصر» الذي سيتكرر في أكثر من موضع سؤال: «ما الذي فعله بنا عبد الناصر؟» في محاولة لخلخلة نظرة المحكوم للحاكم بوصفه أبا، إلا أن مؤشرات كثيرة أيضا تدل على أن الوعي بخلخلة العلاقة بين الأب والابن في مجتمعنا المعاصر، ومشكلة “المجايلة” المطروحة منذ فترة بحدة هي “الوعي” الذي يتم من خلاله رسم الأحداث، وما أدل على ذلك من تمرد «مريم» في هذا الوقت الباكر زمنيا على تقاليد القبلية ومواجهتها لمنعها حقها في اختيار شريك حياتها، هذا الطرح بهذه الكيفية هو تماما مشابه للوعي المكتسب بما تطرحه حركات تحرير المرأة ومنظمات المجتمع المدني لوقتنا الراهن وعقب نضال طويل من حوادث اجتماعية تاريخية.
بيد أن الأمر – اسقاطات الحاضر على الماضي – يبدو أكثر وضوحا وتجليا عند (عبد الجواد خفاجي) في روايته «سيرة العريان»[4]، فبينما يمكن الامساك بواقعة تؤكد على أن الرواية تدور في فترة غزو العراق للكويت، أي تقريبا في عام (1990م)، وهي بداية انتقال بطل الرواية من القاهرة إلى الصعيد لكي يتسلم عمله مدرسا في مدينة نائية ذات قرى مترامية، وفي هذا التوقيت زاره صديقه القديم الذي يقول بالنص: «أيها الصديق القديم .. متى جئت من الكويت؟ – منذ ثلاثة أيام. – لماذا حضرت هذه الأيام؟ – أنت نائم على أذنيك .. صدام خربها. – آه .. مشاكل الغزو .. وهل ستعود مرة أخرى؟» صـ13-14، ثم تتوالى الأحداث برحيل الراوي وعمله معلما ونقله واقعا يذكرنا بالسبعينيات، بيد أنه سيتكرر أكثر من مرة الشكوى من العلاقة السيئة بين المتعلم والمعلم، والتضرر من قرار وزير التعليم بمنع الضرب في المدارس يقول الراوي: «لقد فوجئت أن أحدا لم يقف لتحيتي، وكان التلاميذ منصرفين إلى لهو آخر، وكانت التلميذات يثرثرن كما لو كن في عرس…» صـ96، وسيعقب هذا الموقف الذي سيجد «الرواي-المعلم» نفسه فيه مضطرا لاتخاذ اجراء ما لفرض احترامه وفرض النظام في فصل كل من فيه لا يعيرونه أي اهتمام، سيعقب هذا حوار بين الراوي وإحدى التلميذات المشاغبات، يمكننا باستراحة ضمير أن نطلق عليه “الأنا الثانية للكاتب” هي التي تتحدث على لسان هذه الفتاة، تقول: «سألتها: ألم يكن الأجدر أن تقفي للمعلم؟ فقالت: ((فلقتونا))…، فقالت: ((في الطابور ترصونا كالأحجار، ثم تطالبوننا بتحية العلم، وفي الفصل: كل حصة، قيام وجلوس وأداء التحية.. هل جئنا للعلم أم للتحيات؟)) … فقالت: ((الضرب ممنوع))» صـ97-98، ولا يستقيم هنا “وعي” طالبة مشاغبة مع تناقضية قولبة الطلاب في اجراءات شكلية لا تؤدي لتعليم حقيقي، والحوار الوارد على لسانها، إنه جانب من نقد “الكاتب” للعملية التعليمية جاء متسربا على لسانها، ورغم أن قرار منع الضرب في الواقع الفعلي قد جاء عقب هذه الحقبة زمنيا بسنوات عدة (17/11/1998م)، فإن الأمر هنا واضح جدا أن ما يتم اسقاطه من وعي آني للحظة راهنة خاضت تجارب ثورية ومتغيرات سياسية، فيظهر هذا الوعي منعكسا ومحللا لوقائع اجتماعية يفترض أنها حدثت في الماضي، حتى أن الأمر يصل في (صفحة 178) إلى الحديث عن الزعيم الليبي معمر القذافي بوصفه المخلوع المقتول، وهو ما لم يحدث فعليا إلا في (20 أكتوبر 2011م).
إذن الحراك الوطني المصري، والمتغيرات الاجتماعية بضغطها على المؤلف هي التي جعلته يستكنه صفات وعلاقات وملابسات اجتماعية بعينها في واقع يُفترض أنه ماضي، لكنه في الحقيقة ماضي يتم ادراكه من خلال خصوصية اللحظة الراهنة. ولا سبيل هنا لتحييد هذا الادراك الجديد، وابعاد متغيرات وملابسات الواقع الراهن من تقديم الوقائع الاجتماعية الماضية، فلنتأمل خصوصية المشهد التالي عند (أدهم العبودي) في روايته «متاهة الأولياء»[5] الذي يتحدث فيه عن شخصية «العمدة حمزة»، يقول: «هل صحيح أن من يحكم الناس لا بد وأن يكون أقوى منهم؟ على الأقل ربما لكي يبسط عليهم نفوذه كيف يشاء، أبي كان هكذا، وإنما لا أشبه أبي في شيء، فأنا واحد منهم، نشأت بينهم، وتربيت معهم، أنا أضعف كثيرا من أضعف رجل فيهم…» صـ124
هذا الحوار الداخلي بين العمدة ونفسه لاعنا ميراث كرسي العمودية بعد أن اضطر بسبب صرامة منصبه أن يخسر علاقته مع «الأب لوقا» لفترة من الزمن، ورغم ما صنعه العمدة من جروح في صدور بعض أهالي القرية بقراراته الصارمة، التي تُظهر لنا الرواية أنه يضطر كثيرا أن يأخذها بالمخالفة لقلبه، نابعة فقط من عقله، وتحت بند أنها تحمل الخير والانضباط لأهل القرية، إلا أن العمدة بعدما يتخذ هذه القرارات فإنه يبدو كمن ينتظر من أهل القرية أن ينظروا لقراراته بمنظوره نفسه، بل ربما يشكروه على ما فعله من شأنه، فهو عاجز تماما عن أن ير الأثر النفسي الذي تُحدثه بعض قراراته من جروح وايلام في صدور العديد من أهالي القرية، مما قد يجعل بعض هؤلاء الأهالي يتمنون لو جاءت لحظة مناسبة للانتقام منه، وعلى العكس من ذلك يقف «العمدة حمزة» في لحظة مفارقة سائلا نفسه: «(…) من يكرهني لدرجة أن يربط السبع؟ لا أجد رجلا بعينه، ولا امرأة، كل أهل القرية يحبوننا، لم أفعل معهم إلا الخير(…)»صـ172، إن العمدة يتخذ موقعا ليس فقط سلطويا، وإنما أبويا تجاه كل أهالي القرية، بوصفهم مضطرين إلى النظر لقراراته مهما كانت على أنها الخير الوفير النافع لهم حتى إن لم تقبلها نفوسهم، أو فُرضت عليهم بغير رضاهم.
غالبا ما يتخذ الراوي في الرواية الجديدة موضع الابن، وموضع المعلم، نادرا ما يتخذ موضع الأب أو الجد، أو موضع المتعلم، غالبا ما يقدم الراوي لنا نفسه في هذه الحالة الوسطى بين ترتيب البشرية، إنه «ابن/ معلم» يواجه سلطة الأب وغير راض بما يتم فرضه عليه من تعليمات ومن توصيات، ويعاني حالة من الازدواجية في الحفاظ على مهابة الأب وتقديره، وفي الوقت نفسه تلمس سبل الحياة بشكل آخر بعيد عن سبل الأب في الحياة وعن ميراثه من القيم والتقاليد، ورغم هذا الادراك، إلا أنه غالبا ما يقف هذا الابن موقفا مرتبكا غير فاهم للسلوك نفسه عندما يأتيه من «الابن/ المتعلم».
يقول الراوي عند (صالح البحر): «لقد أراد أبي أن يصنع مني رجلا يحافظ عليه، أما الآن فأنا أصنع رجلا من نفسي، أراني الآن يتحلق الأولاد من حولي في فناء واسع كبير ومظلل بأوراق أشجار كثيفة زرعتها بيدي، وأرى مريم تُقبل نحونا من بعيد، في يدها ورقة بيضاء، ناصع بياضها، وقلم بكر لم يخط شيئا من قبل، وحين تنضم إلينا نبدأ جميعا في مراجعة الدرس.»صـ133
هذه الحالة التي تحققت بعد كفاح يصل لمرحلة الأسطورة في الرواية السابقة، يستطيع هنا الراوي أن يقيم حالة من السلام بينه وبين المجتمع وبين «الأب-الغائب»، معتمدا على فكرة بناء تاريخ جديد، وتأسيس مجتمع جديد، مجتمع قائم على فهم دروس الماضي ومراجعة ما به من أخطاء، أخطاء التغيرات الاجتماعية ممثلة في أخطاء الآباء؛ ليبدأ الراوي خُطى جديدة في الحياة.
وعندما لا يستطيع الراوي أن يقيم هذا السلام متمسكا بواقعية الواقع دون استحضار للأسطورة، يأتي تلخيص هذا الصراع على النحو التالي – عند (عبد الجواد خفاجي) -: «رأيتني وهو الجالس [يقصد أبيه] على طبلية الطعام وحيدا يلغ في الطبيخ وكان الذي أمامه رغفان ولحم، وكنت بين عشرة إخوة نجلس جميعا على مصطبة مجاورة ننظر إليه صامتين، تلتقط آذاننا فرقعة شفتيه وهي تزدرد الطعام، وصوصوة بطوننا الفارغة (…) متلهفين إلى لحظة انتهائه من وجبته (…) جلس هو على نفس المصطبة وراح يطالعنا وقد أصدر فرمانه: كل واحد يأكل نصف رغيف فقط! أتذكر أنني قمت غاضبا ولم أكن قد تناولت شيئا.»صـ173، ولن يتورع الراوي عن الانتقاد المباشر لأولياء الأمور الحاليين – الآباء الحاليين – متخذا موقع المعلم الذي يعاني في العملية التعليمية من كلَّا من المتعلمين وأولياء أمورهم، متهما إياهم بالإيمان الكاذب، ويلوم بشدة سياسات وزير التربية والتعليم التي تعمل على ارضاء أولياء الأمور حتى إن كانت على حساب العملية التعليمية نفسها.
وتصل مراحل كشف الشفرة وتوضيح الاسقاطات داخل النص أقصى مداها عندما يقول راوي (عبد الجواد): «لست أدري ما ضرني وما نفعني إن كان المحبس ملكيا أو جمهوريا، والحال على هذه الحال، ونحن في الحالتين نعيش على المعونات الخارجية [قاصدا ما يأتيه من زيارات الأهالي من خارج السجن] (…)»صـ212-2013
أما عند (أدهم العبودي) يعتني بتوصيف حالة الحراك المجتمعي من جانب أنطولوجي أكثر من تتبع تاريخي للوقائع بنفسها، فيأتي عنده راوي مباشر حاملا هذه الصفة «صوت» ليقدم الرؤية المتضمنة تجاه حركية التحولات المجتمعية وتبدلاتها فيقول الصوت: «أرضنا البكر تطاول عليها الزمن، فض – بلا مقدمات- براءة كل الأشياء الجميلة التي ساورتها ذي قبل، ترنو صوب الآتي بحزن يداخله أمل واهن، يطلق الرحيل صفارته، ويلوح الأمل بمصباح أوشك على الإنطفاء: هنا، ها هنا، ارفعي وجهك قليلا وقد أنتظر(…)»صـ264
بهذه الكيفية التي تشبه إدانة لكل شيء، وتحذير من كل شيء، وعدم استساغه لطعم أي شيء بعد هذا الرصد الطويل لتغيرات اجتماعية متضاربة قائمة على أساس الصراع بين الشخصيات، وبين أنفسها، وبين وعيها وادراكها ورؤيتها للواقع من حولها تقف هذه الرواية موقف الباعث على استكناه الحيرة والتفكير في الغد وفي وقائع انهاء هذه الحالة من عدم الاستراحة.
اذن يتجلى واضحا من النماذج التي تم تناولها أن العلاقة الاجتماعية بين الشخصيات في الرواية المُقدمة للقارئ بعد الألفية وبين واقعها علاقة أساسية يقيمها المبدع في أحداث روايته، وهذه العلاقة ليست حيادية كما كانت في الأوقات التي من المفترض أنها حدثت فيها، وإنما تستكنه الماضي وتعلله وتفسره، وتغوص في أعماق النفس البشرية التي من المفترض أنها عاشت في هذه الأزمان، بيد أن ما تحقق في النص الأدبي ليس “الوعي” الذي كان متاحا لهذه الشخصية، وإنما الوعي المتحقق للكاتب بمجتمعه بعد تاريخ طويل، ومسافة واضحة يمكن من خلالها الحكم على اختيارات هذه الأشخاص في هذه الحقب بتحليل ما أوصلت واقعنا إليه، وقد حضرت “الأنا الثانية للكاتب” في الكثير من النصوص التي كشفت عن نفسها فيها، لتعبر عن نفسها بصفتها مناضلة تجاه تغيير الأوضاع الاجتماعية، ومعبرة عن رغبة في أن تُفُضِ هذه التحولات الاجتماعية عبر الوعي بها إلى مستقبل أفضل.
=============
1 – انظر: تيري ايلجتون: مقدمة في نظرية الأدب، ترجمة: احمد حسان، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، سبتمبر 1991م، صـ 13
2 – انظر: د.السيد يسين: التحليل الاجتماعي للأدب، مكتبة مدبولي، ط3، القاهرة، 1991م، صـ 9
3 – محمد صالح البحر: حقيبة الرسول، دار العين للنشر، القاهرة، 2010م، صـ 7
4 – عبد الجواد خفاجي: سيرة العريان، مجموعة النيل العربية للنشر، القاهرة، 2014م.
5 – أدهم العبودي: متاهة الأولياء، دار الأدهم، القاهرة، 2013م.