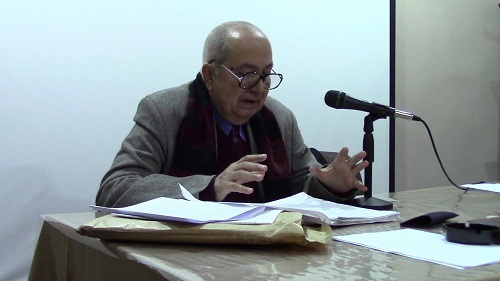د. شكري عزيز الماضي
إضاءة
يشعر قارئ رواية «هليوبوليس» للأديبة مي التلمساني بأنه أمام تجربة جديدة ومتميزة. فهي جديدة ببنائها ومادتها وفلسفتها وأسلوبها وهدفها . ولهذا فهي لون خاص، أو هي كتابة تثير العقل أكثر مما تثير العواطف. ويبدو للمرء أن مصدر الإثارة يكمن في نجاحها في الاستحواذ على اهتمام القارئ وجعله منتبها ويقظا أكثر من حرصها على تسليته وإمتاعه. يحدث هذا من خلال رسم دلالات جزئية بصورة مستمرة ورسم أسئلة وتساؤلات لا حصر لها. وأحسب أن أسئلة القارئ وتساؤلاته تتمحور حول بنية النص ومادته، وحول الدلالات الكامنة بين السطور والكامنة وراء النص برمته. فالقارئ يبدو مهتما بالبحث عن دلالات التقنيات الأسلوبية والانحرافات المتكررة والصور الوصفية والسردية المهيمنة، مثلما يبدو مهتما – بقدر متوازن – بطبيعة المادة الروائية المنتقاة ودلالات الرموز المنوعة والعلاقات المتشابكة والمتداخلة. ويصاحب القارئ – في أثناء بحثه عن دلالات البنية السردية ودلالات محتواها – سؤال يتصل بالدلالة الكلية الكامنة وراء القول السردي، هي دلالة لا يمكن بلوغها أو الوصول إليها إلا من خلال القول نفسه ولهذا كله فإن «هليوبوليس» تفرض على المرء أن يقرأها مرات عديدة . فهي تفرض معاودة القراءة، لأن الدلالات الجزئية للصور الوصفية والسردية تتحول في أثناء التقدم بالقراءة كما تتحول بعد القراءة. وفي أثناء معاودة القراءة تبرز للمرء دلالات جديدة لم يستطع الإمساك بها – في أثناء القراءة الأولى – أو لم يستطع إدراجها ضمن تصور نقدي متكامل. كما تبرز الدلالات الجزئية التي كان قد استخلصها – سابقا – بحلة جديدة.
ويمكن أن يدرج مثل هذا الكلام في إطار بيان أثر النص في أثناء القراءة وبعدها، أي في أثناء التلقي وبعد التلقي، وهو من مهمات النقد القديمة والجديدة – لكنه يوضح من جهة ثانية أن هذا النوع من الكتابة الروائية الجديدة يتحرك في المنطقة الرمادية التي تقبع بين الحدود – في سبيل خلخلة كل الحدود والقيود كما سيتضح – فهو يتحرك بين الظاهر والباطن، وبين المجرد والمتعين، وبين الواحد والمتعدد، وبين الأزمنة المنوعة والأمكنة المتعددة، وبين المتخيل والواقعي، وبين المنطق المعتاد واللامنطق، وبين «الرواية» و«اللارواية». فهي حركة تتمرد على المألوف والمعتاد والمكرر والنمط، فهي لا تهتم بالذات الإنسانية أو بالأشياء، كما لا تحرص على رسم الشخصيات وأبعادها والأحداث وبنائها، ولا على العلاقة بين الشخصية والحدث، لأنها تركز اهتمامها على الظلال التي تولدها هذه العلاقة. فهي لا تهتم بالصورة بل تهتم بما يحيط بها، ولا تهتم باللغة بل تهتم بما يكمن وراء القول ووراء الكتابة. لهذا يصح وصف هذه البنية السردية بالبنية المراوغة.
وإذا صح كل ما تقدم – وأعتقد أنه صحيح – فإن المرء يمكن أن يستبق الأمور ليقرر أن هذا النوع من الكتابة الجديدة يتغيا الكشف عن علاقة خفية معقدة وجديدة بين الإنسان والعالم المعيش. واستنادا إلى هيمنة الصور الوصفية الخالصة والسرد الافتراضي وتعدد الرواة وتنوع الضمائر والتمرد على القيم الجمالية وغير الجمالية الراسية، يمكن أن يمضي المرء قدما إذ يرى أن النص يهدف إلى تجسيد حقيقة نوعية تتمثل في رصد تحولات منظومات القيم وأثرها، هذه التحولات التي أدت – وتؤدي – إلى تهميش الذات الإنسانية أو تفتيتها. وأحسب أن هذه الرؤية أو هذا الهدف هو الذي وسم هذه الكتابة بصفات نوعية مميزة، وأن الولوج إلى عالم النص سيزيد كل القضايا السابقة وضوحا.
العالم الروائي / دلالات جزئية
يتألف نص «هليوبوليس» من مئة وثلاث وستين صفحة من المقطع المتوسط، ويتوزع على ثلاثة وعشرين «مشهدا» لكل مشهد رقم (۱، ۲، ۳، …إلخ). ويبدو هذا التقسيم خاليا من أي معنى، لأن المشاهد ليست مشاهد بالمعنى المألوف – كما سيتضح – فضلا عن أنها منفصلة عن بعضها، فلو قدم بعضها وأځرت مشاهد أخرى (أو حتى حذف بعضها) لما تأثر البناء العام للنص. ويجب ألا يعد هذا التشكيل مثليا، لأنه متعمد ومقصود. فالنص يتمرد على جماليات التتابع والترابط والنمو، وينهل من جماليات التفكك والتشظي (تلبية لرؤيته وغايته). ولهذا يشعر القارئ باستحالة تقديم ملخص لهذه الرواية بسبب الانحرافات السردية والقفزات والانتقالات المستمرة من البداية وحتى النهاية. وإذا ما حاول المرء تقديم خطوط عريضة عامة فإن هذه المحاولة ستكون غير مجدية، لأنها لن تتصف بالدقة، ولأنها ستفقد النص بعض القيم الفنية التي يود تجسيدها. ولتأكيد ذلك وبيانه يمكن الإشارة، مثلا، إلى أن:
- المشهد التاسع : يتحدث عن ميکى والموت والزمن، ثم وصف للعمات والصور. • المشهد العاشر: يصف الطاولات وطبيعة الأطعمة وحركة بعض الأفراد .
- المشهد الحادي عشر: يدور حول كتاب الأبراج ويضم مقاطع وصفية متعددة.
- المشهد الثاني عشر: حول أثاث العمة آسيا وأثاث العمة أمينة…إلخ. • المشهد الثالث عشر: حول الخادمات صابرين، جنينة، حليمة. • المشهد الرابع عشر: حول المطابخ ومحتوياتها وأدواتها.
فلا شك أن مثل هذه الترسيمة تعد اختزالا وتشويها لهذه المشاهد، لأن المشهد الواحد – مثلا – يتضمن صورا وصفية سردية متنوعة جدا، وتتخلل هذه الصور إشارات تاريخية قديمة، وأحيانا إشارات إلى أحداث معاصرة من مثل رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، أو حادثة المنصة التي اغتيل فيها الرئيس أنور السادات وغير ذلك. وهناك التماعات مبعثرة حول التاريخ الفرعوني، كما يتضمن المشهد الواحد جملا وعبارات فلسفية مثيرة ومتناثرة، وهي عبارات تبدو مصقولة ومنتقاة بعناية ولافتة بصياغتها ودلالتها . ويلاحظ تعدد الرواة وتنوع الضمائر داخل اللقطة الواحدة، كما يلاحظ تعدد المستويات اللغوية فالفصيحة تتخللها العامية، والعبارات الحكيمة الرصينة تتخللها عبارات صحافية دارجة، وهناك مفردات كثيرة إنجليزية وفرنسية تكتب بحروف عربية.
وكل ما تقدم قد يعبر عن وفرة الأغراض وتنوعها وتعددها، فالانحرافات المستمرة تؤدي إلى تجميد الزمن وغياب الحركة، وهو ما يفرض غلبة الصور الوصفية الخالصة وهيمنتها مقابل تقلص الصور السردية التي تفرض التتابع والحركة) . وإذ يدل هذا كله على رفض عنيف لجماليات الرواية الحديثة (البداية والوسط والنهاية) والترابط والنمو، فإنه يوحي في الوقت نفسه بغموض العالم وتفككه. فالخلخلة قد تومئ إلى خلخلة العلاقات وأبعادها أو إلى خلخلة منظومة القيم وربما تلاشيها، وتكرار الانحرافات وتشظي الصور الوصفية والسردية (مع غياب الدلالات التي قد يولدها التجاور والتوازي والتضاد) قد يدل على أن العالم بلا معنى. وتعدد الرواة والضمائر وتنوع الصور والإشارات والمستويات اللغوية قد يعبر عن الوجوه المتعددة المتناقضة للحقيقة التي لا يمكن بلوغها. وإذا صحت مثل هذه الاستنتاجات فإن المرء يمكن أن يرجح أن النص يهدف أساسا إلى التعبير عن غموض العالم، وعن قيم الحيرة والسأم والشك وهو ما يعني تفاقم أزمة الإنسان المعاصر.
تفتت الذات الإنسانية
إذا كانت الذات الإنسانية تعيش في عالم غامض مشظى وبلا معنى ومناخ تلفه الحيرة والشك، فمن الطبيعي أن تفقد هذه الذات توازنها ووحدتها وتماسكها. فالذات الواحدة لم تعد ذاتا، بل تحولت إلى ذوات، وهذا يعني أنها أصبحت هامشية أو بتعبير آخر لم يبق منها إلا «الظل».
ويجبهنا النص منذ البدء بالتحولات التي تعتري «ميكي»، وميكي من الشخصيات التي يتكرر اسمها في صفحات عديدة، وتتسلم السرد في صفحات أخرى (لا يمكن وصفها بالمحورية – فالشخصية هنا لم تعد محور ذاتها).
وما يقلق «ميكي» هو عدم عثورها على جواب واضح للسؤال الصعب الذي تسأل به نفسها مرارا : «من أنت؟». والسؤال يفتح أفقا للبحث عن الذات أو جوهرها. لكن ميكي لم تشعر في البداية أن السؤال يشكل عبئا، ربما الإحساسها أننا جميعا نتساءل عن أنواتنا، ولهذا تخبرنا : «في لحظة عابرة أو ممتدة نتساءل كلنا عن أنواتنا، أليس كذلك؟ ونعلم أن الجنون والسأم ووطأة المسافة المقطوعة بين وقتين، تؤدي إلى الأنا. لذلك نقاوم الجنون والسأم بأن نقطع الوقت أمام المرأة، أو نبدأ القص من حيث تنتهي الطاقة على احتمال أجسادنا» (). ولهذا كثيرا ما تقف أمام المرأة، وعندما تخاطب وجهها المنعکس في المرأة بقولها «صباح الخير أيتها العجوز» تجيبها المرأة بصوت أم رؤوم: صباح الندى المعطر أيتها الدمية التعسة» (۴).
وهي لا تجد في هذا الجواب حرجا، في «ميكي» التي تدعي في الأصل ماهي» تشعر – منذ سنوات الطفولة – شعورا قويا وممتدا بأنها «ماريونيت»، والماريونيت – على حد تعبير «بوكلوديل» – «ليس ممثلا يتكلم. إنه كلام يتحرك». أحرك الكلام، هذا كل ما في الأمر، وأخلط الضمائر والأسماء فالوقت كل الوقت متاح لي والتاريخ ليس أكذوبتي الخاصة، التاريخ أكذوبتنا كلنا. الزمن وحده سينتصر كعادته على التاريخ…» ().
فميكي ترى أنها دمية أو عروس من خشب تحكم حركتها خيوط خفية تتدلى منها في كل اتجاه، وهناك أكثر من يد خفية عليا تجذب هذا الخيط أو ذاك، فميكي حبيسة هذه «اللعبة»/ الحياة. لكنها تتمتع بقسط من الحركة الذاتية أو بهامش من الحرية، عندما تتوالد تلك الخيوط وتمتد فتظن أنها قادرة على تحريك نفسها بعيدا عن تلك «الأيدي الخفية العليا» التي مازالت تمسك بالخيوط على الرغم من امتدادها. ولهذا تبدو «حرکتها» وحريتها متوهمة لأنها تدور في إطار من الخديعة المحكمة.
ولعبة الوهم أو الخديعة قد تمارسها الذات منفردة أو تمارسها الذات – کرها أو طوعا أو نفاقا متفقا عليه – مع الآخرين. وفي مثل هذه الظروف والأحوال فإن الذات الواحدة ستشعر بأنها منقسمة على ذاتها، وفي لحظات أخرى بعينها قد تتفتت إلى ذوات بتعدد الظروف والمواقف. ولهذا ترى ميكي أنها «مثل خيال أو عروسة من الخشب، مثل رسم يوحي بالحركة أو قناع على وجه بلا ملامح» (*). وميكي التي تهوى جذب الخيوط» تحاول
في الصباح تعريف القناع أو الأقنعة، وفي «المساء» «تدعي بثبات أنها شخصية محورية متعددة الذوات تقتل واحدة لتحيا الأخريات ثم تقتل الأخريات لتبقى واحدة (
لكن رحلة التحول من «ماهی» إلى «ميكي» إلى «ماريونيت» أو إلى ظل أو قناع أو شيء لم تكن هينة، بل صعبة وشاقة، وتحفها عقبات كثيرة وأسئلة ثقيلة. وفي محاولتها الإجابة عن هذه الأسئلة تبدأ بالبحث عن «معنى في ظل الأشياء، تلك التي حين تترك أثرا يدل عليها لا تلبث أن تغيب، تتحلل» ). ويتأكد لها أن الأشياء تبلى وتبقى الظلال، لكن ما تسعى إليه في الحقيقة هو أن تكون «ظلا طليقا بلا أصل». ولهذا تخبرنا – في ما بعد – أن اسم ميكي يصلح للأولاد والبنات على السواء وهو اسم «يرضي رغبة دفينة تلازمني في أن أكون الاثنين معا ().
ولم ينحصر انقسام الذات أو تفتتها با «ميكي»، التي تكتشف أن أمها «زينات» فقدت اسمها وأصبحت تدعى «زوزو»، ومیکی تناديها «ماما»، بل اكتشفت «أن لها صوتين مثلما كان لها اسمان»، وقد حدث هذا فجأة، مثل صدمة سقوط قناع عن وجه ممثل، فالقناع هو الدور المرسوم، أو المصنوع» والممثل بلا قناع مجرد إنسان بلا دور)
ويبدو أن للصوت ظلالا أيضا، تكمن في نغماته ونبراته وتلاوينه التي تؤكد الانقسام والتفتت، فالنغمات والتلاوين أشبه بالأقنعة، فصوت الأم يتضاعف أحيانا مثل اسميها «صوت الزينات وصوت «لزوزو»، وأنه مثل اسميها يستجيب الضرورات الشخصية التي تلعبها حين تكون زينات أو تتحول إلى زوزو» ().
ويبدو أن انقسام الذات وتفتتها لا يقف عند حد، فلدى تأمل صوتي الأم نجد أن كلا منهما يخفي وراءه صوتا آخرف «الصوت الأول هو صوت «زينات» التي تقول ما تعتقده دائما، ولكن على لسان الآخرين لأنها تأبى الإفصاح عن رأيها بشكل مباشر، كما علمها أبوها وكما ربتها جدتي. الصوت الثاني هو صوت «زوزو» التي تنقل ما يقوله الآخرون بحياد زائف لا يلبث أن ينكشف وراءه رأيها الشخصي في نبرة استنكار أو نبرة تعاطف، فيبدو من صوت «زوزو» أنها تتبنى موقفا متمردا من كلام الغير، إذ تعتبره ساذجا أو طريفا من وجهة نظرها التي تسعى جاهدة لأن تجعلها معلنة.
سلطة الأشياء = ظلال الأشياء
تأخذ الأشياء في رواية «هيلوبوليس» حيزا كبيرا، فهي المهيمنة على العالم الروائي، ويبدو الاهتمام بالأشياء ودقائقها وظلالها متعمدا، بل هو نتيجة الرؤية خاصة – كما سيتضح – ويمكن وصف رواية «هليوبوليس» برواية الأشياء أو الرواية الشيئية، حيث تبرز الأشياء وتظهر قوية ونافذة ومؤثرة في حياة البشر وربما في سلوكهم. ولهذا يرى «ميشال بوتور»: «إن للأشياء تاريخا مرتبطا بتاريخ الأشخاص، لأن الإنسان لا يشكل وحدة بنفسه، فالشخص، وشخص الرواية، ونحن أنفسنا، لا تشكل فردا بحد ذاتنا، جسدا فقط، بل جسدا مكسوا بالثياب، مسلحا، مجهزا … إن الإنسان الحقيقي يتألف من الجسم ومن الأشياء التي تخص الجنس البشري كما يخص هذا العش هذا النوع من الطيور .
فللأشياء سلطة خفية أو سلطة من نوع خاص، وأمام هذه السلطة تبدو الشخصيات الإنسانية باهتة جدا، فالشخصيات في «هليوبوليس مجرد أسماء أو رموز أو حالات أو ظلال مختزلة في الأشياء. فالشخصيات تقدم من خلال وصف دقيق «الأشيائها» و«أثاثها» لا من خلال الحركة والفعل. وهذا يعني أو يؤكد استلاب الشخصية الإنسانية أو تهميشها. وفي مثل هذه الأحوال تصبح الحياة لعبة مكرورة، لهذا نقرأ في الرواية: «كل هذا يبدو مكرورا، كأنما يحدث كل يوم أو على الأقل يحدث كثيرا . بحساب الزمن، نعم، لا شك، غالبا أو ربما، في النهاية، لا أحد يدري. الحدث الأكبر والأهم هو التكرار وليس اللعبة في ذاتها» (۱۴).
وفي غياب الحركة والفعل يغيب الحدث، ومع هيمنة التكرار تصبح الحياة مملة أو بلا معنى، ولهذا يخبرنا صوت أحد الرواة «… وكأن حياتهم تخلو من أية أحداث عداها. لا تخلو قصة من حدث، وعادة ما يصيبنا السأم حين يتأخر الحدث عن الظهور أو عن الإعراب عن وجوده بشكل لافت. نضيع الصفحات بحثا عن حدث يستحق التدوين فلا نجد سوى الأصوات والصور وبعض الأفكار المكرورة» (۱۹).
وفي عالم يهيمن عليه التكرار والسأم ويخلو من المعنى أو من الأحداث/ الحركة التي تستحق التدوین، تبرز الأشياء حادة قوية مؤثرة، ذات قدرة على احتلال جزء مهم من حياة البشر – بل احتلال حياة البشر بكاملها.
وتعد مقولة «إميل دوركهايم» التي تتصدر الرواية «الأفراد هم وحدهم عناصر المجتمع النشطة، وإن أردنا الدقة، يتكون المجتمع أيضا من الأشياء» (5) بمنزلة إضاءة مهمة قد تفسر أسباب اهتمام الرواية بالأشياء، كما قد توحي برؤية الرواية.
ويلاحظ أن بروز «الأشياء في النص يكمن في وصف الأماكن وفي توصيف محتويات هذه الأماكن. فهناك وصف لقصر البارون ومحتوياته، ولمدينة هليوبوليس وشوارعها وأبنيتها، وهناك استرسال واضح في توصيف المنازل من الداخل وما تحويه من أشياء وأثاث. ويبدو أن حياة الأفراد امتداد الحياة الأشياء، وأن تحولات الأثاث مسايرة أو مشابهة التحولات الذات. ولهذا يمكن القول إن تركيز الرواية على عرض «سيرة الأشياء والأثاث ومحتويات الأمكنة يأتي بديلا عن عرض سيرة الأفراد والشخصيات – وإن أردنا الدقة – يتم عرض سيرة أشياء الأفراد وأثاثهم وأماكن سكناهم (1).
لهذا يلاحظ القارئ أن معظم لقطات النص وومضاته الوصفية والسردية و«مشاهدة» تتركز حول توصيف الأشياء. فهناك مشهد يتم فيه عرض مفصل الشرفة المنزل في الطابق الخامس، ثم «شرفة الطابق الرابع حيث تقبع الجدة
شوكت»، ثم محتويات شرفة الطابق الثالث حيث تقيم «العمة آسيا»، وفي شرفة بعيدة «بعد شارعين من البيت تجلس العمة أمينة»… إلخ (۷). وهناك مشهد تعرض فيه غرف الطعام وأنواع الأطعمة وحركة الأفراد، ومشهد آخر يصف غرف النوم ومحتوياتها بدقة متناهية حيث نقرأ وصفا مفصلا لفراش شوكت هانم وفراش العمة آسيا (۸) وفراش العمة أمينة. ومشهد آخر لوصف الملابس وأنواع الأقمشة والألوان المفضلة، وبعده مشهد يوصف فيه المذياع والبيك أب والجرافون والتلفزيون…إلخ وهكذا.
لكن توصيف هذه الأشياء في هذه المشاهد يأتي ليؤكد أن وظائف الأشياء تتغير مثلما تتغير وظائف البشر، ولنتأمل الأسطر القليلة الآتية: : «… أما فراش العمة «أمينة» فقد ظل مصيره مجهولا ولم يثر في خيال
ميكي» سوى ذكرى غائمة عن نمط من الأثاث البسيط الذي يشبه في بدائيته أسرة اليونانيين المقدودة من صخر. ولكن فضلا عن الفراش، كانت غرفة نوم «أمينة» تمتاز عن غيرها بشيء يشبه فكرة ما عن «المعاصرة». كانت أمينة» تمتلك جهازا لعرض أشرطة الفيديو تضعه في غرفتها، ورثته عنها ابنتها. ورغم أنه تعطل أكثر من مرة إلا أن حجمه الكبير ووزنه الثقيل جعلا لها قيمة تاريخية ارتبطت بقيمة الأصالة، وربما أيضا بفكرة معقدة عن الأخلاق الحميدة التي أصبح يبثها تسجيل الابنة البارة بأمها للأحاديث الدينية التلفزيونية …إلخ» (۱۹). في «سيرة» الأشياء والأثاث – كما هي سيرة الأفراد – ليست واحدة، لكن النص يؤكد أن «حياة فراش الجدة شوكت هانم هي امتداد الحياة الجدة» (۲۰).
ويمكن أن نعرض مثالا على هيمنة الأشياء، وعلى كيفية عرضها ووصفها النستخلص منه بعد ذلك الأغراض الفنية والفكرية التي يهدف النص إلى تجسيدها، ولنتأمل المقطع الآتي من المشهد الثاني عشر:
«… الفراش والصوان المصنوعان من الأرو الخالص يختلفان عن أثاث الغرفة من حيث الطراز والقيمة، فالفراش من طراز «آرت ديكو» الذي يميز أثاث بدايات القرن بزخارفه الرقيقة، التي تبرز تموجات الخشب والصوان بأضلافه الأربعة المقوسة للخارج، ومقابضه المصنوعة من الكهرمان، يشكلان معا ما يشبه موجة البحر ذات الانحناءات الخطرة، والهدير الذي يصفو ويروق مع انبساطة الفراش المغطى بملاءة لبنية اللون حلياتها من الركامة البيضاء. تحت الفراش حقيبة سفر من الجلد والكرتون تفتحها فتنتشر رائحة النفتالين في الغرفة. بها أوراق صفراء، وصور قديمة حوافها مهترئة، وبقايا أقمشة مطرزة تهلهلت، ونعي وفاة الابن الأكبر المنشور في الأهرام، وخف صيني من القماش مطرز بالخرز الملون على هيئة تنين تحتفظ به الجدة للمناسبات. الحقيبة والفراش لا ينفصلان عن الجدة ويشكلان معها كتلة متناسقة الخطوط والاستدارات. تنتقل من الفراش إلى المقعد الأسيوطي المجاور لباب الشرفة مرتين يوميا وفقا لموقع الشمس من الشرفة بعد الشروق وعند الغروب، وتنتقل من الفراش إلى الحمام مرتين أيضا، ظهرا وقبل النوم. القط من حقه أن يغفو على الفراش، ينام بين ساقيها أو على الوسادة بجوار رأسها . القط وحده من حقه أن يدس وجهه وشواربه في فتحة قميص نومها وأن يتشمم شعرها الرمادي المنفلت من رباط الرأس الأسود» (۲).
إذا تأمل القارئ هذا المقطع – المنتقى بصورة عشوائية – فبإمكانه أن يستخلص أمورا عديدة منها:
- هيمنة الوصف أو الصور الوصفية. • غياب الأحداث، وتلاشي الحركة. • وهاتان السمتان تؤديان إلى تجميد الزمن.
- انزواء الذات الإنسانية مقابل بروز الأشياء والاهتمام بها وبتفاصيلها، بل يمكن القول هنا إن الذات مجرد ظل للأشياء، وفي لحظات بعينها يبدو التماهي بين الذات والأشياء جليا ولاسيما عندما نقرأ في المقطع السابق الحقيبة والفراش لا ينفصلان عن الجدة ويشكلان معها كتلة متناسقة الخطوط والاستدارات». .
- وعلى صعيد التلقي، يمكن القول إن مشاعر القارئ تظل محايدة، فهو لا يستفز ولا يستنفر ولا يكره ولا يحب أو يتعاطف. وربما صاحبه شعور من الضيق بسبب الاسترسال وغياب الحركة والأحداث وعدم إدراكه (للوهلة الأولى / أو في أثناء القراءة الأولى للنص) غائية المادة السردية ودلالة الصورة.
هذه السمات الفنية تنطوي على دلالات جزئية تهدف مجتمعة ومتضافرة إلى تجسيد العلاقة المعقدة بين الإنسان والعالم. فالذوات الإنسانية ليست سوى أصوات وصور وأشياء وأفكار مكررة وظلال متوارثة، وبعبارة أدق فإن العالم ليس سوى صندوق هائل بلا جدران تتحول فيه الذوات – مثلما تتحول الأشياء داخل الصناديق – إلى أطياف أو ظلال أو قطع مرصوصة. وهذا ما أدركته «ميكي» أو ما قالته لانعکاس وجهها في المرأة في أثناء بحثها الدائب عن السؤال «من أنت»؟:
«… سنتحول إلى قطع مرصوصة في صندوق هائل بلا جدران، النصبح ظلالا للأشياء التي تناوبنا رعايتها وحفظها، لن يبقى في ذاكرتنا سوى بعض من تلك الحيوات المختزلة في الأشياء، تلك التي نصبح ونمسي على مرأى منها، تتربص بنا وبما تبقى لنا من قدرة على التذكر. سوف لا ترحل برحيلنا – لا بد من البكاء الآن على موتنا المتوقع – وسوف تظل مفتوحة العينين على القادم خلف ظهورنا، خلف أطيافنا المتعاقبة ستشبه أشياءنا التي تشبهنا، ونكرر أنفسنا بتكرار ظلنا فيها ونتعرف على وجوهنا المنكسرة في انعكاساتها، وسنحافظ على التركة طالما حافظنا على حياتنا…» (۲۴).
هكذا تتجلى أزمة المصير حادة مروعة، وهكذا تبدو الحياة الإنسانية جافة، قاسية، مكررة، مرسومة، فالحاضر لا يبعث إلا على البكاء والحيرة واللامعنى، والمستقبل لا يخبئ سوى الرحيل والموت.
ومع أن عبارات هذا الاقتباس تبدأ بحروف الاستقبال (السين، وسوف) فإن المستقبل يبدو مسدود الأفق. ويبدو لي أن حروف الاستقبال هنا (تتكرر تسع مرات) تحول هذا العرض السردي إلى سرد افتراضي، فهي تؤدي دورا مهما. فالسين وسوف تعبير عن المصير المرسوم سلفا، وهما يوحيان بالحركة المرجأة، أي أن الحركة لم تتحقق، فعبارة «بعد أعوام ستفتح ميكي صندوقا … إلخ» تدل بأن الحدث لم يحدث، ولكنه قد يحدث في المستقبل، وإن حدث فإنه يفقد الكثير من معناه. بعبارة أخرى فإن مقاطع السرد الافتراضي – التي يزخر بها النص – تأتي لتبين أن المستقبل غامض – ومروع – والحاضر خال من الحركة والمعنى – إذ يتحول الفعل المضارع بفعل السين وسوف إلى المستقبل – والماضي يحتل الذاكرة، وكل هذا يؤدي إلى التكرار والسأم واللامعنى، ويفرض وقوع الذات في أسر الحياة النمطية / أسر التكرار! |
التعالي على التكرار
فالتكرار يوحي بالحركة، ويوهم الذات بالفعل، لكنه فعل يرسخ السائد والمستقر المألوف، فالتكرار أشبه بالمراوحة، والمراوحة حركة في المكان لا تتجاوز الزمن ولا تتخطاه. والتكرار يحكم الكل/ الفرد والجماعة، ولهذا يبدو قيدا لا بد من کسره. لهذا تسعي «ميكي» إلى توليد «الحدث»/ الفعل الحقيقي لا المزيف أي الفعل الذي يمكنها من الإجابة عن السؤال المقلق «من أنت؟». ولكن هل تستطيع أن تدعي محو كلمات مثل «كل مرة» و«دائما» وتصريفات الفعل المضارع الذي يسبقه فعل الكينونة وأفعال الاستمرار، ما زال/ ظل، من اللغة التي هي كلمات وتراكيب تتكرر إلى ما لا نهاية؟ هل هناك مرادف لفعل «کرر»؟ أليس ثمة تكرار في فعل الترادف؟ يقول الاعتقاد الشائع إن الصور والأصوات لا تتكرر بل تتشابه، تتداعى، تتردد، تكرر حضورها ولا تكرر تلقيها، بمنطق أننا لا ننزل نفس النهر مرتين ولا نستقبل نفس الصورة مرتين…» (۲۴).
ويخيل للمرء أن «میکی» تبحث عن التحرر المطلق أي التحرر من كل معطى سابق، وهذا يعبر عن أزمة حادة، إذ نقرأ في المشهد الأخير من الرواية أن الفكرة التي تلح عليها زمنا في مواجهة المرأة هي فكرة «الصعود» «ذلك الصعود الذي لا يقابله هبوط، الصعود المطلق بلاغاية ولا منتهى، ليس كصعود المسيح المخلص، ولا كصعود أوزير» إله النيل، ليس كصعود الروح إلى بارئها في الديانات السماوية، ومن قبلها في الديانات الشمسية، بل الصعود الذي لا يعني بالضرورة فعلا إيجابيا – شبيه التمرد على قوانين الجاذبية – ولا يفضي بالضرورة إلى غاية قصوى. مجرد حركة في الفراغ تظنها الماريونيت نتيجة ذبذبة الخيوط وارتعاشها المستمر، ويظنها الفراغ محاولة الاستكشافه والسيطرة عليه، فيضيق تارة ويتسع تارة أخرى وتضطرب علاماته وحدوده» (۲۰). فميكي تتوق إلى الفراغ اللامتناهي ويخيل إليها أنها تصعد بلا هبوط. ولكن إلام تصعد؟ وهل للصعود معنى بلا فعل مضاد له، أي بلا ثبات أو بلا نزول؟
ونسمع همسها في لحظات محددة «سوف أصعد حتى أبلغ الشمس»، متقمصة «دور فرعون الذي تسلق المسلات والأهرامات وصعد إلى الأبد، واعيا تماما باستحالة بلوغه الشمس» (۲۰). ولكن إذا كان صعود فرعون
علامة وصل أكيدة بين الأرض والسماء»، فإن «الصعود المطلق» الذي مارسته «میکی» منذ لحظة غامضة في الطفولة» (0) لا يتغيا شيئا فهي «لا تريد أن تبلغ شيئا محددا في الواقع، لا الشمس ولا غيرها، كل ما تريده هو أن تعيش منطق الصعود من داخله، جزء من ملايين الذرات المتصادمة الدوارة بلا كلل، أن تظل داخل المصعد وخارجه، على قمة البرج وعند قاعدته، ملتصقة بقبة البازيليك حينا، محلقة فوق وجه ميكائيللا حينا آخر…» (۳۷).
ويبدو أن ميکي تمارس منذ الطفولة صعودين «الصعود المطلق الدائم» والصعود اليومي الموازي ذي الحركات الآلية المتكررة، التي لا تكتسب مغزى مباشرا إلا حين تهدأ أو تتوقف تماما عن الحدوث. فهي حركات نمطية/ مكررة أو حركات دائمة منتظمة ضرورية، تشبه القدر» (۲۸) . لكنها وعت منذ زمن أنها لم تعد بحاجة إلى كل تلك الحركات الواصلة الفاصلة بين نقطتين في المكان، وبدت لها غير ذات جدوى، وكأنها تتكرر لا لشيء إلا لغرض التكرار نمطا للحياة» (۲۹). وتراها قد أدركت أن الصعود المطلق مستحيل … «… قالت لصورتها أمام المرأة، إن صعود الماريونيت، المتحرر من محددات الفراغ ومن القياسات الزمنية الجامدة، هو الصعود الوحيد الممكن، فلم تجب الصورة واحتارت المرأة في ما هي فاعلة… من أنت؟ سؤال لا تجيب عنه الدمية. سؤال واحد قاطع يلزمه صعود أبدي هو ذاته اختراق الحدود المرأة، صعود المصدر الصوت الأول، الظل الزمن في الأشياء أو ظل الأشياء في الزمن، لمجمل الحركات الساذجة المتكررة التي تملأ بها فراغ حياتها. جالت الفكرة بخاطر میکي وهي جالسة على بلاط الحمام الرطب وقد أشرفت مراكب الشمس على الاختفاء وراء الأفق، وبدا لها أن الصعود المطلق مستحيل، فلا بد أن ثمة غاية تخيم بظلها على الوجود، لا بد أن بلوغ الغاية يعني الإجابة عن السؤال» (۳۰).
الكتابة / البنية / ظل بلا أصل
ذكرت آنفا أن العالم الروائي في رواية «هليوبوليس» عالم يلفه الغموض والحيرة والشك والبحث عن المطلق، عالم تتحول فيه الذات إلى
ظل للأشياء أو ظل مختزل في الأشياء. ولهذا يخلو من البطولة أو الأبطال، حتى على الصعيد الفني. فالشخصيات مجرد أسماء أو أصوات أو حالات، أو هي رمز للإحباط والخيبة والتفتت التدريجي الذي يحولها إلى ظلال أو أصداء.
وكل ما تقدم محاولة لقراءة النص، قراءة تطمح إلى اكتشاف «نظامه» الخاص، وهو طموح يفرض استخلاص رؤيته الكلية للإنسان والعالم، كما يفرض الخضوع الجزئي لمنطقه الفني الخاص، ومراعاة منطوقه، والاهتمام بالظلال التي تولدها الكتابة، وهي ظلال ترتسم – كما تقدم – في المسافة الفاصلة بين التشكيل اللغوي والمفاصل البنائية وما تولده من معان ودلالات كامنة وراء التراكيب اللغوية، وفي ثنايا الرموز وتلك المفاصل.
لكن المرء لا بد من أن يعترف بأن منطوق النص والدلالات الجزئية الكامنة في ثناياه تتصف بالغموض، كما أن منطقه الفني الخاص يتصف بالجدة . ولهذا وذاك تتعدد القراءات وتتنوع المداخل، لكن هذا التعدد والتنوع لا يمنع المرء من تأكيد حقائق مهمة وهي:
أن رواية «هليوبوليس» كتابة من طراز جديد، إذ تتمرد على البنى السردية التقليدية والحديثة. ولهذا تبدو صادمة للقارئ الذي يتغيا المتعة والتشويق والإثارة. فهي كتابة تهدف إلى دفع القارئ إلى التأمل وإثارة الأسئلة بدلا من إثارة العواطف، وهي لا تتوجه إلى القارئ العادي بل إلى قارئ نموذجي يعي التحولات، التي طرأت على نظرية الرواية والأدب عامة، ويهتم – تبعا لذلك – بدلالات التشكيل والفلسفة الخاصة التي تستند إليها البنية السردية. واللافت أن رواية «هليوبوليس» تدون اعتراضها على التقاليد الجمالية الروائية المألوفة التي تعتمد مقولات التتابع والترابط والوحدة والنمو العضوي وإثارة العواطف، إذ نقرأ في بداية المشهد الثاني من الرواية:
«… ترفع يدا أفقية على إصبع رأسية بمعنى نقطة نظام»:
بدايات الحكي التقليدية لا تصلح لإثارة الدهشة، والبدايات السنتمنتالية لم تعد تثير التعاطف، فإذا كانت كل البدايات ممكنة ومتعذرة في الوقت نفسه على إنتاج المتعة المفترضة، فإن القفز بين الأحداث من دون قيد يبدو ملائما بل ومرادفا الحركة «میکی» کماريونيت الكلام. ثمة جديد دائما في القصة التي تكتبها وهي تحكيها للمرأة أو تحكيها المرأة بنية كتابتها (اقتصادية، مريحة للأعصاب، محكمة الصنع، يمكن تخزينها في كل الأجواء . صفحات خاصة للأطفال ولسيدات المنازل، وصفات للطهو، مغامرات عاطفية شائقة. اقتنيها الآن وزيني بها مكتبتك!) قالت «میکی» لنفسها: «لا يليق الحكي أن يكون هكذا» (۳۱).
* * *
ويبقى أن نص «هليوبوليس» نص جديد بمادته وموضوعه وأسلوبه وهدفه . وهو نص يتغيا أن يسهم في خلخلة الوعي الجمالي السائد، وتأسيس وعي جمالي جديد ينطوي على مفهوم خاص للكتابة الروائية، يرى أن الكتابة التي تستحق هذه التسمية هي الكتابة التي تثير الدهشة – لا المتعة، والتساؤلات – لا العواطف، والتأمل – لا الانفعال، والصدمة – لا الاجترار. ولن يتحقق لها كل هذا إلا إذا تمردت بصورة دائمة على المألوف والراهن والنمطي، وتحولت بمجملها إلى ظل طليق بلا أصل.