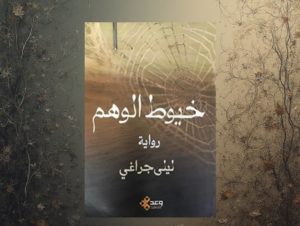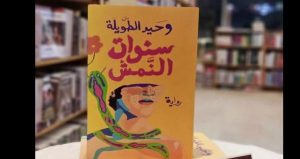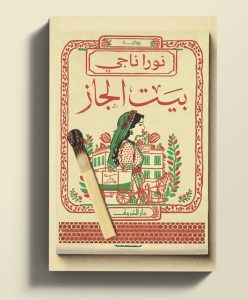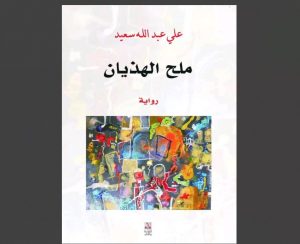د.أيمن تعيلب
في ديوان سمير درويش “يوميات قائد الاوركسترا” سوف أنطلق من منهجية جمالية تجريبية بمعنى أنها ستكون منهجية جمالية قبل معرفية وقبل منهجية معًا، أو قل سوف يكون منطلقي الجمالي إحلالًا لمنطق الوجود محل منطق الثقافة، ولمنطق قوة التعدد محل منطق تفرد الوحدة، ومنطق الحركة محل منطق الثبات، ومنطق جماليات العبور والنشاط والوفرة والهجرة الجمالية والمعرفية اللامتناهية محل منطق التطابق والهوية والانسجام، بعد أن تغيرت مفاهيم اللغة والوعي والتذكر والتوقع والهوية والواقع تغييرات نوعية في فلسفة الجمال المعاصرة، وفي النهاية سوف نحل منطق كتابة الحضور اللحظي بوصفه نسيانًا متكررًا ومتحولًا أبدًا عبر كثافة الزمن المعقد محل منطق الذاكرة الشعرية، ومنطق التراكم والتحصيل الجمالي الفقير الذي شاع في الشعريات العربية المعاصرة شيوعًا مملًا مضجرًا، وفى النهاية أريد أن أقرر بأننا لن نتمكن من رؤية الشعريات العربية التجريبية الوليدة في غياب فلسفة جمالية رصينة للزمان العربي المعاصر، أقصد فلسفة زمنية اللحظة الجمالية الفاعلة حقًّا، فلسفة تترك عقلها المعرفي، وذوقها الجمالي، وجهازها النقدي برمته لفلسفة الجمال المحايثة في ذاتها ولذاتها للزمان والوجود وهما أكثر أصالة وصدقًا ونزاهة من أي تصورات معرفية منهجية قبلية سابقة على محايثة الوجود الجمالي في ذاته، وبالتالي خلجات الجمال والمعرفة والتخييل التي تعتمل في حناياه وطواياه الخفية والمعلنة والمشرفة، ولن نستطيع ضبط الحدود الجمالية والمعرفية التعددية التداخلية بين أشكال الفنون في غيبة العقل النظري العربي الأصيل في تصور الراهنية الزمنية المحايثة للوجود في ذاته ولذاته، فلا يمكن تصور مفهوم الهوية والذات والثقافة والواقع والتاريخ واللغة برمتها والشكل المعبر عنها في غيبة تصور زمني لحركية الوعي الجمالي في استيعاب أشكال الوجود، فثمة علاقات وثقى بين تصور مفاهيم الشعرية وأشكال الفن وتصور مفاهيم الزمان، فقد تكون الشعرية تراتبًا زمنيًّا شكليًّا سببيًّا كلاسيكيًّا يتجسم في هيئة الواقع والزمان والوجود، وقد تنهدم قليلًا التراتبية السببية الرتيبة لحركة الزمان الكلاسيكي الأبدي والمجرد، فندخل في زمنية ذاتية تضع الزمن الفلكي الدوار في مقابل الزمن النفسي الخاص فتتولد الشعريات الرومانسية التي تحيل الزمن الفيزيقي إلى زمنية التخييل الميتافيزيقي، فيتسع الحد الجمالي والمعرفي قليلًا لشكل الشعر هوية ووظيفة ليعبر عن الذات الشعرية صاحبة الزمن الروحي والنسبي لتتزاوج الروحية التخييلية مع الديمومة الزمنية والسيلان الزمني الداخلي، مما يقلل من رتابة السببية الكلاسيكية العقلانية المجردة، ويعمق من لهاب التخييل الذاتي الذي يجعل من الزمنية الرومانسية انغلالًا تخييليًّا رأسيًّا في زمنية الحاضر الخاص في مواجهة الماضي المنقضي، وعتامة الزمن المستقبلي المجهول، لذا حبب للرومانسيين شكل الليل والصمت والموت حيث انطلاق الذات الشعرية من حدود المكان والزمان في ظلمة بهيمية لامتناهية قادرة على محو الحدود الفاصلة بين التعقل والتخييل ليصير التخييل نفسه صورة من صور تعقل الواقع والوجود، ويصبح زمن التشكيل الزماني للنص الرومانسي زمنًا ذاتيًّا تعبيريًّا تخييليًّا تنتفى فيه السببية التعاقبية للموضوعية الكلاسيكية، لتحل بدلًا منها سببية ذاتية داخلية للزمن، ثم تأتى الزمنية الواقعية لدى شعراء التفعيلة بكافة أشكالها الجمالية والمعرفية، لتقرن التصور السببي الخارجي لزمنية التشكيل الكلاسيكي إلى جوار التصور الزمني الذاتي التخييلي الداخلي للرومانسية لتضع هذا الفاصل التشكيلي الحاسم بين زمنية الواقع وزمنية التشكيل الجمالي الخاص للواقع في صيغة جمالية موضوعية تبنيها جدليات تشكيلية بنيوية جدلية تعددية داخلية وخارجية معًا وفى آن واحد، وهنا تنتفي العلاقات التراتبية التعاقبية الكلاسيكية والعلاقات النفسية الداخلية الرومانسية بين الدال والمدلول في التشكيل الشعري التفعيلي لتحل محلها علاقات جمالية موضوعية جدلية، ينفصل فيها الفنان الرومانسي الذي يعانى عن القصية التي تتخلق موضوعيًّا في ذاتها بعيدًا عنه فيستقطب فيها الدال المدلول في أعماقه التشكيلية الزمانية الجدلية ليعيد تشكيل زمنيته الجمالية المستقلة والمناوئة للواقع والذات والتاريخ، ليقع التشكيل الجمالي على الدال في ذاته ولذاته، حيث ينفصل الفنان الذي يخلق عن الفن الذي يستقل، في موازاة تشكيلية جدلية مع الأنساق السياسية والاجتماعية والثقافية التي تحدد مفاهيم الواقع والذات والتاريخ والزمن والثقافة والحضارة عبر بنية ترميزية عامة تكون شروط الحقيقة، وحدود حركة الذات تجاهها، وعند هذا الحد النقدي من تصور الشعريات العربية المعاصرة دخلت الشعريات العربية محاق الأزمة المعرفية والجمالية في تصور مفهوم الزمن في الواقع العربي المعاصر، وتوقف التخييل العربي عن تصور الفاعلية الكثيفة للزمن المعاصر وسلم بالذاكرة الزمنية العربية العامة في تصور أفكار تجريدية كبرى تسوق وتبنى أشكال الواقع، والذات، الثقافة، والاجتماع، والتاريخ، والسياسة، والحضارة برمتها، في صورة من صور الاحتواء الثقافي الترميزي العام الذي هو فيما تتصور قصيدة النثر دمار ثقافي عام، وفي هذا المحك -لا غيره فيما نرى- تقع الأهمية التشكيلية والمعرفية والثقافية البالغة لقصيدة النثر -بصرف النظر عن تسليمنا من عدمه للمصطلح فلا مفر من التسليم بنوعية هذا الجنس النوعي الجمالي الجديد- لتضع تصورًا مغايرًا حقًّا للزمنية العربية المعاصرة، حيث تؤسس وعيًا ولا وعيًا ثقافيًّا عربيًّا جديدًا للخيال والإيقاع والتركيب والبناء تناوئ بها جميعًا ذاكرة التجريد الجمالي والواقعي والسياسي المتسلط، وتكتب النسيان بوصفه حضورًا عربيًّا ممنوعًا، أو قل تكتب الحضور اللحظي الظلي بوصفه نسيانًا متكررًا ومتحولًا أبدًا عبر كثافة زمنية معقدة من التفكيك والتشظي والتوازي والتضاد والتنافر وتأسيس تشكيلات القبح والرعب والتهويمات المجازية الظلية، والاسترسال الحر للتخييل القائم على المفارقة والغرائبية المادية النابعة من رحم الوجود لا رحم الثقافة، وتكسير بل تفتيت الزمن وتجميده ونفيه بما ينفى جلجلة الإيقاع، ويستدعى الخفوت الإيقاعي المنسي للروح الوحيدة والواقع الغائب، والثقافة المكبوحة، والوعي الدفين تحت طبقات اللاوعي الثقافي المؤسسي العام، لا الوعي النفسي بالمعنى الفرويدي الغليظ، وهو الموازي لوعى ولا وعى السلطة الرمزية العامة، فقصيدة النثر إذ تؤسس لخيال المحو الذي يكتب النسيان بوصفه حضورًا مؤجلًا في الواقع المادي اليومي، تناوئ مجازات الصحو في الأشكال الجمالية العربية المتوارثة والسائدة، فقصيدة النثر تحدث هذه الثغرة المعرفية والتخييلية بين جسد الأنساق الثقافية الجمالية الأيديولوجية العامة والتي تمثل وعى ولا وعى الثقافة معًا، وبين ما نتصوره (وعيًا ولاوعيًا جماليًّا ظليًّا) مقصيًّا في جسد الثقافة نفسها، ومن هنا يرتكب رافضو قصيدة النثر مغالطة معرفية ومنهجية خطيرة عندما يتهمون هذا الجنس النوعي الجديد بالقطيعة المطلقة للتراث الجمالي الإيقاعي والمجازى العربي السابق عليها، ففي الحقيقة لم ينتبه معظم هؤلاء النقاد -سواء الموالين للقصيدة أو المنشقين عليها وكليهما يتحركان بحس الأزمة والرفض المطلق لاحس التعدد والاختلاف- أقول لم يستطع هؤلاء النقاد جميعًا التفريق العلمي والجمالي والمنهجي الرصين بين جسد البناء الثقافي الجمالي بوصفه وعيًا للأشكال الجمالية السائدة، وبينه بوصفه لاوعيًا كامنًا للأشكال الجمالية الممكنة والمحتملة، وهنا وفى هذا المفترق الجمالي الحرج والمعقد، تقع قصيدة النثر لتلتقط أشكال التقطعات والثغرات والفجوات الكامنة في جسد الوعي الثقافي الجمالي العام، وكأن قصيدة النثر تكتب هنا اللاوعي الجمالي والإيقاعي والسياسي والثقافي اللامرئي للذات والواقع والحضارة العربية الغائبة والمجهولة والصامتة، حيث لا يتتابع الزمان ولا يتراكم بل يتكسر وينبهم ويتكسر معه الإيقاع المنتظم المجلجل والزائف الذي يحرق هذه المسافات التخييلية والروحية والمعرفية (اللازمنية واللاموضوعية معًا) والتي تترسب في القيعان السحيقة الغائبة في الذات والواقع، وتحاول السلطة الشعرية واللغوية والنقدية والسياسية إدخالها عنوة وقسرًا واختزالًا في النسق الإيقاعي والثقافي الموضوعي العام، لكن قصيدة النثر العربية في مصر تعي لحظتها الزمنية الراهنة جيدًا حيث لا شيء يكتب انكسار الروح غير انكسارها نفسه، ولا لغة قادرة على احتواء الكثافة اللازمنية الباهظة التي تثقل الخيال والذات والشعر والواقع العربي غير مجاز البياض الوجودي، ومجازات الصمت والعراء، أو قل (مجازات الظلال العابرة) التي لا تستكين لشمس السلطة الدلالية الكلية الصاخبة والمشعة في كل اتجاه والماحية لثقوب الروح وأوجاع الوطن، ومغيبات الثقافة، وصوامت التخييل، ولا وعى الروح، حيث تختزل السلطات العامة -السياسية والجمالية معًا- الأزمنة والتواريخ والأمكنة العربية لترمى بها جميعًا في غياهب المنطق، وهيمنات التيه، وتسلطات السحق، ومتاهات تنظيمات القمع، وبهذه المثابة الجمالية التجريبية الجديدة لا يمثل الجهاز الثقافي الجمالي برمته الوجود الجمالي في ذاته، أو قل لا يساوى العلم بالشعر الشعر نفسه، ذلك المخلوق الأخطبوطى العصي على التأطير والذي يثوى هناك في الصمت والغياب والمجهول واللامرئي عبر ديمومات زمنية كلية تعددية تداخلية بين حاضر الماضي وحاضر الحاضر وحاضر المستقبل، حيث تغدو خاصية الانفصال الجمالي نابعة من داخل خاصية الاتصال الجمالي نفسه، فلا يكون الانفصال فجوة بين متصلي الحاضر والماضي بل يغدو فجوات ضمن متصل الحاضر الذي لا يحضر أبدًا بما يفكك فكرة الحضور الزمني الجمالي والمعرفي، بما هو كثافة وجودية خصيبة تتداعى للمعرفي والمنهجي والتجريبي والاستشرافي والمستحيل في وقت واحد، وربما يدفعنا هذا إلى تأسيس (مجازات الظل) في قصيدة النثر، ومجازات الظلال هنا تعيدنا إلى تكوثر دلالات الوجود الفعلي والحلمي والتجريبي، فإذا كانت الشمس الجمالية والمعرفية تنسخ الأشياء والأحياء والموجودات بظلها، لأن الظل كما يقول لسان العرب “الظل في الحقيقة إنما هو ضوء شعاع الشمس دون الشعاع” وبهذا المعنى فإن وجود الأشياء لا يمحى بالظل بل يتكاثر ويتغير ويتحول ويتكوثر، إن الوجود يظل مشعًّا وغامضًا في مجازات الظل، فلا يمكن أن يوجد بصورة محددة، ولا يمكن أن يتلاشى بصورة مطلقة، إنه الوجود الاستعاري على سبيل الحقيقة لا المجاز، يقول ابن عربي (بالظلالات عمرت الأماكن)، فمجاز الظلال يحول الأحلام إلى واقع فعلي طافر باتجاه المستحيل كما يحول الواقع الفعلي إلى إمكان واقعي ضمن ممكنات واقعية أخرى كثيرة “فالظل شخص الكلمة، إذ هو قوامها الذي به تكون، ومستورها الذي يحمل وحي معانيها، ولونها الذي تعرف به”، وهذا ما يوجزه تعريف الظل في المعجم العربي “الظل من كل شيء شخصه وكنهه، ومن النهار لونه إذا غلبته الشمس، هكذا يمكننا أن نعرف ظل المعنى، بأنه عمران الكلمة، وموضع سكنها المتجدد، والمسافة المتناسخة بين طلوع معنى وزوال معنى، وهو ما تعلم به الكلمات في خفاء، وتلقي به إلينا وتكتبه فينا، وتموت الكلمة متى ضحا ظلها” و”تموت الكلمة وتفقد قدرتها على الحياة والإنسان إذا ضحا ظلها، أي إذا صارت شمسًا، لا تخفى لتعلم، ولا تستر لتكشف، ولا تومئ فتلقى، ولا تضمر فتستفهم ولا تتعدد ظلالها فتعمر”(1). ووفقًا لهذا التصور لمجازات الظل لا بد أن يحدث تفكيك كلي للمفاهيم والأنساق والتصورات والمناهج النقدية، وكافة صور العلاقات الثقافية المحيطة بنا، والتى تدشن وعينا ولاوعينا فى النظر للوجود والثقافة والنصوص، فإذا كانت شمس البنية الرمزية العامة المحيطة بنا قد أسست ورسخت طبيعة الأشياء من حولنا، وجعلت من حضور الذات والمعنى والقصد والهوية والماهية والتاريخ والانفصال بين مفهوم الخارج والداخل وترسيخ مفهوم الحد العلمي الصارم ـ جعلت من كل هذا الحضور المعرفي والجمالي حضورًا كليًّا ملزمًا للتفكير وللمناهج وطرائق الوعي، فإن مجازات الظل تعيد تأسيس الهامش ليس بوصفه مضادًا للمركز بل بوصفه بنية اختلاف تبنى نفسها داخل المركز الجمالي ذاته بما يجعل المركز ضد ذاته باستمرار، وأتصور أن البلاغات والشعريات التجريبية الوليدة في خطاباتنا الجمالية المعاصرة والمستقبلية سوف تنحاز لبلاغة الهامش ومجازات الظل، ولنا أن نتساءل هنا فنقول: هل من الممكن أن نبحث لما يسمى بقصيدة النثر عن مسمى جمالي ومعرفي خاص بها بعيدًا عن فكرة الهيمنة الشعرية، أو الذاكرة الشعرية المدمرة للمصطلح، أو بعيدًا عن الحصار التصنيفي الشعري الذي يؤطر وعينا ولاوعينا الجمالي فى رؤية الوجود والواقع والجمال والثقافة برمتها؟! وهنا تعلن قصيدة النثر العربية في مصر عبر هذه الجماليات التجريبية الخصيبة غياب منطق العلية الزمنية السببية والتداخلية والجدلية للنص كما عهدناها فى النص العمودي والتفعيلي، بل ينتفي فيها -من وجهة نظرنا- مبدأ النمو العضوي بالمعنى الفرنسي كما ترجمه أدونيس والخال والحاج وشاؤول ومن جاء بعدهم من نقاد قصيدة النثر(2)، فتعلن قصيدة النثر العربية سقوط قانون الإيهام بالواقع بكل صور الفهم والربط والتفسير والوعي، وتعلى من منطق التفكيك والارتباك والفوضى فثمة انعدام وصمت وخفوت في كل شيء، وثمة اهتزاز مزلزل للمنظومات القيمية والجمالية والمعرفية، وانهيار عربي عام للثوابت الأيديولوجية، ومحو تام للأبنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العربية، والتي تدشنت طويلًا تحت مسميات ديمقراطية وهمية رأينا بعيوننا لا بخيالنا زلازلها السياسية العربية المدمرة في الحرب الأخيرة على العراق وغزة، وكأن قدر الإنسان العربي أن يكون مجرد شاهد ظل عابر على مراسم دفنه ونبذه، بعد أن انزوى -هذا الإنسان- وتلاشت قدرته على الوعي والفعل والتفسير والفهم معًا، وتحول إلى هامش وجود زائد عن الحاجة في نظر السلطات العربية والغربية المعاصرة: أقصد سلطة اللغة والنقد والنظرية والدولة والمؤسسات السلطوية العامة، ومن هنا -هنا بالمعنى الزمني الباهظ بالضبط- تنبع جماليات تجريبية جديدة في قصيدة النثر العربية في مصر والوطن العربي كله، جماليات للرعب والفوضى والتشذر والغموض والشك واللايقين واللاتحدد والفوضى والمنطق الجمالي البيني الغائم واللامرئي لتقرأ المساحات الظلية، والفجوات المعرفية، والثغرات التشكيلية الغائبة في لاوعى الواقع والثقافة والذات العربية المعاصرة، فتعلي من منطق انبناء الغموض ضد منطق رسوخ البداهة وتسيد الوضوح، ومن ذاكرة الظل الجمالي العابر والدفين ضد منطق أنساق السطوع الحارق للسلطة الثقافية والترميزية العامة المجلجة، ومن منطق البطولة الشخصية المجروحة المغلوبة على أمرها في نظر السلطة ضد منطق البطولات التاريخية الخدَّاعة التي تشبه بسلطة الرمز على الواقع المباشر وتلبس عليه، نافية واقعيته الحسية اليومية الحية لصالح قهرها الجمالي والمعرفي العام، وكأن السلطة تعيد تدوير إيقاعات النفس العربية الخفية المحايثة لوجودها المباشر لصالح إيقاع رسمي عام هو إيقاع سلطة الثقافة والنقد والنظرية والشعر الشفاهي الصاخب المجلجل، حيث تقترح قصيدة النثر اللعب الحر للخيال لتكتب مجاز (العراء الوجودى) في مقابل مجاز (الاحتواء الثقافي والسياسي والجمالي الرسمي)، وتؤسس (مجاز المحو الدلالى) أو قل هي (تبنى مجازات للمحو) ضد (مجاز الصحو الثقافي السلطوي العام)، فتمارس قصيدة النثر هذا اللعب الحر لأشكال الكتابة ضد أنساق الثقافة لا لتمحو المستقرات والثوابت السياسية والاجتماعية والحضارية والجمالية -كما يتهمها أعداؤها دومًا من أجهزة الثقافة الرسمية نظرًا لضآلة رأسمالهم الجمالي والمعرفي تجاه ما يحدث في الوطن- ولكن لتزحزحها عن إفكها الجمالي التجريدي، وتلفيقها التشكيلي المؤدلج للخيال والروح والواقع والتاريخ، فهي تبادر بطرح الأسئلة الحسية الحية للذات الهامشية بوصفها مولدة للتباين والاختلاف لا بوصفها هامشية منزوية هشة، فالهامش هنا لا يقف هزيلًا ضد المركز المتسلط كما شاع وهمًا حتى لدى أنصار قصيدة النثر، بل يقف التخييل الهامشي قوة جمالية ومعرفية تقويضية رصينة داخل جسدية المركز نفسه ضد مبدأ ثبات الهوية والوعي والذاكرة واللغة حتى لا تدخرها السلطة السياسية العامة داخل ادخار اقتصادي رمزي ضيق، فتصير قصيدة النثر المتهمة بتقويض الهوية دوما هي القادرة حقًّا على استعادة هذه الهوية وكأنها غفران روح يوسف في مقابل ذئبية ثقافة إخوته، تستعيد قصيدة النثر -عبر مجازات العراء والمحو والبياض وإيقاعات الخفوت الباني الأصيل- هوية الواقع العربي التي كلستها مجردات السلطات الجمالية والثقافية العامة، إن خيال الهامش هو خيال الاختلاف، (خيال الأرازل) -لا نراك اتبعك إلا الأرازل- الذين يتبعون النبوات التخييلية الصادقة غير المرئية لعيون السلطات العامة، وعندما توسع قصيدة النثر من مفهوم الراهنية الزمنية بما ينفى السببية التراتبية بكافة أشكالها -الواقعية والجدلية والبنيوية- بين الدال والمدلول، وبما ينفى مجاز التجسيد التجريدي المطلق للواقع والثقافة، وبما ينفى التدشين التربوي السياسي للذائقة العامة الاستهلاكية، عندئذ تكتب قصيدة النثر شعرية الذات العربية المعاصرة حقًّا، مستبدلة شروط واقعية الواقع بشروط واقعية الكتابة، وشروط تجسيدية المجرد العربي المطلق لصالح شروط لامتناهى التخييل العربي الممكن في كتابة الصمت والنسيان والعبور، وهدم قانون التكريس الجمالي العام والارتهان التسلطي لفكرة النموذج التفعيلي الواحد الذي ينمو ويتكاثر وهميًّا وخداعًا عبر تنويعات تشكيلية كثيرة، لكن داخل أطره الجمالية المجردة لا خارجها على الإطلاق، أشبه بالركض في مكان مغلق، أو امتطاء فرس من خشب، حيث تتغلب الحتمية الأدبية بالمعنى البيولوجي داخل النوع التفعيلي التشكيلي الواحد فلا ينمو الجنس الجمالي بالتراحب والتعدد في الهواء الوجودي الطلق، بل ينمو نموًّا سرطانيًّا غير معافى داخل حدوده الجمالية المعهودة والتي تحرسها السلطات الملكية العامة للنقاد والشعراء الرسميين الكبار، يبدو أن الشعر العربي لا يتخلى بسهولة عن دور التكسب بالشعر والثقافة، والاستغراق الذاتى المتضخم في جماليات المديح وإشاعة فكرة الذكورة السلطوية البطراركية العربية، حيث إنشائية اللغة لا تخلق الوجود، والتجديد بتهزيج الكلم والإيقاع لا التحديث بكتابة الوعي، فلا تستمد قيمة الوجود من فحواه في ذاته بل تستمد من فكر الحواشي والمتون أي من طرق تحصيل الوجود لا من الوجود في ذاته، من طرق تحصيل النظريات والأفكار والأنساق لا من قدرة الإصاخة لقوة الواقع اللامرئى الدفين، لقد انشغل معظم نقادنا ومبدعينا بقوة الثقافة لا قوة الوجود، وأحسنوا الظن بالأفكار لا بالواقع، وأقاموا سدودًا كثافًا بين الواقع ونفسه، والزمن وحركيته الباذخة الكثيفة، حتى لتعجب كل العجب لهؤلاء النقاد والشعراء الشيوخ في مصر الذين يحيون زمنية ديكارتية ونيوتنية بالمعنى الفلسفي الصلب للزمنية المادية المتصلبة لنيوتن ولقوة فلسفة الوضوح والبداهة الديكارتية، ويظنون أنهم ما زالوا قادرين على ضخ الشباب الجمالي والتشكيلي، كيف وقوة أنساق الثقافة، ورتابة النظريات المجردات، هي التي تصنع خيالهم وشعرهم، بعيدًا عن راهنية اللحظة الجمالية المعاصرة؟! بعد أن تغيرت فلسفات العلم وتصورات المناهج، وبعد أن تم إعادة النظر المعرفي والمنهجي والفلسفي والمنطقي في كل شيء الآن، بما يجعل ثقافة العلم المعاصرة ثقافة الأسئلة تلو الأسئلة، وليس ثقافة الاستفسار والتوريث، بما يخرج العلم نفسه من الاستنساخ والتكرار، إلى التقحم المستقبلي الافتراضي، فلم تعد القضية في العلم المعاصر قضية المنهج بل قضية سياسة المنهج، ولم يعد العلم المعاصر مشغولًا بتدشين الحقيقة المجردة المطلقة بل مشغولًا بالخطابات الثقافية والسياسية التي تصنع الحقيقة، فلم تعد الحقيقة حججًا تراثية أو حتى معاصرة بل صارت (ما يتولد عن الخطابات من مفعولات الحقيقة، ولم يعد تعيين النموذج هو الذي يصنع الحقائق بل نحن ننشد اقتصادًا سياسيًّا لها للوقوف على الكيفية التي يدبر بها أمر الحقيقة في المجتمع، ولم يعد هناك تقابل بين العقل والخيال بعد أن صار الخيالي خاضعًا لمنطق لا يقل إحكامًا عن منطق العقل التقليدى، وربما كان هذا أهم ما أثبتته دراسات السيميولوجيا في شتى المجالات، تلك الدراسات التي حاولت رصد (منطق الخيالي) معيدة الاعتبار للميتوس إلى جانب اللوغوس(3).
ومنذ اللحظة الشعرية الأولى لديوان سمير درويش والمتمثلة في عنوانه يدخل بنا الديوان لحظة “عتبة النص” صوب هذه المنهجية الجمالية التجريبية التي ترى إلى الشعرية بوصفها إمكانًا متجددًا، لا إنجازًا جماليًّا متحققًا ومنتهيًا، كما ترى إلى اللحظة الجمالية بوصفها حضورًا تخييليًّا ينفي ذاته في ذات لحظة إثباته، فالكتابة في هذا الديون تتشكل بالمحو كما تتشكل بالإثبات، أو قل الإرجاء الجمالي والمعرفي المستمر لهذا الإثبات الذي لا يثبت أبدًا، وكأننا بصدد كتابة مجازات الظل العابر، هذا الإمكان التخييلي والمعرفي التعددي المفتوح دومًا على الإمكان والمحتمل والتجريبي، فسمير درويش في هذا الديوان شاعر جوال ينقل الشعر من حد الشفاهية الصاخبة المجلجلة إلى حد الكتابية الظلية الجوالة في رحم الثغرات والفجوات والصوامت المغيبات في علاقات اليومي العابر، المتناهي في الألفة والبساطة، والتعقيد والغرابة معًا، فالنص هنا يتناوب بين التحقق النصي التشكيلي، والتجريد الجمالي الميتافيزيقي في لحظة واحدة، ولا أقول لحظتين متتاليتين، لأن بنية النص تتجاوز المسار الجمالي الخطي السببي صوب المسار الجمالي التزامني التعدي البنتوي -أقصد صفة التركيب لا صفة المنهج البنيوي- ومن هنا كان الشاعر موفقًا حقًّا عندما تقصد هذا العنوان (يوميات قائد الأركسترا) فالنص هنا مثله مثل الطلاقة الموسيقية لا يمكن إدراك الدلالة فيه دفعة واحدة على مستوى التلقي، ولا يمكن بناؤه دفعة واحدة بصورة خطية تعاقبية على مستوى نصوصية البنيوية الداخلية. بل تقع شعريته كما بينا آنفًا في جماليات قصيدة النثر -أو قل هذا الجنس الجمالي النوعي الجديد- على الثغرات الخيالية والمعرفية الواقعة بين التحقق النصي الشكلي، والتجريد الجمالي الميتافيزيقي، ألم أقل إن شعرية هذا النص تقع في شكل الحركة لا تعضون الثبات، وفي حضور الظل، لا حاضر الشكل. يقول الشاعر في نصه “8 سبتمبر 2001”:
“لا أجدُ مترًا مربَّعًا..
مترًا مربعًا فقطْ..
أريحُ جسدِيَ القلقَ فوقَهُ.
أربعُونَ سنةً مرَّتْ..
وسنةً..
ولمْ أستطِعْ أنْ أجعلَ رأسِيَ
يتعامدُ على رقبتِي
مرةً واحدةْ!” الديوان، ص84.
وفى هذا التوتر المستمر، والمفارقات اللاهثة بين الكائن وصورته، أو بين الوجود والوعي هو ما يخلق شعرية الفجوة بين أن نكون في العالم كما هو، وبين تفلت العالم منا دومًا، بين أن نلتصق بجسد اليومي والعادي الذي يكون كثافة الحياة وبين أن نلتصق باللغة والرمز والأيديولوجيا التي تلبس علينا الحياة، وتفصلنا عنها ونحن غارقون في أعماقها، ومن ثمة لن يتعامد جسد الشعر والشاعر على جسد الحياة ولو مرة واحدة، وسيكون هناك هذا الوعي الحاد بالغياب والصمت والنفي والعدم، فالشيء الفريد بالنسبة للوعي الشعري هنا هو تحديد إدراك الغياب بوصفه وجودًا ممكنًا، أو إمكانًا شعريًّا مفتوحًا على الحضور الذي لا يحضر أبدًا، “إن مفهوم اللاهوية المؤقتة وإمكانية وجود مظاهر غير التي أراها الآن هو ما يؤدي إلى المعنى المطلوب لوجود آخر، ويتميز الموضوع عن الوعي بغيابه لا بحضوره وبعدمه لا بكثرته، إن القول بأن الوعي هو وعي بشيء ما يعني أن على هذا الوعي أن يقدم نفسه في كائن ظاهر يكشف عنه رغم أنه ليس هو، ولا يعلن عن نفسه إلا بصفته كان قائمًا من قبل، عندما يكشف الوعي عنه”(3).
وهذا الإعدام الدلالي والجمالي المستمر بين الوعي الشعري بوصفه لغة، والوعي الوجودي الظاهراتي اليومي بوصفه تعينًا ماديًّا كثيفًا، هو ما يفتح باب الشعر على الحضور الذي لا يحضر أبدًا، ويفتح باب الاحتمال بوصفه واقعًا ممكنًا كمينًا، بعد أن تغلل الواقع من حولنا في أنظمة فكرية وسياسية واجتماعية محددة وصارمة تغلق تعدده، وتسد أفقه، وتؤطر حدوده التشكيلية اللانهائية، ومن ثمة يأتي الشعر ليكشف لنا صبغية الواقع وليس واقعيته، ووهمية خلق واقع رمزي فائق يكون أكثر واقعية من الواقع نفسه، وانظر معي كيف تتوالى الألوان تلو الألوان لتمحو لون العالم والواقع نفسه، يقول الشاعر في نص “10 يناير 2001”:
“ذُو الثيابِ الرماديَّةِ
الذي ينظِّفُ سيارةً حمراءَ
أمامَ برجٍ سكنيٍّ أبيضَ؛
ينظرُ خِلسةً للفتاةِ الواقفةِ أمامَ محلٍّ مقابلٍ
مدهونةٌ واجهتُهُ بالبرتقاليِّ
-يبيعُ أشرطةَ “فيديُو”-
تلبسُ بنطلونًا أمريكيًّا أزرقَ
ونظارةً سوداءَ كاشفةً”.
الديوان، ص11.
وهنا تكمن مفارقة الشعر عندما تشكل نقاط التيه والعمى مناظير للكشف والبصيرة. ويصير المتناهي في الألفة والحميمية والجسدانية موغلًا في البعد والغرابة والنسيان. يقول الشاعر في عيد ميلاده، نص “7 يناير 2001”:
“أمُّ طفليَّ لم تقلْ لي: “كلُّ سنةٍ وأنتَ طيِّب”
انتهتْ من إعدادِ الطعامِ ثم استلقتْ
تتابعُ المسلسلاتِ التليفزيونيةِ.
زُملائِي في العملِ، كذلكَ
لم يقولُوا لي: كلُّ سنةٍ وأنتَ طيِّب
..
الشمسُ التي انتبهتْ من غفوتِهَا..
..
حتى صمتُكِ الحادُّ
لم يقطعْ خواءَ الأصواتِ المتداخلةِ،
في يومِ ميلادي هذا”.
الديوان، ص9.
لقد كان الشاعر ذكيًّا أو قل كان الشعر ذكيًّا عندما وضع تواريخ نصوصه على رأس كل نص، مفرقًا بين جسد النص وجسد التاريخ، وكأنه يمحو اللحظة التاريخية والجمالية والخيالية الغليظة بين رغبة التاريخ والفكر والمنهج في الاحتواء، ورغبة المجاز في الإخلاء، لأننا نتصور أن قصيدة النثر تكتب مجازات الإخلاء في مواجهة مجازات الاحتواء التي تكتبها القصيدة التفعيلية، فالتاريخ يثبت السائد والعام والمألوف والمهيمن، بينما النص إذ ينكتب في تاريخه، يفر منه هذا التاريخ، فبمجرد أن تكره الواقع والحالة والحادثة على الدخول ضمن أنساق الرموز واللغة والتواريخ تصير محوًا لذاتها، ونسيانًا للصمت والصوت واللغات كلها خواءات اجتماعية عامة تبعدنا حقًّا عن ملامسة مسام ذواتنا البعيدة، ويومنا العابر المنفلت بعيدًا عن كل تنظيم واعتياد وإلف، وإن وعينا بالعابر والمنفلت هو ما يجعل من الوعي الشعري حالة جمالية مؤجلة دومًا في هذه النصوص، التي تحاول الإمساك باليومي العابر، ولعلنا لو تذكرنا هنا الصفحة الأولى من رواية “الغثيان” لسارتر، وتصويره لأزمة كاتب اليوميات، لعرفنا مدى الكد الجمالي، والرهق التصويري في الإمساك بلحظة الحضور المتأبية على الإمساك دومًا، يقول بطل الرواية “أنطوان روكونتان” (سيكون من الأفضل أن أسجل كل ما يحدث من يوم لآخر، وأن أحتفظ بيوميات لكي أفهم، وأن لا أهمل التفاصيل الصغيرة حتى وإن بدت غير مهمة، ولا بد فوق كل هذا أن أقوم بتصنيف هذه الأشياء، لا بد أن أقول كيف أرى هذه الطاولة والشارع والناس وعلبة سجائري، لأن هذه هي الأشياء التي تغيرت، ولا بد أن أحدد درجة وطبيعة هذا التغير، على سبيل المثال علبة كرتونية تحوي محبرتي الخاصة، يتوجب عليَّ أن أقول كيف رأيتها قبل ذلك وكيف.. الآن حسنًا إنها مستطيل متوازي الأضلاع، لا!! لا!! هذا سخف، ليس هناك ما يمكن أن أقوله عنها، هذا ما لا بد أن أتجنبه، لا يجب أن أضفي غرابة حيث ليس ثمة ما يدعو لذلك، وأعتقد أن هذه خطورة الاحتفاظ باليوميات، فأنت تبالغ في كل شيء، وأنت دائمًا متحفز للبحث عن الحقيقة من ناحية أخرى من المؤكد أنه من لحظة لأخرى، ربما أعيد الإمساك بانطباعي أول أمس عن شيء ما كمحبرتي مثلًا، لا بد أن أكون مستعدًا دائمًا وإلا ربما يفلت ذلك الانطباع من بين أصابعي ثانية)(4).
هذا القلق الجمالي والمعرفي الفادح هو ما يجعل من الكتابة إدراكًا للمحو بقدر إدراكها للصحو ووعيًا بالغياب والعدم بنفس وعيها بالحضور والتماسك، فالكتابة إذ تثبت تمحو ذاكرتها أيضًا، وإذ تكتب ملائها تكتب فراغها أيضًا، الكتابة خفة جمالية عابرة، ومجازًا ظليًّا منسيًّا، ومن ثمة فشعرية هذا الديوان تحاول أن تعبر باللاشكل إلى منطق الشكل، وبقوة اللامعنى الكامنة في الواقع والذات والتاريخ والثقافة لتصير إمكانًا دلاليًّا ووجوديًّا جديدًا ضمن نسق المعنى السائد والمعروف، إنها كتابة مجازات الخفاء، وإيقاعات النسيان الكمينة في الواقع والعالم، وتأسيسًا لمجازات (الظل والمحو والعراء) التي دفعنا دفعًا صوب المدهش والصادم والصامت والغريب والمتوحش المركوم في هلامه اليومي الحسي المنبوذ، نرى ذلك أيضًا في نص “21 فبراير 2001”:
“تتحرَّكُ بخفةِ
بقعةُ ضوءٍ في إطارٍ من الماسِ
ترسمُ بأناملِهَا الدقيقةِ خريطةَ الحُلْمِ
وتضئُ شموسًا.
دمُهَا الذي يحتبسُ في وجنتيْهَا
يحملُ لقارئِ ملامحِهَا معنىً ما
بسيطًا وآسرًا.
هي الموجُ الذي تدغدغهُ الرياحُ
الندى الذي يبلِّلُ الصباحَ
وزورقٌ”.
الديوان، ص26.
هذا النص يجسد في نضج تشكيلي مميز، ما نقصده بقوة خيال الخلاء في مواجهة خيال الاحتواء الثقافي العام، أو قل يبنى خيال العبور البيني النشط في مواجهة خيال الحدود المعرفية والجمالية السائدة والراسخة، فبقعة الضوء التي تتحرك بخفة في إطار من الماس تفكك كل تماسك وكل إطار ثقافي منسجم، لأنها تحيل الثبات إلى حركة، والإنجاز الأيديولوجي القائم إلى إمكان رمزي تصوري ضمن إمكانات أخرى كمينة ربما تكون أكثر أصالة منه، فحقائق الواقع وأشياؤه توجد بقوة الوجود، لا بقوة الثقافة، ولا تمحى أبدًا بقوة إخفاء الأفكار الرسمية التجريدية لها، وعندما يمحو الوعي الشعري قوة الثقافة، وصرامة النسق، وموضوعية الوهم الأيديولوجي العام، لصالح طاقة الانتشار الضوئي التعددي الكامن في الأشياء فإنه ينقلنا من الغلظة إلى الخفة، ومن التجهم إلى الطلاقة، رافعا اليومي والعادي إلى حد شعرية الوجود، وليس شعرية الثقافة، وفي شعرية الوجود يتحول اليومي البسيط الآسر إلى تموج لا ينسى تحرك، وندى لا يفتأ يبلل الحياة من حولنا وزورق طاف بقوة فوق أي رغبة ثقافية معلنة أو مضمرة في تجميد نهر الحياة اليومية الباذخة، هذا الزورق الشعري البعيد هو الذي يقاوم الحضور السياسي والحضاري والثقافي الزائف في مقابل إدراك الغياب الأصيل، والمستحيل الممكن، والإمساك بالحركة اليومية الباذخة للوجود. وبهذه الصورة تكتب قصيدة النثر سياسات التشكيل الجمالي اللاواعي للحقيقة السياسية المدبرة، وتفضح التواطؤ الترميزي العام، وتحل منطق الحركة محل منطق الشيوع الثابت، ومنطق الوجود محل منطق الثقافة، ومنطق تشكيل الخفاء، محل منطق التلوث والاحتواء الدلالي العام، للإمساك بالمدهش والصادم والعابر والغريب والصامت المركوم فى هلامه اليومي الحسي العاري حيث يكتب الشعر كما قلنا آنفا (خيال العراء) في قصيدة النثر في مواجهة (خيال الاحتواء) في الشعر التفعيلي، أو قل يكتب النص هنا (خيال العبور) أو (خيال الظل) النشط واللامرئي في مواجهة الأخيلة الجمالية المركزية الكبرى التي تكتبها الثقافة الجمالية والمعرفية الرسمية العامة، والتي ترى الماس معلقًا في آذان السلطة مثلًا، أو بوصفه رمزًا لشيء عام، أو حتى الماس بوصفه بناءًا جماليًّا داخليًّا مستقلًّا، أي الماس بوصفه بناءً وليس بوصفه عبورًا، لكنها في كل الأحوال لا تكتب عن قطرة الماس المنبوذة في ذاتها ولذاتها والتي فككت فكرة الحضور الكلي للماس لتراه خاصية تقطع إشعاعي متموج وهو الموازى الجمالي اللاواعي لخاصية التكسر الزمني، والحلول في الحركية الوجودية الكثيفة المتقطعة للزمن الحاضر، ليكون الزمن خطًّا ملتبسًا مكثفًا، وليس نقط مركزية واضحة، نسيانًا حاضرًا وليس حضورًا منسيًّا متسلطًا، اختلافًا تعدديًّا مرهفًا وليس تطابقًا أحاديًّا غليظًا مناوئًا ـ وهنا ترجع قصيدة النثر باللغوي والتركيبي والإيقاعي والمجازي إلى درجة الصفر الجمالي لتنبع من درجة الكثافة اليومية الحسية المجهولة، ثمة حمولات مجازية وسياسية ترميزية تجريدية تنخر في جسدية الحاضر الثقافي العربي تمنعه من وجوده الحي المباشر، وتؤجل حياة الكائنين فيه، خانقة إيقاعهم الحسي اليومي المعيش لصالح طنطنات إيقاعية كلية مجردة تنتظم الذات فتبتلعها في صخبها الإيديولوجي المعتم، لكن الشعر إذ يتأمل الخفة المطلقة في بقعة الضوء يستنفر الإيقاعات الحسية الباذخة النائمة في تفاصيلها الصامتة المجهولة، فيرتفع النص بها إلى قمم إيقاعية خفية غير معلنة أيًّا كانت درجة توترها وتواترها وانتظامها وانقطاعها على مستوى الدلالات والمعاني والتراكيب والأصوات والتكرار والتعاقب والانقطاع والترابط والترادف والتوازي والتشاكل، فلا يهم التأطير المسبق للتجربة قدر ما يهم المحايثة الفعلية الحسية الأصيلة لها، والقادرة دوما على استقطاب موسيقاها الإيقاعية الخاصة بها بعيدًا عن توجيه آلات الانتظام الموسيقى المسبق، والتي تشرِّح الفراشات بسكاكين البصل -بتعبير مندور- فالكثافة الزمنية المعقدة للإيقاع -بعيدًا عن الكمي والنبري والمقطعي- تتأبى على كل تأطير إيقاعي نهائي، كما أنها لا تقع أيضًا في تفتيتية إيقاعية نسبوية سائلة، ومن داخل هذه الهوة الزمنية الصامتة تنبع قصيدة النثر لتكتب أشكالها الإيقاعية والمجازية والبنائية، ومن هنا تكتب قصيدة النثر السابقة لسمير درويش لحظة ذاكرة الصيرورة الجمالية والمعرفية الخفية الكامنة في رحم التفاصيل اللامتناهية لحياتنا الحسية اليومية، فتثقب الجلد الرمزي واللغوي السميك لجسد الواقع وجسد الهوية وجسد الوعي، فينفجر النسيج اللغوي والجمالي والمعرفي والروحي للإحالات الحسية اللامتناهية، والأصداء الظلية المتوالدة بعيدًا عن ذكورية اللغة، وبطراركية المجاز، وتسلطية الأنساق الثقافية الكبرى، ومن هنا لا تكون قصيدة النثر وسيلة تعبير كما في القصيدة الرومانسية والكلاسيكية العمودية، أو حتى وسيلة بناء وتكوين كما في القصيدة التفعيلية الموزونة، بل تصير صيرورة إنتاج للقاع الصخري السحيق للحياة والواقع، ومجاز حسي حفري للتنقيب عن المنسي والمنبوذ، وهنا تكتب قصيدة النثر السيرة الذاتية الجمالية الخاصة بهذا الكائن اللامرئي المنبوذ في حسيته الصامتة أقصد (قطرة الماس) في النص السابق فبقعة الضوء الصغيرة العابرة تتحرك بخفة وجودية مذهلة وهى قادرة فعلًا على تفكيك كل تماسك ثقافي منسجم، ومن ثمة فنص سمير درويش يحرك الثبات النسقي الأيديولوجي العام فيحوله إلى حركة هوائية متصلة، وترجرج ضوئي متصل، ليكون أي إنجاز رمزي سياسي جمالي عام هو إمكان رمزي ضمن إمكانات تصورية أخرى كمينة وليس خلودًا رمزيًّا وسياسيًّا مهيمنًا طوال الوقت، وربما تكون الإمكانات المجازية الظلية العابرة التي تؤسسها قصيدة النثر أكثر أصالة من الإمكانات الكبرى المسيطرة لأن حقائق الواقع في ذاته ولذاته توجد بقوة الوجود لا بقوة الثقافة، ولا تمحى أبدًا بقوة الإخفاء الأيديولوجي والجمالي لها، حيث تظل تعمل قصيدة النثر بوصفها السوسة الجمالية والمعرفية والثقافية غير المرئية التي تنخر الاحتمالات اللانهائية الكامنة في جسد الثقافة العربية الدفينة وهذه السوسة المجازية غير المرئية قادرة دومًا على نخر منسأة سلطة التملك اللغوى الرمزى العام، بما ينقذ الذات العربية والتاريخ العربي الراهن من انحصاره الموحش داخل زمنية السلطة لتستنقزهما داخل زمنية الوجود نفسه بما يجعل الذات الجمالية الظلية مولد جمالي حركي نشط لا يعين الحضور الفعلي اللحظي اليومي بوصفه تعينًا سلطويًّا بل بوصفه أثرًا تشكيليًّا ومعرفيًّا يباعد دومًا بين الواقع وبين نفسه، وبين التاريخ وبين مغيباته، وبين الهوية الحضارية والجمالية وبين سرقة السياسيين لها، وتأفيك النقاد والمبدعين الكبار الرسميين عليها، وهنا تكمن القوة الجمالية التجريبية حقًّا لقصيدة النثر التي استطاعت أن تنخر داخل الامتلاء الثقافي الميتافيزيقي الأيديولوجي العربي لتبين بصورة جمالية جارحة وصادمة أنه امتلاء وهمي فارغ أدى إلى ما نحن فيه الآن على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية أيضًا. لتقرأ معي هذا النص:
“31 ديسمبر 2001”
“غدًا ستكُونُ الشوارعُ خاليةً من المارَّةِ تقريبًا
وسيضطرُّ مُنَادُو السيَّارَاتِ للصراخِ
جَلْبًا لزبائنِهِمْ..
فمعظمُ الناسِ سيكونُونَ نائمينَ في بيوتِهِمْ
لأنَّهُمْ سيسهرُونَ الليلةَ جماعاتٍ، يحتفلُونَ معًا
بقدومِ عامٍ جديدْ.
لكنَّنِي سأكونُ هناكَ..
لأنَّنِي سأُقَضِّي الليلةَ ممدًَّا أمامَ التليفزيون
أستمعُ لنشراتِ الأخبارِ
ولتوقعاتِ المنجِّمِينَ عنْ أحداثِ عامٍ جديدٍ
يتشكَّلُ الآنْ”(23).
فالشعرية هنا (شعرية المحو) في مقابل (شعرية الصحو) التي نراها في القصيدة العربية الحداثية الموزونة، وشعرية المحو لا تكتب الجنون المتخثر ولكنها تكتب العدم بوصفه إمكانًا وجوديًّا كامنًا بما ينقل مفهوم المجاز من حالة الإنجاز إلى حالة الإمكان المجازى المفتوح المستمر، فهو مجاز الظل الكامن في رحم الثغرات المعرفية يقوم بدور المعادل اللاموضوعي -لا الموضوعي- الجمالي لهذه الثغرات والصوامت حيث تدفع الدال الشعري إلى أقصى إمكان التدلال حتى بلوغ سقف المحو الدلالي “لكنني سأكون هناك” فينكتب الشعر من رحم التكوينات الزغيبة البازغة من أحشاء اليومي والصامت وكل ما يتأبى بطبعه على الترميز والدلالة والشكل، والشاعر إذ يعنون قصائده بتواريخ كتابتها ماحيًا الحد الزمني بين زمن الكتابة الفنية وزمن التأريخ الزمني للكتابة، يخلق نوعًا من أسلوب الالتفات الوجودي الحسي بين الصوت والكتابة، بين الكتابة بوصفها نسقًا تاريخيًّا حاضرًا غائبًا، وبينها بوصفها حضورًا وجوديًّا وجماليًّا مؤجلًا لا يحضر أبدًا، أو هو حضور بسبيله إلى الحضور اللامتناهي، فاللحظة التاريخية التي نموضعها للقبض عليها في الكتابة، تفر إذ تنكتب، فالوجود نفسه سابق على الكتابة، والحاضر الحسي اليومي ينزلق منا وعنا وجوديًّا ودلاليًّا بصورة مطلقة، فنحن مطالبون دومًا بالالتفات من المكان الذي نوجد فيه إلى المكان الذي يجب أن نوجد فيه، أو قل إن المكان والكتابة والتاريخ والذات والمجتمع يفارقونا جماليًّا ودلاليًّا ووجوديًّا في ذات اللحظة التي ندعى نحن القبض عليها في الكتابة الشعرية، حينئذ تعتبر الكتابة منطقًا للعبور الإرجائي المطلق من حالة إلى حالة ولا تستقر في تدلال معين في لحظة معينة، وهنا تكمن قوة كتابة المحو ضد كتابة الصحو، وكتابة المحو لا تعنى العماء والعدم، بل تعنى كتابة لحظة العبور الخفي النابع دومًا من الصوامت اليومية العادية بين لحظتين مجردتين كبيرتين لحظة الماضي الثقافي والجمالي الراسخ، ولحظة الحاضر الجمالي السائد والممتلئ بالترميز الأيديولوجي العام، وإذ يكتب الشعر محوه وعدمه وبياضه الوجودي الديناميكي، يفكك هذا الامتلاء الترميزي والسياسي والاجتماعي العام فيحيله عبر الصور والمفارقات والتكثيف الدلالي إلى فراغ عام، فهو يفكك لحظة الحضور ذاتها، وهنا تأتى القيمة الجمالية والأسلوب والمعرفية الجديدة لما عرف بقصيدة النثر “النص الحر”، فهي تمثل لحظة جمالية كثيفة من المقاومة ضد التجريد والتعميم وسد الأفق الثقافي والوجودي بالإيدولوجيا والأفكار الكبرى الوهمية، وبهذه المثابة نحن لا نريد شعرًا يرتهن في جمالياته الحاضرة لماضينا الجمالي أو لماضي الآخرين، ولا نريد شعرًا يرسم مستقبلنا الجمالي من خلال شتل مستقبل الآخرين في جباهنا الجمالية عنوة واقتسارًا، ففي كل واقع جمالي خاص، تركيباته المعرفية والمجازية والثقافية الخاصة به والتي تتوالد ذاتيًّا بقدر ما تتوالد منهجيًّا ومعرفيًّا، ولا ينتفع من الولادات الجمالية في حضارات الآخرين إلا بما هو على وشك الولادة الجمالية الطبيعية في الأشكال الجمالية لحضارة الأنا، نريد شعرًا لا يسمي العدم وجودًا، ولا الفوضى حرية، ولا القواعد المكرورة الكابحة منهجية، شعرًا يصغي لأشكال التعدد اللاشكلي اللانهائي في الذات والواقع والثقافة، بقدر إصغائه لأشكال التعدد الشكلي الراسخة في عقلنا الجمالي الخاص، ولنكمل مع الشاعر سمير درويش في ديوانه (يوميات قائد الأركسترا)، يقول الشاعر في نص “1 أغسطس 2001”:
“من الممكنِ أنْ أكتُبَ هُنَا:
“رغمَ أنَّ كلَّ شيءٍ ممكنٍ حدثَ اليومَ
في حياةِ رجلٍ غيرِ تقليديٍّ:
مهاتفةِ الأصدقاءِ المقربينَ.
واصطحابِ الأطفالِ إلى المتنزهاتِ.
والفرارِ من سيارةٍ طائشةٍ.
إلا أنَّ الحياةَ أصبحتْ مُمِلَّةً فعلًا”.
المشكلةُ أنَّنِي لو قلتُ ذلكَ
سأعطي مبررًا للنقادِ
كي يشكِّكُوا في فكرةِ “اليومياتِ”
أصلًا”.
ففي اللحظة التي نكتب فيها يومنا، يكون فرار يومنا منا، نحن لا نكتب سوى صورتنا وتصورنا ورمزنا عن اليوم، ولا نكتب اليوم نفسه أبدًا، نحن نكتب التعتيم لا الإفصاح، وكأن المجاز هنا يكتب لحظة المقاومة المستمرة بين القصدي والطبيعي، بين ثقل النسق الثقافي والخفة المطلقة للوجود اليومي الطيفي، فنحن لا نستطيع أن نتكئ كما يقول جورج جادامر في “الحقيقة والمنهج” “على نقطة أرشميدية خارج الثقافة نستطيع من خلالها تحقيق معرفة موضوعية ما بالذات والعالم والخيال والواقع، واليومي العابر”. إن الجهد السياسي والاجتماعي والثقافي المبذول يوميًّا لاستبعاد البسيط واليومي والعابر والهلامي بوصفه عديم القيمة، أو غير محدد القيمة أو “مفلوت القيمة” يصبح في قصيدة النثر “النص الحر” هو ما يصنع جسد الحياة نفسها، أي جسد اللغة وجسد العقل، عندئذ تصير قيم اللامعنى والفوضى واللاشكل قيمًا جمالية ومعرفية أصيلة يجب أن تنضاف بالمثل لقيم المعنى والاتساق والشكل، وهنا تستحضر الشعرية فكرة الحضرة الشعرية بديلًا عن فكرة الحضور الشعري المتعارف عليه!! ففكرة الحضرة هي حضور طيفي عابر ولحظي يقع بين حضورين متعينين، حيث تنتشل الحضرة الشعرية الانفصال اليومي القابع في الحضور اليومي، وترقى به إلى الاتصال الصيروري المتحرك في فكرة الحضور ذاتها، فيتجسد الظلي والعابر والصامت والمجهول، بما يدفع الشعر والذات والثقافة إلى عوالم حاشدة من التوتر والمفارقة والازدواج والتعدد، والترامي بين الحضور بوصفه تجليًا تاريخيًّا عامًّا والحضرة الشعرية بوصفها تخفيًا وتجليًا معًا في ذات لحظة الحضور التاريخي اليومي، لقد رأى كانت من قبل في كتابه “نقد العقل الخالص” أن “الاستنتاج المتعالي يبين أن شروط احتمالية الذاتية هي في الوقت نفسه شروط احتمالية الموضوعية”. وهذا التصور يداخل بين طبيعة المنهج وطبيعة الحقيقة التي يصفها هذا المنهج، أو قل يداخل بين التجربة كما هي في واقعها اليومي الخام وبين منهجية وصفها بعد أن أمحت هذه المسافة التي كانت تتوههما العلوم والمناهج والتصورات السياسية المعاصرة بين الذات العارفة والموضوع المعرف، لقد انتفت المفاهيم الشائعة لفعل التعرف الجمالي حيث يتداخل فعل التعرف بالعارف بموضوع العرفان الجمالي في وقت واحد، وإذا كانت المعرفة -أي معرفة تجريبية أو إنسانية أو منهجية أو منطقية- مبللة بأهواء وتصورات وأشواق العارف، وكل نظرية تدعى الاتساق محكومة بأشكال عماها الدلالي والمنهجي أيضًا، ذلك أن العقل يتعقل من خلال الاستعارات الإدراكية كما يقول جورج لايكوف ومارك جونسون، فإن عبور هذه المسافة الأبدية اللانهائية بين الكلام والظاهرة يبدو مستحيلًا، ومن ثمة وهمية صرامة تقسيم منهجية المعرفة للإمساك بلحظة الحاضر التي تفر منا أبدًا، فالحاضر لا يعنى الحضور، بل يعنى إمكانية الحضور، حيث يقف الشعر في الهوة الأنطولوجية الفادحة بين وضوح الحاضر وغموض الحضور الذي يباعد بين الزمن ونفسه في ذات اللحظة، ومن هنا فشعرية يوميات سمير درويش هي شعرية الشهود بالمعنى الصوفي المادي الحسي، لا شعرية الشهادة بالمعنى المجازى التقليدي، يقول سمير درويش في (يوميات قائد الأوركسترا):
“الفاصلُ الزمنيُّ بينَ موقعتينِ
يجعلنِي أجرِّبُ أوضاعًا جديدةً
تكونُ مستحيلةً أحيانًا
كأنْ تقفَ على قدمينِ ورأسٍ
أو تقفَ على قدمٍ واحدةٍ
واضعةً الأخرَى على الحوضِ المعدنيِّ
أو تجلسَ في وضعِ الكاتبِ المصريِّ
ببعضِ التحريفاتِ
أو..
أو..
الذي يساعدُنِي حقًّا
أننِي أجدُ وسيلةً ما.. مناسبةً
لأُخْمِدَ انفجاراتِي”، الديوان، ص 60.
هنا يصنع الشعر من حالة الوجود حالة جمال، وليس العكس، فلا تقود قوة اللغة، أو سطوة الثقافة خيال الشعر، لكن النص هنا يجيد الإصغاء الجمالي لقوة اللانسق الساري في جسد الألم واللغة والذات ثم يرتفع به إلى حالة من حالات التشكيل الجمالي الحر، وكأن شكَّل القصيدة النثرية ممرًا حسيًّا لانبثاق حقيقة الوجود، أو حقيقة الجمال الموغلة في سريتها وعزلتها بعيدًا عن أنساق الشعر السابقة والسائدة، يبدو أن هذا الشعر يعلمنا كيف نعيد تأسيس تصوراتنا وعقولنا وأفراحنا وأحزاننا وفق منطق التأمل والفحص والمراجعة للحظات الوجود نفسها، وليس من خلال دفق التمثل الرمزي والجمالي السائد للعالم، ذلك أن الوجود سابق على اللغة، وحالة اللاشكل سابقة على نسقيه الشكل، فالذات هنا هي الأصل الذي يجب أن ينقاد إليها المجتمع، والخيال هو الحقيقة الذي يجب أن تعدل هرطقة أنظمة أفكارنا من وهمها بناء على معطياتها على إدارة عقولنا وأرواحنا ووجودنا، والأكثر قدرة أيضًا على هدم وهمية مركزية الأفكار والتصورات وثرثرات الأنساق، وإنشائية الممارسات اليومية الهشة، وربما يدخلنا هذا النص إلى بكارة إيقاعية فوق وزنية أو قل قبل وزنية، لم تنتبه إليها القصيدة الحديثة الموزونة، وهنا تنتفي المغالطة المعرفية والجمالية الشائعة حول خلو قصيدة النثر من الإيقاع تمامًا، أو نسفها التام لكل نسق إيقاعي مسبق، وهذه المغالطة المنهجية ترجع إلى جمود الوعي النقدي المعاصر في تصور الزمنية الإيقاعية المعقدة للحظة الزمنية الراهنة وهى لحظة كثيفة معقدة ومتداخلة، إن قصيدة النثر تفرق بين وعى الثقافة ولاوعيها معًا، ولا تجعلهما شيئًا واحدًا كما تصورت القصيدة الموزونة وكتابها ونقادها الكبار، فنحن لا نتصور الحقائق دومًا، ومن بينها الحقيقة الجمالية، إلا من خلال سطوة النماذج المعرفية الكبرى التي تهيمن على بنية الوعي واللاوعي معًا، فلا تساوى النظريات الجمالية أشكال العالم اللامتناهية، ولا تتطابق الجسارات التخييلية والإيقاعية مع النماذج المعرفية والإيقاعية للإجراءات النقدية السائدة، فالحقيقة هي سياسة الحقيقة لا حجج الحقيقة، فدائمًا الحقيقة تتدشن وسط معتقدات وتصورات وتحيزات، ولا توجد في ذاتها ولذاتها كما تصور دعاة النماذج المعرفية التجريدية الكلية وهمًا وتسلطًا، ومن هنا فقصيدة النثر تكتب الحقيقة بوصفها غيابًا، والنسيان بوصفه حضورًا، والحضور بوصفه إمكان حضور لا تحقق حضور، ويقع إيقاع قصيدة النثر في العمق من هذه التصورات الجمالية التجريبية الجديدة والتي نؤصلها هنا لأول مرة في تاريخ النقد العربي المعاصر، حيث تعود قصيدة النثر بالإيقاع إلى حالات الوجود لا حالات الثقافة، أو قل حالات اللاوعى النفسي والروحي والعقلي لبنية الثقافة نفسها، لا حالات اللاوعي النفسي للفرد، ولا أقصد هنا بحالات ما قبل الوزن الحالات الروحية والتخييلية الهلامية والسديمية الكامنة في فوضى اللاوعي الإنساني، بل أقصد بالتحديد الحالات الروحية والنفسية والتخييلية والمعرفية الكامنة في لاوعي الثقافة والواقع بوصفهما أنساقًا من الأفكار والتصورات والأيديولوجيات، بما ينأى بنا كثيرًا عن فكرة اللاوعي البيولوجي لدى فرويد ويقربنا كثيرًا إلى فكرة اللاوعى اللغوي الترميزي لدى جاك لاكان، وعندما تنغل قصيدة النثر في هذه القارة الإيقاعية واللاإيقاعية الخفية اللامرئية، قارة مجهولات الثقافة ومضمرات الأنساق، فهي تؤسس إيقاع الفئات لا الهويات، إيقاع الدلالات المهمشة في صمتها البعيد، وفي هذا المجال الإيقاعي الابتكاري الجديد أستطيع أن ألفت انتباه القصيدة الحداثية العربية الموزونة عبر أشكالها الموسيقية المتعددة إلى قدرة الشعر المنثور -أو قل القصيدة النثرية كما يدعي أصحابها- قدرتها إلى خلق لون إيقاعي مبتكر أطلق عليه هنا -إيقاع اللاوعي الجمالي والمعرفى- ولا أقول اللاوعى النفسي واللاشعوري كما دشنه سيجموند فرويد، أو حتى الوعي واللاوعي اللغوي الرمزي كما قال جاك لاكان وأنصاره من بعد بوصفهما أنساقًا لغوية رمزية، بل أقصد بمصطلحي الخاص بي هنا “بإيقاع اللاوعي الجمالي والمعرفي للثقافة” المكون المعرفي والجمالي للعوالم الإيقاعية اللامتناهية الكامنة في قصيدة النثر كمكون جمالي وبنائي أصيل فيها في مواجهة كل (أشكال الوعى) الإيقاعي -الوزني والعروضي والصوتي والكمي والنبري- التوافقي والتخالفي والتوازني والمتراوح دوما بين (التناسب- التوازن- التغير- النظام- التوازي- التكرار- التلازم- التنغيم) أو أي صورة من صور الإيقاع الأخرى التي رصدها النقاد في القصيدة الحداثية الموزونة، أو مما قننه وجمعه الباحث المغربي محمد العمري في كتابه المهم: (البنية الصوتية في الشعر)، ونستطيع أن نجمع معظم -لا كل- الجهود العربية الجمالية والنقدية الرصينة في الإيقاع والوزن العربي في جهود (نازك الملائكة- محمد مندور- محمد النويهى- عز الدين إسماعيل- شكري عياد- عبد الله الطيب- عوني عبد الرؤوف- كمال أبو ديب- على يونس- شعبان صلاح- أحمد كشك- محمد بنيس- صفاء خلوصي- محمد العمري – عبد الفتاح لكراد) وغيرهم من النقاد الجادين. نجمع كل ذلك فيما نطلق عليه هنا اصطلاحًا تقريبيًّا: (إيقاع الوعي الجمالي) لأنساق الثقافة الجمالية الموروثة والمعاصرة، لكننا نرصد كل التناسبات واللاتناسبات الصوتية في قصيدة النثر فيما نطلق عليه هنا اصطلاح: (إيقاع اللاوعي الجمالي والمعرفي) لهذه الأنساق، وبالطبع فإن قضية إيقاع اللاوعى هنا تقع على الحدود الروحية والنفسية والعقلية والجمالية البينية للوعي واللاوعي معًا، والتي تكشف أنساق متكوثرة عديدة ومتداخلة لمستويات الوعي واللاوعي معًا، وحتى نجلي فكرتنا النقدية والجمالية هنا بصورة أدق وأوضح مما يبعدها عن التجريد والاختزال واللبس -وحتى لا يتهمنا دعاة العراقة الإيقاعية الموهومة أو دعاة الحداثة المتطرفة المدعاة- نريد قبل أن نقدم خطاطات واستراتيجيات نقدية أولى لما نؤصله هنا لمفهومنا الجديد لهذا التصور الإيقاعي التجريبي، أن نلفت النظر النقدي إلى أن فكرة “إيقاع اللاوعي الجمالي”، هي خاصة معرفية وتصورية في بنية إيقاع الثقافة نفسها وليس إيقاع الشعر فقط، إلى جانب أنها خاصة جمالية تشكيلية في بنية قصيدة النثر، فهي رؤية تتجه صوب إدراك حركة العلاقة قبل إدراك مفهوم العلاقة في ذاته، وتجسد جماليات العبور والنشاط واللازمنية في مواجهة التطابق والهوية والانسجام. فهي قدرة حسية تخييلية على رؤية الثقوب السوداء الصامتة والغامضة واللامرئية في جسدنا الثقافي والجمالي كله.
هوامش:
1- راجع في ذلك: على الديرى، مجازات بها نرى، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، ط 2006، وراجع أيضًا د.أيمن تعيلب، منطق التجريب في الخطاب السردي المعاصر، نادى القصة بالقاهرة، الكتاب الفضي2009، وانظر أيضًا: د.أيمن تعيلب، المقترحات التنظيرية والمعرفية والإجرائية الاجتهادية التي قدمناها بصورة مطولة في كتابنا عن (الشعرية القديمة وأفق التلقي المعاصر: نحو تأسيس منهجي تجريبي)، الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2009.
2- د.صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، كتابات نقدية، العدد54، أغسطس، القاهرة، 1996، ص438. ولعله من الأفضل هنا أن نثبت هذه الببليوجرافيا النقدية التى جمعناها على طول تتبعنا لقصيدة النثر فى الخطابات النقدية العربية المعاصرة أو الدراسات الأكاديمية والمقالات النقدية حول المصطلح الإبداعى لقصيدة النثر كما ارتآها الخطاب النقدي العربي المعاصر:
– سامي مهدي: أفق الحداثة وحداثة النمط. دراسة في حداثة مجلة “شعر” بيئة ومشروعًا ونموذجًا. دار الشؤون الثقافية العامة. الطبعة الأولى بغداد 1988 ص106.
– الدكتور رشيد يحياوى: (قصيدة النثر العربية، الأرض المحروقة، دار أفريقيا الشرق، ط1، 2006).
– د.عبد القادر القط: (قصيدة النثر بين النقد والإبداع)، جائزة يماني، التجديد في القصيدة العربية، 1997.
– أدونيس: في قصيدة النثر. “شعر” العدد 41. السنة الرابعة. ربيع 1960. ص76. يراجع أيضًا كتاب أدونيس: زمن الشعر.
– بول شاؤول، مقدمة في قصيدة النثر العربية، مجلة فصول (أفق الشعر)، مجلد 16، العدد 1، القاهرة، صيف، 1997.
– د.رشيد يحياوى، قصيدة النثر: مغالطات التعريف، مجلة علامات في النقد، مجلد8، الجزء32، مايو، جدة، 1999.
– رفعت سلام، قصيدة النثر العربية، ملاحظات أولية، مجلة فصول، أفق الشعر، مج 16، العدد 1، القاهرة، صيف، 1997.
– د.على عشرى زايد، إن كان هذا شعر فكلام العرب باطل، مجلة إبداع، القاهرة، العدد 3، مارس، 1996.
– د.فخرى صالح، قصيدة النثر العربية: الإطار النظري والنماذج الجديدة، مجلة فصول، عدد (أفق الشعر) مرجع سابق.
– د.كمال أبوديب، قصيدة النثر وجماليات الخروج والانقطاع، مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر، العدد17، يناير 1999.
– د.كمال نشأت، شعر الحياة اليومية، مجلة إبداع، العدد3، القاهرة، 1996.
– د.محمد عبد المطلب، النص المشكل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1999.
– د.على جعفر العلاق، شعرية النثر وبنية التضاد في تجربة ميسون صقر الشعرية، مجلة نزوى، عمان، العدد41.
– د.عبد القادر الغزالي، قصيدة النثر العربية: الأسس النظرية والبنيات النصية، أطروحة دكتوراة الدولة، جامعة محمد الأول، كلية الآداب، وجدة، 2002.
– د.حسن مخافي، الأسس النظرية لقصيدة النثر في الأدب العربي الحديث، (مرحلة التأسيس)، مجلة نزوى، عُمان، العدد 38.
– نهاد خياطة: رأي في قصيدة النثر. “شعر” العدد 25. السنة السابعة. شتاء 1963. ص97.
– سوزان برنار: قصيدة النثر من بودلير إلى عصرنا، ترجمة د.زهير مجيد مغامس، بغداد، 1993.
– عصام محفوظ، السوريالية وتفاعلاتها العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى 1987.
– شربل داغر، الشعرية العربية الحديثة، تحليل نصي، دار توبقال الطبعة الأولى.
– حورية الخمليشى، الشعر والنثر: السياق التاريخي والمفاضلة، مجلة نزوى، عُمان.
– د.عز الدين المناصرة، قصيدة النثر: إشكالية التسمية والتجنيس والتأريخ، مجلة نزوى، عُمان، العدد29، 2002. عن كتاب سيصدر قريبًا عن قصيدة النثر بعنوان (قصيدة النثر: نص مفتوح عابر للأنواع).
– أنسي الحاج مقدمة ديوانه “لن”، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتبرزيه، بيروت، الطبعة الثانية، 1983.
– يوسف الخال: نحو شكل جديد لشعر عربي جديد. شعر. العدد 31/ 32 السنة الثامنة. صيف/ خريف 1964. ص126.
– خليل أحمد خليل: الشعر والنثر والجهل. الآداب. العدد 4 السنة الرابعة عشرة أبريل 1966 ص65.
– عبد العزيز المقالح: أزمة القصيدة العربية: مشروع تساؤل. دار الآداب. الطبعة الأولى. بيروت 1985. ص71.
– د.ياسين النصير، قصيده النثر قصيده مستقبليه، صلاح فائق نموذجا.. دراسة واستنتاجات، ضمن كتاب شعرية الماء: آفاق من الشعر العراقي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، العدد 46، عام 2004، ص154.
– د.محمود الضبع، قصيدة النثر وتحولات الشعرية العربية، كتابات نقدية، العدد 138، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سبتمبر، 2003.
– محمد الصالحى، قصيدة النثر، تأملات في المصطلح، مجلة نزوى، عُمان، العدد 10، 1997.
3- عبد السلام بن عبد العالى، في الانفصال، دار توبقال، المغرب، 2008، ص48.
4- نقلًا عن: موسوعة كمبردج في النقد الأدبي/ مج 9، القرن العشرين والمداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، تحرير: ك. نلووف، ك. نوريس، ج. أوزبورن، مراجعة وإشراف د.رضوى عاشور، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005،، ص448.
5- المرجع السابق، موسوعة كمبردج، ص450.