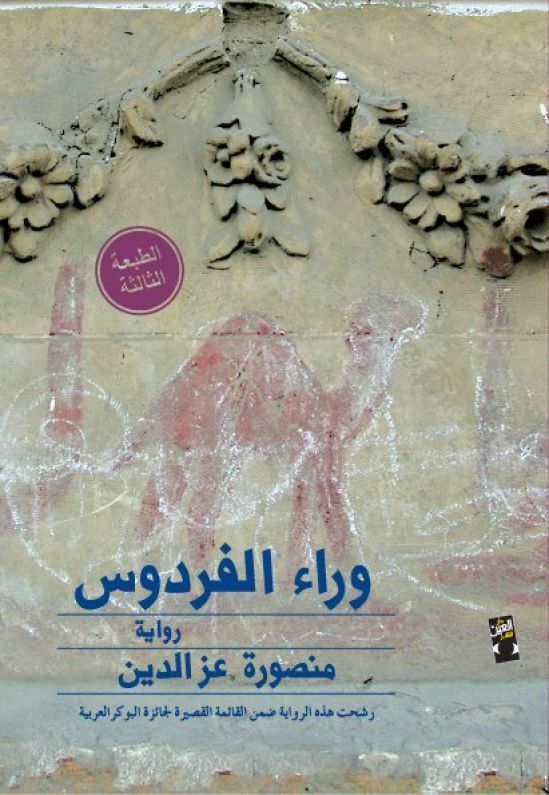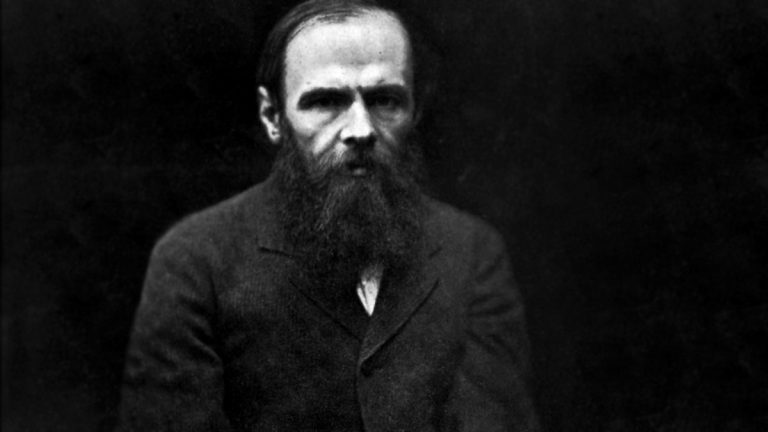يشكل ياسر عبد اللطيف متخيل قصصه استنادا إلى ملامح من سيرته الذاتية الحاضرة، إن بالفعل، عن طريق توظيف جوانب من سيرته المعروفة. وإن بالقوة، من خلال حضور ظلال من سيرته ومن سير من عرفهم عن قرب من شخصيات تحضر في هذه القصة أو تلك. ومن ثم، فإن السيرة الذاتية، هنا، تلتحم بسيرة الآخر وبالمتخيل الذي يمنح للنص القصصي أبعادا فنية جديدة تتجاوز به حدود السيرة ليصبح نصا سرديا منفتحا: نص فيه ظلال من القصة بفهمها التقليدي، ومن السيرة، ومن أشكال سردية أخرى. وبذلك، نجد أنفسنا أمام منحى جمالي/قصصي يجعل “السيرة” بنوعيها: الذاتية والغيرية أفقا لاشتغال المتخيل القصصي وبناء العوالم الحكائية في متن ياسر عبد اللطيف. ونحن حينما نشير إلى استثمار “السيرة” فإننا لا نقصد أن الكاتب يسرد سيرته على نمط السير الذاتية، ولا سير غيره كذلك، من خلال اتباع خط سردي كرونولوجي، بقدر ما نقصد أنه يختار لمحات سيرية ذاتية وأخرى غيرية ليشكل نصوصه القصصية وعوالمها الحكائية الفاتنة والطريفة والغريبة.
في قصة من قصصه المتميزة يستدعي الكاتب شخصية الروائي المصري إدوار الخراط وهو يجري حوارا للتلفزيون عبر رصد مشاهد من تصوير الحوار، لكن المفاجأة أن مخرج البرنامج حذف أهم فقرة أثارت شغف السارد/المحاوِر وشكلت جزءا هاما من مهمته “الإعلامية”، كما عكست طريقة نظره إلى الأفلام التسجيلية، وهي لقطة ترينا من زاوية بصرية/ مشهدية صورة غير مألوفة للروائي إدوار الخراط أغفلها المخرج لكن ياسر عبد اللطيف تمكن من تصويرها عبر لعبة سردية لا تخلو من ذكاء وقدرة على الغوص في الإحساس الذاتي وتجليته كتابة، مع التعبير عن لحظة من سيرته وسيرة الروائي السكندري قصصيا. يقول:
“…نحن فريق عمل لفيلم تسجيلي عن الروائي السكندري إدوار الخراط أنا كاتب السيناريو، والمحاور الرئيسي لإدوار محور الفيلم. لم يكن الخراط من كتابي المفضلين، لكني أقدمت على العمل في الفيلم مضطرا لحاجتي الماسة للنقود في تلك الفترة، وكان هذا هو أفضل الحلول. وأنا أحب صناعة الأفلام التسجيلية على أي حال. المخرج أيضا سكندري، وهو من اختار هذا الموقع للتصوير. كان يريد أخذ لقطات موحية للخراط وهو يسير في أماكن تصلح كخلفيات جمالية يطعم بها مادة الفيلم الحوارية بالأساس. كان رذاذ الأمواج يتطاير من خلف العنابر ونحن واقفون نحضر للقطة أنا والمخرج والمصور ومدير الإنتاج، وإدوار نفسه. قال المخرج للروائي الشيخ أن يأتي سائرا من عمق الشارع على أن تواجهه الكاميرا الثابتة، بحيث تبدو العنابر على يمينه بينما هو يتقدم في الكادر قادما من بعيد تحت الرذاذ المتطاير. خلف المونيتور بدا الخراط وقد جاوز الثمانين بالشعر الأبيض على جانبي رأسه، وبمعطفه الأسود شيخا شديد الوقار. وفي لحظة بدت لي تلك المسيرة التي قطعها من نهاية الشارع لأوله بين أنقاض المخازن، تمثيلا رمزيا لمسيرته الأدبية بكل حمولتها الرومانتيكية، اختزالا جماليا لها في لقطة واحدة. كأنه لم يكتب “رامة والتنين” و “الزمن الآخر” و “يقين العطش” و “حجارة بوبيللو” وآلاف الصفحات إلا كي تلتقطه عدسة بهذه الهيئة، وعلى هذه الخلفية. وفي المونتاج النهائي، أسقط المخرج هذه اللقطة من جسم الفيلم”(ص. 8-9)
وهنا نجد الاهتمام بالتصوير التلفزي والسينمائي وثقافة الإعلام تشكل قسطا هاما من متخيل القصة وعوالمها، كما أن التعبير عن الإحساس الجمالي باللقطة واللحظة الخاص بالسارد/ الكاتب يبدو جليا في هذا المقطع المستشهد به من القصة. وهذا الجانب يحضر في أكثر من نص من نصوص “يونس في أحشاء الحوت”، نذكر على سبيل المثال نص “ماسبيرو، صيف 1998، لغة المالايو” من ثلاثية قصصية حملت عنوان “أروى على الهواء”. ولعل ثقافة الكاتب البصرية/السمعية (السينمائية والتلفزية والإذاعية) تتسرب إلى عوالمه الحكائية بطريقة تلقائية لتسهم في تشكيل متخيله من جهة، كما تعمل، من جهة ثانية، على مد قصصه بنسغ “سيري” واضح عن طريق توظيف ضمير المتكلم المفرد كصيغة سردية وأداة من أدوات نقل الوقائع والأحداث، ومن ثم جعل النص القصصي يُروى من وجهة نظر سارد عارف بشخصياته وأحداثه. سارد يتماهى بالكاتب وينطق باسمه. ولعل هذه السمة الفنية من مكامن قوة الكتابة السردية لدى ياسر عبد اللطيف، وهي لا تنقص من فنية كتابته، ولا تمس غاياتها الجمالية وأبعادها الدلالية.
ويشكل “الحلم” باعتباره طاقة سردية بامتياز إمكانية هامة لقول “السيري” عبر لقطات وإلماعات لا تخلو من توق وتجسيد لرغبات جوانية دفينة خاصة بالسارد. وقد كان الحلم الأداة الأساس التي انبنت عليها القصة الأولى في مجموعة “يونس في أحشاء الحوت” المعنونة ب”حلم ليلة حرب”، ولكن النص يوهمنا، في بدايته وعبر تسلسل وقائعه، أننا أمام حكاية واقعية وأحداث يعيشها بطل القصة، غير أننا في النهاية نجد أنفسنا أمام حلم ليس غير، وأننا أمام مفاجأة غير متوقعة شكلت نهاية القصة وجعلت دلالاتها منفتحة على تأويلات عدة. ومن أجواء القصة وعوالمها نقف عند مشاهدها الأخيرة، يقول السارد:
” استبقتُ الخطى في الزحام نحوها، وهمست في أذنها: هل أساعدك؟ أجابت بكلام كثير لم أتبينه ثم تعلقت تلقائيا بكلتا يديها في ذراعي، فسرت بها وكأني أحملها. وفي الطريق إلى المدرسة – التي تصادف أنها مدرستي أيضا- نَمَت بيننا عاطفة لا أستطيع الآن تحديد كنهها. مزيج عميق من الشفقة والعشق المثالي. كنت أكبرها بعامين أو نحو ذلك. وفي المدرسة صرنا قصة غرام شائعة يتندر بغرابتها ومع شيء من الغبطة الطلبة الآخرون..
ربما لو كنت قد صادفت مثل ذلك الحب في صدر مراهقتي، لأعفيت من الخوض في طرق مظلمة أسهمت في تخريب روحي.
وفي حلم آخر كنت أتخبط في ظلام خراب شاسع. الأرض سوداء من حريق هائل التهم أخضرها ويابسها، والأفق رمادي مع وميض يضوي ثم يخفت كبرق دون رعد. تعرفت على جثتها المتفحمة بين الرماد من ساقها الضامرة” (ص. 2-3)
هكذا يجد القارئ نفسه، في هذه القصة، يلج حلما، ثم ينتقل منه إلى حلم آخر، حتى نهاية النص التي تجلي لعبة السرد في مكرها الفني الجميل. فإذا بكل ما يتبدى له حكيا حقيقيا عن علاقة طفل بطفلة صغيرة ضامرة الساق، تحولت شفقته عليها إلى قصة حب أثارت غبطة تلاميذ المدرسة الآخرين لم يكن سوى أضغاث أحلام، وهو ما يتأكد بالحلم الأخير: حلم ليلة حرب خاضتها الذات الساردة وأحرقت فيها الأخضر واليابس، ودمرت حتى أجمل ما كانت تتوق إليه وتحلم به: موضوع حبها الذي لو عرفه حقيقة لأسهم في إنقاذ روحه الخربة: الطفلة المعاقة. وبذلك كان التخبط في ظلام خراب شاسع، خراب الروح والوجود، والسير في أرض سوداء هي نتيجة هذا الحلم النهائي التي اختتمت به القصة.
ولعل هذا اللعب الفني والمكر السردي من الميزات التي طبعت المجموعة، وجعلت “السيري” لا يقف عند ظاهر الأحداث ومجريات الوقائع، وإنما يغوص إلى الهواجس والكوابس والأحلام ليجعل منها مستوى آخر من مستويات تجسيد “السيرة” والتعبير عنها سرديا. ويحتفي ياسر عبد اللطيف احتفاء كبيرا بهذا الجانب الفني في تشكيل عوالمه القصصية، كما نجد في قصص مثل: لقاءات قريبة من النوع الرابع- في مدينة التلال والنهرين- يونس في أحشاء الحوت- ترتيب الأرفف.. وغيرها من القصص.
كما أن محكي الطفولة، بذكرياته، ومتعه الحسية وتداعياتها، يوظفه الكاتب بكثافة في بناء عوالمه القصصية، تماما كاستناده إلى الحلم بإمكاناته الفنية المنفتحة على الغرابة والطرافة، والقدرة على كشف أعماق معاناة الإنسان وهواجسه وتطلعاته. في قصة “أسماء سميتموها” من رباعية حملت عنوان “أربع دراسات لضوء النهار” يعود السارد إلى ذكريات طفولته المبكرة، ووقائع تشي ببراءة الطفولة وعفويتها ليشكل عالم هذه القصة الحكائي. يقول:
” كنت أقف بجوار حائط مطلي بالجير الوردي تمت تغطيته بشبكة من شرائح خشبية رفيعة طليت باللون الأخضر. الشبكة الخشبية جُعلت لتسلق أفرع للبلاب من المفترض أن تنطلق من حوض رخامي مملوء بالطين أسفل الحائط، كان الحوض مقفرا، وكانت الشبكة الخشبية هناك، عارية من وظيفتها، وكنت أصغر من أن أدرك هذه العلاقة المعقدة. كنت في الخامسة على الأكثر.
وجدتها واقفة بجواري، زميلتي في روضة الأطفال، عايدة رائد راضي. كان أبوها يملك صيدلية بجوار منزلنا، ومع ذلك اختفت من حياتي بعدها، وظللت أذكر اسمها هكذا، ثلاثيا، مرتبطا بهذا الموقف فقط كأن حضورها التاريخي قد جبه ومحاه حضورها اللحظي في ذلك الموقف الغابر.
سألتها مستفسرا عن هذه الشبكة الخشبية: “إيه ده؟”
قالت بثقة طفل في الخامسة: “ده الجزير”.
أخذت كلامها مأخذ الجد. ولم أكن قد سمعت هذه الكلمة من قبل. ولم أسمعها أيضا بعدها في عمري الذي امتد خمسة وثلاثين عاما أخرى. الآن، وبعد كل تلك الأعوام أفكر: “الجزير” مذكر لكلمة “جزيرة”، وهي وفقا للمعاجم العربية واحدة جزائر البحر، وسميت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض. وهي اشتقاق من جَزَرَ بمعنى ذبح وقطع اللحم، فالجزيرة تتخذ اسمها من حيث هي “مقطوعة” عن جسد اليابسة. كذلك كان “الجزير” كما أسمته عايدة رائد راضي مقطوعا عن عالم المعاني بانقطاع صلته بحوض اللبلاب الذي جف فيه الطين. كان مجرد جسم معلق على الحائط، أو بالأحرى، معلق في الهواء.
مع الزمن، تقل تدريجيا فرص اصطدام وعيك بأشياء تجهل مغزى وجودها تمام الجهل كما رأيت تلك التعريشة الخشبية في وضعها الرأسي ذلك النهار البعيد؛ ومع ذلك تحدث من آن لآخر. وفي كل مرة من تلك المرات النادرة، ستقفز إلى ذهني كلمة “جزير” كما خرجت من فمها، ويتردد في أذني اسمها ثلاثيا: عايدة رائد راضي”. (ص. 4- 5- 6)
يتشكل هذا النص القصصي المكثف من استدعاء لحظة من لحظات الطفولة العابرة، وذكرى ارتبطت في ذهن السارد بكلمة تركت أثرها في وجدانه وروحه، وارتبطت باسم طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها تحضر بكل براءتها وقدرتها على الإدهاش، وذلك من خلال إشارة لغوية دالة وفاعلة في مخيلة السارد -الطفل والشاب بعد ذلك- الذي يسترجع المعنى والنبرة الصوتية التي نطقت بها الطفلة الكلمة، وهذا ما يستدعي إلى الذاكرة، أيضا، الاسم الثلاثي للطفلة بكل لوعة وحنين وشوق. وتشي القصة، في بلاغتها القائمة على التكثيف والإشارة الموجزة الدالة، بمدى أهمية “الكلمة” وقدرتها على تحريك الشجون والدفع إلى البحث عن المعاني والسعي إلى المعرفة، كما توحي بانبناء النص السردي انطلاقا من لعبة التداعي واستعمال الذاكرة أساسا لتشكيل المتخيل القصصي.
في ضوء كل ما سبق يمكننا القول إن بناء المتخيل القصصي، وتشكيل صوره السردية، وبناء عوالمه الحكائية عند ياسر عبد اللطيف يستند إلى مكونات “السيرة” الذاتية والغيرية، ولحظات الطفولة، وتداعيات الحلم، وهي عناصر دلالية وفنية يوظفها الكاتب قصد إيصال رؤيته إلى الوجود والحياة من حوله، وهي رؤية جمالية تبلورت في أفق ثقافة أدبية وإعلامية فنية بامتياز، ومن ثم طبعت أدب الكاتب بمياسمها الخاصة ومنحت قصصه نكهة متميزة في السردية القصصية الجديدة في مصر.