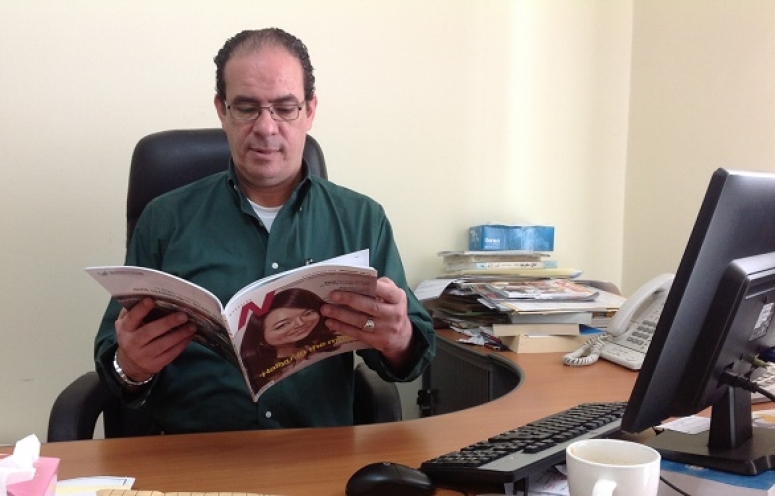العمل في الكويت عزل إبراهيم فرغلي إجبارياً، ولكنه حتي أثناء وجوده في مصر كان يبدو بعيداً طوال الوقت عن الوسط. هذا لا يعني أنه كان مختفياً بالكامل، ولكنه حينما كان يظهر لا يتحدث كثيراً. في الأغلب سيدعك تتحدث. لن يبوح لك بسر مهما تخيلت حجم الصداقة بينكما، ولن يطلعك علي قصة نادرة جرت معه. سيبدو شخصاً محايداً حتي مع صداقتكما، لقد اختار لنفسه شخصية غامضة بعض الشيء. حتي علي “فيسبوك” لن تستطيع أن تكوِّن عنه انطباعاً كبيراً، سوي أنه حاد بعض الشيء بعكس إبراهيم الآخر الهادئ في الواقع، وأنت تتحدث إليه أيضاً علي “فيسبوك” ستشعر أنك تتحدث إلي الزعيم رقم “صفر” في سلسلة “الشياطين الـ13″، بتلك الصورة “السلويت” التي وضعها بديلاً عنه. فرغلي قال لي إنه أصبح ثرثاراً بعد الأربعين، ولكنني لم أقابل تلك الشخصية التي يصفها حتي الآن.
قابل إبراهيم فرغلي الروائي رؤوف مسعد لأول مرة عندما بلغ الأخير 60 سنة، وكلمه كثيراً يومها عن فكرة مواجهة الستين، والأزمة الخاصة بمراقبة ما أنجزه، وما تبقي له من وقت، والطريقة التي يترقب بها نهاية كل عقد في العمر، وظل هذا الكلام عالقاً بذهنه، بشكل ما، ولكنه بدأ يشعر لأول مرة بقيمته بعد أن وصل إلي الأربعين. يقول: “بعد وصولي إلي الأربعين مباشرة شعرت بأنه لا يوجد اختلاف كبير عن المراحل العمرية السابقة، ربما فقط البروباجاندا عن سن النبوة وسن الحكمة، لكن المدهش أني بعد الأربعين تخلصت نسبياً، وبلا إرادة حقيقية من تحفظي تجاه الأشخاص من حولي، وزادت حدة انتقادي لهم بسخرية أظنها سببت لي مشاكل، لكنَّ القريبين تفهموا الأمر والمسألة مرت بالنسبة لهم، وعليَّ أن أعترف بأنني نضجت نسبياً في رؤيتي للحياة والفن عموماً، فبعد الأربعين كتبت (أبناء الجبلاوي) واكتشفت أني فعلاً أصبحت أكثر نضجاً بشكل ما في رؤيتي للحياة بشكل عام”، ويضيف: “بعد الأربعين أيضاً أصبحت ثرثاراً بشكل سخيف، وأحياناً أضبط روحي، علي غير عادتي، أتحدث عن نفسي. أنا في الأصل كتوم جداً وأعتبر الكلام عن الذات شبه خطيئة، لكن رغم الثرثرة ما زلت لا أستطيع توضيح أفكاري بشكل شفهي، أفتقد إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير، وعندي تردد مدهش حول ما إذا كانت أي كلمة سأقولها تعبر فعلاً عما أقصده أم لا، لكني أثرثر وأضحك كثيراً بعد الأربعين علي أي حال”. بعد إصابته بالضغط ومتاعب جسدية من الجلوس طويلاً للعمل، بدأ يتولد لديه نوع من القلق عن إمكانية أن يطاوعه الجسد في تنفيذ أفكار الكتابة المقبلة بنفس قدرته في السنوات السابقة. كان يشعر قبل الأربعين أن أفق الزمن ممتد أمامه، ولم يكن مشغولاً بالألم، حين كان لا يجد الوقت للكتابة بسبب الشغل والمسؤولية والمتاعب، وهكذا أصبح يري الأمر مقلقاً الآن بشكل ما.
لدي فرغلي إن جاز التعبير وجهان مختلفان كلياً. في الواقع هو شخص شديد التهذيب. ينصت كثيراً، رغم اعترافه بميل إلي الثرثرة بعد الأربعين. ربما لا يريد توريط نفسه أمام من يتحدثون، لكن المفارقة أنه شخص آخر علي مواقع التواصل الاجتماعي. حاد وعنيف وساخر، ولا يهتم بمن يمكن أن يُصاب برصاصاته. يقول: “الحقيقة هذه مفارقة حياتي، أنا مهذب جدا مع العالم الخارجي، وبسبب ذلك أظن أن هذا التهذيب أصبح أقرب إلي حالة نفاق اجتماعي مستمرة، لكن علي مستوي العائلة، كان معروفاً عني أنني شديد العصبية وحاد جداً وغير قادر علي ضبط غضبي. أظن أنني فقط بدأت أكبح الضغوط التي كنت أضعها مع العالم الخارجي. أظنني كنت أخاف كثيراً من العالم الخارجي، وأحاول أن أتجنب شروره بالدماثة وحسن الخلق، لكن يبدو أن مخاوف الإنسان من البشر تقل بعد الأربعين، وربما لأن تجربة الحياة البشعة واكتشاف كم القبح الذي تعايشنا معه وكم النفاق والفساد، تجعل الإنسان يقول لنفسه: علي الأقل إن لم تكن قادراً علي مواجهة كل ذلك الفساد فلتقل الآن للأعور في عينه: أنت أعور“.
يشعر فرغلي بأنه يريد أن يؤلف كتاباً بعنوان “لست من عالمكم”. صاحب “ابتسامات القديسين” عاش طفولته معزولاً عن الأصدقاء بسبب تربيته في الخليج، حيث لم يكن له أصدقاء من
نفس عمره، وبالتالي وجد في القراءة وفي الكتب وفي عالم خيالي شيده مع نفسه سعادته الذاتية وكانت الأفكار والطبيعة مصدر إلهام أو مصدر أسئلة بالنسبة له. صنع أساطير صغيرة كان يحكيها لنفسه،، وعندما عاد إلي مصر لأول مرة وكان في “أولي إعدادي” كان يري في الناس الذين أمكن لهم أن يكونوا أصحاباً، إما لأنهم جيران أو من الشوارع القريبة، وحوشاً. الخروج للعالم الحقيقي بالنسبة له كان مأساة، لأنه كان خجولاً بشكل مرضي، ربما بسبب الطفولة المعزولة عن العالم، لكنه حاول المقاومة وانخرط في شلل من عمره في عالمهم، وصولاً حتي لزيارة الغرز لتدخين الحشيش، يعلق: “ولكني كنت أعود وحيداً للكتب والقراءة من دون أن أفرض عليهم ذلك، ناظراً إلي عالمهم في النهاية باعتباره مجدباً وفقيراً“.
فرغلي الشخص الغامض بالنسبة للآخرين عاش تلك الحالة طويلاً، ولم تسمح له الظروف إطلاقاً وحتي الجامعة أن يجد أشخاصاً يتقاطع معهم، ويصير جزءاً من حيواتهم وعوالمهم، وبالتالي عندما انتقل إلي القاهرة للعمل في الصحافة انتقل إليها بنفس منطق القادم من عزلة، والمكتفي بالعزلة. يعلق: “خصوصاً وأنني صديق جيد جداً لنفسي وأستمتع بصحبة ذاتي تماماً”. وعندما بدأ في التعامل مع البشر في القاهرة عاوده الإحساس مجدداً بأنه إزاء وحوش، ولاحقاً حين توسعت الدوائر والتقي بشلة جامعة القاهرة مثلاً وجدهم جميعاً يتحدثون بلغة خاصة، ولكل شيء أو سلوك أو حتي شخص مصطلح خاص، واكتشف أن هذه اللغة تعمق من صعوبة اتصاله وتواصله معهم، وبالتالي لم يستطع الاندماج بالفعل مع أي مجموعة أو أفراد، خصوصاً أن أغلبهم أيضاً وبسبب معارفهم القديمة غالباً كان لهم أصدقاء مقربون وذكريات.. إلخ: “ولهذا لم أشعر أنني من عالمهم، ربما تكون المشكلة عندي أنا في الأساس، مشكلة عدم قدرة علي الاتصال بالآخرين“.
ولكن بهذا الشكل هل يفتقر فرغلي إلي أصدقاء تماماً؟ سواء من داخل الوسط الثقافي أو من خارجه؟ صاحب “كهف الفراشات” لا يبدو مرتبطاً بدائرة واحدة، وإنما يتقاطع مع عدد كبير من دوائر الأصدقاء، يقول: “هنا في الكويت لي صديق من شلة الجامعة اسمه أشرف وهو أقرب أصدقائي عموماً، تزوج وجاء إلي هنا عقب التخرج مباشرة، وهو كان أنتيمي أيام الجامعة وعندما نظل سنوات بدون لقاء ثم نلتقي نستكمل حوارنا كأننا كنا معاً بالأمس، لكنه ليس من الوسط، هو مهندس، يحب القراءة وكان يكتب شعراً أيام الجامعة وأحد شركائي في مجلة كنا نصدرها أيام الجامعة في المنصورة، أما الاكتشاف الآخر فكان مهاب نصر، وهو أحد أقرب الأصدقاء لي في الكويت، من أول لقاء لنا حدث ارتياح وتوطدت علاقتنا بسرعة، واستفدت منه بشكل كبير في رؤية الأمور دائماً من منظار أبعد. إنه قادر علي وضع التفاصيل في سياق عام، وهو أيضاً صاحب تجربة إنسانية كبيرة، وبخلافه لا أعتقد أن لي أصدقاء من الوسط الثقافي، بالمعني الحقيقي لكلمة صديق، أحب مصطفي ذكري مثلاً، وهناك ود كبير وتناغم بيننا، لكن انقطاعه عن العالم يصعب العلاقة، كما أنني أيضا عرفته متأخراً، كما أنني اقتربت من شخصيات كثيرة مثل ياسر عبد اللطيف، لكن لا أعتقد أنني صديق لأي منهم، حسنٌ.. تذكرت لقد تعمقت علاقتي بسيد محمود في الفترة الأخيرة، كما أن الصديقة القريبة جدا لي هي نرمين نزار، وهي ينطبق عليها تقريبا ما ينطبق علي أنتيمي أشرف، وحين نلتقي في أي وقت نستكمل حواراً قديماً مستمراً، ولكن المسافات كما تعلم .. لعن الله المسافات”، ويضيف: “اقتربت كذلك نسبياً من يوسف رخا بحكم عمله في الأهرام ويكلي، وكنت أمر عليه بانتظام، ولما انتقل للعمل في الإمارات والتقينا هناك في مناسبة ما، كنا كمن يعيد اكتشاف بعضنا الآخر أو كمن لقي لقية وأعاد اكتشافها، لكن بعد عودته للقاهرة وانشغاله مجدداً قلَّت الاتصالات، لكنه يظل ممن أعتبرهم مقربين لي، كما تشكلت علاقة اغتراب مع صديق هاجر إلي كندا هو خالد جمال. كنت أجد أيضاً درجة كبيرة من التفاهم بيننا“.
فرغلي واحد من المؤمنين بأهمية التفرغ لمشروع الكتابة وإيلائها العناية التي تتناسب وأهميتها بالنسبة للكاتب. إنه يتحين الفرصة فقط ليتفرغ تماماً للكتابة: “أعتقد أني منذ البداية أتعامل مع موضوع الكتابة بجدية، وأعرف أنها تحتاج إلي تدريب مستمر، ودأب، ولعل فترة الزواج والانشغال والمسؤولية والعمل في أكثر من مكان تعد أكثر فترات الكتابة صعوبة بالنسبة لي، علي الأقل من حيث عدم القدرة علي التعايش المستمر مع الأفكار والشخصيات، وقد كان هذا الانقطاع عن الأفكار يصيبني بإحباط وربما هلع، لكني كنت أحاول التغلب عليه باقتطاع وقت للكتابة في أي فرصة متاحة. خلال كتابة (أبناء الجبلاوي) كنت أعيش في الكويت بمفردي قبل أن تلتحق بي هايدي والبنات، وخلال تلك الفترة أتيحت لي فرصة الكتابة بشكل مستمر ولفترات طويلة، لدرجة أنني احتجت فترة طويلة للتخلص من نبرة وأصوات شخصيات الرواية، لكني لا أعتبر نفسي أنانياً، حتي لو كانت زوجتي قد تظن عكس ذلك وكان عليَّ دوماً التعامل بحكمة بين دوري كزوج وكأب محب لبناته ولقضاء الوقت معهم من قلبي فعلاً، لأن هذا من أكثر ما يسعدني،، وبين فرصة الكتابة بإخلاص، وأظن أن تفهُّم زوجتي لهذا أتاح لي أن أكتب حالياً بشكل مستمر، رغم العمل في الصحافة والانشغالات العديدة“.
ماجدة الجندي هي واحدة من أقرب الشخصيات لقلبه، أو كما يقول “بلا أي مجاملات، واحدة من السيدات اللائي أدين لهن بأفضال كثيرة. تربطني بها علاقة مزيج من الأمومة والصداقة والمحبة، وخصوصاً أنني عملت معها لأكثر من عشر سنوات وكنا نلتقي يومياً ونتحدث كثيراً في كل شؤون الحياة، وكانت تبهرني بإيلائها للأمومة أولوية أولي حتي قبل طموحاتها الشخصية، وكانت نموذجاً أيضا للدفاع عن حقك لو كنت صاحب حق”. لا يستطيع صاحب “باتجاه المآقي” أن ينسي لها موقفاً جري حين التقي بها لأول مرة بعد عودته من عمان. سألته عن أسباب قراره بالسفر إلي هناك، وأخبرها أن علاقة حب كانت تجمعه بفتاة تزوجت فجأة هي السبب في قرار السفر، وجدها وبلا سابق إنذار تغادر المكتب فجأة. جلس قلقاً لا يعرف هل أغضبتها فكرة أنه سافر من أجل فتاة، أم أن هناك مشكلة أخري. كانت في تلك اللحظة تذكرت مسألة أرادت أن تخبر بها رئيس تحرير المجلة التي كانا يعملان بها. يعلق: “لكن لحظات القلق واستغباء الذات التي تسببت فيها هذه الحركة لا أستطيع أن أنساها حتي اليوم، والمشكلة أنها عندما عادت كانت نسيت السؤال، لكن الأهم من هذا كله أنني في كل مواقف حياتي المهمة أجد وجهها أو صوتها رفيقاً، فهي التي سعت لتعييني في الأهرام، وكانت بجواري في كثير من المواقف الصعبة في حياتي ولها أدين بالكثير“.
كنت مندهشاً أيضاً لأن فرغلي لم يأت علي ذكر الفنان أحمد اللباد، الذي أعرف أن علاقة مهمة جمعتهما في الأهرام، خصوصاً في تجربة »علاء الدين«. علي الأقل عمله في هذا المكان قربه منه. أول مرة قابل اللباد الصغير كانت في جلسة دعاه إليها اللباد الكبير، الفنان العظيم محيي الدين اللباد. كان الموعد في “امفتريون” وكان اللباد الكبير سيلتقي بفنانة فرنسية أحب أن يعرف فرغلي إليها، ولاحقاً مر عليهم أحمد، يقول: “كنت أراقب علاقة الصداقة البديعة بين الأب والابن بانبهار، كان اللباد الكبير يتعامل بحنو بالغ مع الابن، كصديق يحبه ويعامله كند، وأعتقد أن هذه هي المرة التي بدأت معها علاقتي باللباد الصغير، واقتربنا كثيراً خلال الفترة التي زاملنا فيها في الأهرام، مديراً لتحرير مجلة (علاء الدين) وكنا نتحدث في شؤون كثيرة لكني كنت دوماً أحب كلامه عن صناعة الغلاف ووجهة نظره فيها، لأني كنت قد استمعت لأفكار اللباد الكبير حول الموضوع وكنت أود أن أعرف كيف تشرَّب اللباد الصغير الصنعة وكيف صنع بصمته الخاصة، والحقيقة أن لقاءات ثلاثية عديدة جمعتني مع اللباد وماحدة الجندي في مكتبها، كانت تدور خلالها نقاشات حيوية عديدة، لكني كنت أشعر بالغيظ الشديد لأن ماجدة الجندي كانت تناديه دوما با أستاذ أحمد بينما تكتفي بالنداء عليَّ باسمي يا إبراهيم”. ولكن ألم يتعرض فرغلي لديكتاتورية اللباد الصغير؟ هل جرؤ علي أن ينتقده يوماً ما وفتح علي نفسه أبواب جهنم؟ يقول: “صحيح. إنه ديكتاتور، ولكن أنا كنت دائماً أحاول بخبث أن أناوش فيه هذا الديكتاتور، وصحيح أن العلاقة معه دائماً شعارها (من خاف سلم) لكن كنت أعرف أن مساحة التقدير المتبادل كانت تمنحني فرصة أن أحدثه بصراحة، ولكن مع الاعتراف أيضاً بأنه هو الآخر لا يكشف نفسه بسهولة لأحد”. يحكي: “أتذكر مرة حدثت مشكلة ما، ومدام ماجدة كانت غضبانة مني لسبب ما نسيته، وهو تدخل يومها بشكل أشعرني بأنه يريد إشعال غضبها بزيادة، فذهبت إليه وقلت له: أنا ممكن أرميك من الشباك ده، ولا أدري كيف واتتني الجرأة بصراحة لأفعل هذا، والمدهش أنه في عز الخناقة انشغل بتبرير موقفه أكثر من موضوع الشباك“.
يري صاحب “أبناء الجبلاوي” أن فكرة الجيل كانت تبدو براقة في البداية، نوعاً من الإحساس بالانتماء لمجموعة ما. لكن سرعان ما تبدد هذا الإحساس، لأن تقسيم الجيل كان مبنياً علي فكرة العمر، أكثر من طبيعة الكتابة. في جيل التسعينيات، كما يقول، هناك كتابة تجريبية وكتابة كلاسيكية ومحاولات حداثية، لكن لا تستطيع كما فعل البعض ليَّ هذه النصوص ووضعها في سلة واحدة، وما يمكن تأمله من تشابه في هذه الأعمال لم يُكتب بعد، وهو الخطاب الضمني، من حيث علاقته بالسلطة مثلاً، أو من حيث بحثه عن لغة تعبر عن اختلال وتغير القيم، فقد يكون هذا خطاً حقيقياً يجمع عدداً من كتاب جيل التسعينات، ويستدرك: “لكن من يلتفت لهذا من النقاد قلة بينهم للأمانة الدكتورة ماري تريز عبد المسيح”، ويضيف: “أظن أن الكاتب في سن متقدمة يبحث عن أشباهه في تجارب الكتابة بشكل عام. حتي لو كانوا ينتمون إلي جغرافيا أخري أو لغة أخري. مثلاً أظن أنني أنتمي لكتاب مثل بول أوستر وساراماجو، وكالفينو، وهيرمان هسه. إنهم مبدعون يرون في الكتابة مغامرة وتجريباً مستمراً، ويحاولون إيجاد التوازن بين الفكرة واللغة والتركيب ورؤية شمولية للعالم”، ولكن ألا يوجد كتاب مصريون أو عرب؟ يجيب: “إدوارد الخراط كان ملهماً في فترة معينة، هناك (اللجنة) لصنع الله إبراهيم، والكتابة الإيروتيكية عند رؤوف مسعد، خصوصاً في (صانعة المطر)، أظنها من الكتابة التي أنتمي إليها أيضاً”. وماذا عن علاقته بالستينيين؟ يجيب: “علاقتي جيدة بأغلبهم، أحب من بينهم كتابات بهاء طاهر وصنع الله والغيطاني، ورؤوف مسعد، وتجمعني بكل هذه الأسماء علاقات تقدير ومحبة ومودة كبيرة. خصوصا صنع الله الذي أحب قراءة أعماله حتي لو اختلفت معها فنياً“.
الخوف هاجس كبير في حياته، ويظن أن تلك الحياة محاولة للتغلب علي الخوف، من المرض أو المستقبل، ومع ذلك يتعامل مع كل شيء بأنه وارد تماماً. الموت طبعاً سؤال كبير بالنسبة له، لكنه يتعامل معه بمنطق أنه الزائر المتوقع باستمرار، عنده إحساس دائم بأنه مستعد دوماً للموت، وحلم مؤخراً بأنه يموت، واستعاد كل تجاربه في مواجهة الموت وتخلص من كل ما يتعلق به في الحياة، لكن في اللحظة الأخيرة تذكر أن هناك كتاباً مهماً يقرؤه ولا يصح أن يموت بدون أن يكمله، وحينما استيقظ بات مشغولاً بفكرة مصير معرفة الشخص بعد الموت، الروح التي غادرت الجسد وهي ممتلئة بالمعرفة والفرق بينها وبين روح فقيرة المعرفة، وهذا سؤال جديد انضم لهاجس الموت.
في السفر لدي فرغلي استعداد للمغامرة والتجارب، لكن في بقية الأمور يمتثل للنمط العادي من الحياة، ولديه شعور مبالغ فيه بالمسؤولية. السفر مهم جداً في حياته، لأن نشأته من الأساس خارج مصر كان دائماً تمنحه فرصة ليري مصر من الخارج. يقول: “عمري ما صدقت أوهام الريادة والشيفونية المصرية، وكانت لديَّ القدرة دائماً أن أري مصر في حجمها وألا أخلط بين الوطنية والشيفونية، وطبعاً السفر للعمل يمنحني الفرصة المستمرة لمراقبة مصر من بعيد وبدون تأثير الحياة اليومية فيها، لكن السفر لغير الإقامة كان يزيد من إحساسي بأهمية تأمل البشر من منطق احترام كل تجربة إنسانية وتأملها وتأكيد إحساسي بأن ما أنتمي له في مصر للأسف مدفون في مدن تحت الأرض لم يستطع المصريون أن يكشفوا عنها بعد“.
هناك كتاب يؤكدون أن عملهم في الصحافة عطل مشروعهم الإبداعي، ولكن فرغلي بطاقته المدهشة وتنظيمه البالغ استطاع الجمع بين عدة أعمال في فترة ما، مع تخصيص جزء لا بأس به من وقته للكتابة. يقول: “العمل في الصحافة رغم أنه يأكل الوقت ويحول حياتك إلي مزيج من العمل المستمر، أي لا فاصل بين الحياة الخاصة والعمل، لكن فائدته كبيرة، أولاً في الخبرات ونوعيات البشر التي يُتاح لك معرفتها، والتحرك بين جغرافيا غير محدودة، غالباً ما تكون ملهمة بشكل أو آخر”. القصة القصيرة بالنسبة إليه فن خاص جداً، أقرب إلي روح الشعر، لأنه غالباً يأتي كدفقة، أو ومضة، القصة باختصار محاولة لتقريب عدسة مكبرة من مقطع من الحياة وتوسيعها حتي تنفجر بالضوء، أما الرواية فبناء كبير ومعقد، وتحتاج لصبر وتفكير، ومحاولة للإمساك بروح العالم وصياغتها فنياً. يقول: “القصة ربما أقرب لي“.
وأخيراً ماذا عن طموحاته؟ يجيب: “نص جديد لا يتسع لطموحاتي، أنا لم أحظ بتقدير أو جوائز إلا جائزة ساويرس مؤخراً حتي زهدت. تكفيني هذه الجائزة وزيادة، وأظن المشكلة اليوم بالنسبة للكتاب أكثر تعقيداً بكثير من موضوع الجوائز. العالم العربي يتغيَّر ويتشكل، والقيم أيضاً، ووضع الكاتب لم يعد نفسه كما كان. كل شيء تقريباً يتغير، ولذلك فإن الأهم حالياً أن يظل الكاتب مخلصاً لقيم الكتابة التي يؤمن بها بعيداً عن كل هذه الضوضاء والضجيج الذي يمكن أن يشوش أعتي العقول“.