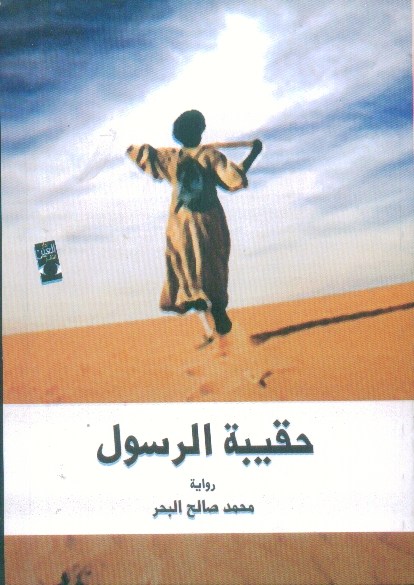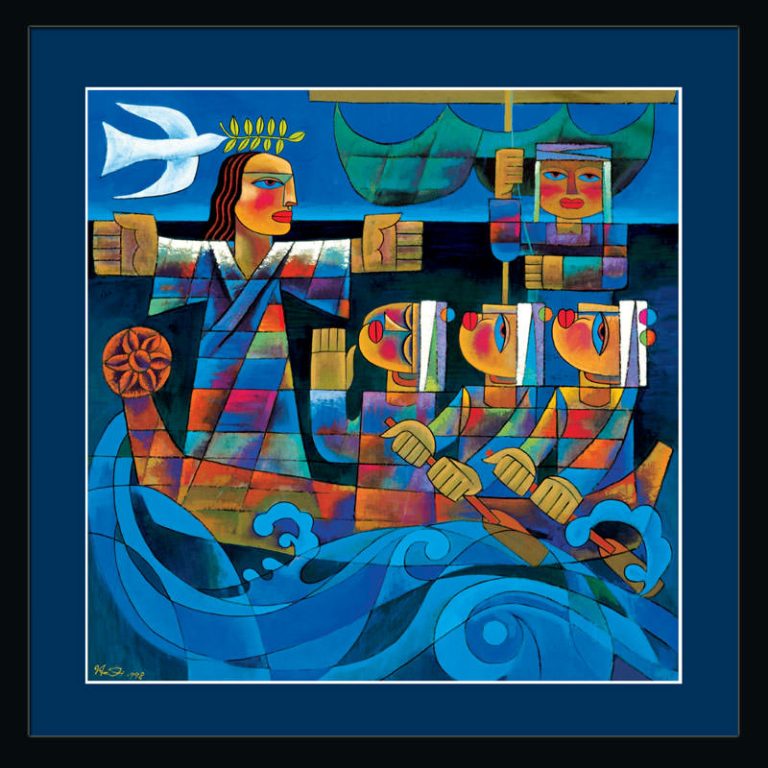د. محمد السيد إسماعيل
ينظر السلفيون إلى الحداثة بوصفها أداة هدم وتخريب وتجريف للهوية الإسلامية كما يتصورونها وهو أمر متوقع نظرا لهيمنة الفكر الماضوى على العقل السلفى الذى يعتمد على “النقل” و”تقديس” التراث والفزع من إعمال العقل، ويتضح ذلك من وصف دكتور محمد مصطفى هدارة للحداثة بأنها “اتجاه فكرى أشد خطورة من الليبرالية والعلمانية والماركسية وكل ما عرفته البشرية من مذاهب واتجاهات هدامة لأنها ثورة كاملة على كل ما كان وما هو كائن فى المجتمع” ( نقلا عن “الشيطان وتجديد الفكر الدينى” نبيل عمر ص 116دار غراب للنشر والتوزيع )
وربما كان من الدال أن نشير إلى أن هذا الوصف الإنشائي غير العلمى الذى ورد فى مقال “الحداثة فى الأدب العربى” للدكتور مصطفى هدارة كان منشورا في مجلة الحرس الوطنى السعودية، وإذا كان د.هدارة يتحدث عن الحداثة فى الأدب العربى فإن عوض محمد القرنى يضعها فى ميزان الإسلام فى كتاب كامل يحمل عنوان “الحداثة فى ميزان الإسلام” حين يقول “… ومن هذه الأفكار التى ابتليت بها الأمة وبدأ خطرها يظهر فى ساحتنا مذهب فكرى جديد يسعى لهدم كل موروث والقضاء على كل قديم والتمرد على الأخلاق والقيم والمعتقدات وهذا المذهب أطلق عليه كهانه وسدنة أصنامه اسم الحداثة” ( نقلا عن السابق ص117)
وبهذا الفهم الذى لايقدم دليلا واحدا على صحته يصف الحداثة الغربية بأنها “نمت وترعرعت على أيدى الشيوعيين من أمثال: نيرودا ولوركا وناظم حكمت وفتشنكو والوجوديين أمثال سارتر وسيمون دى بوفوار وألبير كامو وآتت أكلها على أيدى الجيل المنظر والداعم لها والمحفز على السير فى ركابها من أمثال: لوى أراجون وهنرى لوفيفر وأوجين جراندال ورولا بارت ورومان ياكوبسون وليفى شتراوس وبياجيه وغيرهم كثر ” ( السابق ) وبغض النظر عن التباينات العديدة بين توجهات هذه الأسماء وأفكارها التى وضعها كلها فى سلة واحدة أو فى قفص اتهام واحد، فإننى أكاد أكون على يقين بأنه لم يقرأ واحدا منهم لأنه لو قرأ – وهذا بعيد جدا – ماكال مثل هذه الاتهامات التى تجافى لغة العلم والموضوعية ورحم الله محمد عبده ومحمد فريد وجدى ومحمد حسين هيكل فى مجادلاتهم العقلانية التى تواجه الحجة بالحجة مع مخالفيهم من العرب والغربيين.
فما الحداثة إذن؟
الحقيقة أننى عندما فكرت فى الاقتراب من تصور ما للحداثة – وسوف أقصر كلامى على الحداثة الشعرية بوصفها تمثيلا للحداثة بشكل عام – لم أجد وسيلة إجرائية أفضل من مقارنتها بمجموعة من المفاهيم التى تقع فى دائرتها الدلالية مثل التجديد والمعاصرة على سبيل المثال أو المفاهيم التى تقع – فى النظرة السائدة – خارج دائرة الحداثة أو على النقيض منها مثل الأصالة مثلا، وكان من نتائج هذه المقارنات – وهو مالم يعد من الاكتشافات ذات الخطورة الآن – أن الحداثة لاتعنى مجرد التجديد إذا كان هذا التجديد استنساخا لنموذج غربى أو مجرد المعاصرة إذا كانت تعنى فقط مجرد ” الوجود فى العصر “، وأنها – أى الحداثة – لاتتناقض مع الأصالة التى تعنى – أساسا – الصدور عن الذات وتأكيد فاعليتها.
وبهذا الفهم لاترجع إشكالية ” الحداثة ” – فى تصورى – إلى ذلك التاريخ الذى بدأت فيه حركة شعر التفعيلة بل ترجع – أساسا – إلى دهشة الإنسان المصرى أمام ماصحبته الحملة الفرنسية من منجزات علمية الأمر الذى بدأ معه الالتفات إلى الآخر الغربى والحديث عن ” الحداثة ” تحت أسماء مختلفة اللفظ متقاربة الدلالة كالنهضة والتحديث والمعاصرة.
بدأت صدمة ” الحضارة ” أو صدمة الحداثة بتعبيرات أدونيس إذن منذ ذلك الحين دون أن تنتهى بنا إلى موقف واضح فى التعامل معها، حيث آثر البعض ( الاتجاه السلفى ) الرجوع إلى التراث والنقل عنه دون الإضافة إليه أو مراجعته وآثر البعض الآخر ( الاتجاه التغريبى ) احتذاء الحضارة الغربية بل محاولة التماهى معها وآثر فريق ثالث ( الاتجاه التوفيقى ) محاولة الجمع بين الموقفين السابقين على نحو ماأشرنا فى مقال سابق، والملاحظ على هذه التوجهات الثلاثة أنها قد بدأت – وهو مايلقى بظلاله حتى اللحظة الراهنة كما بدا فى الاقتباسات السابقة – متناحرة بما يعنى استبعاد معانى الحوار الإيجابية واعتماد أحادية النظرة والاكتفاء ب”الذات ” ورؤاها كأنها جزيرة معزولة أو كأنها ” نموذج أعلى ” ينبغى على الآخر الإيمان به كاملا دون شرط واحد بل ينبغى على الواقع نفسه وبأسره أن يسعى لاستشرافه والارتقاء إليه.
وهنا – تحديدا – تكمن الأزمة التى لانزال نشهد العديد من امتداداتها الأكثر تطرفا، أزمة الاكتفاء بالذات وإلغاء الآخر أزمة مفارقة الواقع وغلق باب الاجتهاد أزمة الاعتقاد الواهم بأن كل شىء جاهز هناك عند السلف الصالح أو هناك عند الآخر الغربى
والحقيقة أن الرؤية الصحيحة للحداثة هى القادرة على تجاوز هذه الأزمة بمستوياتها المختلفة لأن سؤالها الأول الذى توليه الأهمية هو : كيف نقف على أقدامنا وكيف نعيش لحظتنا التاريخية ؟ حيث لم يعد الأمر محصورا فى تلك الثنائية الإشكالية التى طرحها رواد النهضة ولانزال نجترها على النحو نفسه تقريبا كأنما قد قيدت خطواتنا على نحو ماكان يرانا – حقا – صلاح عبد الصبور فى قوله :” أقدامنا أثقل من أن تنقل الخطا / وإن خطت تشابكت / ثم سقطنا هزأة كبهلوان “.
أقول لم يعد الأمر محصورا فى هذه الثنائية بل أصبح يتطلب المعرفة الكاملة العميقة التى تسبق الانتخاب الواعى، هذا الانتخاب الذى يتحدد بمتطلبات اللحظة التاريخية التى نعيشها ويحضرنى فى هذا الصدد رأى لتوفيق الحكيم يؤكد فيه عدم فهمه لمعنى المفاضلة بين ” قديم ” و” حديث ” قبل اكتمال المعرفة بهما.
والحق أن معركة ” الحداثة ” قد تجسدت بجلاء فى معركة شعر التفعيلة -أو الشعر الحر كما كان شائعا فى البداية – منذ الأربعينيات وذلك لأنه كان أكثر الأجناس الأدبية استجابة لمتغيرات اللحظة فى هذه الفترة الحرجة كما كان مجسدا – بوضوح – لصراع الرؤى المختلفة وكأنه صورة مركزة لخلاف فكرى أشمل، حيث كان شعراء هذه المرحلة أقرب إلى صورة الطليعة الثقافية التى تدفع دورة التقدم
ولم تبالغ الشاعرة الفلسطينية سلمى الجيوسى عندما قالت – فى تعبيرها عن وضعية الشعراء فى هذه المرحلة – ” لقد حملنا العبء الكبير ” وذلك لأن رواد هذه الحركة الحداثية قد واجهوا – ولايزالون يواجهون – مجموعة من الاتهامات التى تجاوزت ” الأدبى ” إلى السياسى والعقائدى من قبيل الاتهام بالشيوعية والإلحاد ومحاولة هدم التراث وتهديد الهوية كما بدا فى تقرير لجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب فى ذلك الوقت.
والحق أن رواد هذه الحركة الشعرية قد بدأوا معركتهم مع أصحاب الرؤى المناهضة بوعى متفتح لايعرف التعصب ولعل هذا هو السبب فى اقتراح صلاح عبد الصبور تسمية هذا التيار الشعرى بالشعر الجديد بما يعنى – صراحة – إيمانه بتحقق تجليات حداثية أخرى سابقة على مدار الشعر العربى وإمكانية بل ضرورة تحقيق تجليات حداثية أخرى فى المستقبل.
إن هذا الوعى الذى يؤمن ولا يصادر أو يؤمن ولا يدعى هو الذى مايز بين موقف رواد هذه الحركة التحديثية الأولى وموقف العقاد وعزيز أباظة وصالح جودت وغيرهم الذين رأوا فى الشعر نظاما أزليا وكينونة مقدسة لا ينبغى المساس بها وهو أمر أو مفهوم يتناقض مع فاعلية “الإبداع” الذى هو جوهر “الحداثة” الأول، وما دمنا قد انتهينا إلى ذلك التماهى بين الحداثة والإبداع فإننى أرى في ذلك أساسا قويا لإمكانية الخروج على ثنائية الأصالة والمعاصرة الموهومة وإمكانية أن نستبدل بها ثنائية أخرى أكثر جدوى وعمقا في تعاملنا مع التراث أو معطيات الحضارة الحديثة على السواء وأعنى بها ثنائية الإبداع والاتباع التي تفتح – بتغليب طرفها الأول – أبواب الاجتهاد والإضافة والتجديد.