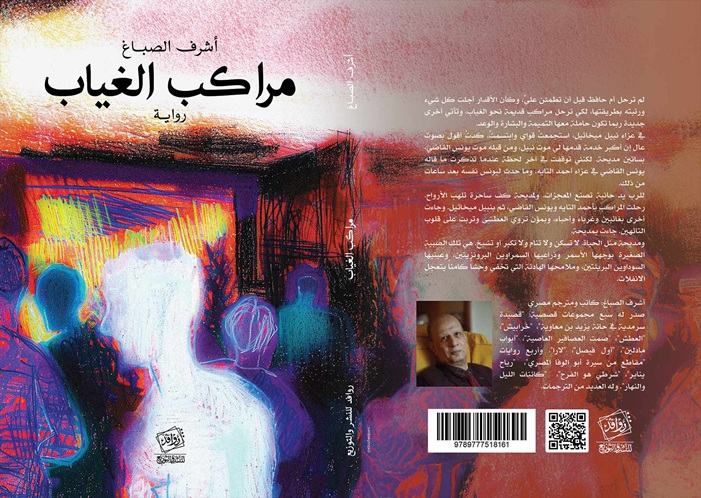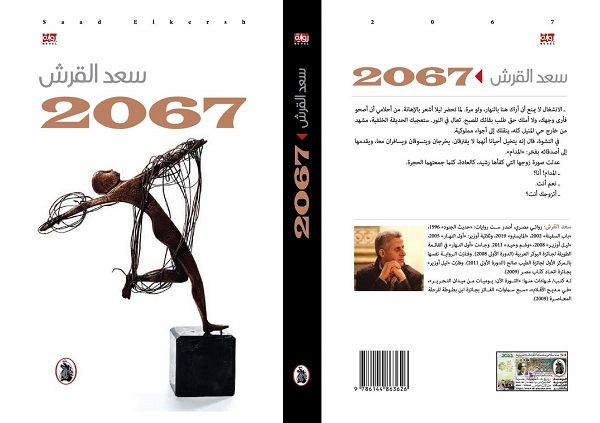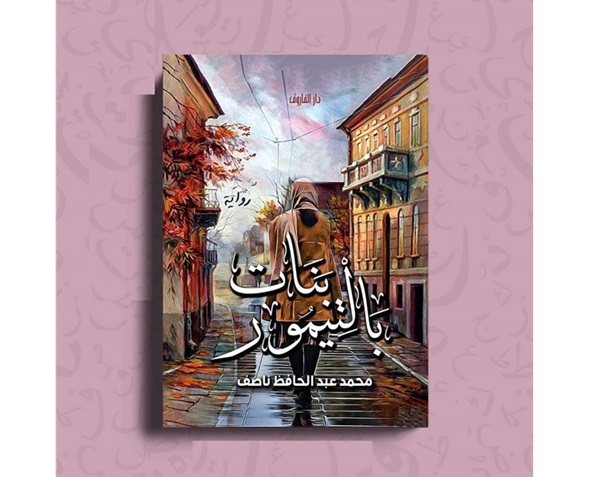عثمان بن شقرون
تقديم:
ماذا لو قرر كاتب أن يختفي؟ ليس فقط عن المنابر، بل عن العالم برمّته؟ أن يتلاشى كما يتلاشى الحبر في مخطوط قديم، أو كما يندثر أثر الأقدام في الثلج؟ هذه ليست فرضية خيالية، بل هي حياة عاشها الكاتب السويسري روبير فالزير عن وعي وإصرار وترصد، واختار فيها الانسحاب التام من المشهد الأدبي والاجتماعي، حتى غدت عزلته النهائية في حدّ ذاتها بيانًا جماليًا، أو شكلًا من أشكال الكتابة الصامتة.
هذا التلاشي الغريب والغامض هو ما يجعل رواية الدكتور باسافينتو (2006)، للكاتب الإسباني إنريكي فيلا-ماتاس، أكثر من مجرد سيرة متخيّلة. فالرواية الصادرة عن دار أناغراما تُعدّ جزءًا من ثلاثيته عن محنة الكاتب الحديث، حيث نرى الراوي، وهو كاتب لا نعرف اسمه أول الأمر، وهو يسافر إلى مدينة مونترو السويسرية، مهووسًا بشخصية روبير فالزير، ومندفعًا شيئًا فشيئًا إلى تقمّص حالته… إلى أن يتبناه تمامًا تحت اسم مستعار: الدكتور باسافينتو.
بهذه الحبكة المتداخلة بين السيرة والهوية والانتحال، تتيح الرواية “الدكتور باسافينتو” للقارئ أن يعيد اكتشاف روبير فالزير، لا عبر أعماله مباشرة، بل من خلال ظلاله، من خلال هذا التقمص المهووس الذي يمارسه الراوي في زمن مغاير. وهنا تكمن فرادة النص. إنه لا يُحيي فالزير كمجرد مرجع أو شخصية أدبية، بل يحوّله إلى تجربة معيشة وإلى مشروع وجودي. فهل يمكن للكاتب المعاصر أن يكرر اليوم فعل الاختفاء؟ هل بإمكانه، أن يفعل كما فعل فالزير، أن ينجو من “احتقار العالم”، بالتلاشي الكامل؟
في هذه المقالة، سنقتفي هذا الأثر الفالزيري في رواية “الدكتور باسافينتو: للروائي الإسباني إنريكي فيلا ماتاس، ونقارن بين مصيري الرجلين، كما سنسائل معنى التلاشي الأدبي، أهو خلاص أم انتحار بطيء؟ أهو كتابة أم انمحاء؟ وسنحاول، عبر هذا التحليل المتواضع، أن نلامس حدود هذه الهوية السائلة التي تنكتب بالغياب.
مأزق الغياب في عصر الاتصال
لا يكتفي إنريكي فيلا-ماتاس في روايته الدكتور باسافينتو، باستحضار شخصية الكاتب السويسري روبير فالزير، بل يُقيم معها حوارًا وجوديًا وأدبيًا عميقًا، يجعل من فالزير، لا مجرد مرجع أو أيقونة، بل “بطلًا أخلاقيًا” للرواية. ذلك أن فالزير، الكاتب الذي اختار التلاشي الكامل والانزواء داخل مصحة نفسية في هيريسو خلال السنوات الثلاث والعشرين الأخيرة من حياته، جسّد أقصى ما يمكن أن يبلغه كاتب في رفض الشهرة والمؤسسات الأدبية، وابتكار معنى للحياة خارج كل سلطة. يمشي باسافينتو، بطل الرواية، على خطى فالزير، لا من باب المحاكاة السطحية، بل كتجربة وجودية موازية. أن تتلاشى، أن تختفي، أن تصبح شخصًا لا يُرى، لا يُطلب، ولا يفكر فيه أحد. لكن باسافينتو يكتشف المفارقة المؤلمة، ذلك أن الغياب لا يكون غيابًا حقًا إذا لم يلحظه أحدٌ. والتلاشي الذي لا يُفتقد يبقى ناقصًا ومعلقًا، وربما عبثيًا. فالزير نفسه، رغم اختفائه، صار بعد موته حضورًا هائلًا في الأدب المعاصر، لا لشيء سوى أن غيابه اكتسب دلالة شعرية وفكرية، فصار يُستعاد باعتباره أسطورة النكران والمحو الطوعي.
زار فيلا-ماتاس المكان الذي عاش فيه فالزير، المصحة المشرفة على بحيرة هيريسو، حيث يحيط الصمت بجمال طبيعي أخّاذ. وجد قبر فالزير أيضًا مُبعدًا عن باقي القبور، كما لو أن التهميش امتد حتى بعد الموت، ليغدو قدرًا متواصلًا. لكنه أيضًا رمز وشكل من أشكال الصمت الجمالي الذي اختاره الكاتب عن سبق إصرار، تمامًا كما فعل في كتابته الأخيرة حين كان يخط نصوصه بالقلم الرصاص، بخط صغير جدًا على قصاصات ورق مهملة: تذاكر ومغلفات وأجزاء من جرائد قديمة وأظرفة… يكتب حتى ينفد الورق، كأن العالم يضيق، والصوت يختفي، واللغة تتحلل.
باسافينتو ليس “دون كيشوت” ولا “ألونسو كيخانو”، كما يقول السارد، بل هو ظلّ فالزير وتجلٍّ حديث لفكرته المتطرفة عن العدمية الأدبية. إنه صورة لرغبة الكاتب العميقة في الإفلات من التهريج العام، ومن عبودية الصورة، ومن المؤسسة التي تصنع من الكاتب نجمًا. يقول فيلا- ماتاس إنه، بخلاف فالزير، مضطرّ إلى أن يكون “وجه الرواية” أمام الجمهور، بينما كان فالزير يختار أن يتوارى حتى عن ظله. ومع ذلك، لا تتوقف الرواية عند تأمل عزلة فالزير، بل تفتح سؤالًا فادحًا: هل يمكن، في زمن الاتصال الكلي، أن نختفي حقًا؟ وهل للغياب معنى إن لم يُلاحَظ؟ كيف يمكن للتلاشي أن ينجو في عالمٍ تُقاس فيه الوجودية بمدى الحضور الرقمي والتفاعل الاجتماعي؟ ربما لم يعد الاختفاء ممكنًا إلا كتمثيلٍ، كمحاكاة هشّة لغيابٍ حقيقي يرفضه الواقع في كل لحظة. بهذا المعنى، لا تُقرأ رواية “الدكتور باسافينتو” كرواية عن فالزير فحسب، بل كتأملٍ في مأزق الكتابة المعاصرة نفسها: التعلق باللاشيء كقيمة، والتوق إلى التلاشي كخلاص. إنها رواية انسحابٍ تُلهم بقدر ما تُرعب، وتظلّ مفتوحة على سؤال الغياب.
باسافينتو قناع للعبور من الذات إلى الفراغ
في رواية الدكتور باسافينتو، لا نجد كاتبًا يسرد سيرة أو يقدم بطلًا يتطور عبر الحبكة، بل نواجه طيفًا يسير على هوامش الحياة والأدب، طيفًا لا يبحث عن الظهور بل عن التلاشي. باسافينتو ليس شخصًا حقيقيًا، بل «قناع» يرتديه كاتب قرر أن يختفي من ذاته، وهو ما يصرّح به بنفسه: «أردت أن أختفي، أن أمحو أثري، أن أكون مجرد فكرة غامضة تمرّ في ذهن أحدهم.» (ص 21). هذا الانمحاء الإرادي يذكّرنا بروبير فالزير، الذي كتب ذات مرة: «أرغب في أن أكون لا أحد، أن أعيش كما تعيش نملة خلف ورقة.» عبارة تناظر، حد التطابق، هواجس باسافينتو الذي يعلن صراحةً: «إنني أطمح إلى أن أكون هامشًا في كتاب مهمل، أو رمادًا في درج منسي.» (ص 63). ليست الرواية إذًا عن باسافينتو فحسب، بل عن شبح فالزير الذي يتسرّب في كل نفس من أنفاس السرد، لا بوصفه شخصية مُستحضرة، بل ككيان يتقمص النص ويعيد تشكيله من الداخل. يتحدث باسافينتو عن نفسه بصيغة المنحلّ والمتبخّر، ويقرّ أكثر من مرة أنه لا يملك «رغبة في الحضور»، وأن اسمه ذاته قد يكون وهمًا: «أنا لا أوقّع باسمي. لا أعرف إن كنت أملك واحدًا. باسافينتو ليس أكثر من ستار دخاني.» (ص 89). بهذه العبارات، تنقلب الرواية إلى تجسيد لتجربة الاختفاء، لا كموضوع روائي، بل كجوهر وجود. وكما انسحب فالزير من الحياة العامة إلى صمت المصحة، ينسحب باسافينتو من اللغة الصاخبة إلى صدى لغوي هامس، يعيد رسم ملامح الغياب بوصفه شكلًا من أشكال الوجود المتعالي.
منذ اللحظة الأولى في دكتور باسافينتو، يُدرك القارئ أن الهوية لم تعد معطًى ثابتًا بل مسرحًا للتحوّلات والتقمّصات. لا تُقدَّم الشخصية المحورية باسم واحد، بل تلبس أسماء متعددة: سيزار أيريا، دكتور باسافينتو، رافائيل دي لا كروز… وحتى حين يُذكر اسمه الأصلي – إن وُجد فعلاً – فإننا لا نلمسه إلا من خلال أقنعة. «إن لم أختفِ، فلن أستطيع أن أكون أحدًا آخر. وإن لم أكن أحدًا آخر، لن أكون أبدًا أنا.» (ص 46) هكذا تصاغ المعادلة الجديدة للهوية: أن تكون هو، لكي تكون أنا. أو بتعبير معكوس: لا تتحقق الأنا إلا بنفيها. يُذكّرنا هذا بالاستراتيجية الفالزيرية التي كثيرًا ما تتوسل بالتواضع والتضاؤل والتمويه، لتدوير فكرة الحضور في غلاف الغياب. الكاتب يصبح بطوعه هامشيًا، لا لأنه لا يملك شيئًا ليقوله، بل لأنه يعي أن المركزية قاتلة، وأن الاسم قد يُقيد أكثر مما يُحرّر. لم يكن التواري عند روبير فالزير مجرّد سلوك اجتماعي أو حالة نفسية، بل خيارًا وجوديًا. لم تكن أسماؤه الأدبية سوى قناع للاحتماء من خطر الظهور. أما في حالة باسافينتو، فإن انفصاله عن اسمه الأصلي يتحول إلى فعل كتابي بامتياز. يقول: «أنا أكتب لكي أنسى من أكون. لأجرّب أن أكون شخصًا لا يشبهني.» (ص 78) بل إنّ باسافينتو لا يتقمّص شخصية فالزير فقط، بل يبدو أحيانًا كأنه أعاد تجسيده روائيًا، عبر مسار التقلّص والانسحاب الذي يقوده إلى العيادة النفسية، كما لو كان يسير حذو الخطى إلى مصير يشبه ما حدث لفالزير نفسه، حين دخل مصحة هيريساو وبقي فيها صامتًا لأكثر من عشرين عامًا. في هذه الثنائية بين “الأنا” و”الهو”، لا نعود نعرف من يكتب من، ولا من يحكي باسم من. تتداخل الأصوات وتُمحى الحدود بين الأصل والظل، بين القائل والمنتحل، لتصبح الرواية كلها تجربة عبور، من الهوية نحو الفراغ.
الجنون كخيار وجودي وصرخة صامتة ضد معايير العالم
في رواية الدكتور باسافينتو، لا يُطرَح الجنون كمجرد حالة مرضية، بل يُستعاد بوصفه تجربة حدودية، أو طريقًا للانفلات من القبضة الصارمة للعقلانية والمؤسسات. إن الكاتب الذي يدخل طوعًا إلى مصحة للأمراض النفسية لا يبدو مجنونًا، بل هو واعٍ تمامًا بما يفعل، كمن يضع نفسه داخل قوسين ليعيد النظر في موقعه، وفي معنى أن تكتب داخل عالم تحكمه المعايير الصارمة. «أدخل إلى العيادة النفسية لأني أرغب في أن أتعلّم الصمت، أن أختفي عن كل شيء. الجنون ليس مرضًا، بل هو شكل آخر من الحضور.» (ص 102) يُحيلنا هذا المقطع إلى التجربة الحقيقية لروبير فالزير، الذي انسحب إلى مصحّة عقلية وبقي فيها حتى وفاته، رافضًا العودة إلى الحياة الأدبية. لم يكن فالزير غائبًا عن الكتابة فقط، بل غائبًا عن الحاجة إلى الكتابة، وكأنّ الصمت هو شكل الكتابة النهائي، والأكثر صدقًا. عند فيلا ماتاس، يبدو باسافينتو مأخوذًا بهذه الرغبة في الجنون النبيل، لا بوصفه انهيارًا نفسيًا، بل قطيعة جذرية مع العالم. الجنون هنا هو الاسم الحركي للاعتراض. دخول المصحّة ليس إذعانًا، بل رفضًا لكل ما هو مألوف. إن الرواية تسائل نفسها من الداخل: هل يمكن للكتابة أن تستمر دون أن تصطدم بجدار العقل؟ وهل الجنون هو المآل الأخير لكل كتابة صادقة؟ لا يخلو هذا التوازي بين باسافينتو وفالزير من بعد تراجيدي. الأول يضع نفسه داخل الجنون كتابةً، والثاني عاشه صمتًا. لكنّ الاثنين التقيا في ما يمكن تسميته بـ”الانسحاب الكبير”، ذلك الفعل الصامت الذي يحتجّ أكثر مما تقول الكلمات. وهكذا يغدو الجنون ليس فقط موضوعًا روائيًا، بل أيضًا موقفًا وجوديًا وأدبيًا، يُعيد تعريف العلاقة بين الذات والعالم.
التلاشي الأنيق كممارسة جمالية ومناهضة للغرور الأدبي
منذ الصفحات الأولى في الدكتور باسافينتو، تظهر الكتابة لا كأداة لإثبات الوجود أو ترك الأثر، بل كوسيلة للانسحاب والانمحاء والاختفاء الطوعي. لا يكتب الراوي ليُعرَف، بل ليُمحى، تمامًا كما فعل فالزير الذي رفض الشهرة والظهور، واختار أن يكتب في الظل، بل أن ينسحب في صمت حين شعر أن الكتابة لم تعد تعبّر عنه. «أكتب لأتوارى… فالكلمات، حين تُقال، لا تعني دائمًا الرغبة في أن تُسمع.» (ص 57) هنا تتجلى مفارقة باسافينتو: هو يكتب رواية عن رغبته في ألا يكتب، يخطّ سطورًا عن حاجته إلى الصمت، يصطنع اسمًا مستعارًا ليقول ما لا يريده أن يُنسب إليه. في هذا المعنى، تُصبح الكتابة تمرينًا على التلاشي، على التخلي، لا على الامتلاك أو التوقيع. روبير فالزير كان قد قال في أحد نصوصه: «كل ما أريده هو أن أكون ضئيلًا، أن أمشي دون أن يراني أحد.» هذه الجملة تصلح لتكون شعارًا مشتركًا بينه وبين باسافينتو. كلاهما يطارد أثرًا لا يريده أن يُلتقط، يكتب في لحظة يريد فيها أن يختفي، يحوّل فعل الكتابة إلى عملية محوٍ مستمرة، لا تكدّس الوجود بل تفتّته. وعلى هذا النحو، فإن الرواية ليست فقط تحية لفالزير، بل هي تمثّل للكتابة بوصفها عبورًا نحو العدم، نحو الاختفاء الأنيق. إنها كتابة ضد الغرور الأدبي وضد الهوس بالظهور، وضد الأثر الذي يتضخّم بفعل الأنا. تقول رواية الدكتور باسافينتو للقارئ: ربما تكون أعظم أشكال الكتابة تلك التي تتركك دون كاتب، بلا توقيع، بلا تمثال يُقام له لاحقًا.
فن الغياب والأدب الهامشي احتمال خلاص أخير
يلتقي روبير فالزير وباسافينتو (أو الراوي في رواية فليا ماتياس) في جوهر نظرتيهما إلى الأدب: ليس كمنصة للظهور أو تثبيت الأنا، بل كفنّ للغياب. كلاهما يدرك أن الأدب الحقيقي لا يقوم على الامتلاء بل على الفراغ، لا على البروز بل على التواري. لقد حوّل فالزير حياته إلى قصيدة انسحاب، من الحياة الأدبية ومن المجتمع ومن ذاته. أما باسافينتو، فحوّل اسمه إلى قناع وقناعه إلى كتابة، وكتابته إلى محاولة لتفادي الكتابة نفسها. إنهما كائنان يخافان من السطح ومن الضوء ومن النظرة التي تحوّلهما إلى شيء مرئي وملموس، قابل للتحديد. إن الأدب، بالنسبة لهما، لا يُكتب ليُفهم، بل لينفلت عن الفهم. إنه أثرُ غياب وليس شاهدَ حضور. لا يدّعي أنه يمتلك الحقيقة، بل يمرّ جوارها برشاقة، كمن يتجنب لفت الانتباه عمدًا. وربما لهذا السبب، يشعر القارئ بأن ما يكتبه فالزير، كما يكتبه باسافينتو، لا يُقرأ إلا بنصف العين، وبقلب يقظ لتقلبات الظل أكثر من وضوح المعنى. ولعل في اختيار ماتياس لشخصية مثل فالزير ليبني على أثرها مشروعًا روائيًا بهذا العمق، ما يعكس رغبة دفينة في تمجيد الأدب الهامشي والصامت والمقاوم للعرض. الأدب الذي لا يطلب قارئًا، بل يختبر وجوده الهشّ أمام قارئ افتراضي عابر…
ليس من قبيل المصادفة أن يُستدعى روبير فالزير، هذا الكاتب الذي عاش على الهامش ومات في عزلة ثلجية، إلى صلب رواية معاصرة كتبها فيلا ماتياس بعد قرابة قرن من الزمن. فحين تختنق الكتابة بثقل الأنا، وتُحاصرها المؤسسات، ويُختزل الأدب في الأداء والاعتراف والاعتلاء، يلوح ظلّ فالزير كاحتمال أخير للخلاص: الكتابة بوصفها نكرانًا، والانسحاب كأسمى أشكال الوجود. في رواية الدكتور باسافينتو، لا يُستحضر فالزير كشخص أو سيرة، بل كأثر وكعلامة على درب العزلة، وكرفيق في رحلة التخفي. وهكذا، تصبح الرواية أكثر من مجرد سرد لاضطراب كاتب؛ إنها تمرين على الصمت، ومحاورة مع أشباح الكتابة، ومحاولة لفهم لماذا يتوجب أحيانًا أن نكتب لكي لا نُكتب.
بهذا المعنى، لا يُقرأ فالزير في الرواية، بل يُقتفى أثره. إنه لا يحضر، بل يُلمَح في انثناءات اللغة، في توقفات المعنى، في ذلك الإحساس بأن شيئًا ما ينفلت دومًا من القبض. فربما كان أعظم ما يمنحه فالزير للأدب ليس كتابته نفسها، بل طريقته في التواري عنها، في أن يقول دون أن يرفع صوته، ويكتب دون أن يترك أثره. في عالم يعجّ بالصخب، يعلّمنا فالزير، كما يعلّمنا باسافينتو، أن للأدب صوتًا آخر: صوت الغياب.