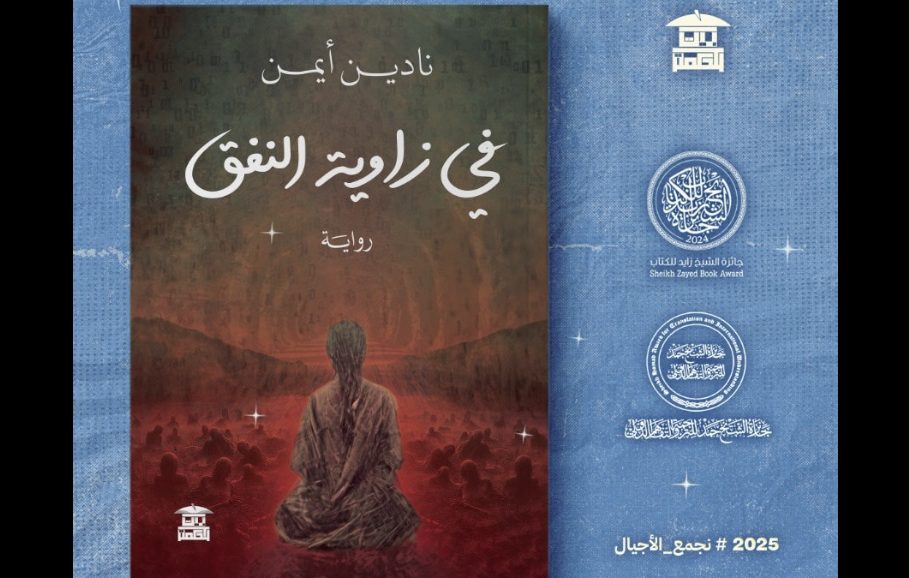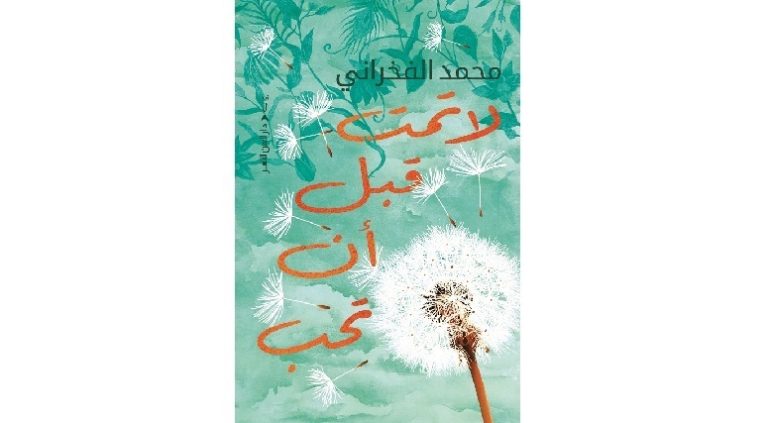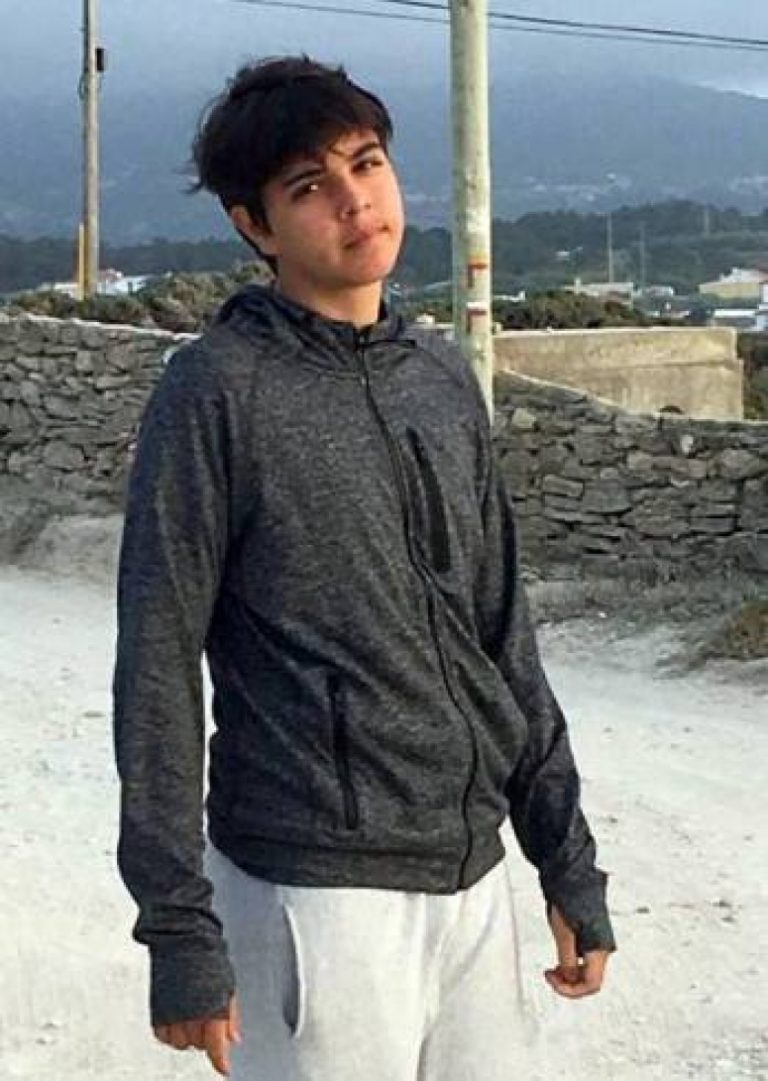نادين أيمن
الدكتور بدر
لاحت بلدتنا بوصفها عهدًا حديثًا، لا تشبه تلك التي مضت، وإن احتفظت ببعض سماتها الحبيبة. كانت تبدو من بعيد لوحةً سيرياليةً تتداخل تفاصيلها، وإذا ما اقتربتَ؛ ترى الشوارع والبيوت، والعشش والعمارات الشاهقة، والزحام الذي لا ينتهي، والأنفاق التي تعرف قاطنيها ولا تسمح لذرات الهواء بالمرور تتراص بتماسك لا مثيل له، وتفصلها عن الأنفاق المجاورة حوائط خرسانية مستوية تمامًا، تعزلها عن العالم المحيط، لتمكث في ظلام متصل، وعندما يحل الصباح، تجود بعض الثقوب الصغيرة بمرور أشعة الشمس، وكأن الشمس تخشى أن يراها أحد في مثل هذه الأمكنة.
كان كل شيء يسكن هنا، الخير والشر، النظام والفوضى، الواقع والحلم، وذوو الفراء الأحمر، الذين فرضوا سيطرتهم على الخطوات والأنفاس منذ نشأة بلدتنا قديمًا، وحفر أول نفق، ودخول أول ساكن.
تمضي السيارة وأنفي يفتش عن روائح مألوفة، بينما تلوح في الأفق محادثة الدكتور بسيوني الأخيرة، وهو يخبرني بتطورات مرض والدي، وضرورة وجودي إلى جواره في الفترة المقبلة، لم أصدق أن والدي الذي كان يقوم كل صباح بابتسامة الواثق أن طلوع الشمس هو ميلاد لحيويته المتجددة، وضحكته الرائقة؛ سوف يصبح غير قادر على مواصلة الحياة، وهو الذي يعرف قيمة العيش ويقدره، فقد أصبح هزيلًا، تنتابه نوبات الأنين المتصاعد، ولا يقوى على الحركة أو الابتسام، وكأن الحياة استهلكته في دروبها دون أن يدري، فأصبح يدفع الأيام دفعًا حتى تمضي، ساعات كثيرة بالنوم، وساعات قليلة بقضاء الوقت قرب الأحباء.
كان الجميع يلقبونه بالدكتور، إلا أنه لم يكن طبيبًا أو جراحًا، بل كان يُدرِّس الشعر والأدب والبلاغة بمختلف عصورها، أستاذًا جامعيًّا أحبه الطلاب كثيرًا، وكانوا يعدِّونه أبًا روحيًّا لهم، يترددون إلى منزله، لاستشارته في أمور شخصية أو عامة، وأحيانًا كانوا يأتون لمشاركته سماع الموسيقى في صالونه المعروف.
تبدلت الأحوال، ولم يعد يجمع بينه وبين أصحابه سوى حكايات متفرقة من زمن فائت؛ فقد قلَّت الخُطى إليه، وانسحب هو من علاقات كثيرة، ومع أنني كنت أعلم أن ذلك يحزنه؛ فإنني لم أستطع تغيير نظرته للأمور، فقد كان يملك رأسًا عنيدًا –على الرغم من حكمته وصبره المعهودين- وقرر تضييق دائرة معارفه.
أما أنا؛ فقد اعتدت أن أحمل أعبائي كل يوم، وأتركها خلف ظهري عندما أجلس إلى مكتبي، لأصوغ المقالات التي كلفني بها مديري “الريس رفعت”، حتى جاء اليوم الذي سمعت فيه طرقًا لاهثًا على الباب، كان والدي في الجامعة، وكنت أكتب مقالًا غارقًا في التفاؤل، وكانت سياسة جريدتنا هي نقل الحقيقة كاملة، ولكن بتصور يبعث البهجة في النفوس؛ لذا تحتم على “الريس رفعت” عند إجراء مقابلات تعيين المحررين، أن يختار من لهم مهارات أدبية فائقة، وكنت ضمن المختارين بعناية؛ فالأمل والعزيمة ليست مجرد مهارات أمتلكها، هي روح تسكنني وورثتها عن والدي.
هكذا اعتدت تقديم الحقيقة في ثوب مزركش أتقن حياكته، هل أزين الحقيقة أو أشوهها؟ لا أعرف… لكن لا يوجد خيار آخر لمجاورة الريس رفعت.
تركت تزيين الحقائق والمقالات وذهبت لأفتح الباب عندما ازداد الطرق عليه؛ لأجد أحدهم يحمل والدي، وكان شاخصًا ببصره في ذهول والدماء تتدفق من فمه بلا توقف.
**
– أود أن نسير معًا حتى نبلغ المنتهى.
قالها وهو ينهل من بحر عينيها عسلًا صافيًا.
– أعتبرها قصيدة جديدة يا بدر؟ محتاج تقول حاجة ومكسوف؟
– تقصدي إيه بمكسوف؟ عايز أقول حاجة وقلتها خلاص!
– إيه اللي قولته خلاص؟ أنا مش فاهمة حاجة أبدًا.
– أنت فاهمة كويس جدًّا، تمللي بتفهميني من غير شرح مفصل، أنت عارفة قد إيه بحب المجاز… و…
– وإيه كمان يا بدر؟ بتحبني؟ أنا عارفة إنك بتحبني قد المجاز تمام، ويمكن أكتر، عمومًا أنا كمان بحبك جدًّا جدًّا، ومستعدة أروح معاك حد المنتهى، وأبعد كمان لو تحب.
ضاقت عيناها شغفًا وارتسمت على وجهها ابتسامة طفولية، ثم أشارت بسبابتها صوب المنتهى، وأخذت تدور في حلقات وتجري أمامه حتى يلحق بها.
كانت أمي فتاة رقيقة، تصغر والدي بعامين، امرأة رشيقة مرحة، تتحدث بسرعة، ولا تحسب لكلامها حسابًا، عكس والدي تمامًا، يزن كلامه، ولا يقطر منه إلا بالمعقول.
حاول اللحاق بفستانها المنفوش، لكن بذلته المكوية بعناية جعلت خطواته رصينة جدًّا.
وكانت أمي كالفراشة، حطت على قلبه كي تمتص اعترافًا طال انتظاره، وطارت منتشية بارتوائها.
**
حملت والدي الغارق في الدماء ووضعته على فراشه، لم تكن الصدمة بالسهولة ذاتها التي تمكنني من السيطرة على انفعالاتي.
بعد مجيء الدكتور البسيوني، وإخباري بحقيقة مرضه ووجوب التزامه الفراش، خرجت وراءه بحجة شراء العلاج اللازم، جلست على سلم البناية، أنتحب “زي الولايا”، حتى خرج أحد السكان على صوت بكائي وحشرجة صوتي “يا حبيبي يابويا”. لماذا نقل لي الدكتور البسيوني الحقيقة في صورتها الخام؟ أعرف جيدًا أنه يعمل طبيبًا، وليس صحفيًّا في جريدة العاصمة، لكنني لم أعتَدْ رؤية الحقيقة الخالية من الأمل، كل ما اعتدته تناول الحقائق وهي مخبأة في غطاء مزين بأبهى الألوان، هل يعاقبني الله على تشويه الحقيقة؟ وهل كان لي خيار آخر بخلاف ما فعلت؟! أعرف أنني لا أستطيع صوغ حقيقة مرض والدي بأسلوب أدبي ملون، هل لا يملك الدكتور البسيوني القدرة على تقديم الحقيقة بصورة أقل ألمـًا؟
عدت إلى شقتنا حاملًا الدواء، حقنت والدي ببعض العقاقير المسكنة، قبلت جبينه ويديه، ذهبت إلى غرفتي تاركًا بَابَيْ غرفتي وغرفته مفتوحين؛ حتى إذا ما ناداني أجبته في الحال.
جلست إلى مكتبي، حاولت قدر الإمكان السيطرة على انفعالاتي ودموعي، وفردت مجموعة من الورق الأبيض أمامي كي أخرج عصارة تفكيري، وأنجز بعضًا من المطلوب للنشر. متاهات عقلي مظلمة ولا أفهم شيئًا! شرعت في إفراغ محتويات عقلي في صورة شخبطات:
“لماذا استجاب الدكتور البسيوني لرغبة والدي في أن يبقى بالمنزل دون مواصلة علاجه بالمشفى، والدي ذو رأس صلب، وقراراته تفتقد إلى المرونة على الدوام، لكن مكوثه بالمنزل، سيحوله إلى جثة، وستهرب الروح من الجسد المعتل، مستنجدة بقَدَر أكثر رحمة من صلابة رأسه”.
أخذت أدور في حلقة مفرغة، حتى ثقل رأسي، ساقطًا فوق المكتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روائية مصرية .. الرواية صادرة عن بيت الحكمة .. معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025