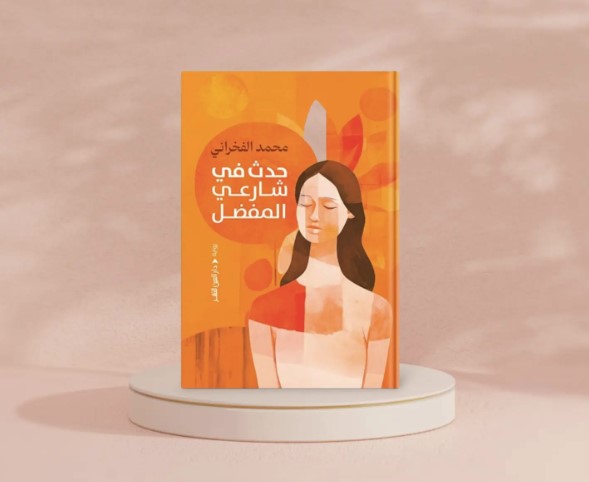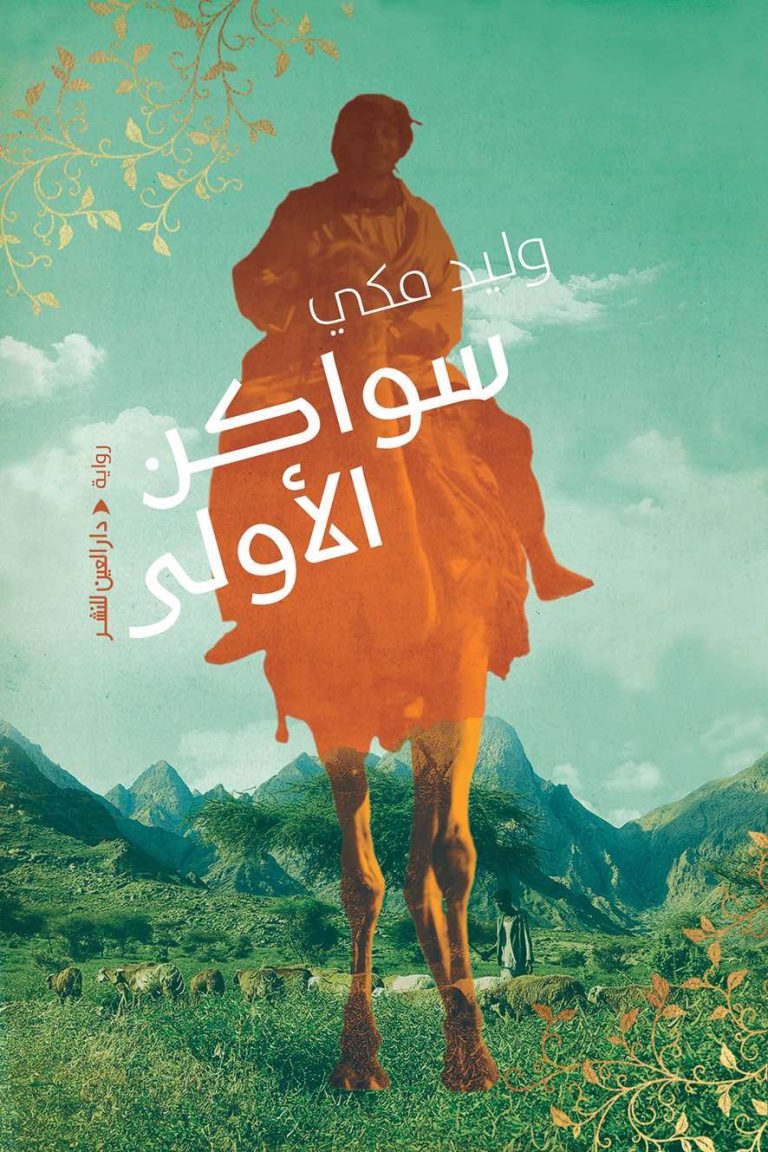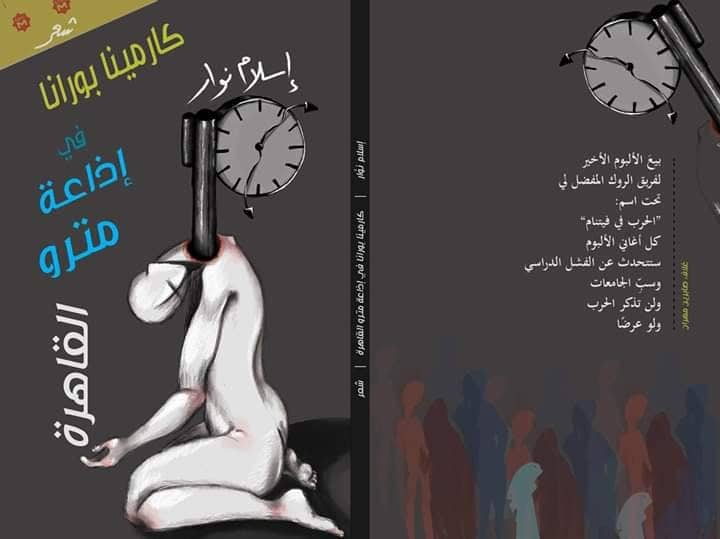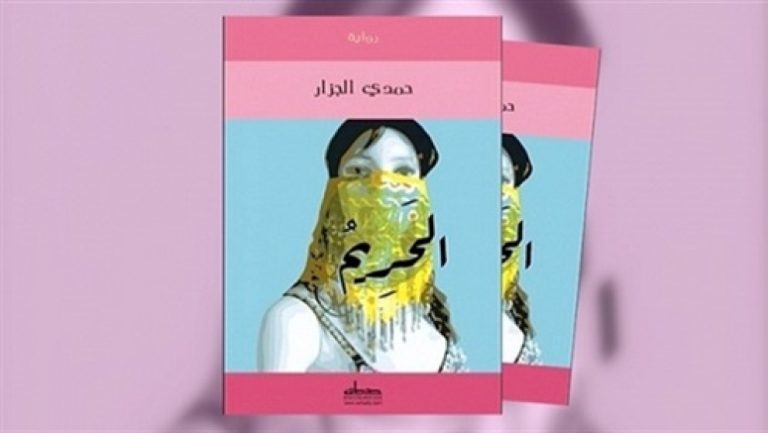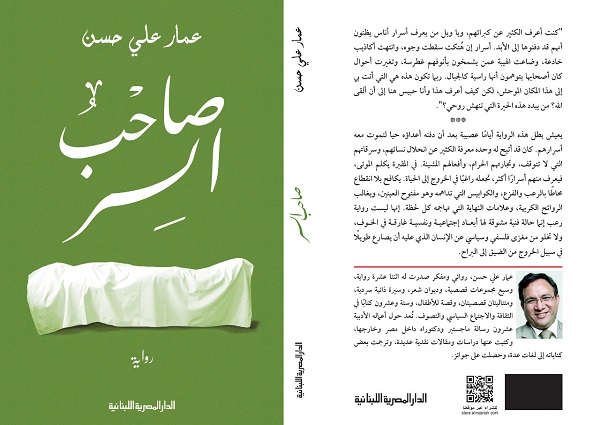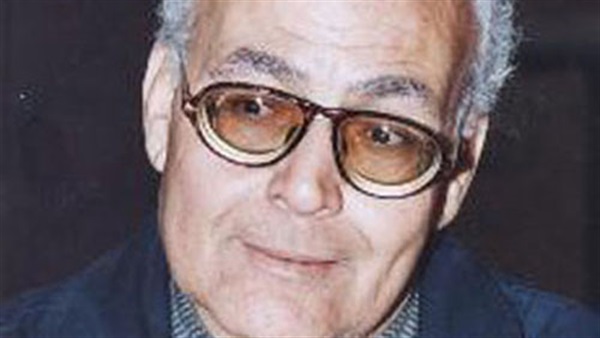أحمد حسن عوض
ماذا لو تخيلت نفسك إنسانا وحيدًا على ظهر الأرض التي غادرت ولم يبق منها غير بيت طيني ريفي قديم؟
هذا ما فعله محمد الفخراني في روايته “حدث في شارعي المفضل” الصادرة عن دار العين عام 2024، حيث جعل بطلة روايته المذيعة الشابة هي الكائن الوحيد الذي بقي على قيد الحياة بعد رحيل الأخ الرسام الموهوب ذي السنوات الأربع عشر، الذي تنازل عن قلبه طواعية لتأكله أخته؛ كي تستمر حية بمفردها على سطح ما تبقى من الأرض بعد أن ارتحلت بكل كائناتها وانحسرت في مساحة ضيقة، لكنها صالحة للحياة وقابلة للنماء لا الاتساع.
وإذا كانت الرواية بأقسامها الخمسة قد بدأت بقسم المناجاة الذاتية والمنولوجات الداخلية المكثفة ذات العناوين الداخلية، فإنها في القسم الثاني سترصد مظاهر الديستوبيا التي تعرضت لها كائنات الأرض بداية من التصدير على لسان البطلة :” كان أكثر شيء مرعب لي، أن أعتاد منظر إنسان يأكل إنسانا” وانتهاء بتقلص سطح الأرض إلى بيت طيني ومساحة زراعية محدودة، لتنخرط بنية الرواية بعد ذلك في رصد حياة البطلةالمسكونة بروح الحياة ومحبة البشر والكائنات والأشياء، حيث استطاعت تلك المثابرة الدءوبة المؤمنة بحتمية المسعى لاسترداد القيم المفتقدة- عبر الأقسام الثلاثة التالية- أن تحول تلك المساحة الأرضية المحدودة المتمثلة في بيتها/مأواها الأليف إلى ما يمكن أن أطلق عليه “يوتوبيا الفرد الواحد” بكل ما فيها من عمق الداخل وجسارة الروح وثراء التأملات الإنسانية، مما يجعل القارئ يشعر بألفة عجيبة تنبع من عالم الوحدة الخلاقة، ويؤمن بقدراته الفردية الكامنة في أعماقه، ويحلم مع البطلة بإمكانية قيام الحضارة الإنسانية من جديد، بسبب ذلك الموروث الجيني الحضاري المتراكم الذي تؤمن به البطلة:
“أفكر أن كل إنسان يحمل بداخله خبرات وتجارب كل البشر قبله، ذاكرتهم ومشاعرهم وأحلامهم وآلامهم وكل ما مروا به، كلها مشفرة داخل روحه وجسده وعقله، وعند تعرضه لتجربة خاصة أو موقف استثنائي، ينفك جزء من شفرته البشرية الإنسانية، وتعمل بداخله خبرات وتجارب البشر قبله بما يكفي ليعبر ويتجاوز، ويفعل أشياء لم يتوقع أنه يعرفها، هو لم يكن يعرفها، لكن البشر قبله عرفوها وهو يحملها كلها بداخله”
وبالرغم من أن الرواية تنتهى دون أن تحقق البطلة حلم عودة الأرض فإن ختامها يدعونا إلى تأكيد دور الرؤية وتفعيل منطق البصيرة، وفتح نوافذ المعرفة مجددا حتى في آخر لحظات ما قبل الرحيل حين بلغت البطلة الخامسة والثمانين من عمرها بعد ستين عاما من حياة العزلة الخلاقة على سطح ما تبقى من الأرض : “يمر أخي أمام النافذة، عيناه في عيني، عيناي في عينيه، ونبتسم أنا له، وهو لي، وأنا وهو معا نبتسم لنا معا.
يمر أخي . . يختفي ولا يختفي. وأنا أنظر من مكاني عبر النافذة
وأرى ..
وأرى ..
وأرى ..”
إن هذا التمثيل الأيقوني لفعل الرؤية بتكراره وتجدده المضارع وتجسده الرأسي البصري كشجرة راسخة الأعماق في باطن الأرض/ صفحة الختام، يؤكد في فلسفة الرواية ورؤيتها السردية وعبر تحريض مبدعها- دون أن يحرضنا مباشرة بالطبع- على تفعيل حيوية الحواس والسعي لاستعادة براءتها المفقودة وإمكاناتها الخلاقة وأهمية الغوص في أعماقنا من جديد، في عالم سيطرت عليه الرتابة التقنية الخانقة والتكرار النمطي المخيف.
“ يتساءل كثيرون أو يفكرون عما يمكن أن يجدوه لو نزلوا إلى أبعد نقطة بداخلهم، البعض يتوقع أن يجد ماء، والبعض يتمنى كنزا، بعضنا يتمنى غابة أو سماء أو بحرا أو نهرا أو عواصف أو صحراء أو طائرا أو وحشا أو نورا أو أشياء أخرى، البعض يتوقع أو يتمنى أن يظل ينزل إلى ما لا نهاية.
أشعر أني لو نزلت بداخلي عميقا، أعبر دمي ومائي ولحمي وعظامي، وأصل إلى أبعد نقطة بداخلي، أقرب نقطة بداخلي سأجد أرضا”
حيث يغدو ما رصدته البطلة من تنوعات الحفر الأركيولوجي النفسي- الموازي للحفر في طبقات الأرض لاستخراج نفائسها- دعوة تحريضية مضمرة لأن يفتش كل إنسان عن نفسه الحقيقية وفرديتة الغائبة أو بمعنى أدق جنته الضائعة.
وإذا كان المعري الشاعر المعتز بفرديته قديما لم يتقبل فكرة العيش في الجنة وحيدا دون الأنس بالبشر في بيتيه الشهيرين:
وَلَو أَنِّي حَبَبْتُ الخُلْدَ فَرْدًا
لَمَا أَحْبَبْتُ فِي الخُلْدِ انْفِرادَا
فَلَا هَطَلَتْ عَلَيَّ وَلَا بِأَرْضِي
سَحَائِبُ لَيْسَ تَنْتَظِمُ البِلادَا
فإن بطلتنا- الناجية الوحيدة المؤمنة بتوارث الحس الحضاري الإنساني عبر العصور- كانت أكثر جسارة وإصرارا على أن تصنع معنى لوحدتها، وتنسج أنسا لوحشتها عبر ملمحين أساسين: أولهما الإصرار على رسم الكرة الأرضية على سطح كرتها البلاستيكية وتلوينها وكتابة أسماء الأماكن والشوارع بما فيها شارعها المفضل كل ثلاثة أشهر تقريبا، بعدما تمحى ألوان الكتابة والرسومات من سطح الكرة البلاستيكية/ رفيقتها الملازمة.
وثانيهما: المناجاة الدائمة للآخرين ونداءاتهم المستمرة بل التحاور معهم بعد ذلك عبر استعادة بث برنامجها السابق “في منتهى السهولة” الذي تحلق فيه -عبر خيال فانتازي- بكرتها البلاستيكية في الفضاء مناجية البشر لكي يعودوا إلى أعماقهم ويقدروا قيمة حياتهم على ظهر الأرض في إحساس يخامره اليقين بعودة الأرض، تلك الحزينة التي لا تحمل ضغينة، برغم تحملها طويلا صراعات البشر وسخافاتهم وحماقاتهم.
ولا شك أن تلك الرؤية أو الروح الكلية المهيمنة على منظور الرواية قد استدعت تقنياتها السردية وأساليبها البلاغية المجسدة لها بدءا من العنوان “حدث في شارعي المفضل” حيث جاء مصوغا في جملة فعلية تشارف أفق اليقين والمضي الحاسم الذي تجسده صيغة الفعل الماضي “حدث” وتؤطره ياء الملكية”شارعي” المشفوعة بالنعت “المفضل” حيث الخصوصية البالغة والمحبة الخالصة، لكن قراءة متن الرواية تكشف عن مفارقة تخالف أفق توقع القارئ المترقب فضاء من الأحداث الحياتية والعلاقات الاجتماعية التي تحدث بين جيران الشارع وبطلة الرواية مثلا، فإذا بالرواية تنعطف إلى الفضاء الكوني وعالم كوكب الأرض والأحداث الكبرى التي تمر بها، وتدفعها إلى الرحيل الاختياري بكل ما عليها من بشر وكائنات،
لتبقى البطلة المذيعة وحيدة تبحث عن جنتها الضائعة أو شارعها المفضل الذي يبدو كأنه معادل للعالم بأسره، ” تمنيت وأتمنى أن يوجد شارع يمر بكل العالم، أمشي فيه وأمر معه بكل مكان وكل إنسان”
وقد وفق الفخراني في اختيار بطلته مذيعة لتبدو كأنها الصوت الباقي بشجنه الدافئ الذي يتحدث بالنيابة عن البراءة المفقودة وإمكانية عودة الأحلام مرة أخرى عبر إذاعة كونية تحاول أن تستنهض ما تبقى من الإنسان في الإنسان، وتدفع ما تبقى من الأرض ليستعيد الأرض، فهي الأرضية المشاءة التي تفضل المشي عن الطيران لتلمس حميمية الأشياء وتحسها بروحها؛ لذلك كان لابد -وفقا لمنطق إحكام الرؤية وإكمال المنظور الفلسفي للرواية- أن يكون البطل الثاني/ الأخ الرسام الموهوب مكملا الصورة كاشفا عن انحياز البطلة للون الأصفر بتجلياته الخلاقة في الطبيعة متمما عنصر القيمة باستبقاء اللحظات الجمالية المكثفة الخصبة في حياتنا حتى لا تولي هاربة في متاهات المكرور واليومي والمعتاد.
وقد استدعت طبيعة الرواية أن يكون السرد بضمير المتكلم؛ لأنها رواية مناجاة بامتياز، تبدأ في قسمها الأول بلوحات نفسية تعبيرية أقرب إلى روح قصيدة النثر، وتعتمد في بقية الأقسام على المونولوج الداخلي ومناجاة الذات، واستدعاء حالة الأنا/ أنت عبر مناجاة الرسام الموهوب واستعادة الحوارات معه، وحالة الأنا/أنتم عبر مخاطبات البشر والكائنات والأشياء والأفكار وعبر التماهي مع ضمير المتكلم الجمعي “نحن” وكأنها تتحدث من خلاله بلسان كل البشر ؛ لذلك جاءت بنية الزمن في الرواية أقرب إلى البنية التكرارية الدائرية ، ليس فيها تنام متسارع للأحداث بقدر ما فيها من دفء النجوى وثراء الداخل الذي يبدو فيه السرد كأنه استعادة لحالات مشابهة حدثت في أزمنة سابقة ، وإن كان السرد بالطبع لا يخلو من البنية الدرامية كما نري على سبيل المثال في نوابات الغضب والثورة التي تعتري البطلة في علاقتها بالكرة البلاستيكية وتفريغها ثم إعادة ملئها بعد هدوئها والاعتذار لها، مما أتاح للفخراني أن يتعامل مع الزمن في الرواية بشيء من الأريحية التي تتراوح ما بين الانضباط الشديد كأن تستيقظ البطلة الساعة 5 و5 صباحا وليس الخامسة مثلا، وأن تحرص البطلة على وضع تقويم دقيق لحياتها بالأيام والشهور والسنوات من ناحية، وطرح بعض السنوات والشهور عبر منطق التشكك في دقتها التامة، وعبر تحريك عدد ساعات اليوم كأن يكون المدى الزمني لليوم ساعتين فقط من ناحية أخرى؛ مما يبعث إلى الذهن منطق الزمن الشعوري الذي أشار إليه هنري برجسون أو منطق “البحث عن الزمن المفقود” الذي شغل مارسيل بروست في روايته الشهيرة ورأى إمكانية استعادته؛ لأنه ليس مفقودا تماما بل نائما في أعماقنا ويمكن بعثه عبر التجارب الحضارية والجمالية.
على أن ذلك الزمن الشعوري الحاضر بقوة في رواية الفخراني يمكن أن يعد- بمعنى من المعاني- رد فعل للزمن التاريخي الحديث بحروبه وصراعاته من جهة وتقدمه العلمي والتقني في عالم الانترنت والاتصالات من جهة أخرى، وهو زمن لا يمكن تخيله بمعزل عن خصوصية الحيز المكاني وتمركز شجرة الزيتون في واجهة البيت الريفي برمزيتها المقترنة بالعطاء المتعدد والسلام النابض بالحياة باعتبارها مجسدة لرسالة المحبة التي تبثها البطلة المذيعة صباح مساء إلى العالم الذي غيبته الكراهية وطوته الحروب؛ لأن التحليق لمخاطبة العالم كان دائما من خلال الكرة البلاستيكية المعلقة على أحد أغصانها فهي مركز المكان والمنطلق والمستقر.
وإذا كان عز الدين المناصرة قد اختار عنوان “لن يفهمني أحد غير الزيتون” لمختاراته الشعرية ليؤكد انتماءه إلى شجرة الزيتون المباركة المجسدة لهوية الإنسان الفلسطيني فإن محمد الفخراني قد جعل منها رمزا للعطاء المتجدد والعمل المتواصل الذي تسعى من خلاله البطلة الزارعة الصانعة لاستعادة روح الحياة المفتقدة وذاكرة الحيوية القديمة.
مع إيمانها الراسخ بأن العالم كله سيفهمها وليس الزيتون فقط كما ارتأى الشاعر الكبير.
وقد جاءت لغة الرواية ممتلئة بروح تلك الحالة الصوفية الاستغراقية حيث التماهي- في يقين البطلة- بين البشر والأرض،
“أفكر أن هذه الكلمة (الأرض) لن تختفي أبدا، هي ليست قادمة من خارجنا نحن البشر، هي فينا، في تكويننا ونحن في تكوينها، وطالما لم تختف كلمة (الأرض) فلن تختفي من الأرض أي كلمة أخرى“
وقد جاء أسلوب الرواية مفعما بالروح الشاعرة الممتزجة بفاعلية الخيال البصري والسعي لتمثل مشاهدات الذكريات العاطفية الحية من جانب، والاعتماد على أنسنة الأشياء وتفعيل دورها في حياة العزلة من جانب آخر، وذلك الملمح الأخير يمثل- فيما أرى- حساسية أسلوبية لعصرنا الراهن تتجلى في كثير من الأجناس الأدبية المعاصرة، وتبدو لي كأنها رد فعل جماعي من المبدعين- على غير اتفاق مسبق بالطبع- إزاء لحظتنا الحضارية الراهنة التي انسحب فيها دور الإنسان الفاعل بعد أن أصبح العالم شديد الوطأة على أفراده العابرين، يطبعهم بطابعه الرقمي، وينزع عنهم تنوعاتهم الخلاقة فيقعون مرغمين في فخ النمطية والتشيؤ، وإذا تشيأ الإنسان فلابد أن يسعى المبدعون إلى أنسنة الأشياء ليستشعروا الدفء بين أوصالها، وهو ملمح بارز قابل للملاحظة الإحصائية في الرواية ، حيث نراه متكررا بين صفحاتها، كما نرى على سبيل التمثيل في رصد محمد الفخراني- موظفا حيوية الحواس الخمس وفاعلية الأداء الاستعاري القائم على ملمح التشخيص- مشاعر البطلة إزاء عود الكبريت والتفكير فيه باعتباره صديقا أليفا وإنسانا له هواجسه البشرية ومشاعره الخاصة:
“ضبطت نفسي داخل هذه الألفة، وأحببتها، أسحب عود كبريت خشبيا من علبته، أمسكه مثل خبيرة بأطراف سبابتي وإبهامي والوسطى، وأحك رأسه الأحمر مرة واحدة خاطفة بجانب العلبة المنقرش بجانب الكبريت، وأراقب لحظة ارتباكه أو فرحه وهو يشتعل، وأستمع إلى صوته “تششش” أرفع الجزء الزجاجي للقنديل، وأقرب عود الكبريت من الفتيل، فينبت في رأسه لهب برتقالي صاف، أتفرج عليه ثواني، وأعرف أني أعرفه، أطفئ عود الكبريت بنفخة لطيفة من فمي، وأفكر .. هل يكون عود الكبريت مرتبكا أم فرحان لما يشتعل؟ أم يفرح ويرتبك معا في نفس اللحظة، هل يفرح في البداية لأنه يشتعل بالحياة، ثم يرتبك لأنه يعرف أن حياته قصيرة، أم يرتبك أولا لاشتعاله فجأة بالحياة ، ثم يفرح لأنه يعرف أن هذه الحياة قصيرة وعليه ألا يضيعها بالتفكير كم هي قصيرة؟ أم أنه هذا كله؟”
لندرك عبر تلك الصياغة الدافئة ومثيلاتها المفعمة بمحبة الحياة النابضة بروح التعاطف مع البشر والكائنات بل الجمادات رسالة محمد الفخراني في روايته التي لم يكن هدفها أن تحكى حكاية البطلة الناجية الوحيدة بقدر ما كان همها أن تدفعنا إلى التأمل فيما آلت إليه رحلة الإنسان على ظهر الأرض بالرغم من تقدمه التكنولوجي الرهيب ومعارفه الهائلة، إذ لم يورثه ذلك التقدم حكمة الحياة التي كان من الممكن أن تتسع للجميع فإذا بها تنتهى إلى صوت منفرد وحيد ظل مؤمنا بالحياة، يهتف سدى دون عودة الأرض الضائعة.
……………..
*نقلا عن مجلة إبداع، أكتوبر 2025