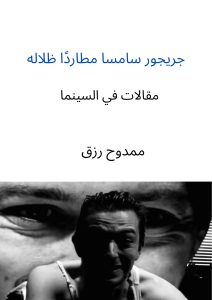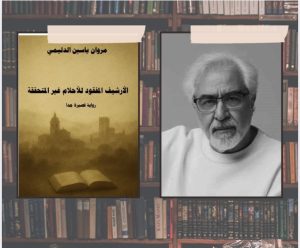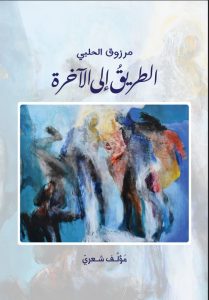من الكتاب:
ذات زمان قديم، ربما أوائل ستينيات القرن الماضي، كنت قد عرفت أول الحب، وأول الحنين، وأول رغبة الذوبان فى الآخر، وأول الخوف من فقدانه، كنت تلميذًا بالإعدادية، كسولاً ومتدينا وغامضًا، لم أسمع سوى حكايات أبي، وأغاني أمي، ولم أقرأ سوى روايات المدرسة، أيامها، ولأنني لم أقدر على كتابة الشعر الذي تخوفت منه، ولم أبح بعاطفتي لأحد لأنني خفتُ من البوح، أيامها، جرؤت على الرواية، وشرعت فى كتابتها، ومع ذلك كنت كل يوم أحمل تحت إبطي بعض دواوين الرومانسيين، وأخرج إلى الطبيعة، كنت أظن أنهما، الرومانسية والطبيعة، هي طريقي المأمونة إلى قلب هانم، لم أكن أعلم أن شعراء الرومانسية الذين صاحبتهم كانوا محدودي التقنية، بلغة أخرى كانوا يفتقرون إلى قصدية التقنية، ولم أكن أعلم أن الطبيعة التي لجأت إليها كانت محدودة بفضاء أقل من مدينتي، أقل من ريفيّ، أقل من أحلامي، محض حقول وطيور وحيوانات مألوفة، وترع نحيلة، ماؤها عكر أحيانًا، صاف نادرًا، وبضع شجرات توت، ونخيل متناثر، والأهم فتيات ونساء جريئات فى السر خجولات فى العلن، ورجال مجهدون غير قادرين على الجرأة أو الخجل، وصبيان يشبهونني
كنت أتخيلهم يحبون هانم وينافسونني عليها، كان الشعر الذي أقرأه سهل المذهب سهل المأتى كأنه هو أيضاً أقل من أحلامي، مثله مثل الطبيعة، بعد فترة هجرت الرواية التي أكتبها، وبدأت أكتب شعرًا مطبوعًا يشبه الشعر الذي أقرأه، لم أفكر أن أقرأ ما أكتبه أمام الآخرين، كان شعري كله عن هانم، ولقد حسبتهما، شعري وهانم، أهم أسراري، فى أوائل السبعينيات وبعد موت عبد الناصر بوقت قصير، صادفت الكتب الثلاثة: قصائد أولى وأوراق فى الريح وأغاني مهيار الدمشقي، وأصبحت، وأنا فى الطرقات، فى كل الطرقات، أحملها تحت إبطي، وأنا فى البيت، فى كل البيت، أضعها إلى جواري كانت هانم قد أصبحت حنينًا أجوف، وكنت أبحث عن حنين عميق، حنين جارف، دواوين أدونيس الثلاثة قادتني إلى خالدة، وإلى السماء الأخرى، وإلى بيروت، وإلى زملائه جميعًا، وإلى مجلة شعر، ومعهم بدأت أكنس الأوراق الصفراء الساقطة من أشجار شعرائي الرومانسيين، فى تلك الفترة تصادف أنني شاهدت الفيلم الروسي (المعلم الأول)، المأخوذ عن رواية الكاتب القرغيزى جنكيز إيتماتوف، هل شاهدته فعلا، وتصادف أنني اعتبرت عنوان الفيلم هو عنوان علاقتي بشعر أدونيس
أذكر بطلة الفيلم التيناى سليمانوفنا، أذكرها ليلة زفافها على الإقطاعي الباترون، وهى تصرخ من الألم فى أثناء اغتصابه لها، وبسببها يلجأ معلمها ديوشين، يلجأ إلى الدولة والحزب والبوليس على أمل أن ينقذها، ولمّا يفعل، يعودان معًا، التيناى وديوشين، الفتاة والمعلم، وفى طريق العودة تمطر السماء، وتغسل الأمطار جسد الفتاة، التي فجأة تقف وتخلع ملابسها وتنطلق وتقفز لتكون فى قلب البحيرة، تستحم وتتطهر، وينتهي الفيلم بأن نرى ديوشين يمسك فأسه ويضرب بها الشجرة الوحيدة الموجودة بالقرية، شجرة التقاليد القديمة، ولأنني كنت مسكونا بالقصائد الأولى، والأوراق فى الريح، وأغاني مهيار، فقد اختلط علىّ مشهد الفأس، وأصبحت أرى أدونيس محل ديوشين، بل أصبحت أرى أدونيس على هيئة سيزيف، حيث تلاعبت بي الأسطورة وغيّرتني إلى أن ساعدتني فى العثور على ضالتي، بعدها تلاعبت بالأسطورة وغيرتها، فسيزيف يصعد الجبل من أجل أن يصل إلى قمته، ويعود بالصخرة التي هناك، ولكنه فى كل مرة لا يصل، وأدونيس يصعد الجبل من أجل أن يصل إلى قمته، ويجتث بفأسه المصقولة الشجرة التي هناك، شجرة التقاليد القديمة، وينجح فى الوصول والاجتثاث، ولكن شجرة جديدة بتقاليد جديدة سرعان ما تنمو وتصبح شجرة التقاليد القديمة، ويعاود أدونيس الصعود، وهكذا هكذا دون انقطاع، كانت صورة أدونيس، ونصوص دواوينه الثلاثة، وخيالات فيلم المعلم الأول، الصورة والنصوص والخيالات، كانت تقودني إلى أزمنة أقدم، حيث أواخر الأربعينيات المصرية، والتي أعتبرها، ويعتبرها معي بعض آخرين، وكأنها العصر الذهبي المغدور، الذي سرعان ما دهسته أقدام العسكر، وظلت طوال العقود التالية تدهسه، ومازالت تدهسه، بدعوى أنها تحمينا من أقدام غليظة أخرى، أقدام الإسلاميين، وبدعوى أنها تحمينا من انحلال الدولة وتفسخها.
فى أواخر أربعينيات القرن الماضي، خرجت من أحضان الحركة الرومانسية الغالبة آنذاك، حركة جديدة، أسموها حركة الشعر الجديد، وزعموا أنها أكثر واقعية، وزعموا أنها أكثر ثورية وحداثة، وتصادف أن الحركة الجديدة تزامنت تقريبًا مع ضياع فلسطين ونشوء دولة إسرائيل، وتزامنت أيضا مع بدايات انتصار حركات الاستقلال الوطني ومع حدوث ثورة يوليو 1952 التي أنشأت حولها أنصارًا شاعت تسميتهم فيما بعد بالناصريين، وأنشأت حلفاءً أغلبهم من القوميين العرب وبعضهم من الماركسيين التقليديين، وأنشأت خصومًا من الإسلاميين والليبراليين والماركسيين الأكثر تشددًا، والجميع، الأنصار والحلفاء والخصوم، عندما انتبه مفكروهم إلى ضرورة الفن تذكروا الشعر والتفتوا إليه وأجبروه أن يكون عامًّا وخطابيًا، أجبروه أن يكون شعر نضال عند أقصى نقطة، وشعرًا ميسور الفهم عند أدنى نقطة، أجبروه أن يكون بديلًا لنضالهم البائس والمهزوم غالبًا، حتى أنّ أحدهم، محمود أمين العالم، فضّل روايات محمد صدقي العمالية على روايات نجيب محفوظ التي تنشع بعرق البرجوازية الصغيرة، وفضّل شعر كمال عبد الحليم صاحب نشيد دع سمائي فسمائي محرقه، على شعر صلاح عبد الصبور، لعلهم كانوا معذورين لأنهم أصحاب هويات معطاة ومحددة، الأصح أصحاب هويات موروثة وجاهزة، وكانوا يكرهون من الفن أن يضل ويصبح غابة، ويفضلونه إذا اهتدى وأصبح شجرة، وهذا الموقف القديم يفسر الكراهية التي يكنها مثقفو أنصار ناصر وحلفائه وخصومه لشعر أدونيس، فأدونيس كان ومازال يتقدم بخطوات واسعة باتجاه أن يكون الكوزموبوليتاني المارق، الكوزموبوليتاني حتى النخاع، هويته متخيلة، تتحدد بكل ما يختلف هو معه، وفور تحديدها يحاربها خوف أن تستقرّ وتثبت، والتاريخ الشخصي لأدونيس هو تاريخ هويات متعاقبة، لا يجمعها إلا ما يمكن أن يكون نطفة وجود، ما يمكن أن يكون خلية أولى، والذي راج عن أن خروجه من جماعة شعر فى أواسط ستينيات القرن الماضي، كان نتيجة صدام وخصومة، لا يمكن أن يكون سببًا حقيقيًا، إنه محض دافع، السبب الأولى بالاعتبار هو أن أدونيس قرر أن يهجر سفينة جماعة شعر لأنها وصلت ميناءها الأخير، لقد قال أدونيس ليوسف الخال: يكفي، ولعله فكر فى أن بقاءه دون أن يغادر سوف يجعل هويته فى طور التحديد والثبات، سوف يجعلها هوية مقتول، حتى أنسي الحاج، أظنه كفَّ مبكرًا عن كتابةِ الشعر، بسبب ذلك الوصول إلى الميناء الأخير، غابة أدونيس تناسب تمرده وشجرة الآخرين تناسب ثورتهم، والثورة عمقيًا أدنى مكانة وقدرًا من التمرد، التمرد مطلق لا ينحدّ، والثورة مرهونة بما تسعى إليه، وبعدها تتلاشى وتصبح دولة، يكفى أن نتذكر ثورة عبد الوهاب البياتي و دولته، غابة أدونيس مازالت تنبئ عن أماكن مجهولة لم تطأها قدماه أو عيناه، وهو فى غابته يسير حسب بوصلة معرفته وليس حسب بوصلة خبراته، فمعارفه تجعله يدرك أن بالغابة أراضي بكرًا لا تسعفه خبراته على أن يتخيلها.
أدونيس هذا الذي أصبح عدوًا لكل تلك القوى، الإسلاميين والقوميين والاشتراكيين الجوف والناصريين والبعثيين ومحدودي الثقافة والجهلاء، أصبح أيضاً عدوًا للقوى الجديدة المضافة التي تكاد تكون حبيسة نزعة الاستهلاك الفوري للأشياء المادية والفنون والآداب، حبيسة التفاهة، مازلت أذكر أيام أصدر أدونيس ثلاثيته (الكتاب)، مازلت أذكر وجوه بعض هؤلاء، تلك الوجوه المنتصرة الفرحة، وكأنه، أي أدونيس، عاد ليحمل بين يديه حقيبة آبائه، عاد ليقضي البقية من عمره فوق قبر علَّامتهم المشهور ومن تراب القبر يصنع تماثيل العلّامة ويوزعها على مريديه، وحسبت أن سوء فهم ما قد جعلهم يظنون أنه هكذا استفاق وعاد وتاب وأناب، بعدها ظللت أحاول أن أضع استغرابي فوق طاولة بعيدة عنى، إلى أن استقام استغرابي واستطال وأشرق، فالمتنبي الذي تدور الثلاثية حوله بسبب مخطوطته المتخيلة، المتنبي هذا فى شعره، وكما يقول المازني الذي أحفظ قوله المتنبي هذا توجد فى شعره قوة تخطئها فيمن عداه من مشاهير شعراء العرب، وهو من المقلين، وعلى إقلاله لا يطيل قصائده، انتهت كلمات المازني، التي لابد أن نتبعها بالقول بأن أدونيس ليس هكذا، وأن أدونيس أحد أغزر الشعراء المعاصرين، وإذا كان المتنبي يأخذ بيدك إلى ما يريد مباشرة، ولا يطيل الدوران لبلوغ غايته، حتى أنه يدفع المعنى الذي فكر فيه دون زيادة أو نقصان، كأن شعره هو شعر البديهة، حكمته مسروقة من نفوس محيطيه، وكأنها حكمتهم، لاحظ أن حكمة أدونيس هى حكمته وحده، يتبناها المحيطون به، المتنبي ليس الشاعر الوحيد صاحب الأمثال الحكيمة، ولكن أمثاله هو ودون الآخرين أكثر سيرورة على الألسنة، وذلك بسبب إحكام التسديد إلى الغاية، والاقتصاد إلى الحد الواجب، وحسن اختيار الألفاظ، وحلاوة سبكها، وهذه كلها صفات تختلف عما يمكن لأدونيس أن يفكر فيه أو يفعله فى كلا الشأنين، اللغة والمعنى،
فعند أدونيس المعنى فى اللغة القديمة، موجود مسبقًا، والكاتب يصوغه بشكل جديد لكنه فى اللغة الحديثة ينشأ فى الكتابة وبعدها، ولذا كانت ثلاثية الكتاب مدهشة لأنها أجبرتنا على أن نراهما معًا، أدونيس والمتنبي، وكأنهما صاحبان، فنحاول أن نصدق، ونحاول ألا نصدق، وسوف نظل نعتقد أن الصورة ليست مغشوشة، ولكنها مثل كل أفعال أدونيس، لها أكثر من متاهة، ولها ظاهر واحد، وعدة بواطن، الثلاثية أجبرتني كلما لمحتها أو فتحتها أو طرحتها جانبًا، أن أتساءل عن علة فنية خفية أدارت زنبرك (الكتاب) بأجزائه الثلاثة، قلت لنفسي: لعل المتنبي هو التمثيل الشعري الأجلى للثقافة العربية فى أغلب عهودها، باتفاق عاشقيها وكارهيها، وباتفاق القيم والقواعد الحاكمة، وباتفاق القراء والدارسين على صحة هذا التمثيل، واختيار أدونيس للمتنبي يتكئ على صواب هذا التمثيل لذا فإنه اختيار ينطوي على بعد هجائي خفيّ يخترق الثابتين، ثابت الثقافة العربية وثابت المتنبي، كما أنه ينطوي على بعد تقريظي يحيط بالمتحولين الاثنين، متحول الثقافة العربية، ومتحول غير المتنبي، الذين منهم أبو نواس وأبو تمام، خاصة أن صفحات ثلاثية الكتاب لا تكفُّ عن نزف الدم الذي يكاد يكون طابع هذه الثقافة، إنه الكتاب الأحمر إذن، كان طه حسين قد كتب كتابه المتنبي بهاجس يقترب فى معناه وليس فى مبناه من هاجس أدونيس، وليس غريبًا أن يظل طه حسين هدفًا دائمًا لأغلب القوى التي خاصمت أدونيس فيما بعد، عمومًا أدونيس لم يؤلّف الكتب والدواوين بلسانه وقلبه فقط، ولكنه ألّفها أيضاً بألسنة الآخرين بعد أن وضع لسانه تحت كل هذه الألسنة، فديوان الشعر العربي، وديوان النثر العربي، وديوان النهضة، وديوان البيت الواحد، لا يمكن أن تشبه فى آثارها وتأثيرها على قرائها ما فعله القدماء فى مختاراتهم، حماسة أبي تمام الكبرى، وحماسة البحتري، وحماسة الشجري، والحماسات الأخرى، وجمهرة الجواهري، ومختارات البارودي، كلها وغيرها تدخل ضمن شعر العرب أكثر مما تدخل ضمن شعر منتخبيها، يمكننا أن نستثني حماسة أبي تمام الصغرى، والمسماة بالوحشيات، أدونيس وحده هو الذي استطاع أن يؤلف مختاراته، سواء بالعناوين، وسواء بالترتيب، وسواء بالحذف، وسواء بالالتفات إلى المهمل فيها، وتجاهل الأكثر شيوعًا، وسواء بالهوامش، وسواء بروحه المبثوثة فى كل مختاراته، حتى أن بعض مختاراته اعتمدت أيضا على رغبة صاحبها فى أن تكون صادمة، لأن صدمة الحداثة فعل أدونيسي مألوف وغير مألوف، ولعلّى أنصفه، وهو ليس فى حاجة إلى إنصافي، إذا أشدت بإدراجه ضمن ديوان النهضة كتابه السادس الذي يضم نصوصًا للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية الذي لا يمكن أن نتجاهله مادمنا نتعقب نصوص النهضة الأكثر سريانًا فى زمنها وفيما بعد زمانها وفى زمننا، نصوص النهضة باعتبارها قوسا زمانيًا حيث لا يجب تفضيل محمد عبده ومحمد رشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبي واختصاصهم بالقبول والمدح واستبعاد ابن عبد الوهاب واختصاصه بالتجريم والذم، فكلهم غرماء فى الدين، وكلهم شركاء فى استمرار هيمنته، بل يكاد يكون الإصلاحيّ منهم أكثر قدرة على إطالة عمر هذه الهيمنة، هكذا محمد عبده وليس هكذا محمد بن عبد الوهاب، وكلنا نعرف أن الماركسية عندما دخلت أوروبا الغربية كانت أقوى فى البلاد التي لم تعرف الإصلاح الديني البروتستانتي عنها فى البلاد التي عرفت، مع العلم أن الوهابيين هم الأكثر غلوًا فى معاداة أدونيس، ها أنذا ودون قصد أحيد عن رغبتي وأنخرط وأتذكر وأستحضر من لا يجب استحضارهم، كنت أتمنى وأنا أكتب عن أدونيس، أن أحيط نفسي بأشخاص أحبهم وأشياء أتعلق بها، لكن أدونيس المثالي بقدر لا أملك تحديده، والمادي بقدر أيضا لا أملك تحديده، والذي لا يحب أن أصفه كعرّاف، وأن أصغى إليه كساحر، لم ينخدع مثلما انخدع معظمنا فى صوابية الشعب الدائمة، الصوابية المقدسة، ورأى الربيع العربي فصلًا بلا ربيع، وأنكرنا عليه رؤيته، محبوه لاموه وأنا منهم، وخصومه هاجموه بضراوة معهودة عنهم، وفئة ثالثة ظلت تنتظر كأنها الفرقة الناجية، لكن أدونيس المثالي بقدر، المادي بقدر، غلبت رؤيته رؤيتنا، وأصبحنا وكأننا خارج كل الفصول، أصبحنا وكأننا على مشارف العدم، هل أستعين لكي أستعيد توازنى بما بدأت به، ليست لدىّ نسخة من فيلم المعلم الأول، ولكنني أمتلك رفًّا من روايات جنكيز إيتماتوف، التي أنوي أن أقرأها جميعًا مرة ثانية، وبينها رواية المعلم الأول، برسوم ماركيفتش وترجمة غائب طعمة فرمان، ولأنني أعلم أن أدونيس لا يحب قراءة الروايات، أتخيل الآن كيف لوجهه المليء بتجاعيد المستقبل والملتفت بعيدًا كيف سيطلع لي من كل الصفحات ويصرفني عن رسوم ماركفيتش، ويصرفني حتى عن جنكيز إيتماتوف الذى يترجمه غائب باسم تشينغيز إيتماتوف، لعله النطق الأصوب، ويصرفني كذلك عن دقات قلبي، ويسد أذنيه خشية أن أسأله عن سيرته الذاتية التي أبلغني ذات مساء فى باريس أنه سيكتبها، وأذكر أنه كان قد اهتدى إلى عنوانها المشحوذ بالضمائر أنا هو أنت، هكذا تقريبًا، لكننا، وكما فعلنا دائمًا، لابد أن ننتظر سيرته فى المكان الذي هناك، قرب غابته واسمه، لأنه يحب أن ننتظره، فى المكان الذي هناك، قرب غابته واسمه.
……………….
يمكنكم تحميل كتاب “الشهيق والزفير” لـ عبد المنعم رمضان >> من هنا