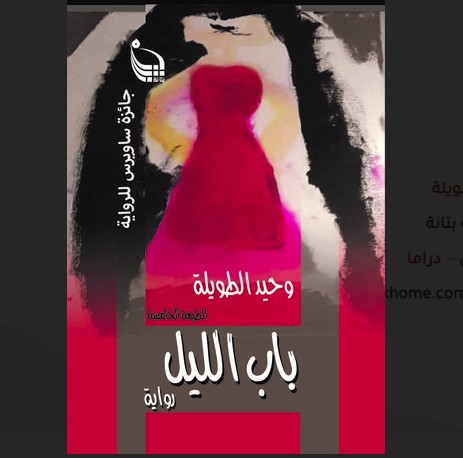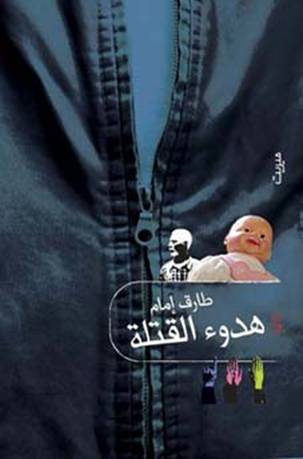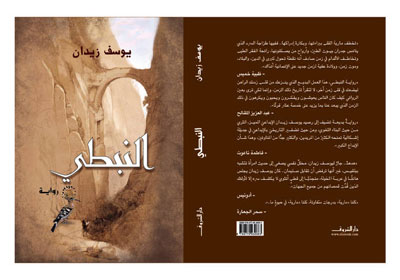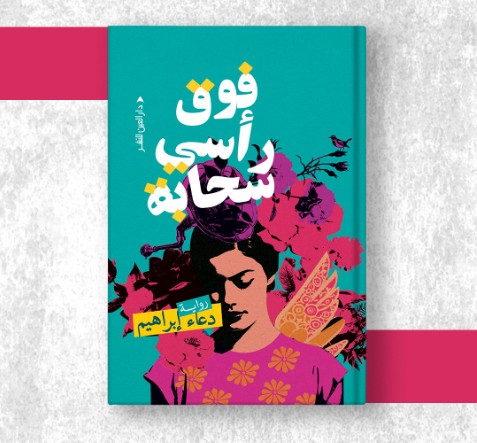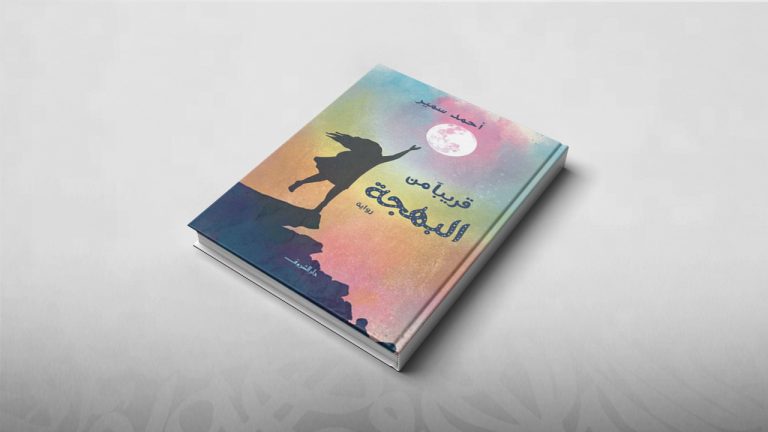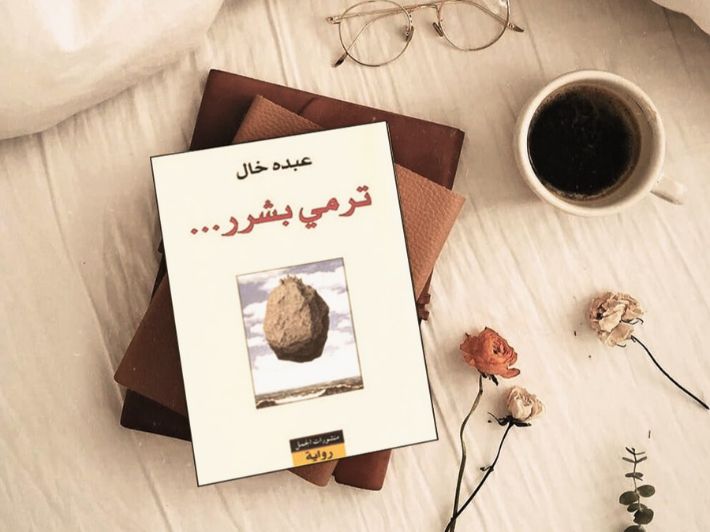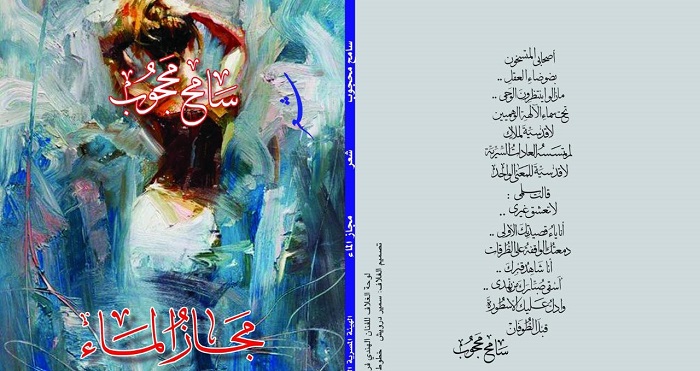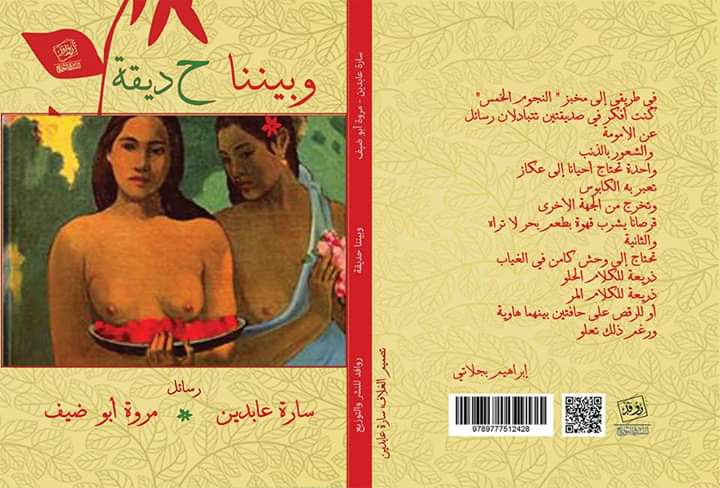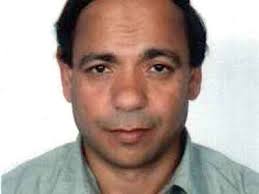للعهر ساحات نضالية أخرى غير الجسد .. هذا ما يؤكده الروائي وحيد الطويلة فى روايته “باب الليل” الصادرة عام 2013 بالإشتراك بين ثلاثة دور نشر عربية: دار ضفاف – بيروت، ومنشورات الإختلاف – الجزائر، ودار الأمان – المغرب.
تدور الرواية فى تونس، وتحديدًا في مقهى يسمى “لمة الأحباب”، هو في واقعه لمة العاهرات والمناضلين السابقين ونهَّازي الفرص، وهم على اختلافهم يشتركون في الضياع التام .. ضياع في الماض، أدى بدوره لضياع آخر في الحاضر، ومن ثمَّ المستقبل.
تنقسم الرواية لـ 15 فصل (باب البنات، باب الفتح، باب النساء، باب العسل، باب الهوى، باب للا درة، … الخ) وهي متصلة منفصلة، متشابكة متقاطعة، فكل شخصية لها بنية منفصلة، لكنها تعود لتشتبك بجسدها ومصيرها مع أخرى في فصول أخرى.
المقهى هو مكان لإصطياد الزبائن (رجل لامرأة، وامرأة لرجل) وتسجيل الإعجاب، والحمام هو آخر خطوات تتبُّع الفريسة حيث تبادل أرقام الهواتف للقاء المرتقب .. فـ “كل شيء يحدث في الحمام”.
في “مدينة لا تعرف سوى الأجساد والنقود”، حيث “لا يدفع فيها أحد لأحد لوجه الله والمحبة، ولو في الأعياد الوطنية”، ولأن “الأهل في ضيق، والعمل مستحيل، والعريس بعيد”، ولأن “لا أحد يملك هنا فرصة أو نصف فرصة”، يغدو العهر مبدأ ووجهة نظر واختيار أوحد. “الجسد هنا هو المجداف الذي يتكىء عليه الجميع .. وكله معروض في أجمل فاترينة تحت أشيك ملبس أو أجمل عري، لكنه بلا أدنى شاطىء من روح”.
القضية الفلسطينيَّة هي محور الرواية، بما أن مناضلي وثوار الأمس من فلسطينيين وغيرهم من جنسيات عربية أخرى، أساسيَّة ومؤثرة، يدفعهم الواجب كما القدر والمكتوب. “في أي شيء يمكن أن تناضل الآن؟ في الوطن؟ أي وطن !! لقد تغيَّر طعمه بعد مائة إتفاق رديء، بين أرجل جماعتنا وتحت أقدامهم، وكفى الوطن أن يبقى في توهة الحلم، على أن يستيقظ الأخير من سُباته”، فتكتشف بهذه العبارة أن مآل القضية الفلسطينيَّة هو نفسه مآل الوطن العربي كله؛ تائه، متقهقر المكانة، يقتات فُتات حلم تحوَّل لكابوس مرعب.
الشخوص كما ذكرنا سابقًا، خليط يتكون تحديدًا من العاهرات والمناضلين السابقين. درة: صاحبة المقهى، العاهرة المحترفة الراقية، التي لا يطالها إلا رجال المناصب أو المحظوظون، كسوف: القواد، رجل الظل، الذي ينقل أرقام الهواتف، ويتم صفقات التواعد، نعيمة: العاهرة التي تختطف أختها فرصتها، حلومة: السحاقية الثلاثينية، الخدومة، خريجة السجون، محمد كازانوفا: العاشق الذي لم تسلم واحدة من غزواته، والذي أحب واحدة فقط بصدق، لكنه لم يحظ بها، أبو شندى: الفلسطيني الذي أوصدت في وجهه باب العودة للوطن بعد إتفاقية أوسلو عام 1993، أبو جعفر: الفلسطيني، الأقرب للجنون، والمؤمن بأن صدَّام لا زال يحيا، شادى: الخمسيني الذي ألقى بالنضال جانبًا، وبات منشغلًا بالنضال في الجسد، ألفة: العاهرة الشريرة، والشرهة لكل شيء، باربي: الصحفية الثلاثينية التي لا تضاجع سوى شباب عشرينيين، بريجينف: الذي بيبع الوهم، رحمة: أرملة خلوقة، لم تنزلق للرذيلة لكن عالمها المنغمسة فيه هو المقهى، حبيبة: مغنية المقهى التي تحلم بالسفر إلى مصر لتحقيق حلم الشهرة، السيد إنجرام: مصري، ناضل في بيروت، وسيط بين الفُرَقاء، يقبض من كل ناحية، غسان: تونسي من أب سوري، مناضل سابق، ومخبر حالي، مجيد: لبناني، ليس له همًّا سوى الخمر والنساء، سي الُمنجي: من كبار ضباط الأمن السابقين. وكما نلاحظ، غالبية أسماء الشخصيات أسماء أعلام، والبقية أسماء مستعارة مثل (بريجينيف، باربي، بورقيبة) أو خليط من الإثنين، مثل (محمد كازانوفا).
يدفن الواحد منهم حكايته في الباقين، ينسى بهمهم همومه. الكل يلعب بالورق والجسد “لقتل الوقت المقتول، في إنتظار وقت آخر لا يجيء“.
لم يكن من قبيل المصادفة أو الشيء الغريب أن نجد ذاك الجمع الذي “لم الشامي على المغربي”، فالإثنين واحد، أو دعنا نقول وجهين لنفس العملة، بل على العكس، أحدهم كان ويظل الرابح، ففى إحدى العبارات يقول مناضل قديم لإحدى العاهرات: ” نحن كلنا قمنا بثورة في المنافي، وأنت وحدك قمت بثورة في المقاهي، الفارق الوحيد أنك تربحين، أما نحن فنخسر”.
قصة النضال والاستعانة بالمومسات (كما يرويها أبو شندي)، والذي كان مسرحه أوروبا في السبعينيات، ذكرنى بفيلم “ميونخ” الذي كانت تدور أحداثه حول تنفيذ منظمة أيلول الأسود لعملية تصفية البعثة الرياضية الإسرائيليَّة في اوليمبياد ميونخ عام 1972. “كل شىء يحتاج للمومسات .. حتى الثورة”.
بساط الرواية رحب جدًّا، بما أن البطل فيها هو المكان (المقهى)، وبذلك نحن أمام سردية لا نهائية، فالأبطال بغير عدد، يأتون ويذهبون، يتلامسون ويتباعدون، يشتبكون ويهجرون، فالمقهى هو الحياة، والزبائن هم الناس بإختلافهم، وبكل ما يملكون من نجاحات وإخفاقات.
يلعب المقهى برواده لعبة الكراسي الموسيقيَّة، أو فلنقل لعبة البازل، فالعاهرة الواحدة تمر على أكثر من زبون، اليوم واحدًا، والآخرتَأجَل يومه للغد، فيتراجع للخلف مؤقتًا .. وهكذا، ربما لهذا نجد أن فصول الرواية يمكن أن تلعب بها كقارىء نفس اللعبة أيضًا، فأنت تستطيع بسهولة أن تضع أبوابًا مكان أخرى، تؤجل واحدًا وتستقدم آخر. “قطعة تدخل في مكانها الصحيح كي تخرج قطعة أخرى، أو تبدِّل مكانها، تنتقل من طاولة لأخرى كما يفعل أبو جعفر المهزوم، حين يمرض أو حين يدَّعى المرض ينتقل إلى طاولة الفلسطينيين، أو تنتقل الطاولة كلها إلى المستشفى، وحين يبرأ يحوم حول طاولة نعيمة أو ألفة أوأى واحدة أخرى، أو يجمعهم معًا على طاولته. درة سيدة اللاعبات، مبتكرة اللعبة، يمكن لها أن تنتقل بين كل الطاولات لتغير قواعدها بين دقيقة وأخرى. أبو شندي حاول أن ينتقل ثم عاد أدراجه سريعًا. شادى مدفون بسعادة في قطعة بازل شابة تعشق الشعراء والشعر الرماديّ. حلومة ورحمة وحبيبة، قطع جديدة تبدأ عملية الإحماء لتدخل على الرقعة بعد قليل ….”
يقول الراوي: “الجسد الحي يمسح موت الروح أحيانًا”، وذلك حين يتحدث عن التحايل على موت الروح بخوض غمار المتعة الجسديَّة التي تساعد “أحيانًا” على إبراء الروح من علّتها، لكنه يعود فيقول: “الخسارة فيما مضى كانت في الأرواح، لكنها الآن تعشش في الروح”.
لنخلُصُ إلى أن الأرواح المهزومة لا تهدهدها ولا تنجيها الإنتصارات الجسديَّة، وتلك هي إشكالية الروح والجسد في هذه الرواية. لكن حينما نأتي للعشق، فللحديث طعم ولون آخر: “جمال العشق أن يصبح هو الديانة، يُنحي كل الديانات أو يجعلها تذوب فيه وتأخذ لونه وطقوسه وصلواته”. إنه العشق الذي غرق فيه أبو شندي مع زوجته الراحلة، والتي لم يتصور امرأة سواها، ذكراها منعته من العبث مع غيرها، حتى حينما فكَّر في ذلك مرة واحدة، تراجع حينما ذكَّر نفسه بأن درة ما هي سوى عاهرة محترفة. لكن هو أيضًا لم يبرأ من علة الروح التي عطبت مرة بالنضال، ومرة بالفقد.
بداية من “باب الرجال”، مرورًا بـ “باب النساء”، وحتى “باب للا درة” يحدث تكثيف في الخطاب الفلسفيّ، وتلخيص سريع للشخصيات، ومآلها، فتعتقد أن نعيمة سوف يرتبط مصيرها أخيرًا بـ أبو شندي، وبأن درة ستظل خادمة مطيعة لـ سي المُنجي، ضابط الأمن السابق، والمخبر الحالي، فتتأكد أن لعبة البازل قد اكتملت، لكن هيهات، فلم يكن ذلك نهاية المطاف، ولن يكن، فالأحداث المتدفقة، والأحلام المهشَّمة، والوعود المقطوعة، بلا نهاية. فالمقهى/الحياة “يحتضن الجميع، سره داخله، يطوي غرامه في أعمدته .. إن مرَّت واحدة أعجبتك وخطفها آخر، فستقع بين رجليك في اليوم التالي”.
يتبدَّل الزمن، تتغيَّر الأولويات، تختل موازين القوى، “ابن الثائر يصبح عميلًا، معادلة جديدة لزمن جديد”، ويأخذ النضال شكله الجديد، “الناس هنا تناضل في كرة القدم، وفي عجيزات النساء، في لقمة العيش، وتفكر بشرَه شديد في النقود”، وحتى ما تبقَّى منه لا يعدو كونه إستعراضًا، حتى أن تشبيه السياسيّ أو المناضل بالراقص يأتي على لسان إحدى الشخصيات أكثر من مَرة: “الرقص الحار يحتاج مجنونين، في السياسة لا بد له من داهيتين، أو داهية ومجنون على أقل تقدير”، وفي موقع آخر: “مناضل، قل راقص”.
حين يُطلَب منك التوقف عن النضال، عن بيع تاريخك ووطنيتك ووطنك، حين تُقطع عنك سُبُل العيش وسُبُل العودة، فتصبح لاجئًا، غريبًا، سقف طموحاتك أن تبدأ حياة جديدة في غربة أكبر، حتمًا سوف ينتهي بك الحال إلى النضال فوق الأسِرَّة حيث الأجساد الممددة ببذخ، فهذا فقط كل ما هو مسموح لك، وكل ما تبقَّى لك من نضال!
تنتهي الرواية عندما تلوح إرهاصات ثورة آتية (14 يناير 2011)، فتبدأ درة بتغيير دفتها بإتجاهها، هي التي كانت تتملق نظام بن علي وتسخر من نظام بورقيبة، فتغير اسم المقهى، وديكوراته، بل وعاهراته اللاتي فاحت رائحتهن وتهدلت أعمارهن، و باسم جديد، وديكور أجمل وعاهرات أصغر، تستقبل نظام سياسيّ جديد، بعد أن تركل بقدمها صورة الرئيس السابق!
الرواية مسرودة بصوت الراوي العليم، متحدثًا للقارىء، مُرتَّعة بمونولوجات داخلية للأبطال حيث صوت مع، وصوت ضد، مُطَعَمة بمرادفات من العاميَّة المصريَّة. واللغة تترواح بين الإيروتيكية والجادة، الأولى حين الحديث عن الجنس والغواية، فنجد أنفسنا مثلًا أمام درس عميق في فن الجنس والمضاجعة حينما تصطاد باربي شابًا، فتتحدث معه حتى لتخال أنك تقرأ “الروض العاطر للنفراوي”، والثانية حين تحل السياسة، فتُطرد المُتع في هيبة حضورها، إلا أن اللغة بشكل عام عذبة، شاعرية، لا تخلو من سخرية لاذعة، وتورية تفضح أكثر مما تُخفي، أما حين يتحدث الراوي عن مشاهد الخوف الزائد والإرتعاب بلا مبرر وبلا جرم يذكرمن عقاب محتمل من نظام الرئيس، حين كان غسان طفلًا، أو ابن شادى، الطفل الذى حلم بأن يصبح رئيسًا، فهنا اللغة تصبح كوميديا سوداء حد العبث.
كتب نجيب محفوظ معظم رواياته إن لم تكن كلها، جالسًا على مقهى الفيشاوي، وكتب جمال الغيطانى في كتابه “ملامح القاهرة في ألف سنة” عن المقاهي وأصلها وما تعبر عنه، وعن كونها ركن أساسي في أدب نجيب محفوظ،، وكتب مكاوي سعيد في كتابه “مقتنيات وسط البلد” عن مقاهي ومطاعم وبارات وسط البلد، حيث كانت ولم تزل ملتقى المثقفين والفنانين المصريين، يمارسون فيها الفن والسياسة والكلام والصعلكة. هنا أيضًا، في الهامش الأخير، نجد الروائي يذكر اسماء المقاهي التي نسج منها/فيها روايته (مقهى الأوبرا، مقهى باب سويقة، مقهى العتيق، مقهى الشواشية، …الخ)
للمقاهي تاريخ يكتبه روادها بالدم والدموع والخمر والجنس، وللتاريخ محترفوه الذين يكتبونه من فوق منضده تقبع في ركن جانبي خلفيّ في إحدى المقاهي، كي يراقب الجميع بعين ثاقبة .. وأحسب أن وحيد الطويلة أحد هؤلاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدرت الرواية في طبعة خامسة مؤخرًا عن دار بتانة