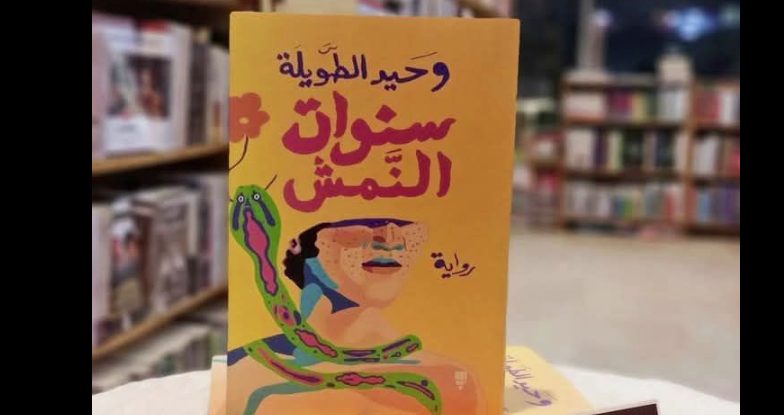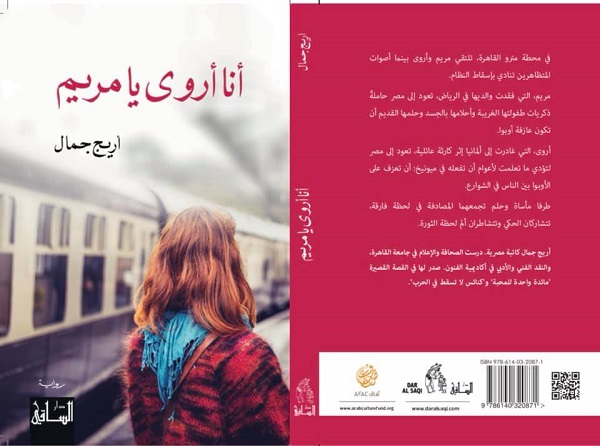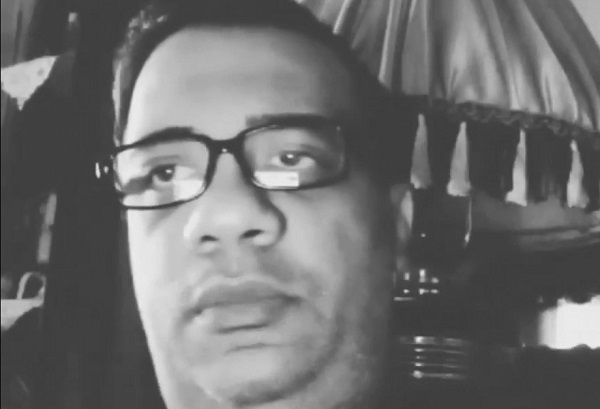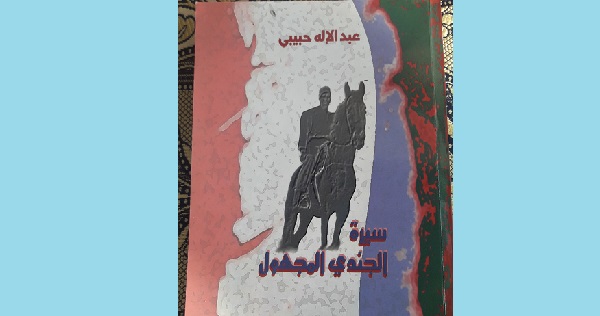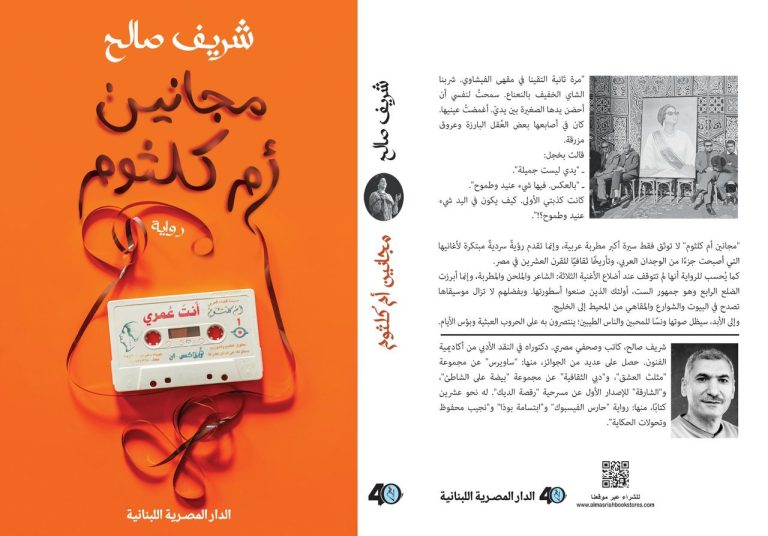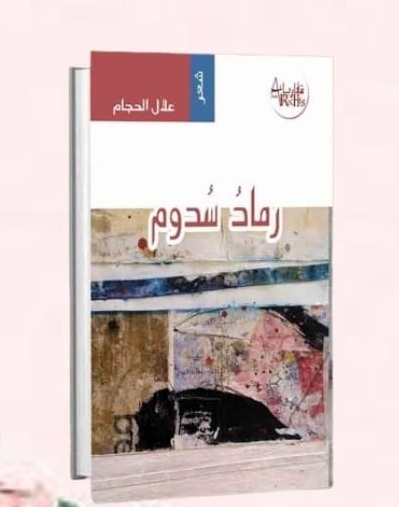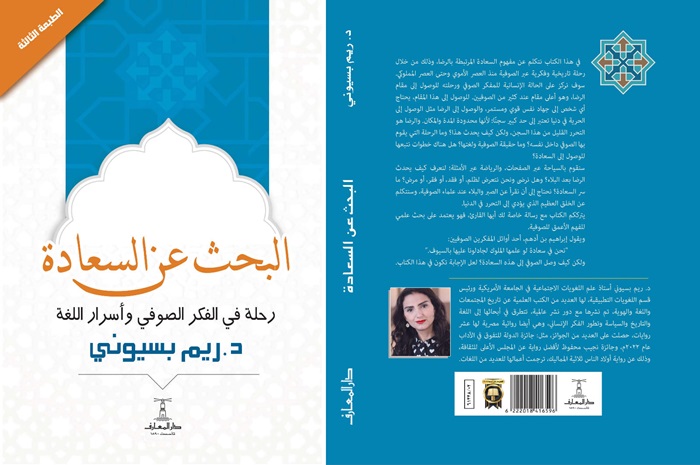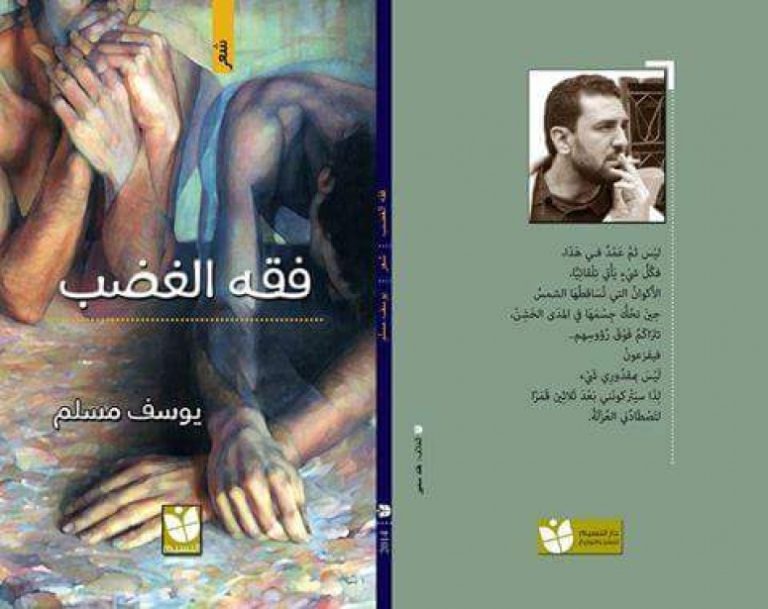سمير قسيمي
في روايته الأحدث سنوات النمش، لا يقدّم وحيد الطويلة حكاية بطل فرد، بل يؤسس لمعمار سردي تصعد فيه الحكاية من “فردنة الألم” إلى كتابة التاريخ الشعبي لعائلة تتناسل منها القرية بأكملها. يكتب الطويلة من زاوية شديدة الخصوصية: زاوية من وُلد موسومًا بالنمش، ذلك العيب الجسدي الذي يبدأ كوصمة، لكنه سرعان ما يتحول إلى عدسة يرى بها السارد العائلة والعالم.
يخلط الطويلة بين السيرة الذاتية والخيال بعفوية ساخرة. فالصوت يكتب كمن يعترف، لكن من دون أن يدّعي البراءة. حكاية الطفولة لا تستعذب الحنين، بل تنبش في القذارة اليومية: بول على السرير، وصراخ بين النساء، وذكورة مشوّهة تبدأ بالسخرية وتنتهي بالدم. إنه عالم يُعاد ترتيبه لا ليُجمّل، بل ليُفضح.
في كل مشهد تقريبًا، يظهر النمش كعلامة مفتوحة. ليس مجرد رمز للعار أو الاستثناء، بل وسم يُعيد رسم الجسد كأرض نصية. النمش لا يغادر الجسد، لكنه يتكلم. يتكلم حين تصمت العائلة، حين تنهار “رجولة الأب”، حين تهرب “الأخت الكبرى”، حين تنقلب “الأم” إلى كائن صلب في الظل، أو حين تُردّد فريال هجاءها المؤلم على عتبات الموت.
لكن النمش، وهو يتكاثر على جلد السرد، لا يعزل الذات عن العالم، بل يربطها بجذور عميقة. فمن خلاله نسمع صوت التاريخ العائلي، صوت الفضيحة والهمس، التواطؤ والخوف، الحب الممنوع والجسد المجروح. النمش يكتب لا بلغة الأطباء، بل بلغة النساء الهاربات والرجال المذعورين. ولهذا، فإن الرواية تشبه “جردًا سيريًا” لعائلة عربية، منزوعة المجد، لكنها مشحونة بالتفاصيل: الملفحة، الطشت، العتبة، المفتاح، النبوت، وحتى طريقة طيّ الثياب.
الهجّالة كمنفى وجودي: النساء في قلب السرد لا هامشه
يخترق الطويلة في سنوات النمش النموذج التقليدي للمرأة الريفية، لا ليمدحها ولا ليشهر بها، بل ليُحرّرها من موقع “الضحية الأبدية”. النساء هنا لسن أجسادًا مكسورة فحسب، بل أرواح تتهكم، تُراوغ، وتنهض كل مرة من وسط الركام. “فريال” مثلًا ليست أرملة عادية، بل مؤرخة بلكنة هجائية، تمشي في جنازات العائلة كمن يُشيّع زمنًا كاملاً.
“الملفحة”، ذلك الرداء اليومي، لا تظهر كقطعة قماش، بل كدرع أنثوي. تختبئ فيها الأسرار، وتُخبأ تحتها الخطايا، وتُشهر بها التحديات. حين تخلعها فريال، تكون الثورة. وحين تتشبث بها النساء، تكون العزلة أو الحياء أو الذل. إن الملفحة تُروى في الرواية كما تُروى الحروب، وتُربط بشرف العائلة كما يُربط الدم بالميراث.
الأجساد النسائية ليست أداة للفتنة، بل موضع للصراع. فالثدي في الرواية ليس موضع إثارة، بل علامة على الأمومة الملتبسة، تمامًا كما يصبح الحيض أو التبول لحظة سردية تكشف هشاشة الكائن، وتضخّم مأساته. وهناك لحظة عابرة – حين يتبول الطفل على نفسه – تصبح من أقسى لحظات النص، لأنها تفضح تواطؤ المحيط في قمعه، وتُعلّق على الجسد علامة لا تُمحى.
الرغبة لا تُعاش في هذه الرواية بشكل طوباوي، بل ككبت معمم. النساء يملكن الرغبة، لكن لا يملكن جسدًا حرًا. كل ما في حياتهن خاضع لسلطة العائلة: الزواج، الحكي، الحركة، وحتى البكاء. ومع ذلك، لا يستسلمن. يسخرن، ويُحاكين، ويُدبرن، ويُشهرن أجسادهن كأرض معركة.
السلطة، اللصوص، والعار: الحكاية التي كتبتها الطوابير
في سنوات النمش، لا حضور مباشر للدولة، لكن حضورها الثقيل يتجلى عبر نسخها العائلية: الأب، الجد، الأخ، وحتى “القرابة”. السرد لا يكشف الدولة إلا من خلال تأثيرها العكسي: قمعها، غيابها، سجونها، وطقوسها البوليسية التي تنتهي بـ”إزالة الشارب أمام الضابط”، في لحظة قتل رمزية للرجولة الكاذبة.
المجتمع هنا ينتج سلطته، كما ينتج طعامه. الأخ يجلد أخاه، والجدة تحاكم ابنتها، والعائلة تُعيد إنتاج أدوارها القديمة، وتلعبها كأنها قدر لا مهرب منه. حتى عندما يثور بعض الأبناء، فإنهم لا يغادرون الحكاية، بل يعودون إليها كأشباح. الجميع أسرى خطاب العار، لا القانون.
والعار ليس خاصًا بالفعل الجنسي أو الجريمة، بل هو آلية اجتماعية لسحق الفرد داخل الجماعة. ومن المفارقات أن أكثر من يحمي “السمعة” في الرواية هم أنفسهم من يكسرونها. لكن لا أحد يعترف. كل شيء يُدار بالتورية: “قالوا”، “سمعنا”، “يمكن”، “حكايات مش مؤكدة”، مما يمنح الرواية بُعدًا أنثروبولوجيًا خالصًا.
الشخصيات الثانوية هنا لا تقلّ أهمية عن المركزية. اللصوص، الشيوخ، العمّات، الأصدقاء، كلهم يتورطون في نسج شبكة القهر. حتى الأطفال يتحولون إلى أدوات في يد الكبار، لا يحملون البراءة، بل مرآة مشوهة لمجتمع لم يترك لهم شيئًا.
الحوار في الرواية ليس حوارات روائية تقليدية. بل هو امتداد للصوت الداخلي، مشبع باللكنة، بالشتائم، بالمرويات الشعبية، بالأغنية، بالعبارة نصف المبتورة. كل جملة حوار هي “وثيقة كلامية”، تُسجّل اللهجة، وتؤرشف الطابع المحلي، وتُظهر كيف تتحول اللغة إلى خندق مقاومة أو مساحة إذلال.
في المعمار السردي: عندما تتحول الحكاية إلى نَسَب وجودي
يتم بناء الرواية على تقطيع زمني ومكاني، لكن لا فوضى في الانتقال، بل تشظٍ محسوب. كل قفزة في الزمن تكشف غشاءً نفسيًا جديدًا، وكل استدعاء للماضي يعيد رسم خريطة الذات. ليس الماضي أرشيفًا، بل حاضرًا متجددًا، يعود كل مرة بصورة ألعن.
البنية السردية تعتمد على التناوب بين السرد التأملي والقص الحواري، بين المشهد والتذكر، بين الجسد واللغة. ويبدو أن السارد لا يسرد فقط، بل ينحت نصّه كما تُنحت الأجساد في الوحل: بصعوبة، ببطء، بشيء من الألم، وبكثير من الحياء المكسور.
أبرز ما يميّز الرواية هو أن كل رمز فيها ليس منفصلًا عن الجسد. حتى الماء – الذي يظهر في مشاهد متكررة: بئر، مطر، بول، عرق – لا يحيل إلى الطهارة فحسب، بل إلى الرغبة، إلى الدنس، إلى انكشاف الحقيقة. أما المفتاح، فهو ليس مجرد أداة، بل استعارة لفكرة “السيطرة” أو “الفتح”، ولهذا تحتفظ النساء بالمفاتيح، بينما يضيعها الرجال، أو يبحثون عنها عبثًا.
حين تنتهي الرواية، لا تنتهي الحكاية. بل تصل إلى لحظة صفاء قاتمة، حين يقول السارد إن “النمش زال من روحه”. لكنه لا يزول من اللغة. إذ تبقى الرواية كلها محكومة به، كأنها كُتبت من أجل أن تفسره، أو أن تسامحه.
رواية تفضح النسب وتحرر السرد من مجازاته
رواية سنوات النمش هي، في جوهرها، تفكيك هائل لخطاب العائلة العربية، بكل ما فيه من سلطة، ذكورة، تواطؤ، ومأساة. إنها ليست رواية عن مصر فقط، بل عن العالم العربي بأكمله حين يتحول النسب إلى قدر، والعائلة إلى محكمة، والجسد إلى ورقة خاسرة.
وحيد الطويلة لا يكتب فقط “نقدًا للسلطة الأبوية”، بل يكتب هجاءً لعالم بأكمله، ويضع تحته نار الحكاية، وحزن الجسد، وحنق النساء، وفضيحة اللصوص. الرواية تستحق أن تكون مرجعًا في دراسة تقاطع السيرة، السياسة، الجسد، والرمز، وهي تُثبت أن الأدب – حين يُكتب من القاع – يمكنه أن يعيد رسم العالم من دون شعارات.
في زمن الروايات المتزينة، تمنحنا سنوات النمش حكاية بوجه مغبرّ، لكن بصوت لا يُنسى. هي رواية مكتوبة ضد النسيان، وضد الغفران السهل، وضد النظافة اللغوية. هي رواية تعرف أن “النمش” لا يُغسل،
بل يكتب، لكن بسحر قلم الطويلة.
————–
وحيد الطويلة: كاتب الحكايات المهزومة ببلاغة السخرية
كاتب وروائي مصري وُلد عام 1960، يُعدّ من أبرز الأصوات السردية التي أعادت تشكيل اللغة الروائية العربية من الداخل، عبر مزيج متفرّد من الحكي الشعبي، والسخرية السوداء، والتأمل الفلسفي العميق في شؤون الهامش والهوية والسلطة.
كتب الطويلة في الرواية والقصة القصيرة، وله حضور لافت في الصحافة الثقافية، حيث عمل في عدد من الصحف والمجلات المصرية والعربية. عُرف بأسلوبه الذي يتراوح بين الحميمي والهجائي، وبين الغنائي والواقعي، كما عُرف بشخصياته المهزومة، المتأملة، الخارجة من النُسخ الجاهزة للأبطال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روائي جزائري .. نقلاً عن مجلة الشارقة
روائي جزائري .. نقلاً عن مجلة الشارقة