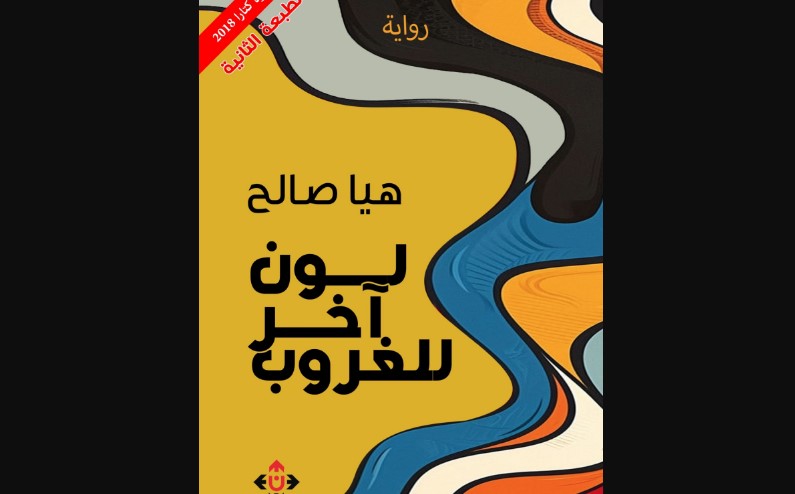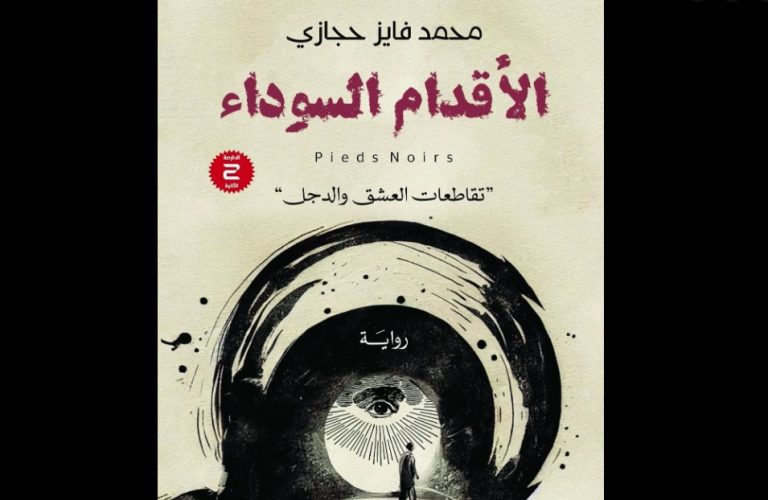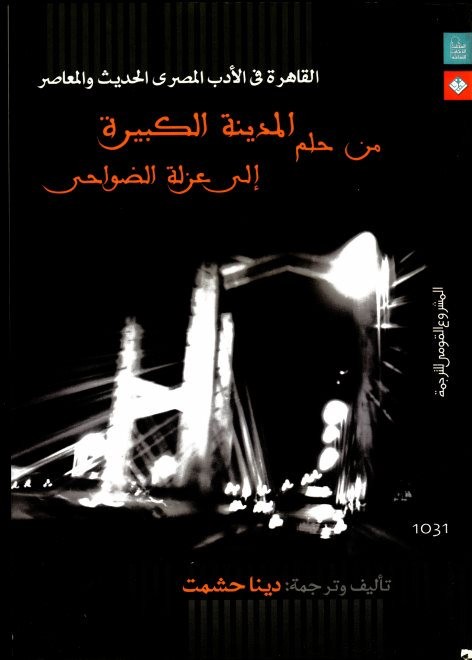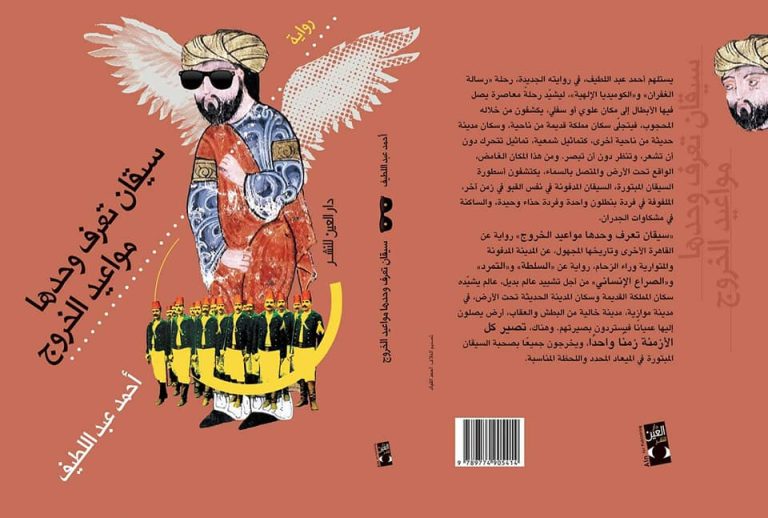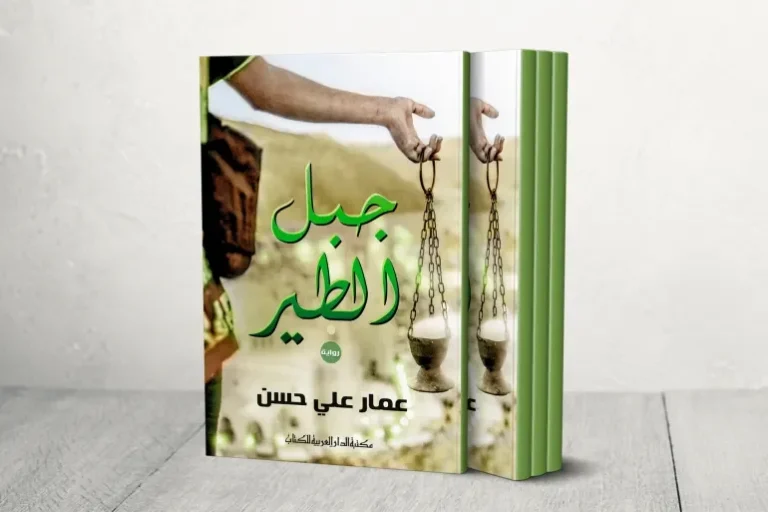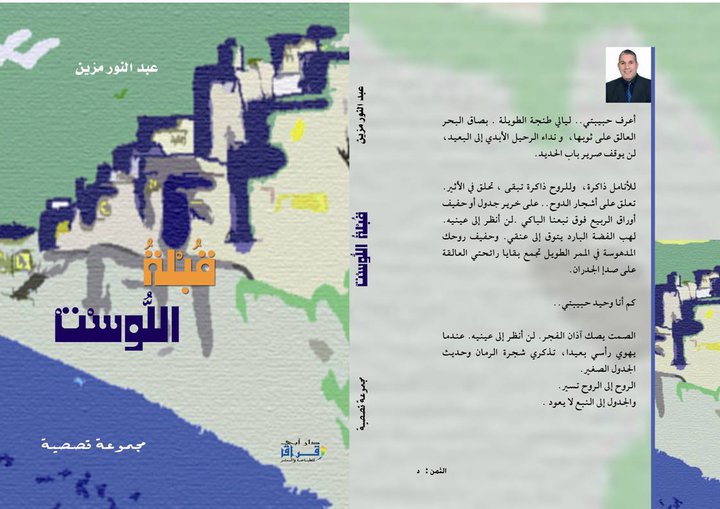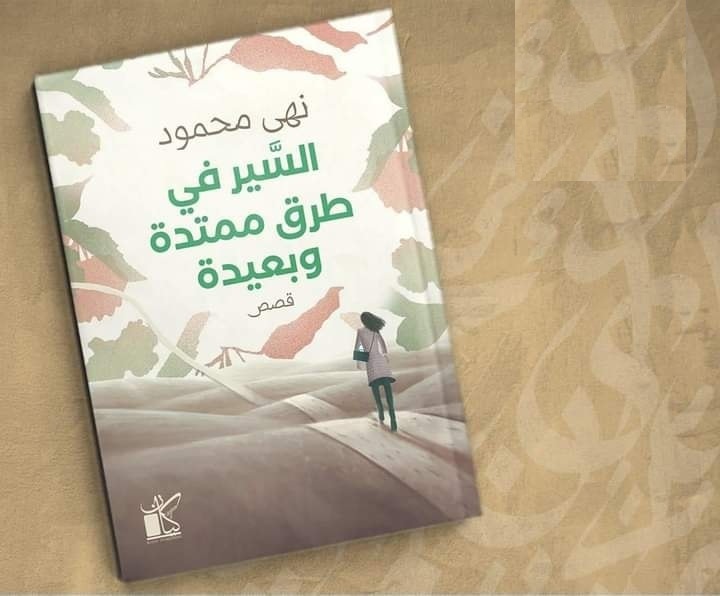رضوى الأسود
إن أردت للزمن عُنوانًا فسيكون رواية “لون آخر للغروب” للروائية والناقدة وكاتبة السيناريو الأردنية “هيا صالح”، والتي فازت روايتها تلك بجائزة كتارا عام 2018 عن فئة الروايات غير المنشورة.
الرواية مكونة من حكايتين متوازيتين ومتقاطعتين في آن واحد. الأولى بطلها “نجيب”، الكاتب الذي يحترف مهنة “الكاتب الخفي” أو “كاتب الظل” الذي يبيع أعماله لآخرين يضعون فوقها أسمائهم، ويقبض هو ثمنًا معقولًا لها، ولأنه كاتب موهوب بحق تفوز رواياته المكتوبة (بحسب طلب الزبون) في مسابقات أدبية هامة. وهو الرجل هادىء الطباع، المنفصل عن زوجته، والذي لم يجرب الحب قبلًا، والذي تسير حياته هادئة، حتى يضطر لإجراء عملية جراحية يتم فيها زرع قلب جديد له بدلًا من قلبه العليل، ومنذ ذلك اليوم تنقلب حياته رأسًا على عقب! فيرى أشباحًا يؤكد طيلة الوقت أنها حقيقة واقعة! وكذلك تقع حوادث غامضة لزبائنه، حتى يجد نفسه طرفًا في قضية مُلغَّزّة، تستجوبه فيها الشرطة ليس كشاهد، ولكن كمتهم!
والحكاية الثانية تٌعَد حكاية داخل الحكاية، إذ أنها الرواية التي يكتبها “نجيب” بناء على طلب زبون يريد رواية تُحذَّر من الخيانة، وفي ذات الآن يريدها أن تحتوي على مشاهد ساخنة تثير الغرائز! والقصة تحكي عن “وفاء” التي تعيش حياة زوجية روتينية تعيسة، حتى تلتقي بـ”كريم” وتبدأ قصة حب فريدة بينهما، تنتهي بموت “كريم” في الحرب السورية الدائرة.
في الحكاية الأولى يتحدث الراوي العليم بضمير الغائب، وفي الثانية تتحدث البطلة “وفاء” بضمير المتكلم، وتُتبادل فصول الحكايتين بتتابع منتظم.
“الإنسان هو من صَنَعَ الآلة وأوجد مفهوم الزمن؛ فالعلاقة بين وعي الإنسان والزمن علاقة تبادلية، يمكن تخيل الدماغ مسرحًا كبيرًا تجري عليه أحداث يقوم ببطولتها الزمان والمكان، غير أن هذا المسرح الفيزيائي هو في الحقيقة مسرح ذاتي باطن. كلنا نسعى إلى كسب المزيد من الوقت، ولعل هذا هو ما قاد الإنسان منذ أسطورة “جلجامش” إلى البحث عن إكسير الحياة”. الزمن هو البطل الحقيقي للرواية، والذي نجده متحققًا بداية من العنوان؛ إذ أن الغروب ما هو سوى توقيت، ثم في العناوين الخاصة بفصول المخطوط الذي يكتبه “نجيب” والذي يبدأ منذ الساعة 12:00 وينتهي 3:16، وكذلك في متن الرواية ككل، سواء في تلك العبارات التي يصيغها “نجيب” وكأنه يرسل بها إلى صديق “افتراضيّ” له، أو في المونولوجات الداخلية لبطلة روايته “وفاء”.
الموت الذي يطل علينا بأشكال مختلفة بطول الرواية سواء موت أكلينيكي (الشخص المتبرع بالقلب)، أو موت بيولوجي (والدة “وفاء”)، أوموت الأمل الذي ينتج عنه موت الروح، وهو الموت الذي يعاني منه غالبية أبطال الرواية، هو بحد ذاته نوع من “التوقيت”، أو حدًا فاصلًا بين شكلين للحياة أو طورين مختلفين للفرد، إذ تتحدث الرواية في مواضع مختلفة عن التقمص، وعن أن الموت ليس النهاية، ولكن هناك حياة أخرى للروح التي لا تموت، في حين يبلى الجسد.
وبقدر ما كان تحديد بطل الرواية (الوقت) هينًا و جليًّا، فمن الصعب بمكان محاولة تصنيف الرواية إذ أن عناصرها السردية متنوعة، وكذلك بناءها الثري والمتفرد، فقد لجأت الروائية لإدماج السينما والمسرح والموسيقى، وكذلك استخدمت أساليب تراوحت بين الواقعية، والواقعية السحرية، والرومانسية، والغرائبية، والبوليسية، والرعب!
رواية الأسئلة الوجودية بامتياز، تحمل فلسفة رؤيتها الخاصة لعالم دمويّ نعيشه، عالم من الوحوش الضارية التي تقتات على بعضها بعضًا، فالرواية التي استغرقت سنوات لكتابتها، قٌدَّت من وحي أحداث ما بعد “الربيع العربي”، ومن رحم واقع خَرِب تعيشه ما تبقى من أوصال الدول العربية؛ سوريا واليمن والعراق وليبيا، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، وما نتج عن ذلك من شتات وتشرذم للفرد العربي، حتى أنها قدمت بطلتها “وفاء” كأردنية لأم فلسطينية وأب عراقي، تقع في حب فنان سوريّ (كريم). وقد نُسِجَت الأحداث من نكسة الروح لدى الشخص العربي الذي يعيش في مجتمعات مأزومة، منافقة، إذ لا يرى الزبون الذي أتى لشراء رواية أية غضاضة في كونها وعظية تحذَّر من الخيانة، وفي الوقت نفسه يطلب من “نجيب” ملئها بمشاهد إيروتيكية لضمان رواجها!
وبالمثل تناقش التطرف الديني والجماعات الإرهابية التي تتخذ الدين ستارًا، إذ أن “كريم” المعجون بالفن هو الشخصية التي لم تنخرط في حرب مذهبية، وعلى النقيض نرى والد “وفاء” وشقيق “سلطان” (صديق “نجيب”) ينخرطا في ممارسة إرهاب باسم الدين، وكأن الروائية تقول أن الفن بطبيعته يملأ الروح ويهذبها، ومن ثمَّ ينبذ التطرف، وأن الثقافة والإطلاع يجليان البصيرة ويفتحان آفاق العقل، فنرى “كريم” يرفض خوض غمار حرب لا تخصه، كونه يؤمن بأن التضحية يجب أن يكون لها سببًا، وبما أن لا أحد يعلم من يحارب من ولأجل ماذا، فقد ترك بلده ورحل، أما هما فارتأيا أن يدافعا عن الدين الذي هو في حقيقته ليس بحاجه لأن يذود عنه أحد!
“لون آخر للغروب” عالم مهزوم داخليًّا وخارجيًّا، عالم مسجون، يعيش به أسرى، بعد أن استعبدته الدول الكبرى “الحرة”. إنها رواية الخسارات الصرفة، هزائم الدول والأفراد، الأب الذي هُزِمَ جسديًّا وروحيًّا في العراق، فعاش بقية حياته -وهو الذي كان مرشحًا بقوة لخوض غمار حياة مبشرة- شبح أدميّ، خالعًا عنه شخصية الضحية، مرتديًا عباءة الجلَّاد، متحولًا إلى وحش. أشخاص الرواية برمتها أرواحها متآكلة. هم مجموعة من الضحايا، ضحايا الحروب والمجتمع والعقد النفسية والجشع الماديّ. فـ” وفاء” وأختها “سعاد” ضحيتا الأب المشوه نفسيًّا، وهو نفسه ضحية الحرب، والحرب صنيعة الدول الكبرى التي تستعبدنا وتحركنا كدمى، وفي ذات الآن هما ضحيتا المجتمع المحكوم بالعادات والتقاليد البالية والموروث الدينيّ. الكل مُكَبَّل الرغبات. وكل الأشخاص والأمور متصلة ببعضها كحلقات في قلادة.
ولأنها رواية الثنائيات، فسنجدها تكتظ بأسئلة عن الحب والكره، الحرية والعبودية، الجبر والاختيار، الحقيقة والخيال، وحيث للذاكرة دائمًا نصيب الأسد، فكل موقف يستدعي ذكرى، وكل حكاية تُفضي لأخرى أبعد منها، وكل حب مهزوم ثمرة لجحود أبوي، وكل هزيمة شخصية سببًا لهزيمة جمعية.
ولأن كمال الحياة في نقصانها، ولأن الإخفاق في الحب شرطًا لخلوده (سواء في الذاكرة الجمعية أو في الوجدان الشخصي)، نجد أن الحب الذي لا يُنسى هو المبتور، هو الذي ظل معلقًا في قلوب أصحابه، لا يكلل بعنوان صارخ التعريف، وكذلك كانت قصتا حب “وفاء” و “كريم”، وكذلك “نجيب” وحبيبته الوهمية التي كان يراها حقيقة لا تقبل الشك.
للأسماء دلالاتها الواضحة سواء بالتطابق مع صاحبها أو بالتضاد الذي يبرز المعنى ويؤكده، فـ”وفاء” هي المعنى الحقيقي للوفاء وإن كانت قٌدِمَت كبطلة خائنة في رواية مكتوبة، إلا أنها فعليًّا لم تخن زوجها، وكذلك ظلت وفيَّة لـ”كريم”، وكانت عنوانًا للوفاء في علاقتها بـ”لينا” حتى بعد وفاتها، “سلطان” دلالة على السلطة، إذ كان ضابطًا مُحققًا، أما “سعاد” والذي اشتق من “السعادة”، فهو نقيض حالة تلك الشخصية التي تعيش في تعاسة (وإن كانت تنكرها وتتحايل عليها) بسبب وفاة الأم، وجحود الأب، وزواج أجبرت عليه، وحرمان من الأمومة، و”ابتسام” التي لا تمت بصلة لاسمها، كونها شخصية بغيضة، لم تقابل الأختين يومًا ولو بشبح ابتسامة، أما “كريم” فهو الفيض الذي أُغدق ذات صدفة على حياة “وفاء”، فيض من سعادة، وحب، وتفاهم، واكتمال.
حاولت الأم التحايل على الموت حين قالت لابنتها أنها كالأرض لا تموت، وقال “كريم” أنه يمكن هزيمة الموت قاصدًا أن الفن يبقى ولا يموت، وقد صرَّح برغبته في الحياة -وهو يلفظ أنفاسة الأخيرة- لأنه كان يريد العيش من أجل “وفاء”. وهنا الإشكالية في أبهى صورها وأعقد تجلياتها حين تكون الحياة ثقيلة والموت خلاص من بين فكَّيها والأمل مستحيل، إلا أن الفرد يتشبث بالحياة خوفًا من المجهول، متسربلًا بالرضا كـ”سعاد” شقيقة “وفاء”، أو ملتحفًا بـ”الحب” (أيّا كان شكل الحب وهمي أم حقيقيّ).
تشابهات الشخصية -وإن لم تتطابق- كالتي بين “سلام” وبطلة القصة “وفاء” وكذلك اشتراك غالبية الأبطال (الفرعية والثانوية) في الخذلان في علاقاتهم الزوجية، في التعاسة، في أزماتهم الوجودية، تدل على أن الجميع يحمل الهم نفسه، وإن اختلفت التفاصيل.
ترى “سلام” (صديقة “نجيب”) أن هناك ما يمكن تسميته بـ “الثالوث المقدس”، وهي العلاقة التي تجمع الكاتب، بالمتن، بالقارىء، وهي علاقة نجدها وقد تحققت في الرواية التي نحن بصددها، فـ”نجيب” (الكاتب) وجد نفسه وقد أستُغرِق بكله في الرواية (المتن) التي يكتبها حتى باتت هي التي تكتبه، متخيلًا بطلته وكأنها حبيبته ويستمر في مطاردات وهمية لها، كذلك حين قرأت “سلام” الرواية، تَكَشَّفَت لها حقيقة معاناة “نجيب”، وبدأت هي الأخرى تستغرق معه في عوالمه وأفكاره التي تثير عندها حالة من العصف الذهني تظهر بوضوح في نقاشاتهما معًا، متفهمة لأزمته وشخصيته، وفي ذات الآن تحذره من أن أوراقه تبتلعه في جحيمها.
الحوار في الرواية، والذي نرى بطلتيه “وفاء” و “سلام” ممسكتان بدفته، وذلك في حديث الأولى مع صديقتها “لينا”، وحبيبها “كريم”، وشقيقتها “سعاد”، وكذلك الذي يدور بين الثانية و”نجيب”، غاية في الثراء، لما يحويه من كم هائل من المعلومات ووجهات النظر، والرؤى الفلسفية للحياة، والسياسة، والصداقة، والعائلة، والموت، والتي بدورها تدعو القارىء للتفكر واستخلاص وجهة النظر خاصته.
توضح لنا الرواية أن الأشخاص المختلفون يتجاذبون، بمعنى أن التوافق لا يأتي من التشابه، بقدر ما يأتي من التكامل، فالاختلاف ثراء. وهنا نرى التوافق بين “وفاء” التي تحمل بذرة تمرد وجنون مطمورة تحت ركام السلطة الأبوية والمجتمعية، تحب، وتتفاهم -بشكل ما- مع شقيقتها “سعاد” الهادئة، الروتينية، المستسلمة تمامًا، و”وفاء” ذاتها تقع في عشق “كريم” الأكثر منها جنونًا وجنوحًا، والذي يُحكِم سيطرته على حياته باختياراته الحرة وليذهب المجتمع إلى الجحيم. فكل شخصية منهم تطمع -داخليًّا- بأن تكون الأخرى التي عجزت عن أن تكونها، والتي تُحقق لها ما فشلت هي عن تحقيقه.
تنتمي الرواية لروحٍ مغامِرة تعترف للقارىء في الصفحات الأولى وقبل بداية الرواية بأنها مثله، لا تعرف أين ينتهي الدرب، ولا المكان الذي تقودها الأحداث إليه! روح تدخل كل مرة غمار كتابة ما، فتنتهي إلى رواية، أو تُفضي إلى مسرحية، أو تتحول لكتاب للطفل، ولأن -كما أتي على لسان “نجيب” وصديقته “سلام”- “الكاتب الجيد يحتاج قارىء جيد، والقارىء الجيد يستحق كاتبًا جيدًا”، تستحق بالفعل “هيا صالح” قارءًا مثقفًا، واعيًا، ذكيًّا، مستبصرًا، لأنه هو فقط -بتركيبته تلك- من سيستمتع معها بالمغامرة، وستلمس روحه عمق الحكاية، تلك الحكاية التي يقصها عليه كاتب شديد التميز، يكتب من روحه وعصارة عقله وخلاصة تأملاته مثل “هيا”.
ولأن الموت قد يكون بداية وليس نهاية، فربما يكون هناك لون آخر للغروب، لونًا زاهيًا لا خافتًا، لونًا محرضًا على المغامرة، لا دافعًا لليأس، لذا -ورغم كل ما تضج به الرواية من حزن وموت- نجد ثمَّ أمل يشرق من عتبة الرواية وينسل من نهايتها، حين يقرر “نجيب” أن تكون روايته تلك باسمه، وليس باسم آخر، في مشهد تنتصر فيه الرغبة في الحياة والتوق إلى التحقق من خلالها.