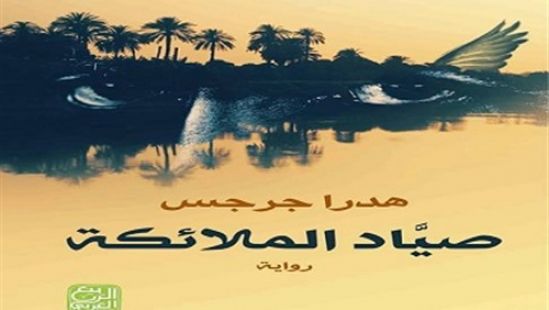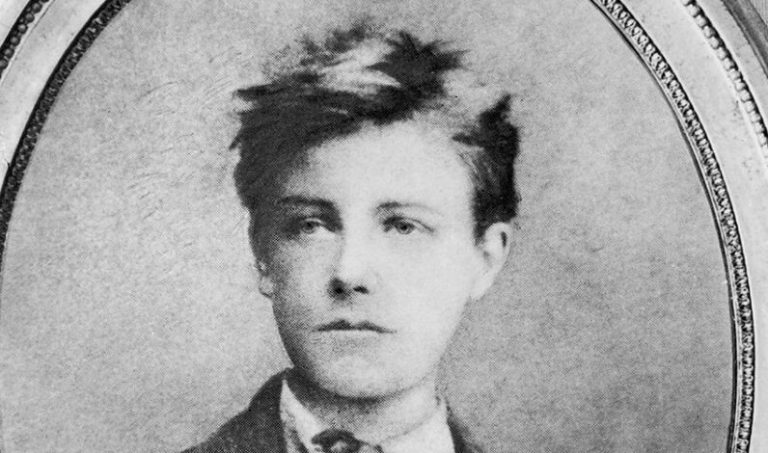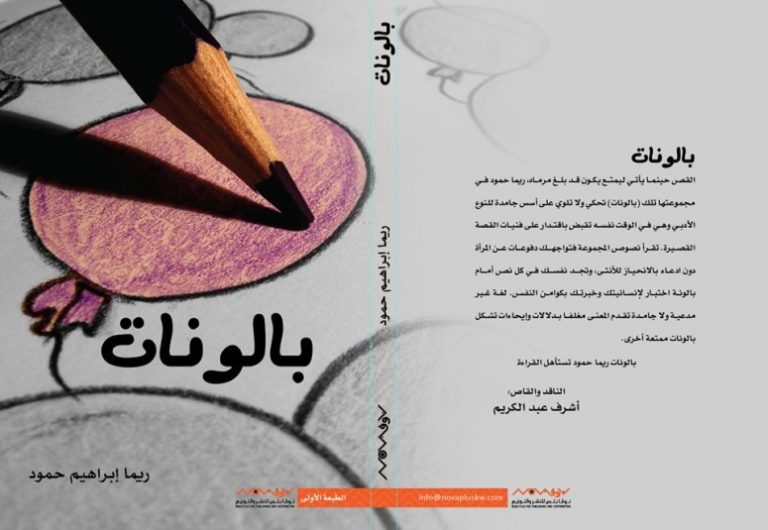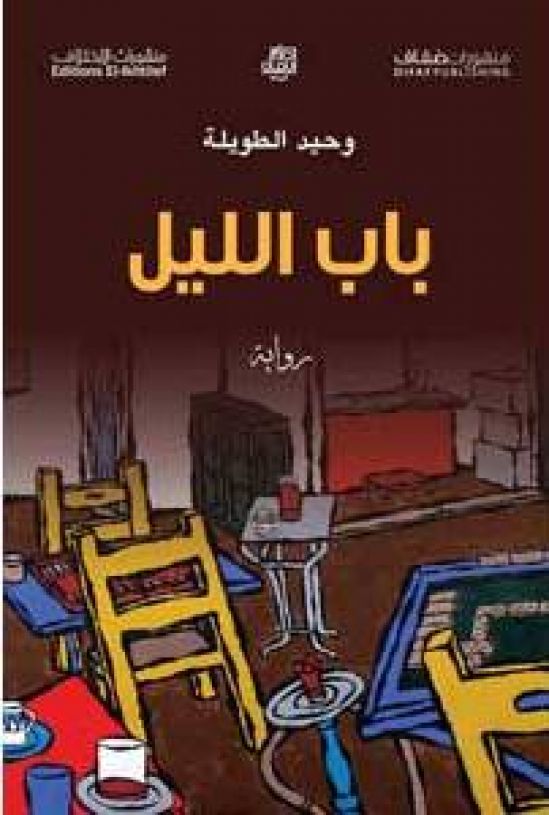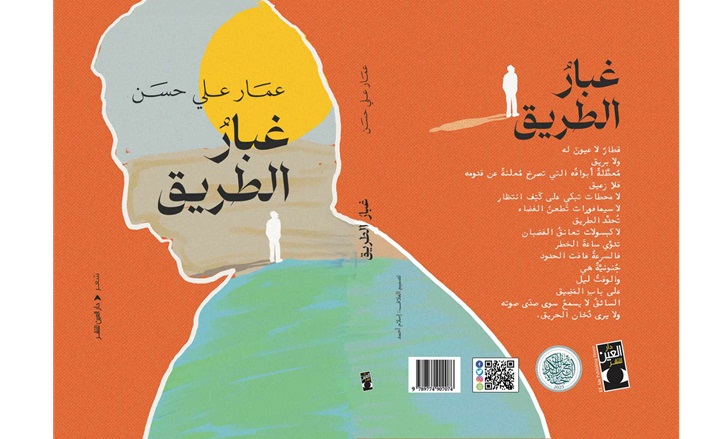قراءة نقدية في العرض المسرحي البصري ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في بورسعيد
ولاء الشامي
في بورسعيد، المدينة التي تنبضُ بالموانئ، وتلتقي فيها رياح البحر برائحة الذكريات، استقبل مسرحها أحد العروض المصرية المعاصرة التي يمكن وصفها بأنها تجربة بصرية وفكرية متجاوزة، عرضًا لم يكتفِ بأن يكون جزءًا من الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، بل حمل في داخله ملامح التجريب الجاد، والاشتباك مع أسئلة الفن في عصر التكنولوجيا. ليس غريبًا إذن أن يحصد المركز الأول في المهرجان القومي للمسرح 2024، وأن يُتوَّج قبلها بـ جائزة السينوغرافيا في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
تعدّت هذه الفعالية كونها مجرّد حدث ثقافي عابر، فتحولت إلى تجلٍّ حقيقي لشعار الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري: “إلغاء مركزية القاهرة”؛ فأن تستضيف بورسعيد هذا العرض ليس مجرد توزيعٍ جغرافي للأنشطة، بل إعادة ترسيم لخرائط الوعي المسرحي، وللمشهد الفني المصري بأسره.
وسط هذه الفعالية النابضة، جاء العرض المسرحي الذي حضرتُه ليأخذ مكانه بوصفه عرضًا ليس تقليديًا؛ لا يكتفي بإعادة تمثيل الكلاسيكيات، بل يتعدّى ذلك إلى إعادة قراءة تقنية وفكرية لمسرحية “ماكبث” لشكسبير، من خلال تجربة جديدة وجريئة: استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة فنية شريكة إبداعية في صياغة العمل المسرحي.
- الذكاء الاصطناعي ككاهن مسرحي:
إحدى أبرز نقاط الجرأة في هذا العرض كانت في إعلان المخرج محمود الحسيني – بشفافية كاملة – أن المعالجة الفنية للنص تمت بالتعاون مع برنامج ذكاء اصطناعي، فتجاوز بذلك ما اعتدناه من نسب العمل للمخرج أو الكاتب وحده. هذه المصارحة النادرة تحيلنا إلى سؤال فني وأخلاقي عميق: من يملك النص؟ ومن يحق له صياغة الحكاية؟
استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة تأويل ماكبث لا يمكن اعتباره توظيفًا شكليًّا، بل انغماس واعٍ في بنية النص الدرامية، خاصة حين استُبدلت الساحرات – رموز النبوءة والقدر – ببرنامج ذكاء اصطناعي يقدّم لماكبث توقعاته حول المستقبل إثر تحريضه على اغتيال منافسه.
هذه الإزاحة الرمزية من الميتافيزيقي إلى السيبراني لم تكن عابرة؛ فقد أضاءت بذكاء على مفارقة العصر: لم تعد النبوءة تأتي من الأرواح الغامضة، بل من الخوارزميات، ولم يعد مصير الإنسان مرهونًا بالخرافة، بل بالتقنية التي صنعها بيده.

ومن أكثر التحولات الرمزية جرأة في هذا العرض استبدال مملكة ماكبث بمصنع، بما يحمله من دلالات عن عصر الإنتاج الميكانيكي، والآلة التي تلتهم الروح البشرية. فجاءت افتتاحية العرض بمشهد صامت على خلفية عقرب ساعات ضخم يدور بسرعة، بينما يتحرك الممثلون في رتابة وسط خطوط الإنتاج، كأنهم روبوتات بلا إرادة. هذا المشهد لم يكن مجرد مقدمة، بل اختزال بصري لفكرة فقدان الحرية في زمن الماكينة.
كما استُبدلت الساحرات بكيان تكنولوجي هو “مدركة”، برنامج تنبؤات يحاكي العقل الاصطناعي، يقدّم لماكبث نبوءاته حول المستقبل في مقابل الملكة والمملكة. إشارة الممثل في نهاية العرض، وهو يقول: “مدركة قتلت طفلي”، تفتح باب التأويل واسعًا: هل التقنية – بوصفها وريثة النبوءة القديمة – تقتل البراءة الإنسانية؟ وهل نحن أمام قراءة معاصرة لفكرة أن المعرفة المطلقة قد تحمل بذور الفقد؟
- الصورة أقوى من النص:
لكن رغم هذا، لا يمكن إغفال ملاحظة نقدية مهمة: الحبكة بدت – في مواضع عدة – سطحية أو غير مشبعة. قد يعود ذلك إلى اختزال بعض المشاهد أو تسريع الإيقاع، أو ربما هو أثر المعالجة الرقمية التي قد تُفرط في التركيب الزمني دون تعميق نفسي كافٍ.
ولعلي لا أنفي هنا احتمال أن يكون هذا الانطباع شخصيًا، فالعرض يدفع المشاهد للتأمل، وقد تختلف مستويات التأثر بحسب خلفيات الجمهور وتوقعاته.
فبصريًا، كان العرض تجربة آسرة. الإخراج اعتمد على لغة بصرية دقيقة، قائمة على توازن بين الإضاءة والتكوين والحركة، دون إفراط في الزخرفة أو خيانة للمعنى؛ فكانت الإضاءة تُستخدم بوصفها خطابًا مكمّلًا للكلمة، بل وأحيانًا بديلًا عنها. الظلال تلعب، والنور يُوجّه الانتباه، وكأن الخشبة نفسها تتنفّس.
الإضاءة في العرض كانت مبهرة بحق، حيث لعبت دور المخرج الخفي للمشاهد. الضوء لم يكتفِ بالكشف عن الحدث، بل رسم الإيقاع النفسي للشخصيات، وأضفى على بعض اللحظات بعدًا أسطوريًا، خاصة في مشاهد التنبؤ والتحولات الدرامية الكبرى.

- تمثيل يتجاوز الكلمة:
من أبرز عناصر القوة في هذا العرض كان أداء الممثلين؛ فحركتهم جاءت محسوبة بإيقاع مدروس، تتكامل مع النسيج البصري وتخدم بناء الشخصيات. ولم تكن هناك حركة عبثية أو انفعالية زائدة، بل كل خطوة، كل التفاتة، كانت تعبيرًا ضمنيًّا عن الصراع الداخلي، خاصة في شخصية ماكبث التي تجسّدت بحضورٍ متوتر يليق بها.
والبطلة – التي أدّت دور الحبيبة – كانت لافتة في حضورها، فقد امتلكت قدرًا عاليًا من الحس المسرحي، إذ قدّمت شخصية مشحونة بالانفعال المكبوت، مُوازنة بين الرقة والقسوة ، بما امتلكته من قدرة على التعبير من خلال الإيماءة والنظرة والصمت. فكانت صادقة، ومتمكنة من أدواتها، وتضبط انفعالاتها دون أن تفقد التوهج.
أما غريم ماكبث – الذي شارك في أول أيام العرض- فقد كان مثالًا لحضور فطري، يجمع بين القوة والضعف، وبين التهديد والإنسانية، وهو توازن صعب في مسرحية كهذه، فقدّم دورًا طغت عليه الكاريزما والقدرة على تجسيد الصراع الأخلاقي والإنساني.
- حين يتحوّل المسرح إلى مرآة للزمن:
هذا العرض – رغم كل حداثته البصرية وتقنياته المتقدمة – ظل وفيًّا لجوهر المسرح: مساءلة الإنسان، وتفكيك السلطة، واستدعاء السؤال الأخلاقي الأزلي: ما الثمن الذي ندفعه حين نُخطئ الطريق، ونُصغي لوعود لا نعرف مصدرها؟
لكن الفارق هنا أن “القدر” لم يأت من السماء، بل من شفرة، من برنامج، من ذكاء ليس بشريًا. وهذا في حد ذاته دعوة لتأمل علاقة الإنسان بالآلة، وهل سيأتي اليوم الذي تُدير فيه الآلة مسرح الوجود بأكمله؟
- سينوغرافيا كاشفة:
السينوغرافيا التي صاغها العرض كانت من أقوى عناصره، حتى أنها استحقت الجائزة الدولية عن جدارة. استخدم المخرج كراتين التعبئة، وسرير زوجة ماكبث، والمكتب الذي يتحول فجأة إلى علبة تخرج منها الشخصيات، لتجسيد عالَم مغلق يبتلع أبطاله. هذا الاقتصاد في العناصر المادية لم يكن فقرًا بصريًا، بل ثراءً رمزيًا، يحيلنا إلى عبثية الروتين الصناعي وضيق الأفق في عالمٍ تحكمه الآلة.
- الموسيقى: بين إديث بياف وماكبث:
الموسيقى التي وضعها إيهاب عبد الرحمن جاءت متقنة، لكنها حملت خيارًا جريئًا في لحظة فارقة: إدراج أغنية “لا ندم” (Non, je ne regrette rien) للمطربة الفرنسية إديث بياف، قبيل مشهد قتل غريم ماكبث في إدارة المصنع. هذا الاختيار، في سياق انهيار زوجة ماكبث وتعاستها، خلق توازياً مثيرًا بين القوة الظاهرة والانكسار الداخلي.
كما تميز المشهد الذي يؤنّب فيه ماكبث ابن عمّه – الذي صار عاملاً على السير – بشحنة شعورية كثيفة، حيث التصاعد الموسيقي يعمّق الإحساس بالقسوة والخذلان.
- بين التقنية والإنسان:
العرض يترك المشاهد أمام سؤال مفتوح: إذا كانت “الساحرات” في زمن شكسبير يرمزن إلى القوى الغيبية التي تتحكم بالمصائر، فهل تحلّ محلّهن اليوم الخوارزميات، وتصبح التكنولوجيا هي التي تصنع قراراتنا، وتحدد نهاياتنا، وربما تقتل براءتنا؟
هنا يتصل العرض بما يمكن تسميته “السؤال الإنساني الأزلي”: إلى أي مدى نحن أحرار في قراراتنا، وإلى أي مدى نخضع لقوى أكبر منا؟ كان القدر في الماضي يُتصوَّر على هيئة آلهة أو نبوءات، أما اليوم فقد يأتي في صورة نظام ذكي، أو خوارزمية، أو سلطة اقتصادية وسياسية تحاصر الفرد.
وتمامًا كما فعل “ماكبث” حين انصاع لنبوءة الساحرات، يجد إنسان العصر نفسه أمام معضلة مشابهة: إذا عرفت مصيرك مسبقًا، فهل ستسعى لتغييره أم ستسير نحوه بخطى أسرع، وكأنك تؤكد وقوعه؟
- تجربة تستحق التكرار:
“ماكبث” محمود الحسيني ليس مجرد إعادة إنتاج لنص كلاسيكي، بل إعادة طرح للسؤال الإنساني الأزلي الذي يدور حول الوجود البشري منذ زمن، ويظهر في الأدب والفن والفلسفة بأشكال مختلفة بصيغة معاصرة. عملٌ جمع بين الجرأة التقنية، والجماليات البصرية، والرمزية العميقة، ليؤكد أن المسرح ما زال قادرًا على التجريب الحقيقي دون أن يفقد روحه.
فلا يمكن إلا أن أُعبّر عن امتناني لوجود عرض بهذه الجرأة وهذه الجودة في مدينة مثل بورسعيد. تجربة فنية تستغل إمكانات المسرح بوصفه فنًّا قادرًا على التجريب والتجديد، قادرًا على أن يتجاوز نفسه، ويعيد إنتاج كلاسيكياته بروح معاصرة لا تمحو الأصل بل تضيف إليه، في إشارة واضحة إلى أن مركزية القاهرة ليست قدرًا محتومًا، وأن الفن قادر على أن يعيش ويزدهر أينما وُجد الشغف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناقدة مصرية