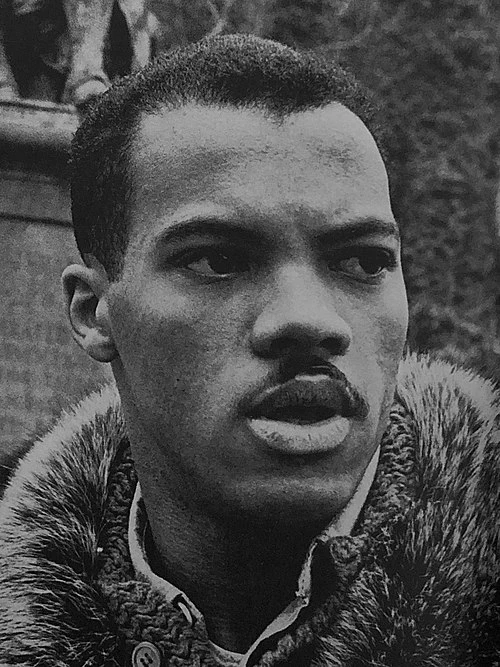أفين حمو
حين طالعت صفحات ليس بعيدًا عن رأس الرجل – عزيزة ويونس للشاعر والكاتب سمير درويش، وجدتني أنزلق إلى عالم يضج بالسخرية والعبث، عالم ينضح بالفلسفة المضمخة بانفعالات لا تمنح القلب فرصة للمراوغة. لم يكن في الأمر فسحة لالتقاط الأنفاس، بل كان قذفًا مباشرًا في صلب الحكاية، كأنني رصاصة أُطلقت دون إنذار، استقرت في عمق النص… وداخلي.
منذ السطر الأول، تشعر أنني أمام مقامرة سردية. الرصاصة التي اخترقت رأس يونس لم تكن مجرد طلقة عابرة، بل بوابة تفتح على تأملات عميقة في الوجود، في الزمن، في ذلك البياض الذي يبتلع كل شيء، لا كنهاية، بل كبداية لتساؤلات لا تملك إجابات. كأن الموت هنا ليس سوى إعادة صياغة للحياة، حيث تتكشّف الحقيقة ببطء، بين الظلال والكلمات، بين المسكوت عنه وما تبوح به التفاصيل المتناثرة كأشلاء على جسد الزمن
“يرى بياضًا يزحف ببطء، يغمر الوجوه والمكان، يتحول إلى امتداد بلا نهاية. يرى جسده ريشة هشة، تتمايل في الهواء، تتسرب عبر طبقات من الحجب والحكايات، لتذوب في بحر البياض.”
هذه ليست مجرد كلمات، بل مرآة تحاصر القارئ، تجبره على التحديق في الفراغ الذي يبتلع المعاني. صوت الرصاصة يتردد، الدم يسيل، والبياض يتمدد كحقل من الصمت. الزمن هنا ليس خطًا مستقيمًا، بل ثقب يبتلع اللحظات ويعيد تدويرها. اللغة لا تقف عند حدود الحكاية، بل تتجاوزها إلى سينما داخلية، حيث تتباطأ اللقطات، ويصبح كل تفصيلٍ علامة على هشاشة الحياة وانعدام اليقين.
في لحظة ما، وجدتني أسترجع مشاهد سينمائية عالقة في ذاكرتي، كأنني داخل فيلم أبيض وأسود يتجلى فيه القدر فجأة. الزمن في هذه الرواية ليس رقمًا على ساعة، بل دائرة تتشابك فيها المصائر، وتتعثر فيها الأرواح وهي تحاول أن تجد تعريفًا للحب، للموت، للعبث.
في قلب هذا العبث، يقف يونس، ممزقًا بين الأزمنة، بين أماكن لا تكتفي بأن تكون خلفية للأحداث، بل تتحول إلى شخصيات نابضة بالحياة. القاهرة هنا ليست مجرد مدينة، بل كائن حي، يتنفس، يتوتر، يتآمر، يسقط مع سقوط أقدام الحائرين في شوارعها. في ميدان التحرير، وسط الضجيج، يسري صوت صديق طفولته، يسري صباحي، كنداء بعيد يأتي من خلف طبقات الزمن.
يتذكر يونس أنه ابن الجبل، حيث كان كل شيء أكثر وضوحًا: قريته الصغيرة، جارتُه عزيزة، الحب الأول الذي وُلد كهمس في ليل الريف. لكنه حين انتقل إلى القاهرة، بدأت تفاصيله تتشظى، تعرف على نساء لم يكنّ مجرد عابرات، بل علامات تركت أثرها في روحه، حفرته كما تحفر الريح ملامح الزمن على الصخور.
“أنا يونس الذي سُمِّي باسم النبي، الذي أخذ اسمه من شيخ الجامع القريب، يونس الذي كان منذورًا للتعليم الديني، يُعَدُّ ليكون واعظًا، إمامًا وخطيبًا، أجلس في مكان ليس مكشوفًا على سطح الدار وأرسم اسكتشات لحبيبتي، لعزيزة، أرسمها في الصفحات الفارغة في الكراسات، منحنية في وضع الركوع.”
هكذا كانت النساء في حياته: محطات عبور، لكن كل محطة تترك ندبة لا تندمل. عزيزة، ذاكرة البراءة الأولى. وئام سلطان، تعيده إلى طفولته دون أن تدري، توقظ داخله ملامح عزيزة عبد الفتاح، الطفلة التي علّمته كيف يكون الحب، وكيف يكون الفقد. مليكة، تلك المسافة بينه وبين نفسه. وآية عبد الرحمن، المرأة التي لم تترك له مهربًا من أسئلته المؤجلة. لم تكن هذه النساء مجرد شخصيات، بل كأنهن أطياف تراقبه وهو يتداعى، يتشظى، يتساءل:
“آية بنت مختلفة، ليست مثل عزيزة عبد الفتاح، الريفية التي رسمت لهما بيتًا بالطباشير وقالت له: ‘أنت الرجل’ وهو بعدُ طفلٌ يبول على نفسه لا إراديًّا. ليست مثل وئام سلطان، الفتاة الشعبية التي كانت تؤمن بأن ‘عشق الروح مالوش آخر لكن عشق الجسد فاني’، والتي انتقمت منه بجسدها حين رأته يتوق إليه، قربته منه كثيرًا دون أن يأخذ ما يريد، ثم انسحبت فجأة، وتركته في التيه.
ليست مثل ماهيتاب، المحجبة الممتلئة قليلًا، الوحيدة التي دخلت شقته ونامت على سريره، ثم خرجت منه مباشرة إلى مراسم زفافها، وكأنها لم تكن هناك. ولا مثل نجوان سيف الدين، الأرستقراطية التي كانت تصعد الدرج بسرعة، دون أن تنتبه للذين دهستهم في طريقها.
آية هي لحظة قيام طائر الفينيق من الرماد، هي نقطة التحول، بنت الحضارة القديمة، التي تعرف البرمجة، تجيد اللغات، تلبس طاقية فوق شعرها، لا لتجمّله، بل لتخفيه، وكأنها في صراع دائم مع هويتها.”
لكن أكثر ما جعلني أتمسك بهذه الرواية كمن يحاول القبض على سراب،واندهش لحدة ذكاء الكاتب كان استدعاء الحكاية القديمة الشعبية: عزيزة ويونس من السيرة الهلالية. لم يكن هذا مجرد تلاعب بالتراث، بل إعادة خلق للأسطورة داخل زمن جديد، كأن الكاتب أراد أن يقول إن كل شيء يعيد نفسه، الحب، الفقد، الغياب… ولكن بصيغ جديدة، وبألم مختلف.
ليس بعيدًا عن رأس الرجل – عزيزة ويونس ليست مجرد رواية، بل تجربة حسية وفكرية، كل جملة فيها كانت اختبارًا، كل مشهد سؤالًا يطفو فوق سطح الحياة. لم يكن سمير درويش يكتب حكاية تُروى، بل كان يصنع دوامة من المشاعر، تأخذك نحو تلك اللحظة التي يصبح فيها البياض هو الحقيقة الوحيدة. ذلك البياض الذي يسكن رأس يونس… ويسكننا جميعًا.
………….
الرواية صادرة عن دار بتانة 2025