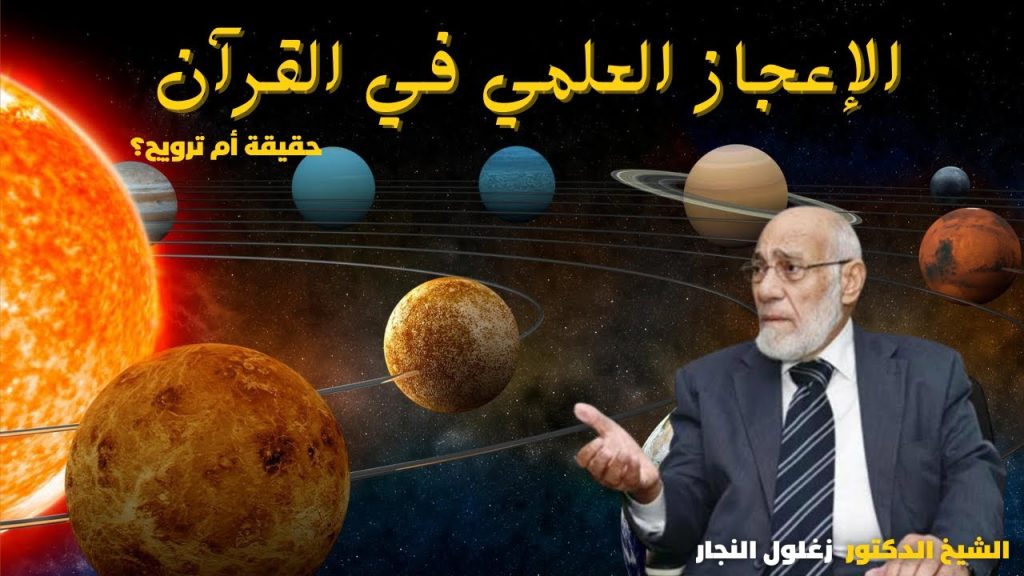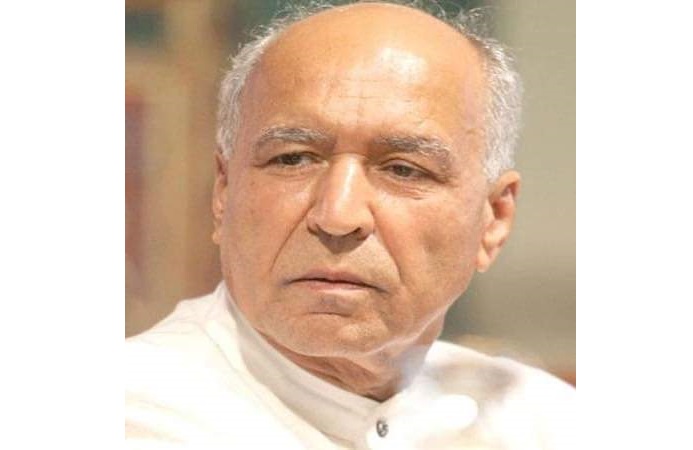لم يضر أحد الدين ولم يضعه على طرف نقيض مع العلم مثلما فعل “علماء الدين”، وذلك حينما خلعوا على القرآن الكريم صفة الكتاب العلميّ، ففسروا آياته بما يتناسب مع وجهة نظرهم المراد اثباتها بشتى الوسائل، حتى لو كان فيه ضررًا على كتاب الله، حيث أن وجهة النظر تلك لا تستند أساسًا على المنهج العلميّ، فيبطل بالتالي استدلالهم ومن ثم استنتاجهم.
يُعَد القرآن معجزة لغوية، بلاغية، نحوية، ويعتبر إعجازه الأروع في كونه أكبر كتاب مفتوح على تأويلات لا نهائية، وهنا تأتي عظمته وقوته ومرونته التي لولاها لما يكون صالحاً على مر الزمان، وفي إختلاف الرؤى والتفاسير رحمة بالناس والمتغيرات من الظروف.
بدأ اعتبار القرآن كتابًا علميًّا منذ حلقات البرنامج التليفزيوني الشهير “العلم والإيمان” لمصطفى محمود، حينما كان يَعرِض الأفلام العلمية التي تعتمد منهج البحث العلمي والتجريب المعملي، فيُلبِسها رداءً دينيًّا بما يتواءم معها من آيات القرآن ليثبت في النهاية أن القرآن معجزة علمية! ولا نستطيع الجزم بدوافعه وأسبابه لذلك، قد تكون محاولة لحسن الخاتمة في مرحلته العمرية المتأخرة، أو قربى إلى الله بنُصرَة كتابه كما فعل قبله أناس ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا من وضع أحاديث في الترغيب إحتسابًا للأجر عند الله مثل نوح الجامع الذي وضع لكل سورة حديثاً في بيان فضلها، أو لمحو صورته القديمة كملحد سابق، وإعلانًا لتبرُّأه منها.
رحل مصطفى محمود، وترك تلك المساحة من التأويل العلمي للدين شاغرة، حتى أتى من بعده زغلول النجار حاملًا شعلته التي أوقدها – للأسف – في جسد الدين، وليس لإنارة العقول. كان المناخ الذي ظهر فيه الأخير أكثر تهيئة وتمهيدًا من ذى قبل، مدعَّمًا بالجهل والتجهيل التام للمصريين حتى لدى شريحة المتعلمين منهم، وتغلغل مبدأ النقل وإعدام العقل على مشانق إتهامات الزندقة والإلحاد، فأتم بحلقاته الممتدة في إحدى الجرائد الشهيرة تحت عنوان: “الإعجاز العلمي للقرآن”، تحطيم كل قيمة عقلية ومنطقية باقية.
كان حظ زغلول النجار أوفر بكثير من سابقه، فأُفرِدت له مساحات شاسعة في الجرائد، وكذلك في البرامج التليفزيونية. تفوق التلميذ على الأستاذ، وأصبح ذائع الصيت، كثير الأسفار، نجم الندوات والمؤتمرات، لكن أتت له الرياح بما لم يشتهيه، وظهرت إرادة الحق في إظهار وبيان التدليس باسم الله وكلماته؛ فكان السقوط المريع في عام 2017، في ندوة بمدينة فاس بالمغرب، حيث أحرجه شباب مثقف واعي باستجوابات وإثباتات علمية تضحد مزاعمه، فلا يملك ردًا سوى نعتهم بالعصابة، والأشرار، والمنسلخين عن العروبة والدين! وماذا كان سيفعل غير ذلك بعد انكشاف هشاشته وكذب إدعاءاته “العلمية”؟!
جاءت هذه النهاية الدراماتيكية بعد سنوات من تجرعنا زغلول النجار وأشباهه وتربعهم على عروشنا، وقد ساهمت الدولة للأسف الشديد في علو شأنهم وإزدهار تجارتهم، مع أنهم كانوا الباب الخلفي لاستقطاب الشباب في فخ الإسلام السياسي، بل إنهم يقومون بدور لا يقل بشاعة عما يقوم به الإرهابيون، فما يقدمونه يُصَنّف تحت بند الإرهاب الفكري، وتعطيل العقل والمنطق، والتدليس بمزج العلم بالدين، وهم في الحقيقة منفصلان تمامًا، قد يكملان بعضهما، فيغذي العلم العقل، ويغذي الدين الروح، لكن المنهج والقاعدة والهدف مختلفان. لكن المدلسون يصرون على مزج الإثنين في البوتقة نفسها، يصرون على إثبات حقيقة ورسوخ الدين عن طريق العلم، بينما الدين هو الثابت بغير إثبات طالما استقر القلب عليه، واطمأنت الروح له، وآمنت به كل الجوارح.
زغلول النجار وغيره، بتأويلاتهم الخاطئة التى تصل حد الأكاذيب، صرفوا الناس عن إعمال عقولهم بإبعادهم عن المنهج العلمي، فما الحاجة إلى العلم، والقرآن كتاب الكتب وبه تفسير كل شىء؟! هؤلاء المروجون – بأدلة فاسدة علميًّا – إلى أن القرآن يحوى حقائق علمية يكتشفها العالَم كل يوم، يهدفون في نهاية الأمر إلى الدعاية للدين وليس للعلم. فالعلم الأوحد بالنسبة إليهم هو كتاب الله وسنة الرسول، وما دون ذلك غير مُعتَرَف به ولا يُعَد علماً (عمر ابن الخطاب وابن تيمية والشافعي لم يروا علماً سوى القرآن، وما دونه تشاغُل عن ذكر الله)! ولنتذكر كراهية المسلمون لمفكريهم وعلمائهم، وماذا فعلوا بابن المقفع الذي قُطَّعت اوصاله وتم شواؤها، ثم أجبر بعد ذلك على أكلها، وصَلب الحلاج، وإجبار ابن رشد على مشاهدة كتبه ومعها كتب ابن سينا والفارابي وابن الهيثم تُحرَق في الساحة الكبرى بمدينة أشبيليه، وسط تكبيرات وهتافات العامة!
للأسف، يتم ذلك كله في وضع ربما هو الأسوأ على مر التاريخ، نذوق فيه – كعرب ومسلمين، عدا من قرر النجاة بنفسه وبلاده – كل أنواع الإنحطاط والهوان والتخلف والدموية كنتيجة منطقية لغياب العقل الواعي، والتفكير المنطقي، والبحث العلمي الذي لا ميزانية تُذكَر له، وبدلًا من أن نخرج وننجو بأنفسنا من ذلك الوضع الأليم، وكي لا نصبح شعوبًا منقرضة، وعالة على العالم الذى يطعمنا ويكسونا ويفكر بدلاً منا، العالم الذي ملأناه فوضى وتقتيلًا، نتقوقع أكثر فأكثر على جهلنا، همنا وشغلنا الشاغل وثقافتنا الوحيدة، كتاب وحيد نتمحور حوله دون سواه، متناسين أن القرآن ليس كتاباً تاريخيًّا أو علميًّا أو سياسيًّا أو نفسيًّا أو ينتمي إلى أي من العلوم الإنسانية المختلفة، وإنما هو كتاب روحي خالص لتنظيم حياة الناس وضمان سعادة البشرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب المقال تعليقًا على ندوة زغلول النجار بالمغرب 2017