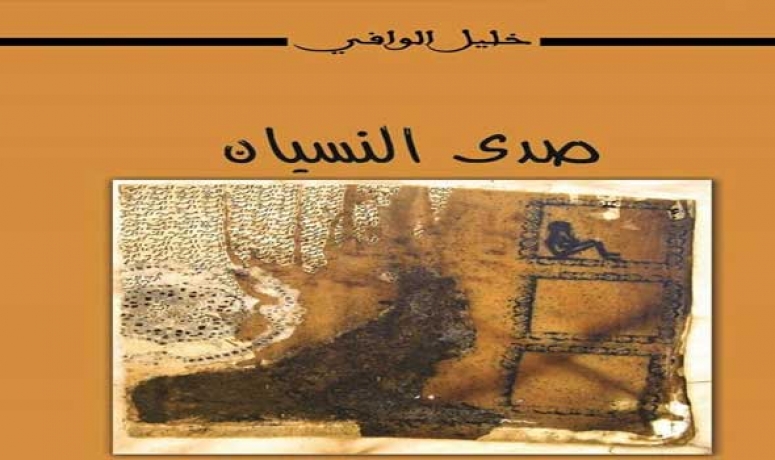انطلاقا من هذا الفهم سنقف عند أشكال بناء الصورة في ديوان “صدى النسيان”، وهو العمل الثاني للشاعر خليل الوافي بعد ديوان “ما أراه الآن”، وواسطة العقد في ثلاثية شعرية سيُصدر الشاعر جزءها الثالث “صرخة الطين” في القريب. وقد اشتمل الديوان على نصوص ضمتها أربعة أقسام، وهي: حدائق من حجر، ووجع يكتبه الصمت، ووشم على ذاكرة المنفى، وبعد كل شيء. وكل قسم من هذه الأقسام ضم نصوصا تحمل عناوينها الخاصة وتتوزع توزعا شاءه الشاعر أن يكون على الشكل الآتي: القسم الأول احتوى ثلاثة نصوص: سماء الحلم العربي، يا صاحبي، قول على قول. والقسم الثاني تضمن أربعة نصوص، وهي: عتبات البوح، مولاتي، عروس البحر، دثريني بالبياض. واشتمل القسم الثالث، على ثلاثة نصوص، بدوره: صدى النسيان، راحل يا أمي، صك الباب. أما القسم الأخير فقد انفرد بنص يتيم حمل وسم: هذا أنا.. بالعربي. فكيف تتشكل الصورة الشعرية في نصوص هذا العمل الإبداعي؟ وما حدود تشغيل الذاكرة وآفاق توظيف المخيلة في تشكيل صور الديوان؟ وما هي الأبعاد الدلالية والفنية التي تحملها هذه الصور الشعرية في أفق اشتغالها؟
سنقف عند صور منتقاة من قصائد الديوان قصد تجلية حدود تشغيل الذاكرة وآفاق توظيف المخيلة في تشكيل متخيل النص الشعري وصوره الفنية.
” أكتب قصائدي؛
أكتب وجع أمتي؛
أرسم وجه أمي
في صخر الموج
ينير منارة دربي
في هدير الحلم،
تطوي السحب أوراق غيمتي،
أحمل حروفي المبللة،
فوق صفحات عذاباتي،
أقاوم عاصفة الصحراء
بعباءة جدي المهلهلة
أجدني هناك صبيا
أقرأ ما تبقى مني
في وصايا محارب
أتعبه بكاء طفلة
تركض خلف حطام المآذن المشتعلة..”(ص.10-11)
يكشف منطوق هذه القصيدة عن أفق دلالي يشكل صور النص استنادا إلى طاقة الخيال، لكن الخفي بين ثنايا السطور هو الحضور المكثف لأداء الذاكرة، وهي تُكون بؤر التصوير الشعري سواء من خلال حضور رسوبات نصوص كثيرة تنثال من مقروءات الشاعر ومحفوظاته، أو من خلال الإحالة على وقائع وأحداث تاريخية معاصرة تتصادى مع أخرى قديمة. وهكذا نجد في المقطع الذي نشتغل به، نوعا من التصادي مع جبران خليل جبران في حديثه عن وجه الأم ووجه الأمة، في قول الشاعر: “أكتب وجع أمتي؛ أرسم وجه أمي، في صخر الموج”. وهذا التصادي ترسيخ لفعل الذاكرة واستحضار لرمز هام من رموز ثقافتنا العربية المعاصرة، وهو في نفس الآن حديث عن وجع الأمة: الأم الذي يتجدد عبر الأزمنة. ولا يكتفي الشاعر بهذه الصورة، وإنما يتبعها بصور أخرى تجعل ذاكرة القارئ تتحرك مع ذاكرة الشاعر وهي تستحضر لحظات من زمننا المعاصر الدامي، ومن تاريخنا القديم الذي يتصادى مع ما نعيشه الآن: عاصفة الصحراء والحرب على العراق وتدمير حضارته. وحطام المآذن المشتعلة بما ترمز إليه من انهيار الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، وفي غيرها من بقاع العالم. هكذا نجد أن متخيل القصيدة الذي يركز على تصوير الراهن يجعل من انثيالات الذاكرة وتداعي الصور والوقائع جانبا حيويا في بناء قسمات النص الفنية.
“ما زلت أرى
ما أراه الآن،
وأخجل مما تراه عيني.
ماذا دهاك أيتها العير؟
لم أجد أثري على الرمل
حين وقفت على مضارب القبيلة
أبحث عن قلادة أمي
وأشيائها التافهة في ركن البيت،
وسيف جدي
ذاك الذي تزينه ألوان الصدأ،
وخريطة وطن
لا تحمل رائحة التراب..
لا تحمل سلالة دمي..”(ص.65)
يبني هذا النص الشعري صوره الفنية على أساس سردي يستدعي عددا من التفاصيل والجزئيات التي تقدم لنا مشهدا عن روح قلقة ترفض ما يقع الآن وتخجل مما تراه العين وتستبطنه النفس. وتستدعي صور القصيدة أجواء عالم الصحراء وما تختزنه ذاكرة الإنسان العربي من ماضيه: العير والقافلة ومضارب القبيلة والأثر على الرمل.. وكلها عناصر تستنفر إلى خيال المتلقي ما عرفه في الشعر العربي خلال عصره الجاهلي وما بعده من وصف للصحراء وعوالم البداوة، ومن تجليات للصراع والعراك، ومن مخايل انهزام واضمحلال لمكامن القوة والحضارة. هكذا ينتهي بحث الشاعر عند مضارب القبيلة إلى خيبة أمل بحيث أضاع الماضي والحاضر معا، ولم يجد رائحة الوطن في الخريطة، كما لم يجد علامات سلالته المجيدة. بهذه الشاكلة يتماهى الشاعر بصوت الجماعة ويجسد معاناة الإنسان العربي المعاصر، وهو يوظف صوره الشعرية المتخيلة المستوحاة من الذاكرة الشعرية، وما صورته من أوجه الضياع والاغتراب وانهيار الحضارة.
“عنيدة أنت…
حين تغادرين حلمك الأزرق
وتخرجين حافية القدمين،
تطلين من نافذة الزمن،
وأنا أغسل ظلي.
تحترق أصابعي
وردا للعيون الشاردة،
أشتهي عطرك،
يعتريني صمتك
وأنت تنسجين
ليلا من النجوم.” (ص49)
نقف عند هذا المقطع الشعري الذي نلمس فيه توظيف الشاعر لطاقة الخيال في ابتداع صوره الفنية. وهي صور تتميز بالجدة، ولا تتكئ كثيرا على المخزون التراثي أو المعاصر. يأخذ الشاعر حريته في تشكيل مقومات متخيله الشعري حينما يدبج نصوصه الغزلية، وقصائده الوجدانية الخالصة، كما نلمس في المقطع الذي نشتغل به، المأخوذ من قصيدة “عروس البحر” وكما نجد في نصين آخرين في الديوان، وهما: مولاتي، ودثريني بالبياض.
في المقطع أعلاه يشكل الشاعر صورة أسطورية لأنثى عنيدة تأبى إلا أن تغادر حلمها الأزرق لتطل من نافذة الزمن على الشاعر الذي يمارس لعبة الكتابة والمحو، وهو يسعى إلى غسل ظله، ويحرق أصابعه وردا للعيون الشاردة. وتبدو المخاطبة التي تجتاز حدود الزمان، متحكمة في المكان والزمان معا، فهي تنسج بسحرها وعطرها ليلا منيرا بالبهاء والصفاء. إنها عروس البحر الأسطورية التي تجتاز حلمها الأزرق لتتماهى بمعاني الجمال المطلق. على هذا المنوال يُشرع خليل الوافي لمخيلته الباب لتشكل صوره الشعرية الجديدة، التي وإن اختزنت صورا تحيل على الذاكرة الثقافية، والآثار الشعرية العربية والعالمية، كما نرى في صورة “خروج المرأة حافية القدمين”، التي تستدعي صورة أفروديت ربة الحب والجمال لدى الإغريق، إلا أنها تحافظ، في سياقها الشعري، على طزاجتها التصويرية.
“صُك الباب..
لي كل هذا البحر
أعبره وحدي،
أعبره في فيافي
ريح تأكل صمتي
على مرافئ خجلي..
أمد أشرعتي
لموج يكسر حلم طفلة
على مرمى الجسد..”(ص84)
يصور هذا المقطع، في لغة بوح شفيفة، معاناة الذات الشاعرة. وذلك عبر صور شعرية تستند إلى منطق التداعي والاسترسال، ومن خلال مجازات واستعارات تبني متخيلا جديدا لا يستند إلى الذاكرة إلا في حدود دنيا. هكذا يخاطب الشاعر الأنثى التي أوصدت الباب مرددا عبارة : صك الباب طول القصيدة، مختارا العزلة، مغامرا عبر البحار والفيافي، ووسط عصف الريح التي تأكل صمته وتخذل أشرعته التي تنكسر تحت هول أمواج كما تحطم حلم طفلة ترنو إلى الحياة والاستمرار والبقاء. بهذه الشاكلة تتالى هذه الإمكانات البلاغية لتصنع عالم الشاعر المتخيل الذي يقف عند الآن، ولكنه لا يقطع مع ما فات، وفي صلب كل ذلك هناك استشراف لما هو آت.