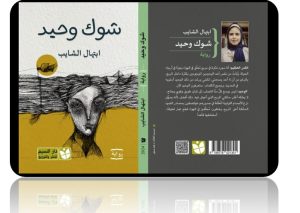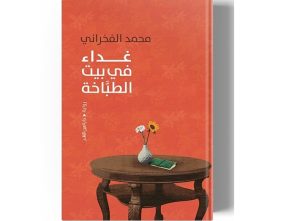وعلى المستوى الكتابة ترشح هذه الرواية في ثناياها جملة من البدائل الفنية التي قد تمثل مهاداً لثورة علىالمفاهيم الرجراجةالتي يسهل وفقها تصنيف ما يكتبون ضمن هذا النوع الروائي أو ذاك. مفاهيم وقفت كجدران لم يستطع كثير من كتاب السرد العربي أن يتجاوزوها.. ولعل نجاحاتهم السالفة وشهرتهم في هذا السمت قد فرضت عليهم عدم تغيير خطهم السردي الذي دأبوا عليه.. غير أن هذه الرواية فعلت ذلك بكل جرأة، وقد سجلت بعض الانفلاتات الابتداعية اختطها الروائي بصورة تبدو منزاحة عن سلفها ومخترقة ولو بقدر لحدود هذا الجنس الأدبي، ولعل أهمها:
من غرائبية العبثي إلى سؤال التجنيس ..
قد يستشكل على القارئ تصنيف رواية “حب في خريف مائل” ضمن المسار العبثيأو الذهني أو في برزخ وسيط بينهما.. ولعله سيتخلى في نهاية المطاف عن قراءتها في ضوء تاريخ هذا الجنس أو ذاك، إذ يجدها تخالف عبثية “ساموئيل بيكيت” (في انتظار غودو، مثلاً) التي تتغذى على دونية البطل وهامشيته في المجتمع الروائي مع تسليمه السلبي بذلك، ولا غريب كامو (ميرسو) الذي يمعن متهابلاً في انسحاقه اجتماعياً ومازوشيته فردياً، ولا حتى(زوربا اليوناني) لكازان زاكييس الذي يسير منتشياً بعبوديته ولا يتكرس وجوده الحيوي إلا في ظلالتابعية الممتعة للرئيس التي تتيح له تشكيل عالمه. عكس هؤلاء جميعاً.. نلفي بطل رواية حب في خريف مائل.. سيداً في عبثيته، التي يُطَهّر بها عالمه من سخافات عالمنا ، من أصنام المجتمع، وأزلام السياسة، وأوهام الثقافة… ساخراً منها جميعاً.. لكأننا أمام ما يمكن أن نسميه بطل الممحاة الذي يلغي مسميات عالمه من الوجود بما فيها اسمه.. في رواية لا تحتفل بالأسماء ولا تقدم لنا هويات متحاوريها إلا بداية من ص(53)، أما اسم [نور الدين بوخالفة الذي يظهر على غلاف الرواية على أنه المعني بأحداثها]، فلا أثر له بين صفحتها.. ويندر في تاريخ السرد العربي قديمه وحديثه أن نجد نصاً بلا أسماء مركزية.
ولعل أول بديل لمكانة الاسم هو تركيبة البطل اللامنتمي الذي يستحوذ-في غنى عن هويته الاسمية- على جل اهتمام القارئ، حيثيصنع البطل لا انتماءه بطريقة تخرجه عن نماذج اللامنتمي التي صنفها كولن ولسون في كتابه النقدي لروائع الأدب العالمي (اللامنتمي). يسير بطل قسيمي نحو نهايته متعرياً من منطقية الأسباب والنتائج، ومتحرراً من تبعات ما يقوم به من أفعال. فكثرة علاقاته الجنسية لا تعني ولعه بالجنس، فهو ليس شبقياً البتة كما يصرح بذلك(ص65).. بل يعيش متنقلاً بين عاهراته دون متعة تذكر ولا نعمة تُشكر.. بطل متوحد هناك على أرض اللاأمل الجرداء حيث يلقى سعادته:»السعادة أن يعيش المرء بلا أمل ولا طموح ولا حتى أحلام»(80).
يستمر إهدار المركزيات في هذه الرواية بصورة توحي بتمرد بطليكبح سطوة المقدس في مجتمعه.. فيجد القارئ نفسه إزاء رواية بلا مقدسات، ولا مدنسات، ما يعفيه من أي التزام أو تخندق إيديولوجي.
وعند بلوغ حالة التجرد التام من أي التزام تفرد الرواية حزمة المقدسات والمدنسات على الطاولة، وتناوشها من أدق الزوايا وتعرضها لمختلف الرؤى قبل أن تمسحها من الطاولة وتضع مكانها بدائل غرائبية تجعل القارئ على استعداد دئم لتقبلكل ما يأتيه خوارق في هذه المغامرة.
لوحات التغريب:
يرسم قسيمي من تمرد بطله ولا انتمائه لوحات تتجاور فيها المتناقضات فتضحى متناغمة من فرط ائتلافها في فضاء الرواية التي تناقش مشيئة الله وأقداره بجوار مشيئة الإنسان ونزواته. من منظور شائخ يستمتع بمعابثة الوجود والموت في خريف العمر.
ولعل أولى اللوحات التغريبية التي تشد القارئ نحوها هي ظاهرة التمائمية (le fétichisme) المستشرية في سائر أركان النص، تمائمية تجرد أفعال البشر من المعنى فيستحيلون في نظرك جماداً، وتبث الروح في الجماد فينتفض حياً.. فتضحى السارة المهترئة معشوقة لا تزاحمها في القلب أي مخلوقة.. وتجعل من الأعضاء الجنسية كائنات حية تحاور صاحبها.. وتتمظهر في صور تحولية شتى فتغدو حصاناً وسلحفاة وحلزوناً بكل ما تحمل هذه الكائنات من دلالات تستنطق واقع المجتمع، وذهنيته ورؤيته للأشياء من منظور خطاب معمق للجسد..
يتحول الجسد في الرواية إلى كون تتساكن فيه كائناتعديدة تتحاور فيما بينها تارة وتحاور صاحب الجسد تارة أخرى، خالقة بوليفونية صاخبة ولوحات فسيفسائية متراكبة.. تمنح لكلٍ من هذه الكائنات صوته المستقل عن الجسد، وتخصه بجوهرية فائقة تجعل العالم برحابته وضوضائه خارج الجسد محض هراء لا يؤثر على حركة البطل ولا على مواقيت ساعته التي تخالف المواقيت الموحدة لدى بقية البشر من حوله.
يحيل خطاب الجسد إلى خطاب المسكوت عنه أو المحظور الذي تتنوع صوره في الرواية بين واضحة وشفافة ومعتمة.. ولعل أبرزها لوحة الجنس التي تحظى بمكانة التيمة المحركة لدواليب النص حين ابتعدت عن مفهوم الشبقية وصارت لساناً ينطق به خطاب الجسد إشارة وعبارة،وعن رؤية للعالم تتجاوز حدود الجسد نفسه.
تواصل التمائمية في الرواية صناعة خطابها حينما تجعل من جزئيات ملقاة على هامش الحياة، أشياء مقدسة وحميمية تقوم عليها حياة بطل الرواية( قاسم) القائمة على: قصاصة ورق، حزمة أوراق بيضاء، كلمة جدار… لندرك في الأنفاس الأخيرة من الرواية أن هذه العناصر الثلاثة هي جوهر الوجود الحقيقي الذي يمكن أن يمدنا بالحياة وليس ذلك الوجود الذي اتفقنا على تقاسمه منذ الأزل، وطالما اعتقدنا واهمين أنه الحقيقة.
لعلنا أمام جنس محدث من السرد، قد يكون [الرواية التمائمية]، التي تختزل لنا الوجود بأسره في مجرد قصاصة ورقفي مهب الريح، قد تكون هي صحيفتنا المكتوبة دون استشارتنا، بينما نلفي أنفسنا منهمكين – بين لحظتي الميلاد والفناء البيولوجيين- في بناء جدران وهمية ننفق فيها عمرنا ونخرب بها وجودنا.. ثم ندرك في خريف العمر أننا لم نبنها إلا لهذه الغاية المأساوية في وجودنا المشتت الذي يبدو كراسة محشوةبصفحات بيضاء يتأبطها كل منا ليكتب فصله الخاص حول تجربة الإنسان المهدور التي عاشها..
و في غمرة تلك التجاذبات الفكرية بين المتحاورين في الرواية يتراءى الحب فردوساً مفقوداً.. أو لنقل أسطورة لجوهرة مستحيلة لا يغني عنها وجود البطل بين أحضان عاهراته الحزينات اللاتي تحمل كل من هن ذرة من ذرات جوهره المشتت، لتنير لنا جانباً من جوانب عالمه المظلم.. وهكذا عاهرة بعد أخرى، وذرة من الجوهرة بعد أخرى،يتلملم شتات الجوهرة، فتلتقي السبل الضائعة، وينقشع الظلام عن الزوايا المعتمة وتتبدى سبل جلية أمام القارئ، الذي يكتشف في نهاية المطاف كل أسرار البطل وخبايا مملكته، ولا يصل هذه الحقيقة إلا حينما يكتشف البطل حقيقته، وذلك باكتشاف سر آخر نسائه . فيجد القارئ نفسه يهتك حجب الأسرار في اللحظة نفسها مع بطله يداً بيد وقدماً بقدم، وهذا في تقديري ما يصنع متعة التلقي النابع من هذه الصنعة المحكمة للرواية التي تتجسد أيضاً في تلك اللمسة التي يصنع فيها الروائي من لفيف عاهراته مفاتيح لنوافذ مضيئة بدورها على لوحات من التاريخ الثقافة والفن تنوس بأسئلة فكرية ووجودية حائرة.. فتتحول العلاقة بين جسدي رجل شريد وامرأة عابرة إلى مائدة يحكي طعامها قصة خشوع رهباني في لحظة صوفية.. بينما يحيل كلامهما إلى لوحات فنية غرائبية.. كأن يستلهم البطل أسلوب الفنان التشكيلي [فيرناندو بوتيرو] في الرسم وهو يتأمل مظهر إحدى العابرات على جسده المنهك..
شعرية التداعي:
بعيداً عن منطق الفضاء الرصين والمحكم البناء للرواية العربية ، تؤثث «رواية حب في خريف مائل» فضاءها بكل ما هو رث متداعٍ ومتحلل مهجور، وتكمن الغرابة في أن فضاء الرواية سواء كان مكانياً محسوساً أو متخيلاً مجرداً، قد شُيد على أسس هشة متحركة لا تثبت على حال.. وأرضية زلقة تنذر في كل خطوة من السرد بانهيار عالمها المهجوس بالتداعي.
إنها إستراتيجية خطابية يمكن أن نسميها [شعرية التداعي] التي تعمد إلى تشتيت المكان في الرواية، جاعلة منه أرخبيلاً من الأمكنة التي تأبى التجانس والائتلاف، وهي مهددة على الدوام بالانهياركلما حلت بها قدماالبطل الشريد، الذي ما أقام بساحة أو معلم إلا دب فيه الاضطراب وأنذره الخراب، وحالما يغادره البطل تتهاوى الأبنية خلف ظهره، ويتآكل العالم تحت نعله معلناً انتهاء الصلاحية بعده، يرتحل البطل من مكان إلى آخر دون أن يلتفت إلى ماضي الخراب الذي خلفه، كما يغادر الأنبياء مدنهم الآثمة التي ادارت لهم ظهرها زمن النعمة، فأداروا لها ظهورهم في زمن اللعنة.
و كلما أمعنا النظر في ذلك اليباب الذي يعتام فضاء السرد، تفتقت شعريتهخلف كل زاوية معتمة، أو معلم خرب، أو جدار مائل..
لعلنا أمام [رواية الجدران]التي تميل مع كل صورة نحو المزيد من الاكتناز دلالةً وإيحاءً، جدران تجعل من البطل ذاتاً محاصرة في العالمبعد أن كانت مظنة حمايته . يتحول الصراع فجأة بين البطل وعالمه إلى صراع بين جدرانه الداخلية والخارجية، فيما يبقى جسده المنهوك.. مجرد غشاء فضفاض لهذه المعركة الأبدية التي يخوضها كل واحد منا .. وعبر عنها الروائي بجداريات سرديةيعثر فيها البطل على حل طلسمي للحياة التي تعنيه، ولعل الأمر يتعلق بنص اطلع على حقيقة حاولت أن تحكيها مختلف التجارب البشرية منذ بدء الخليقة فيما حفظته وضيعته النحوت والأسفار..
سلطان الحكاية
في نسق تصاعدي تستأنف رواية «حب في خريف مائل» تلك الفلسفة الوجودية التي بثها سمير قسيمي في سابق رواياته؛ فمن حيث العنوان، يبدو الحب سلطاناً يحتضر بعيداً عن مملكته التي شيدتها عصور الفروسية والرومانس، كأني بالحب هو البطل المهزوم الذي أحرق في شيخوخته قلاع الوهم التي شيدها شبابه، أما الخريف فما هو إلا النزع الخير من كل حياة عبثية يكشف اصفرار أوراقها على أن ما سبقها من اخضرار وزهو محض أكاذيب سرعان ما تسقط أوراقها وتذروها الرياح، وكذا كل ما شيده الإنسان مائل إلى هكذا مصير في زمن دوراني لا يعرف البداية ولا نهاية.
ينفتح عنوان هذه الرواية على بقية عناوين سمير قسيمي الذي يبدو أن مشروعه يتجاوز صناعة الرواية إلى صناعة قارئ وناقد مختصين بعالمه السردي.. وأراه سائراً بثبات إلى هذه الغاية سواء قصد إليها أم لم يقصد. فمن الحيف بمكان أن يُقرأ هذا العنوان بمعزل عن الحقل الدلالي لعناوينرواياته السابقة، فخطاب الرواية نفسه ليس سوى [تصريح بضياع] أشياء وأفكار قدستها الإنسانية بالتوارث وحان وقت استبدالها بنظائر أقل لمعاناً وتفاؤلاً، وكل يوم من يوميات البطل يشي في ميله الأبدي نحو الهاوية بأنه: [يوم رائع للموت]، دون أن يعني الموت نهاية المطاف، بل يتكشف لعبة شائقة وجد الإنسان نفسه أحد بيادقها المتدحرجة، أما البطل نفسه فشأنه شأن صاحب الرواية؛ شخص [حالم] أبداً ويأبى أن يحيا ويموت في زمن خارج الحلم. ولعله ما من زمن يولد فيه المرء ويفنى سوى زمن الحلم.
و حسب الرواية العربية أن تقدم نصاً بهذه البدائل الفنية والفكرية للسرد والقارئ والناقد معاً لتفتتح عهداً جديداً علينا تدارس ما يرشحه من بدائل، ونقاش ما يميزه من فوارق، ورصدما يتبدى على متنه من ملامح الحداثة، اللهم إلا إذا قيض لمثل هذه الرواية أن تخاطب زمناً غير هذا الزمن، فيُتوّجها غيرنا في الأزمنة اللاحقة عنواناً على علامة فارقة في السرد العربي ذات 2014 من القرون الخوالي..