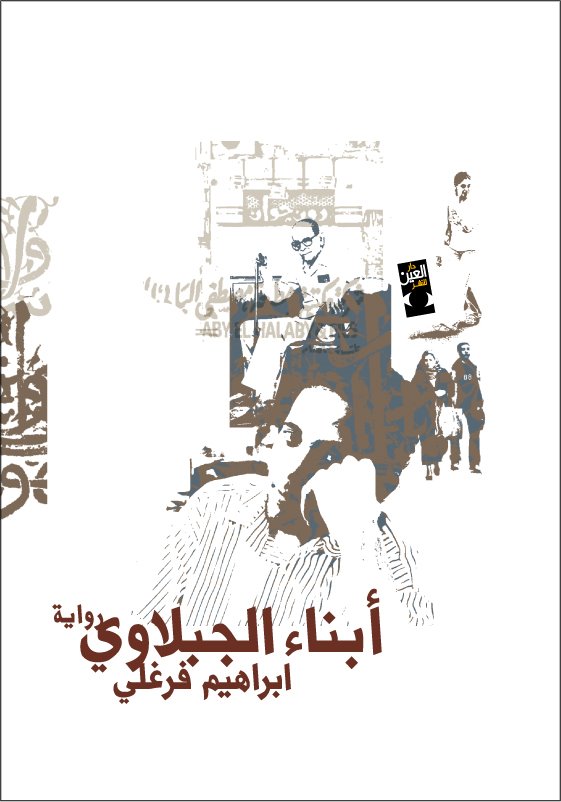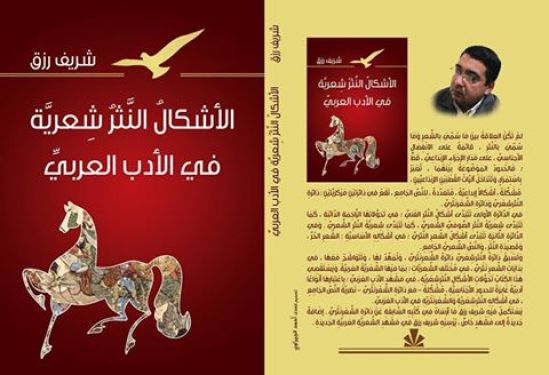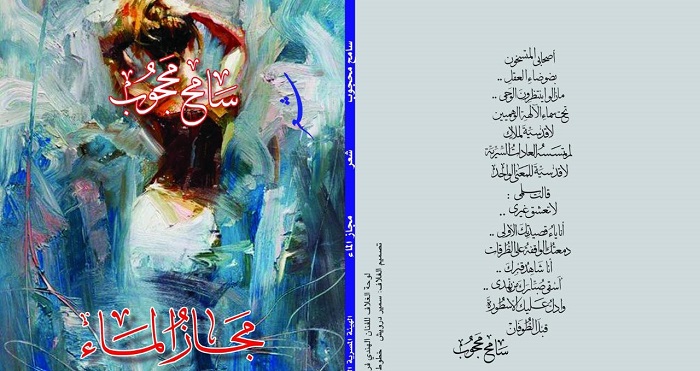د. شهيرة لاشين
لا أعرف ما الذي يدفعني، كلما التقيت شخصًا للمرة الأولى، إلى التحديق في أنفه قبل أي تفصيلة أخرى. ربما بدأ الأمر حين رأيت أنفًا ضخمًا مصبوبًا كصخرة على وجه صاحبه، مشهد أثار فضولي تجاه الطريقة التي يتنفس بها، وخصوصًا أن فتحتي أنفه كانتا صغيرتين بحجم حبة السمسم وتتواريان أسفله. ومنذ ذلك اللقاء صرت أتتبَّع الأنوف التي تمر أمامي؛ أرى الأنف الطويل رمزًا للوقار، والقصير علامة للخفة، والمحدَّب إشارة للنخوة، والمستقيم دلالة للنقاء.
ولطالما ظل نوعان فقط يثيران فيَّ النفور وأبتعد عنهما قدر الإمكان؛ الأنف المنفوش الجشع، الذي يشبه حبَّة القلقاس بفوهتين عاليتين تبتلعان الهواء بشراهة وكل ما يمر أمامهما، والأنف الصغير الناشف، البخيل كما أراه، والذي يبدو كقطعة عظم تلمع تحت الجلد وتمنح صاحبها هيئة الخارج لتوه من قبره.
يشدَّني هذا التنوع في أشكال الأنوف وأحجامها دائمًا، ربما لأن الأنف العمود الفقري للوجه، يُكشف عبره ظاهر الشخص وباطنه معًا. كل نَفَس يمثل اتفاقًا مؤقتًا مع العالم. إنَّه العضو الذي يدخل منه أول نَفَس ويخرج منه آخر نَفَس، ولا شيء يبيَّن الندرة والاختلاف من شخص لآخر كما يفعل؛ يكفي أن يطول قليلًا أو يضيق أو يعلو، حتى يتحول الوجه كله إلى لغةٍ جديدة، وتنهض منه شخصية أخرى جديدة كليًّا.
في مديح الأنف وحاسة الشم المهضوم حقها أكتب؛ فإذا كانت أشكال الأنوف أول ما تلتقطه عيناي في كل وجه، فإن الشم ميزاني الدقيق الذي يحدد ارتياحي وخوفي، وقربي وبعدي عن الأشياء. ومرتبة الأنف في هذه القراءة تتأسس على ارتباطه بحاسة تمنح علاقتنا بالعالم عمقها الأول، فالرائحة تصل إلى الوعي قبل الصورة، وتفتح مسارًا مباشرًا نحو الذاكرة والعاطفة. يشم الإنسان زمنه وطفولته ومدينته، يشم الخوف والقلق والخطر، ويشم جاذبية شخص لا يعرفه، وكأن الأنف خزان الذاكرة الأعمق. يسمي العلم ذلك “ذاكرة الشم”، وتشير الدراسات إلى أن الروائح تُخزَّن في مناطق دماغية ترتبط بالحنين والانفعال أكثر من الصور والأصوات، مما يمنحها قدرة على استعادة مشهد من الطفولة بدقة مدهشة، وإثارة خوف قديم، وإعادة شعور بالحب أو الفقد، وفتح أبواب لذكريات كامنة. وهكذا يتخذ مديح الأنف شكله كاحتفاء بأداة معرفية تصل بين المرئي والمستتر، وتفسح للحدس طريقه نحو القرار وتعيد الإنسان إلى خبرته الأولى بالعالم.
من هذه العتبة تبدأ سلطة الشم بوصفها جهازًا اجتماعيًا يعيد تشكيل العالم عبر منظومة تبتكر لغة تحدد الجماعات من خلالها حدودها، وتعيد إنتاج التراتب الطبقي فيما بينها، بحيث يمتلك كل مجتمع رائحته الخاصة، ففي الطبقات العليا التي تمتلك الثروة والنفوذ تتكون الرائحة من مزيج العطور الرفيعة، وزهور الحدائق، والهواء المصقول داخل السيارات الخاصة. هذه الروائح لا تشير إلى ترفٍ مادي فحسب، وإنما تكشف عن اقتصاد للهدوء واتساع للمساحة الشخصية ودرجات محسوبة من العزلة التي تقوم عليها فكرة الحياة المطمئنة. هنا تصبح الرائحة مؤشرًا على القدرة على التحكم في المحيط، وعلى امتلاك مسافة آمنة تُحصَّن الجسد من الاحتكاك اليومي بالعالم الخارجي.
وفي الجهة المقابلة تتراكم في العشوائيات ووسط المدينة، من الطبقة الوسطى وما دونها، روائح تنشأ من تفاصيل الحياة اليومية؛ رائحة الطعام الذي يُطهى داخل البيوت، ورائحة فانيليا الكعك والغرف القديمة، وهواء مشبع برطوبة الزحام، وأجساد أنهكها العمل والتنقّل. هذه الروائح تحمل سردًا يعكس اقتصادًا للكدح والتصالح مع المساحات الضيقة، وتكشف هشاشة البنية التي تتحرك داخلها هذه الطبقات. وفي عمق هذا المشهد تتخذ الرائحة معنى يتجاوز دورها الحسي، إذ تتحول إلى شاهد اجتماعي يحدد شروط العيش ويعمل كمعيار غير مكتوب لتوزيع الموارد والفرص. وبالتالي يتكون عالم طبقي يقرأ بعضه بعضًا عبر الرائحة ذاتها، وتصير المسافة بين الطبقتين محمولة على اختلاف في الإيقاع اليومي ودرجات الإرهاق والقدرة على حيازة المساحة، أكثر من أي اختلافٍ في الملبس أو اللغة.
في واحدة من أشهر القصص القصيرة في الأدب العالمي، وهي قصة «الأنف» لنيقولاي جوجول(1842)، يستيقظ كوفاليف ذات صباح ليجد أن أنفه اختفى تمامًا من وجهه، فيبدأ بالتفتيش عنه تحت السرير، وفي سلة المهملات، وفي أي زاوية يمكن أن يختبئ فيها. وحين لا يعثر عليه داخل البيت، يغطي وجهه وينزل إلى الشارع باحثًا عنه، ليكتشف أن أنفه قد أصبح مسؤولًا حكوميًا أعلى منه رتبة. يقف كوفاليف أمام أنفه عاجزًا عن اختيار الطريقة الملائمة لمخاطبته بعد أن تحول إلى شخصية ذات شأن. ومع ذلك يجمع شجاعته، ويتقدم نحوه بأدب طالبًا منه العودة إلى وجهه. عندها يجيبه الأنف بلهجة متعالية: “بالنظر إلى اللباس الذي ترتديه، لا يمكن أن تكون هناك علاقة بيننا”.
تكشف القصة أن فقدان الأنف يوجه ضربة مباشرة إلى صورة الذات ويعري غرور البطل الذي اعتاد الاعتماد على هذه العلامة في تثبيت مكانته أمام الآخرين. ويتصاعد المعنى مع ارتفاع مكانة الأنف حين انفصل عنه وأصبح مستشار دولة، فيترسخ التفاوت الطبقي من خلال تعاليه على صاحبه وتصرفه كمن يمتلك موقعًا أعلى مما كان يمنحه له جسد كوفاليف نفسه.
البطل شخصية يغلب عليها الغرور، ومع ذلك يجد القارئ نفسه مأخوذًا بمحنته وهو يجوب المدينة بيأسٍ بحثًا عن أنفه المفقود، ربما لأنه يتخيل الفزع ذاته لو استيقظ صباحًا ووجد أن أنفه قد اختفى من مكانه. يصوغ جوجول من هذا الاحتمال قصة تلمع بسخريتها، ويُظهر فيها كوفاليف أنه قد يحتمل فقدان ذراعه أو ساقه أو حتى أذنه، أهون عليه من فقدان هذا العضو، لأنه وحده يتقدم صورته ويعلن مكانته بين الناس. هكذا تتخذ القصة شكل نقد اجتماعي ساخر للبيروقراطية والطبقات، ويظهر الأنف فيها بوصفه رمزًا للسلطة والهوية والكرامة.
ومع ما للأنف من أهمية كما يبدو، إلا أن البدايات الأولى للفلسفة شهدت فصلًا حادًا بين الجسد والعقل، بين الحواس والفكر، وبين العالم السفلي المرتبط باللذة والعاطفة والعالم العلوي المتصل بالتجريد والنقاء والصفاء الفكري. وأدت هذه الثنائية إلى تأسيس نسق متكامل شكَّل منظور الفلاسفة تجاه الجسد، حدَّ من قيمة الحواس، وجعل الأنف أداة للاشتباه والالتباس قبل أن يتحول إلى مفتاح معرفي يوضح علاقة الإنسان بالعالم.
إننا نقف أمام تاريخ طويل من الخوف من الجسد وحواسه. فاتسمت النزاعات الفلسفية الأولى لسقراط (470–399ق.م) بتقليل شأن الحواس إلى حد التطرف، معتبرًا الرغبة قيودًا تحجب الحقيقة، وصنَّف هو وأفلاطون(427–347ق.م) العطور والروائح كعلامات على الانحطاط. على النقيض، جاء أريستبوس القورينائي (435–356ق.م) وكان من تلاميذ سقراط، لكنه تبنَّى فلسفة مختلفة، ترى في اللذة الحسية المباشرة-الطعام، الشراب، الرائحة الطيبة، اللمس، المتع الحياتية- طريقًا طبيعيًا إلى السعادة، رافضًا فصل الجسد عن الروح، وجاعلًا الحواس جزءًا من التجربة الإنسانية لا عقبة أمام الحقيقة.
واستبطنت التيارات الدينية والصوفية والروحانية موقفًا يتناغم مع التصور السقراطي، رغم الحضور العميق للأنف في الأساطير والديانات، إذ تتجسد لحظة الخلق عبر النفخ فيه. في الأسطورة البابلية تنفخ الآلهة الحياة في الأنف، وفي سفر التكوين يصبح الأنف موضع اللقاء الأول بين الإله والإنسان “ونفخ في أنفه نسمة حياة”. وبتماهيها مع الفكر السقراطي، تعاملت تلك التيارات مع الحواس، وفي مقدمتها الشم، بوصفها مصدر فتنة ونافذة إلى عالم يستدعي التحصّن، فغدت الحسيات نقيض الطهارة، وتحول جسد الإنسان إلى مساحة تخضع للرقابة والانضباط. ويكشف هذا التمنع عن الحواس عن ميل للهروب من ملموسية العالم وروائحه وتقلباته، مما يجرد الإنسان من قدرته الطبيعية على الاستلذاذ والدهشة. ومع تراكم هذا الإرث الأخلاقي صار للشم عبء ثقافي وديني يضع الحواس في خانة المؤشرات التي يُقاس عبرها الانحراف.
ويبرز في هذا الإطار موقف إيمانويل كانط (1724–1804م)، الذي أسس لتراتب حسي صارم، يقسم الحواس إلى “موضوعية” كالسمع والبصر واللمس، و“ذاتية” كالشم والذوق، معتبرًا الأخيرتين متصلتين باللذة أكثر من معرفتهما، فاحتلتا أدنى سلم الإدراك. واستبعد الشم والذوق من مجال المعرفة الموضوعية، بينما اعتبر اللمس حاسة تقدم معرفة مباشرة. ويتجلَّى في موقفه نزعة أخرى مرتبطة بتصنيف عنصري، إذ نبذ رائحة السود وفضَّل رائحة البيض، معتمداً على حاسة الشم نفسها التي استبعدها معرفيًا.
وقد اعتمد الفلاسفة طويلًا على رأي كانط، وظل تصنيفه للحواس مرجعًا ثابتًا لسنوات طويلة، إلى أن أُعيد الاعتبار لاحقًا للأنف ولحاسة الشم، إذ لفت سيجموند فرويد(1856–1939م) الانتباه إلى أنَّ الروائح تفتح طرقًا قديمة نحو الدوافع الأولى، وأن الطفل يتعرَّف إلى العالم عبر الشم قبل أي حاسة أخرى؛ فتنشأ من خلالها روابطه الأولى بالحياة، وتُحفر في ذاكرته آثار يصعب محوها. ومن هذا المنطلق اكتسبت الرائحة منزلة جديدة، متصلة بالرغبة والطقس والمحبة والموت والقداسة، ومتسللة إلى الذاكرة كجوهر قادر على فتح كهوف بعيدة في المخيلة، حاملة الإنسان إلى مناطق لا يبلغها العقل وحده.
في الأدب، كثيرًا ما يتحول الأنف إلى مفتاح لفهم النفس البشرية، أو مرآة تكشف ما تخفيه الوجوه. فدستويفسكي، في «ذكريات من بيت الأموات» (1862)، يصف ملامح السجناء بوصفها سجلاً حيًا لماضيهم؛ الأنوف المكسورة أو المسطَّحة تشير إلى تاريخ من العنف والقسوة، بينما الأنوف الدقيقة تومئ إلى الخجل أو الانسحاق الداخلي. وبعد عقود قليلة سيظهر أنف «بينوكيو» في حكاية كارلو كولودي (1883)، لينمو مع كل كذبة، ويصبح واحدًا من أكثر الرموز رسوخًا في الوعي العالمي حول علاقة الأخلاق بالجسد.
يتخذ الأنف دورًا دراميًا كاملًا في المسرحية الفرنسية «سيرانو دي برجراك» لإدموند روستان (1897)،. سيرانو الفارس الشاعر، الذي يمتلك موهبة فريدة ولسانًا بليغًا، يحمل فوق وجهه أنفًا ضخمًا يشكل مركز هشاشته الداخلية، ويمثل الحاجز الذي يفصل بينه وبين روكسان التي أحبها. يتحول الأنف هنا إلى عقدة القصة ومصدر توترها، إذ تتكثف حوله مفارقة الحب المستحيل بين الموهبة والجسد، بين ما يظهر للعيون وما يخفيه الشعور.
وبنفس التركيز على جعل الأنف محورًا وجوديًا كاملًا، تأتي رواية تُشم قبل أن تُقرأ، وهي «العطر» لباتريك زوسكيند (1985). يقدم فيها زوسكيند نقدًا لاذعًا للمجتمع الفرنسي في القرن الثامن عشر، مجتمع يختنق بالقذارة المادية والأخلاقية معًا، وتظهر فيه الجماعة البشرية ككتلة قابلة للتوجيه، تندفع خلف الروائح كما تندفع خلف الرموز والخطابات. في هذا العالم يولد جان باتيست غرنوي بلا رائحة جسدية، في مجتمع يقيَّم الإنسان من خلال منظومة الحواس، فيجد نفسه خارج التصنيف البشري منذ اللحظة الأولى. يتحول هذا الغياب إلى خلق رائحة تمنحه حضورًا ومعنى، وتفتح أمامه طريق السيطرة على الآخرين.
أنف غرنوي عبارة عن أداة تتجاوز حدود الشم إلى قوة تقتحم الأجساد وتكشف خباياها، فهو يتحرك في العالم عبر فتحتيه اللتين تتسعان كلما اقترب من رائحة جديدة، فيبدو كمن يفتح عينين إضافيتين تستقبلان ما يتوارى عن بقية الحواس. يستخدم أنفه كسلاح يسبق خطواته ويمد سلطته الحسية نحو الآخرين، فيتتبعهم كما يتتبع الصياد أثر فريسته. ويكفي أن نستعيد جريمة القتل الأولى له، كي تتجلى هذه القدرة الحسية الهائلة التي قادته إلى مصيره بالنهاية.
يمارس غرنوي القتل كجزء من عملية فنية يقترب منها كعمل كيميائي يهدف إلى صناعة جوهر بشري متخيَّل. تحدث أول جريمة وهو في شبابه حين كان يعمل حمَّالًا للجلود، وأثناء سيره ليلًا عبر الأزقة، يلتقط أنفه رائحة لا تشبه أي شيء عرفه من قبل؛ رائحة فتاة شابة تغسل ثمار البرقوق الأحمر. يتتبع الشذى كالمسحور، ويصل إلى الفناء حيث تجلس وحدها، فيقف قريبًا منها، مستسلمًا للرائحة التي تختلط فيها نعاشة العرق بصفاء البحر، ولمعان دهن الشعر بزيت الجوز، ودفء الجلد بزهر المشمش. تتشكل أمامه صيغة عطرية ساحرة تمحو قيمة كل الروائح التي عرفها سابقًا، فيشعر أن حياته لا تكتمل إلا بامتلاك هذا الجوهر الفريد.
ينحني نحوها ويغلق عينيه كي يحفظ رائحتها داخل أعماقه، فيما تمتد يداه إلى عنقها. يتوقف جسدها تحت ضغط أصابعه، فيضعه برفق على الأرض بين حبات البرقوق المتناثرة حولها، ويمزق ثوبها لتتفجر الرائحة المحبوسة في الهواء. يشرع في تشمم كل موضع فيه، من الرأس حتى القدمين، ينتقل خلالها من البطن إلى الصدر، ويصعد إلى الوجه والشعر، ويعود إلى ثنايا الجسد كافة في حركة دائرية متواصلة، جامعًا آخر ما تبقى من العبق عند الذقن والسرة وثنايا الساعد. يظل يدور حولها لحظة محاولًا استعادة توازنه بعد هذا الامتزاج الحسي العنيف، ثم يغلق منافذه الداخلية ويحفظ رائحتها في أعماقه جيدًا، ويطفئ الشمعة ويرحل. ومن رائحة هذه الفتاة تحديدًا يبدأ هوسه الأبدي بالسعي إلى “الجوهر الأنثوي”؛ جوهر يراه قريبًا من الكمال الحسي، ويصبح حلمه بصنع عطر يضع الآخرين تحت سلطته مشروعًا يتحرك من الفكرة إلى الفعل.
النظر إلى الأنوف في الوجوه، تلك العادة التي بدأت بها كلامي، صار وسيلتي لالتقاط العلامة الأولى في كل إنسان. فكل أنف يحمل أثرًا يشي بشيء من حياة صاحبه ويكشف طبقة من سيرته. وهذا الانتباه ليس رغبة في المراقبة بقدر ما هو محاولة لرؤية العالم بطبقاته الظاهرة والخفية معًا، ومديح الأنف هنا احتفاء بحاسة تتعامل مباشرة مع الطبيعة من دون أي وسيط عقلي أو بناء تصوري، حاسة تنفذ إلى التجربة في شكلها الأول. ومن هذه النقطة تتشكل خصوصيته الفلسفية؛ فهو عضو ما قبل الوعي وما بعده في آنٍ واحد.