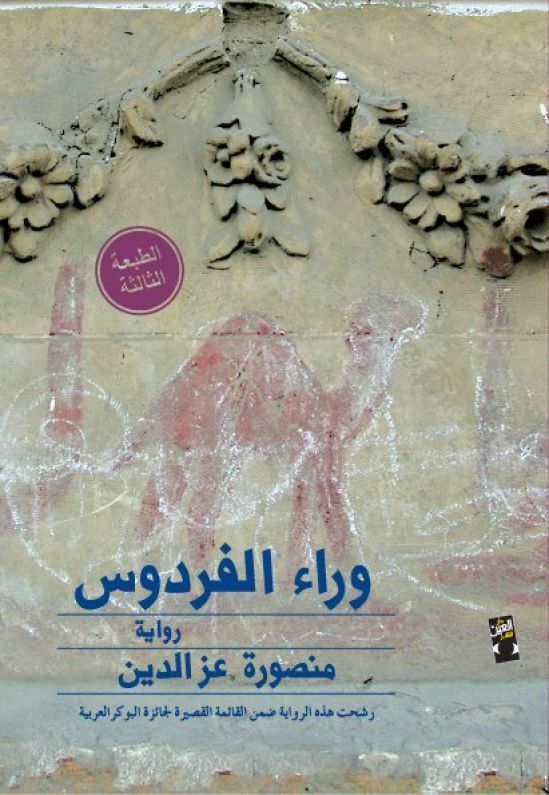عبد الرحمن أقريش
آسفي، 1989.
ترجل (العمراني) من سيارته.
بدا شابا وسيما، حليقا، أنيقا كعادته، وجه مستدير بملامح مشرقة، متورد، ينضح صحة ونضارة، بشرته القمحية الفاتحة، شعره الأشقر الخفيف، ابتسامته السخية.
ينظر إليه (المامون)، يتأمله، يقدر أنه لم يتغير كثيرا.
استقبلا بعضهما بالأحضان والقبلات كما يليق بصديقين قديمين، تبادلا بعض المجاملات. ثم توادعا.
ابتسم (العمراني) جامعا بين الاعتذار والوعد.
– أعتذر فأنا مستعجل، أنت تعرف إكراهات العمل، إنما لا بأس، فأنت ضيفي يوم السبت المقبل، سنسهر معا، ينبغي أن تكون في الموعد.
…
عاش (العمراني) حياته في تناغم تام مع قدره.
أحب الحياة، الحياة أيضا أحبته ومنحته كل شيء، الشباب، المال، الجمال، الذكاء والتفاؤل، بمقاييس الزمن كانت حياته قصيرة، مثل فصل في كتاب، عاشها على عجل وكأنه على موعد مع الموت، وكأن أحدهما يتربص بالآخر وينتظره.
كان متدينا بطريقته، يصلي بانتظام، يصوم رمضان، خدوم، كريم، ينخرط في أعمال الخير بسخاء حاتمي لا تخطئه العين، ولكنه كان دنيويا، يستمتع، يقضم كعكة الحياة، يمتص رحيقها، يلبس على الموضة، ملابس مفصلة على المقاس، بدلات وأحذية أنيقة وغالية، عطور، خمور، سهر، نساء وسفر…
يبدو الأمر بعيدا الآن، بعيدا جدا، فقد مضى زمن طويل.
أتذكر أنه أول من لبس (البيجامة) في حينا الشعبي، بيجامة رفيعة ملونة بخطوط عمودية، تلك (البيجامة) كانت تحمل أكثر من دلالة، فهي من جهته تشير إلى نوع من التميز الطبقي، والحقيقة أن أبناء الحي لا يعرفون هذا النوع من الملابس، يرونه فقط في الأفلام والمسلسلات.
ومن جهتنا نحن شلة الأصدقاء، كانت تلك (البيجامة) فرصة للتندر والسخرية المرحة.
ننظر إليه، نشير إليها.
أحدنا يخاطبه، ويسأل.
– أنظر إلى حالك…في نظركم، هو يشبه من؟
– (رشدي أباظة)؟…
– (فريد الأطرش)؟…
– لا، إنه يبدو مثل (يوسف وهبي)…
ويعترض صديق آخر.
– في الحقيقة، هو يبدو مثل سجين هارب من مسلسل مصري…
يبتسم هو، يضحك الأصدقاء، يضحك هو أيضا.
الظاهر أن سخريتنا لم تكن تزعجه كثيرا، فقد كنا نحبه، وكان هو أيضا يحبنا.
كانت صداقتنا حقيقية رغم الفارق الاجتماعي، في ذلك الزمن البعيد تبدأ الصداقات في المدارس، وتعززها مباريات الكرة وعلاقات الجوار في الحي يوما بعد يوم.
في كل مرة يستعيد فيها (المامون) صورته، أو ما تبقى منها، يجد نفسه أمام شخص بسيط، تلقائي، كريم النفس، مستعد دوما للصداقة، مرح، متفائل، محب للحياة والمتعة، والحرية والانطلاق.
…
أوقف (العمراني) دراسته عند عتبة البكالوريا، ولكنه حصل على وظيفة مرموقة في (مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة) بفضل اسمه العائلي وبفضل الهدايا الغالية التي تلقتها زوجة المدير، وظيفة سهلة فصلت على المقاس تعز على أصحاب الشهادات العليا، فالمال، والأسماء العائلية، والعلاقات، والوساطات، وتبادل المصالح والمنافع، كانت وما تزال عنوانا للرقي والنجاح الاجتماعي.
في المغرب هكذا تسير الأمور.
هل كان الأمر يزعج أصدقاءه؟ ربما، لكن ذلك لم يكن مهما، إنه جزء من طبيعة الأشياء، وبشكل ما لم يكن ذلك يعنيهم ولم يمنع صداقتهم، كانوا يغبطونه طبعا، بعضهم يحسده، فالثراء والمال كانا دوما موضوعا للأحلام والغيرة والأوهام والإستيهامات.
ومع ذلك فنحن لم نكن أغبياء، وندرك أن أمور الحياة لا تقاس دوما بالمال والثروة، وأن هناك أشياء أخرى أكثر أهمية من المال.
في الحي كان هناك نموذج آخر مختلف، (سي محمد) الشاب الوسيم الهادئ الذي أنهى مساره الأكاديمي وأصبح أستاذا في الجامعة، تجتمع الشلة في مكانها المعلوم (راس الدرب) يمر هو، يتوقف، يسلم، ينخرط في حديث جميل ومسترسل عن الجامعة والكتب والدين والسياسة…
ثم في لحظة ما، يودعنا ويمضي.
يمضي هو، ونرسم نحن لحظة صمت طويلة وكأننا مسحورون، فقد كان العبور إلى الجامعة حلما جميلا يلوح في الأفق، وكان (سي محمد) رمزا وتجسيدا حيا لذلك الحلم.
(المامون) من جهته كان يفهم المسألة بشكل جيد، القضية في نظره بسيطة ولا تحتاج إلى ذكاء كبير.
لقد قسم الخير والشر بين الأغنياء والفقراء بالتساوي، الفقراء عادة أناس طيبون، ولكنهم يصبحون أشرارا عندما يضيفون إلى بؤسهم المادي رذيلة الحقد والخسة والحسد، أما الأغنياء فأمرهم عجيب فعلا، يتملكهم شعور غريب بالتفوق، يعتقدون أنهم محظوظون، بعضهم يعتقد أن الله اصطفاه لسبب ما وخصه بالمال والثروة، بعضهم لا يهتم كثيرا بالدين وقضية الحلال والحرام فيبني ثروته بطريقته الخاصة بعيدا عن الله، وبعضهم الآخر يعتقد أن الفقر والغنى هي قضية حظوظ وأرزاق مقسمة هناك في مكان ما في السماء، وأن الفقراء يستحقون الشفقة والتعاطف، أحيانا يستحقون الصدقات، هبات وهدايا، ولكنهم لا يستحقون أكثر من ذلك، فهم غشاشون، طماعون، لصوص، نفوسهم دنيئة، واطية، تنضح بالحقد والغيرة والحسد.
…
الأصيل، يوم ربيعي جميل ومشرق.
تجولا في المدينة على غير هدى، يقود (العمراني) سيارته بهدوء، يلتفت، ينظر، يتأمل الوجوه والواجهات الزجاجية بفرح طفولي، يمد يسراه خارج السيارة، يحرك كفه، يبسطها ويضمها وكأنه يعب الهواء، بدا وكأنه يعيد اكتشاف المدينة أو يراها لأول مرة، توقف مرات ليعقد مواعيد سهرة ليلية مع الفتيات، فعل ذلك مرة، مرتين، ثلاث…
يسأله (المامون).
– لم كل هذه المواعيد؟
ابتسم، ثم أطلق ضحكة مرحة، وأجاب.
– من باب الاحتياط، لو المجموعة الأولى لم تحضر، نعول على الثانية أو الثالثة وهكذا…
أوقف سيارته أمام حانة (الملجأ)، ذهبا توا لركنهما المعهود بجانب المسبح الأزرق، وقف النادل صامتا بأدب.
يبتسم العمراني، ويطلب بإشارة من يده.
– كما العادة.
…
يشرب (العمراني)، يدخن، يتكلم، يثرثر، ينتقل من موضوع إلى آخر، يفعل ذلك بمتعة ظاهرة، ينظر إليه (المامون)، يتأمله، يتأمل إيقاع حركاته الذي يرتفع بهدوء في تناغم مع عدد الكؤوس التي يحتسيها، ينصت له صامتا ويبتسم.
ينظر إليه (العمراني) نظرة عتاب، نظرة من يخشى ألا يأخذ كلامه على محمل الجد، يرشف رشفة خفيفة من كأسه، يرفعها في وجهه.
– لم تبتسم هكذا؟ ألا تصدقني؟ أنا من يتكلم وليس الكأس…
يبتسم (المامون) مرة أخرى، يحرك رأسه في حركة خفيفة وكأنه يعتذر.
يفكر، يخاطبه، يخاطب نفسه صامتا.
– أنا أصدقك…ولكن الجزء الأكبر مما تقول ومما أقول، ما كان ليقال لولا هذه الكؤوس…
يتحدث (العمراني) عن موضوعاته المفضلة، العمل، المال، النساء والمتعة.
ثم يتحدث عن حادثة السير الأخيرة التي تعرض لها، يحكي بكثير من التفاصيل، يصف كيف نجا بأعجوبة، يتحدث بنبرة الشاكر الممتن.
– الحمد لله، تخيل السيارة تحطمت بالكامل، ولكني خرجت منها سالما…
يصمت قليلا، ويواصل.
– أنا محظوظ فعلا، مجرد جراح ورضوض بسيطة، لا كسور، لا إعاقة…أنا محظوظ بالخصوص لأن المحرك لم يمسسه سوء!!
يبتسم (المامون)، الإشارة واضحة، (العمراني) لا يقصد محرك السيارة.
يعلق ضاحكا.
– فعلا، ذلك المحرك هو أعز ما نملك.
…
ثم في لحظة ما، يقترح (العمراني) الذهاب إلى بار آخر في منطقة (سيدي بوزيد)، يجيبه (المامون) بسرعة ودون أن ينظر إليه.
– لدي فكرة أفضل!
يسأله صامتا.
– …؟
– نشاهد الغروب.
تركا السيارة أمام الحانة ونزلا إلى الشاطئ الصخري، مرا على ضريح (سيد الغزوة)، ضريح بني على بعد أمتار من أمواج المحيط وكأنه يحرس البحر من الغزاة، في نفس الضريح وعلى بعد خطوة او خطوتين يربض قبر (الحاج عبيد)، زليج وشاهدة من الفخار التقليدي، قبر بسيط وبدون بهرجة، الذين يعرفون الرجل وحتى الذين لا يعرفونه يروون عنه حكايات عجيبة، يقولون إنه شخص عصامي بنى ثروته بصبر وأناة، راكمها قطعة قطعة على مدى عقود من الزمن، فعل ذلك بحرص وتدبير شديدين، ثم أصبح من الأثرياء عندما تحولت فدادينه إلى مقالع للأحجار ومواد البناء.
مازحه أحدهم مرة مقارنا بين السخاء الحاتمي لولده البكر، ومعرضا في نفس الوقت لحرصه الشديد الذي يلامس حدود البخل.
– ابنك (سيدي الحاج) في منتهى السخاء والكرم، أما أنت فرجل حريص…
يبتسم الرجل، يصمت قليلا، ويجيب في جملة مليئة بالعبرة والمفارقة.
– وما الغريب في ذلك؟ فالسبب واضح، أبوه رجل غني جدا…
في إشارة إلى أنه لم يبدل جهدا يذكر في بناء تلك الثروة التي يتباها بها.
يحكي (العمراني) تفاصيل القصة بنبرة المصدق والمعتبر، يقف إجلالا أمام القبرين، ويقرأ الفاتحة.
وقف (المامون) عند عتبة الضريح جامدا مثل تمثال، فهو أمام الموت يعود إلى ذاته، يمضغ هواجسه، ينصت ويكتفي بالصمت.
جلس الصديقان عند حافة جرف صخري تنغرس قاعدته تدريجيا في البحر، خلعا أحذيتهما، يضرب الموج عند أقدامهما المتدلية في الماء، ينظران للأفق، يخرج (العمراني) زجاجة الكونياك من جيب سترته، يمدها في اتجاه (المامون) بصمت، يمسكها، يرفعها إلى شفتيه، يعب منها جرعات خفيفة ومتفرقة.
يعيدان نفس الحركات بنفس الصمت، تتشرب أرواحهما منظر الغروب وهدوء المساء في خشوع بودي عجيب.
ينظر (المامون) بعيدا، يبدو منخرطا وغائبا تماما، يتملكه شعور غريب، شيء يشبه الكآبة، قطع الطريق على هواجسه، طردها بسرعة لكيلا تفسد عليه سعادته، قرر أن يستمتع ويمتص رحيق اللحظة.
…
الساعة العاشرة صباحا.
حي (أناس)
استيقظ (المامون) بصعوبة، ألم فظيع يشق رأسه إلى نصفين، أخذ حماما باردا، أشعل سيجارته الصباحية الأولى، وراح ينظر لبقايا الاحتفال التي خلفتها سهرة الأمس، مائدة تعج بالفوضى، بقايا طعام، زجاجات خمر فارغة، كؤوس، مياه معدنية، علب وأعقاب سجائر…
عبثا حاول استعادة صور الليلة الماضية، لا شيء، تبخرت، انمحت التفاصيل، ولم يبق منها إلا صورة باهتة لفتاة متبرجة، ثملة، تدخن بشراهة، تقضم أصابع بطاطس مقلية، وتنظر إليه بعينين نهمتين.