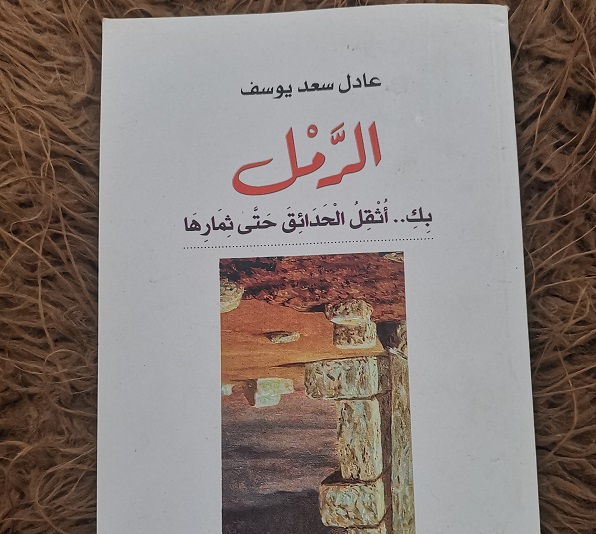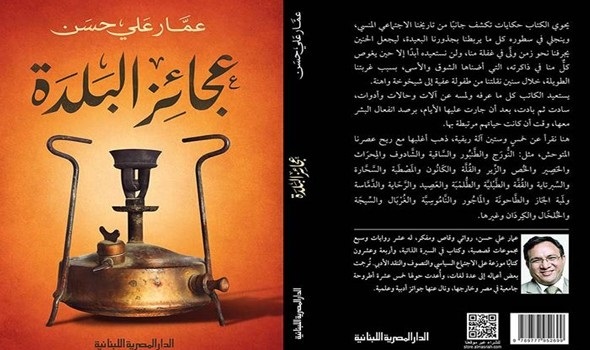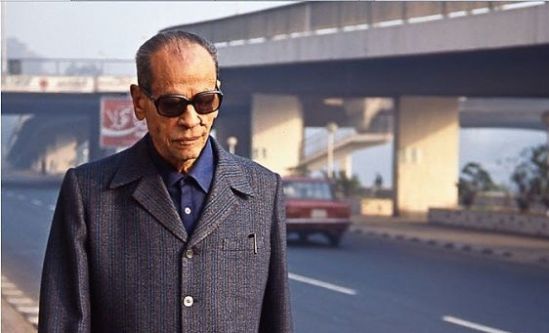شوقي عبد الحميد يحيى
باتت المعلوماتية عنصرًا أساسيًا في الرواية الحديثة، حيث أصبحت المعلوماتية سمة العصر. وكان لزامًا أن يعيشها شريف العصفوري، الذي جاب الكثير من بلدان العالم، فلم يكتفِ بما اختزنته الذاكرة من أماكن وأناس في بلده، ولكن أن يستحضر تلك الشخصيات من بلاد العالم، ليصهرها في بوتقة القصة القصيرة، ويستخرج منها الدلالات التي تعيد القارئ إلى أرض الوطن. فبعد أن كانت الرواية التي صاغها المصري توفيق الحكيم، والسوداني الطيب صالح، واللبناني سهيل إدريس، في رواياتهم، عاقدين المقارنة بين الداخل والخارج، أبى شريف العصفوري أن يقلد تلك المقارنات التي مر عليها العديد من السنوات، فلجأ إلى إحضار الشخصيات، وجعلها تسلك في حياتها ما يريد أن يوصله لأبناء وطنه، وكأنه يقرأ الحاضر من صفات التاريخ الماضي.
فإذا كان الإبداع يقوم على الإنسان وعلاقته بمن وما حوله، والإنسان — أي إنسان — هو اثنان في واحد: أحدهما ظاهر للناس، والآخر مخبوء بداخله، لا يعلمه إلا هو؛ ولذلك كان الإبداع تعبيرًا عن الدواخل.
ومن هذه الدواخل، نستطيع القول بأن شريف العصفوري إنسان مثقف أولًا، وهو لا يعيش بمفرده على هذه المجرة؛ لذا نجد أن غالبية القصص تحتوي على أسماء بعينها، وأشخاص بعينهم، وكأنه يغرف من الحياة ومن الناس حوله ما يستطيع أن يخلق منه قصة، وينفذ منها إلى عمق رؤيته للحياة وللناس، وفي ذات الوقت تعبير عن رؤيته هو للحياة، وكيف أنه كفر بالحياة، ويحاول الهروب منها، إما إلى داخله، وإما إلى العوالم التي يشعر فيها أنها حرة في دورانها في محيط الكون اللانهائي. لذا نجد أنه ضاق بالحياة الخاصة والعامة؛ ففي الحياة الخاصة، نستطيع أن نقرأ في قصص «الأغاني القديمة» و«الانتزاع»، حيث نجد فيهما التوحد وإخراج ما بالداخل، رغم اشتعاله وفورانه، ونضيف إليهما قصة «القمر 47»، وإن كنت لا أدري — تحديدًا — لماذا 47، فربما كانت تمثل شيئًا محددًا في ذهن الكاتب. حيث يتحد الإنسان — في هذه القصة — مع القمر. وفيها أيضًا نستطيع تلمس لماذا هو مثقف؛ حيث نجد أن هناك بعض الجمل التي توحي بذلك، والتي لم يُسرف فيها الكاتب، وإنما تركها كإشارة أو نافذة على عالم مزدحم بالرؤى، اكتنزها الكاتب في تلك الاستعارات الدالة. فنقرأ فيها: {وتسمى خمسة أيامه الخيرة بالعجوز وبالقديم، حتى وصفوه بالعرج}. حيث تأتي هذه المصطلحات شبه غريبة على القارئ العادي، فيكون عليه البحث عن هذه التسميات، فيجد أن العجوز هو من مر عليه الوقت، والقديم هو أيضًا من مر عليه الوقت، أما العرج فهي مشتقة من (العرجون)، والذي قال الله فيه في سورة يس: {والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم}. حيث قربه ما يحدث للقمر مثلما يرى الناس على أرض الواقع؛ حيث العرجون هو غصن النخلة الذي يحمل البلح، والذي يتقوس وينحني، ويصفر ويضعف، كلما قَدِمَ ويبس. أي أن القمر ضعف ولم يعد يبعث الضوء للناس. فجاءت كلمة «العرج» وكأنها دعوة للقارئ للبحث والمعرفة، لا أن يتقبل ما يقوله الكاتب وكأنه قضية مسلَّمة. وهي صفة من سمات الكتابة عند الكاتب الذي يحترم قارئه ويدعوه للمشاركة. ثم يُتبعها بجملة: {لكن القمر ينضج بعد نهاية الشهر}، أي أن القمر لا يموت، ولكنه أقرب للموت، لكن الله بث فيه الحياة من جديد. وكل هذا للإسقاط على الإنسان، الذي يتصوره الناس قارب الموت أو أصبح في حكم الموت، على الرغم من أنه — الإنسان —: {أرحل وراء القمر، في غيبي الإمام، في كسوف ما وراء كوكبنا، يشتعل القمر وتفوح رائحته داعية للعناق والعشق، أنا الإمام كاهن ديانة القمر}. وهكذا يتوحد الإنسان مع القمر، ذلك الذي يتصوره الناس قد مات أو أوشك على الموت، وكذلك الإنسان، حتى وهو في الخامس والثلاثين أو في الأربعين، يشعر بالنشوة ويشعر بالحاجة، فضلًا عن سياحة القمر وسط المجرات الهائلة، ولا أحد منها يتطفل على الآخر أن يحد من حريته في الحركة؛ فهكذا الإنسان يسعى للوصول إلى مثل هذا… على الأرض.
وإذا ما عدنا إلى أولى قصص المجموعة «الأغاني» فسوف نجدها نظرة كلية على الحياة. فالأغاني تعيدنا إلى الحياة التي كنا فيها أحرارًا، ولا مسؤوليات، ولا يتذكر فيها الإنسان المرض أو الهزال:
{لا أتذكر شيبًا ولا هزالًا، ولا مرضًا، أتذكر الأغاني القديمة عندما كان الغد وعدًا بالأمل}.
حيث المرض والحسد، ولكنه فقط يختار النظرة التي تفرض على القارئ تأمل الحياة في حينها، عندما كان الغد أو المستقبل مليئًا بالأمل. فالأغاني تصعد وتهبط بنا في عوالم كانت تصعد بنا وتهبط، وكأنها تعاقب الليل والنهار، أو كر الأيام بما تحمل. فالقصة في عمومها تحمل الهروب من الحياة، بتفاهتها، إلى الماضي الذي نعيش فيه على الأنغام والألحان التي تحمل مشاعرنا للتسامي عن الحاضر المرعب.
ويبلغ الكاتب قمة الضياع للنفس، والتوهان وسط الزحام حين يوضح:
{في محاولاتي لصنع شيء قيم من حياتي، تبدو سيرتي كفيلم سريع الإيقاع، ولكن مخرجه مصري، جمع الموسيقى العاطفية والخلفية الجميلة الشاعرية وأداءً أسطوريًا للممثلين، ولكني كمشاهد لا أفهم الرسالة التي يأتي بها الفيلم، أو ربما لا يستطيع المخرج بلورة فكرة جوهرية تجعل الحياة أكثر منطقية، وأوضح رسالة، أو حتى أقل إيلامًا}.
وفي قصة «الانتزاع» نعيش لحظة عشق مليئة بالحركة، حتى لو كان السكون هو المسيطر على القصة، ولكنها حركة داخلية ينتقل فيها السارد من البطء والتمهل إلى التسارع والعدو وراء اللاشيء، لتنتهي القصة بـ: {فيظل قلبي في صدري ينبض دون ارتحال أو تسارع}، لتؤكد استمرار السكون.
وفي قصة «المسرح النحاسي» نجد أنه عندما يضيق الإنسان بالحاضر يهرب إلى الماضي، واستحضار «المسرح النحاسي»، حيث تعيد كلمة المسرح تحديدًا للذهن أن الدنيا كالمسرح؛ الممثل يؤدي دوره وينصرف، ليقوم آخر بدوره بعده. وهنا يستحضر الكاتب من مضوا، وكيف ضاع بينهم…
وينتقل الكاتب من الداخل إلى الخارج، من الذات إلى الأحوال العربية عمومًا، في قصة «الصحافة وأمين الشرطة»، حيث يلقي الضوء على أسباب حبس الحرية في البلدان العربية، فنعيش أحدها، حيث يلقي الضوء على أحوال الإعلام العربي المعتمد على ما يُملى عليه، حتى لو خالفت الواقع الأليم. وذلك عندما يعرض السارد رأيه فيما يحدث، وعندها يخرج أحد المدنيين ليقول:
{أنا اسمي الأمين معروف بمباحث الدولة بنويبع، وأنت حتشرف معايا في القسم لما نوصل، مش حسيبك!}
والتي تبين المراقبة الصامتة أو الرقابة الخفية، والتي تعد على الناس أنفاسهم. وعلى الرغم من عدم ذكر أي إشارة للصحافة في القصة، فإنها — القصة — تشير إلى كل وسائل التوجيه وبناء الرأي الذي يجب أن يُقال، وليكتفي الإنسان العربي بمتعته الشخصية فقط — المتعة بالزوجة — ولا تتحدث فيما لا يخصك. وعلى الرغم من امتداد القصة لرحلتي المجيء والذهاب، والاستمتاع بالزوجة، والمقهى أسفل البيت وما يدور فيه، إلا أنها — القصة — تظل في حدود القصة القصيرة، من حيث إنها تتركز في جلسة القسم، وتذكر رحلتي الذهاب والعودة، فهي تتركز في المساحة الزمنية المتعارف عليها في القصة القصيرة.
وفي قصة «القطط والعصافير» تحاول القصة أن تتخذ من طبائع القطط نموذجًا للحياة البشرية، وإن اتجه الجزء الثاني من القصة إلى الجنوح نحو (العلمية) أو العقلانية، لتصل إلى أن الدين يساوي بين البشر والحيوانات، وسعيهم نحو السلام.
ويأتي العنوان شاملًا القطط والعصافير — على الرغم من أن القصة لم تأتِ لسيرة العصافير — وكأنها تجمع بين الشراسة والسِّلم. فالقطط تتحول إلى الشراسة — رغم طبيعتها المسالمة — وذلك حين يُعتدى عليها، أو على مملكتها غازٍ أو طامع. والعصافير هي رمز الوداعة والسلام.
وفي قصة «القمر 47» سنجد التوحد بين الأنا والقمر، توحد الحبيب بالقمر. يدور السارد معه أينما ذهب، وهو لا يذهب إلى البعيد، ولكنه يسبح بين المجرات النشوانة، الشاعرة بالحرية في محيط لانهائي من الكون، يعيش — هو — معهم، يصلي، لكن صلاته ليست كصلاتنا؛ إنها سمر وموسيقى ورقص وغناء. بينما الشعراء يتغنون في القمر الطفل، في ليلة الرابع عشر، لكنه — الإنسان والقمر — يعيشون بعد ذلك، حين يختفي القمر عن الأنظار، فجوف القمر ملتهب، مثلما جوف الإنسان، والإنسان في السابعة والأربعين (كتوم ناطق، ظاهر وباطن، حاضن ومبتعد، اشتعال فوق الاشتعال، فجوف القمر ملتهب مثل الأجرام}. وفي النهاية، لا يهمه إن أراده الناس أم انصرفوا عنه.
فإذا ما انتقلنا إلى قصة «رمان أدريانا» سنقرأ في القصة التي منحت المجموعة اسمها، نجدها اعتمدت على العقل أكثر من اعتمادها على العاطفة. تحمل في ثناياها التعريف بالشخصية، لكن الفعل أو الحركة الداخلية كانت باهتة، ربما تحمل في ثناياها الشوق أو الرغبة لنيل (رمان) أدريانا، ولو مرة، ولكن تلك الرغبة، إلى أن يصل إليها القارئ، يكون قد تاه في التفاصيل الأولى، والتي لم تكن تؤدي إلى تلك النهاية.
ومثل ذلك يمكن القول على قصة، حيث إن النهاية، أو منبع القصة، يأتي في النهاية من القطتين الخاصتين بالسارد، ولكن كل تلك المقدمة التي تستغرق ما قبلهما ليس بالضرورة أن تقود لتلك النهاية.
وكان يمكن — لو أن الكاتب أشار في تلك المقدمة الطويلة إلى تلك القطتين أكثر من مرة — أن يجعلنا نعيش مع تلك النهاية بشكل غير مفاجئ أو مفتعل.
المعلوماتية في القصة القصيرة
في قصة «سوناتا فلامنجو»، إذا ما قرأنا مفتتح القصة، سنجد أنها تقول:
{قالت لي: أنا اسمي صوفي، رددت عليها: أهلًا صوفيا. قالت مجددًا: أنا صوفي فقط، من أصل فرنسي، أحمل الجنسية التشيلية! قلت ضاحكًا: تشيليانا! ضحكت قليلًا، وانفرجت قسمات وتعابير وجهها، وارتخى الجسد المشدود كسيف مشرع.
حاولت التبسط: أحب الرئيس أليندي، شهيد عظيم قتلته الفاشية! قطبت حاجبيها وزمجرت قائلة: خرب البلد وقارب أن يضيع التشيلي! سقطت عليَّ غيوم التكدير والغضب، فحوَّلت سهام الاتهام إلى أكثر طريقة صديقة: أنت من أشياع السفاح القاتل بينوشيه! الديكتاتور الممثل! قاتل الآلاف ومعتقل عشرات الآلاف… ردت صوفي: بينوشيه أنقذ تشيلي من الفوضى ومن الشيوعيين والماويين، لم تكن الفاشية، صوفي، بقبيحة}.
وأمام هذه المقدمة لا بد أن نبحث عن كل من الرئيس «أليندي» والسفاح «بينوشيه»، وفقًا لما أطلق عليهما السارد. وسنجد أن سلفادور إيزابيلينو أليندي غوسينز، وُلد في 26 يونيو 1908، وتوفي في 11 سبتمبر 1973، هو طبيب وسياسي تشيلي، يُعتبر عمومًا أول رئيس دولة في أمريكا اللاتينية ذي خلفية ماركسية انتُخب بشكل ديمقراطي. شغل منصب رئيس جمهورية تشيلي منذ 1970 وحتى 1973، عند مقتله في الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه، والذي خططت له ونفذته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه. وأن أوغستو بينوشيه، وُلد في 25 نوفمبر 1915 في فالبارايسو، وتوفي في 10 ديسمبر 2006 في سانتياغو، وهو:
{سياسي وجنرال عسكري تشيلي، شغل منصب رئيس تشيلي من 1973 إلى 1990، والمسؤول الأول عن مقتل الرئيس}.
ثم نقرأ أن {الجنرال الفاشي عدل الدستور بحيث لا يُحاسب على أي من جرائمه، أمر طيرانه بإلقاء شباب الجامعات من الطائرات الهليكوبتر في المحيط لتأكلها أسماك القرش، تداول الطيارون فيما بينهم عن أفضل مراعي القرش ليلقوا فيها بالشباب مغمضي الأعين، خوفًا من أن يستدل أحدهم على طريق للعودة للوطن من بعد ابتلاع القرش}. فنحن هنا أمام رئيس انتُخب بالطريقة الديمقراطية، هو الرئيس «أليندي»، رغم أن له ميولًا شيوعية، وآخر انقلب عليه بمساعدة أمريكية، واستولى على الحكم بدلًا منه، وهو الجنرال «أوغستو بينوشيه». وعلى الرغم من أن المعروف عن «أليندي» هو الفاشية، إلا أن السارد أطلق على «بينوشيه» لفظ الفاشي، كما أطلق على «صوفي» نفس اللقب، وهو ما يعني أن الاسم شيء، والواقع شيء آخر. والكاتب هنا يعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي، أو ما يقول به الواقع. بينما يعود في نهاية القصة، لنجد أننا أمام إنسان عربي لا يهمه التاريخ ولا الجغرافيا، ولكن يهمه فقط:
{طريقي المنير هو مضاجعة صوفي بأقسى درجات العنف أو الشبق انتقامًا! اللعنة لأوغستو بينوشيه، والنشوة لصوفي}.
فنستطيع أن نتبين التحول الذي أصبحت عليه «صوفي» — التي كانت صوفيا — فعندما دعاها السارد للعشاء لم تمانع، بشرط أن تختار هي المطعم، فهي لم تنس المطاعم اللاتينية، فاختارت مطعم (الحمامة)، حيث إنه مطعم «تشيلي»، {ولكنه مليء بصخب الحياة وشغف الحياة اللاتينية — حيث تشيكوسلوفاكيا — في العاصمة الأمريكية التي تغتال الديمقراطية بالليل وتدعو لها بالنهار، عن الانقلابات المدفوعة الأجر}. فهي هنا تحن إلى الجو اللاتيني، وتتهم الديمقراطية الأمريكية، ورغم ذلك تؤيد الحكم الحالي، والذي يجلس على كرسيه السفاح «بينوشيه». وحيث {بين القتل والجنس برزخ صغير، الجنس في البرية قنص، والقنص في البشرية قتل}.
فإذا ما وصلنا إلى القصة الأخيرة في المجموعة، وهي قصة «نصر»، وهي قصة جيل ضحى من أجل الوطن (عقاب الصبي «نصر» للصغار إذا ما أقدموا على فعل لا يرضاه الخُلق الحسن)، وضحى «نصر» من أجل الوطن (الاشتراك في نصر أكتوبر والبلاء الحسن فيه). ورغم حصوله على الشهادة العالية، فقد سبقه رفقاء له علمهم الأخلاق الفضيلة، وسرق والده فتاته، مدرسة الفيزياء ذات الرائحة الفرنسية، وتقدم لخطبتها، فـ«هجر» نصر البيت، ليجلس على المقهى، ويستمع إلى من جاء ليخطب ابنة نصر، وهو ما يزال جالسًا على المقهى.
ونستطيع هنا تحديد الزمن إذا ما تأملنا: {كانت رائحة المعلمة بعطر فرنسي في زمن الاشتراكية، كانت فكرة العطر للنساء ثورية بما فيه الكفاية}، التي تشير إلى زمن معين، خاصة وأنه بعد نصر أكتوبر، أي بعد 1973. وإذا كان الأب يمثل الماضي، فيمكن التأويل بأن الماضي، أو الجيل السابق، سرق المستقبل من يد «نصر» بسرقة محبوبته المعلمة. {ازدادت الأمور سوءًا عندما تقدم والد نصر لخطبة ثريا (المعلمة). نصر أقسم ألا يعود لبيت والده، ذلك الذي ينافسه في حب صعب وممنوع لمعلمة الفيزياء. نصر أنهى تعليمه الثانوي وتطوع للخدمة بالجيش}. وتفرغ «نصر» لـ{أما نصر فالنضال من أجل لقمة العيش، وتخطاه كل من كان أقل منه في الفتونة والقوة لأنه نال درجة علمية من الجامعة، وحتى لو لم يتعلموا شيئًا}. فالإسقاط هنا واضح ولا يحتاج إلى تأويل. ولا يملك القارئ إلا أن يتأمل، بعد أن يبحث عن الدال وما يؤدي إليه، وكأننا — مرة أخرى — أمام حث القارئ على ألا يستسلم للكاتب، وأن يشاركه في صنع القصة، التي أدخل شريف العصفوري إليها المعلوماتية، والتي يواصل فيها محاولة الهرب من الواقع الذي لا يضيئه، إلى عالم يكون الإنسان فيه حرًا ومنطلقًا دون قيود.
التقنية القصصية
قد يبدو من بعض القصص أنها لا تحمل الحركة — وهي الشرط الأساسي للقص — مثل القصتين الأوليين، واللتين يبدو فيهما أن لحظة شعورية انتابت الكاتب وانتهت. أو قد تبدو القصة وكأنها رواية تضم في حناياها السنوات والسنوات، ولكن الكاتب يحافظ على ما تعارف عليه الجميع من أن القصة القصيرة هي لحظة. وأنا أقول إن الكاتب لم يغادر هذه اللحظة؛ ففي القصة الأولى «الأغاني القديمة»، والتي يعبر فيها السارد عن أنه يعيش حياته مع الأغاني القديمة هروبًا من الواقع، ثم يأتي في النهاية بخلاصة القصة، أو (القفلة) لها، وكأنها تقدم الخلاصة، وهي مستمدة من سياق العمل، وليست دخيلة عليه أو مفتعلة، حيث يقول في النهاية: {استمعوا لأغانيكم القديمة}. وهي فلسفة الكاتب؛ فإذا كان الإنسان يضيق بحياته الحاضرة، فعليه أن يعيش في الماضي بالاستماع لأغانيه القديمة.
وفي القصة الأخيرة «نصر»، رغم أننا ذهبنا إلى حياة نصر كاملة، إلا أن السارد جالس على المقهى، وعندما جاءه شاب ليسأل عن حفيد «نصر» كان هذا السؤال دافعًا للتذكر والتأمل بين الماضي والحاضر. وإن كنت لا أعلم على وجه التحديد من الذي سرق نصر أكتوبر، بينما من ضحى في الحياة المدنية وفي المعركة أصبح من ساكني الهامش. وبين القصة الأولى والقصة الأخيرة العديد من الرؤى، حيث حافظ في الغالب منها على عناصر القصة القصيرة، بينما غلبه الإخبار عن الرحلات والجولات، والاكتناز بثقافة الغرب، فضاعت القصة، مثلما كانت القصة التي منحت المجموعة اسمها.