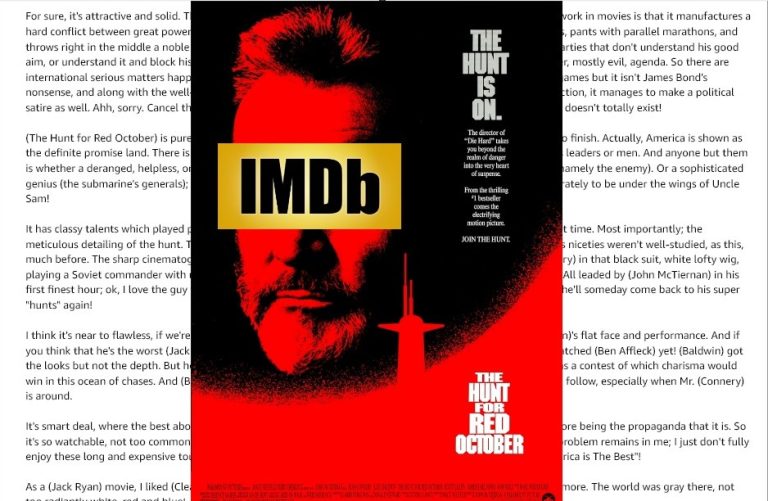عادل محمود
في تاريخ السينما المصرية، يمكن بسهولة أن نعد المخرجين الذين قدموا أفلاما ناجحة، أو أولئك الذين صنعوا موجات عابرة، أو حتى من أسسوا مدارس جمالية واضحة. الأصعب هو العثور على مخرج صنع معيارا لا يقاس به الفن فقط، بل تقاس به علاقتنا بالواقع.
داود عبد السيد ينتمي إلى هذه الفئة النادرة، لأنه المخرج الذي تعامل مع السينما باعتبارها وسيلة لفهم المجتمع وكشف عيوبه الداخلية، لا أداة للوعظ أو إلقاء الخطب. استخدم الفيلم ليحلل طريقة تفكير الناس، وكيف تتشكل علاقاتهم بالسلطة وبالخوف وبما اعتادوا عليه حتى صار طبيعيا. أفلامه تطلب من المشاهد أن يفكر فهي لا تقدم حلولا جاهزة، سينما تحليلية تمسك الفكرة من جذورها، تضع المشاهد أمام سؤال واضح: كيف يحدث هذا الواقع؟ ولماذا نقبله؟
هذا المقال لا يسعى إلى كتابة سيرة احتفالية، ولا قراءة ذوقية، هو محاولة لتفكيك مشروع داود عبد السيد بوصفه مشروعا فكريا متكاملا: كيف تشكل؟ ما خصائصه البنيوية؟ كيف عالج العلاقة بين الفرد والنظام؟ ولماذا ظل حتى اليوم مخرجا مقلقا أكثر منه مرضيا؟
تخرج داود عبد السيد في المعهد العالي للسينما في منتصف سبعينيات القرن العشرين، في لحظة تاريخية لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والاجتماعي: ما بعد هزيمة 1967، ثم حرب 1973، ثم التحول التدريجي نحو اقتصاد الانفتاح، وتحول الدولة من مشروع اجتماعي واسع إلى جهاز إدارة مصالح. هذه التحولات لم تدخل أفلامه كشعارات، بل كبنية ضغط يومي على الفرد.
عمله كمساعد للمخرج يوسف شاهين، ومنه تعلم أن السينما موقف قبل أن تكون حكاية. لكن الفارق الجوهري بينهما أن داوود عبد السيد لم يذهب إلى السيرة الذاتية الصاخبة، ولا إلى الذات بوصفها مسرحا دائما للصراع، اختار طريقا أكثر هدوءا وأكثر قسوة في ذات الوقت، كاميرا تراقب في صمت، شخصيات تفكر وصراع لا يحسم بانتصار أو هزيمة بل باستمرار المأزق.
السبعينيات والثمانينيات في مصر لم تكن مجرد عقدين زمنيين، بل مرحلة إعادة تشكيل للعقد الاجتماعي بأكمله. الدولة الناصرية بوعودها الكبيرة وإخفاقاتها الأكبر كانت قد تراجعت، السادات فتح الأبواب أمام رأس المال الخاص، وانسحبت الدولة من دورها الإجتماعي. هذا التحول لم يكن سياسيا فقط، بل ثقافيا ونفسيا، المواطن الذي كان يعتمد على الدولة بات عليه أن يدبر أمره بنفسه في ظل قواعد غير واضحة وفرص غير عادلة.
داود عبد السيد التقط هذا التحول بدقة، لم يصور مأساة درامية، بل تغيير تدريجي في طريقة عيش الناس، في توقعاتهم، في علاقتهم بالمؤسسات. الفرد في أفلامه ليس بطلا ثوريا يواجه النظام، بل شخصا عاديا يحاول أن يفهم القواعد الجديدة، وأحيانا يحاول أن يستفيد منها، وأحيانا يسقط في فخاخها.
هنا تتبلور ما يمكن تسميته “الواقعية المفكرة”: واقعية لا تكتفي بتسجيل الواقع أو إعادة إنتاجه، بل تفككه وتعيد تركيبه على هيئة أسئلة قابلة للفحص. هذا النوع من الواقعية لا يقدم صورة فوتوغرافية للحياة، بل خريطة تحليلية لها.
البنية السردية في سينما داوود عبد السيد لا تقوم على حدث رئيسي يقود إلى حل، بل على مأزق يتكشف تدريجيا. المأزق ليس شخصيا فقط، بل اجتماعي وسياسي ومعرفي. الشخصية لا تواجه خصما واضحا، بل شبكة من القيم المتناقضة، والقرارات المؤجلة، والتواطئات الصغيرة التي تنتج كارثة كاملة دون أن يشعر أحد أنه ارتكب خطأ جسيما.
في فيلم “الكيت كات” (1991)، “الشيخ حسني” ليس مجرد شخصية كاريزمية ساخرة، بل نموذج معرفي: رجل كفيف يرى ما لا يراه المبصرون. المفارقة هنا ليست شعرية فضفاضة، بل سلوكية دقيقة: المجتمع يرى الوقائع لكنه لا يفهم بنيتها، الشيخ لا يرى الوقائع لكنه يفضح منطقها. الفيلم لا يقدمه كبطل، بل يضعه داخل حي شعبي يتعايش مع الفقر، ويقوم بتحويل العجز إلى نكتة يومية. الضحك هنا آلية دفاع اجتماعي، وسيلة لتحمل واقع لا يبدو قابلا للتغيير.
لا يقدم الفيلم رسالة عن الفقر، بل يشرح كيف يتعايش المجتمع معه، وكيف يتحول من مشكلة إلى حالة طبيعية، ثم إلى جزء من الهوية. هذا تفكيك ثقافي، لا خطاب شفقة. الحي الشعبي في “الكيت كات” ليس ديكورا، بل كائن حي له منطقه الخاص: شبكة من العلاقات والمصالح والقيم التي تنظم الحياة بطريقة تختلف كليا عن القانون الرسمي أو الخطاب الأخلاقي السائد.
الشيخ حسني يتنقل في هذا العالم بحرية، لأنه لا يخضع لقوانين البصر. يسمع ما يهمس به الناس، يشم رائحة الخوف والطمع، يلمس التوتر في الهواء. الكفيف هنا يملك معرفة لا تعتمد على الظاهر بل على الجوهر، وهذا بالضبط ما تفعله سينما داود عبد السيد، لا تنظر إلى السطح بل تحفر تحته.
إذا كان لا بد من فيلم يلخص مشروع داود عبد السيد، فإن “البحث عن سيد مرزوق” (1991) هو المرشح الأوضح. هنا تصبح المعرفة نفسها موضع شبهة، البطل لا يعاقب لأنه خالف القانون، بل لأنه طرح سؤالا بسيطا وخطيرا : من يدير اللعبة؟ وأين يقف الفرد منها؟
الفيلم يعمل كتشريح دقيق لبنية السلطة غير المرئية، سلطة لا تحتاج إلى قمع مباشر لأنها تعمل عبر الغموض والوساطة والانتظار. سيد مرزوق ليس شخصا بقدر ما هو وظيفة: نقطة تحكم إدارية، مركز قرار بلا وجه. يشبه كثيرا مراكز القرار التي يعرفها المواطن العربي: موجودة، فاعلة، ولا يمكن الوصول إليها.
الرعب الحقيقي في الفيلم ليس في العنف، بل في التنظيم، السلطة هنا عقلانية هادئة وتعمل بكفاءة، وهذا أخطر أشكال السلطة، لأنها لا تثير الغضب بل تنتج الامتثال. البطل يوسف، موظف بسيط في جهاز حكومي، يكتشف خطأ إداريا صغيرا، يحاول أن يصححه فيجد نفسه في متاهة من الإجراءات والتأجيلات. كل من يسأله يحيله إلى شخص آخر، وهذا الشخص الآخر يحيله إلى ثالث، وهكذا. لا أحد يرفض طلبه صراحة، لكن لا أحد يساعده.
هذه البيروقراطية ليست فسادا بالمعنى التقليدي، بل بنية تحكم، السلطة لا تمارس نفسها عبر المنع، بل عبر التعقيد. الفرد لا يمنع من الوصول، لكنه ينهك في الطريق، وحين يصل إلى النهاية يكتشف أن المسألة ليست في الوصول، بل في أنه لم يكن من المفترض أن يسأل أصلا.
الفيلم لا يقدم رسالة مباشرة ضد البيروقراطية، بل يحلل كيف تعمل هذه البيروقراطية كآلية للسيطرة، السلطة لا تحتاج إلى أن تكون شريرة، بل أن تكون معقدة، والمواطن لا يحتاج إلى أن يقمع، بل أن يحير.
واحدة من أكثر سمات سينما داوود عبد السيد جرأة هي موقفها من المثقف، لا تقدمه بوصفه ضحية دائمة، ولا بوصفه منقذا أخلاقيا، بل بوصفه عنصرا داخل بنية قد تفسده أو تجعله شريكا في إعادة إنتاج القمع.
في “أرض الخوف” (1999)، الضابط الذي يدخل عالم الجريمة باسم الواجب، يتحول تدريجيا إلى جزء عضوي من هذا العالم. الخط الفاصل بين المُراقِب و المُراقَب يذوب، المعرفة، بدل أن تكون حماية، تصبح مبررا: “أنا أفهم اللعبة .. إذا أستطيع اللعب”. الفيلم لا يقول إن السلطة فاسدة، بل إن العمل داخلها – حتى بنوايا حسنة – قد يعيد تشكيل المعايير الأخلاقية للفرد. هذا نقد بنيوي للدور، لا إدانة أخلاقية للشخص.
الضابط يبدأ الفيلم واثقا من أنه يستطيع أن يبقى نظيفا في بيئة قذرة، يؤمن بأن معرفته بالقانون وإيمانه بالعدالة يحميانه من الانزلاق. لكن تدريجيا، ومع كل قرار صغير يتخذه، يكتشف أن القواعد التي يحاول أن يطبقها لا تعمل في هذا العالم، يضطر إلى التفاوض، إلى التنازل، إلى استخدام أساليب المجرمين أنفسهم. وفي النهاية، يصبح جزءا من النظام الذي كان يحاول أن يصلحه.
هذا ليس سقوطا أخلاقيا بالمعنى الدرامي التقليدي، بل عملية تآكل تدريجية، السلطة لا تغوي الفرد، بل تعيد تعريف ما هو معقول وما هو ضروري. المثقف أو الضابط – أو أي شخص يدخل البنية – لا يفقد قيمه دفعة واحدة، بل يعيد ترتيبها بما يتوافق مع الواقع. وهذا أخطر من الفساد الصريح، لأنه فساد منطقي.
كثيرا ما وصفت أفلام داوود عبد السيد بالبطء. هذا الوصف، عند الفحص، لا يكشف عن عيب فني بقدر ما يكشف عن أزمة ذائقة. البطء هنا ليس ضعف إيقاع، بل اختيار أخلاقي؛ الزمن في أفلامه يُترك ليعمل. الانتظار، التردد، تراكم التفاصيل الصغيرة التي تفرغ القيم من معناها دون انفجار درامي.
في “مواطن ومخبر وحرامي” (2001)، تتقاطع مصائر ثلاث شخصيات تمثل ثلاث وظائف اجتماعية. لا أحد برئ بالكامل، ولا أحد شرير بالمطلق. الزمن المشترك بينهم يكشف كيف تعاد صياغة الأخلاق وفق الموقع الاجتماعي، لا وفق المبدأ. المواطن العادي، المخبر الذي يعمل لصالح النظام، والحرامي الذي يخرق القانون، كلهم يتحركون في نفس المدينة، نفس الشوارع، نفس المقاهي. الحدود بينهم ليست واضحة، المواطن قد يصبح مخبرا إذا احتاج إلى حماية، المخبر قد يصبح حراميا إذا احتاج إلى مال، والحرامي قد يصبح مواطنا إذا وجد فرصة للاستقرار.
هذا التداخل ليس عشوائيا، بل مبني على منطق اقتصادي واجتماعي واضح، النظام لا ينتج مواطنين ملتزمين بالقانون، بل ينتج أفرادا يحاولون البقاء، والبقاء يتطلب مرونة أخلاقية. الزمن البطيء في الفيلم يسمح للمشاهد أن يرى هذه التحولات وهي تحدث، بدلا من أن تفرض عليه كنتيجة نهائية.
السينما السريعة تخفي العمليات، تعرض النتائج فقط. السينما البطيئة تكشف الآليات، تظهر كيف يتحول الإنسان من حالة إلى أخرى. وهذا البطء ضروري، لأن التحولات الاجتماعية الحقيقية لا تحدث في لحظة درامية، بل في تراكم يومي صامت.
داود عبد السيد لا يصنع أفلاما سياسية بالمعنى الدعائي، لا خطب، لا شعارات، لا بيانات. السياسة عنده تظهر حيث يجب أن تظهر: في علاقات العمل، في اللغة اليومية، في توزيع الخوف، وفي الصمت. هذا ما يمنح أفلامه عمرا أطول من كثير من الأفلام السياسية الصريحة، لأنها لا ترتبط بحدث آني، بل ببنية مستمرة: كيف تدار الدولة؟ كيف يعاد إنتاج الطاعة؟ كيف يتحول الخوف من حالة استثنائية إلى عرف اجتماعي؟
في رسايل البحر (2010) لا تتكلم الشخصيات عن السياسة، لكن السياسة تحكم كل تفصيلة في حياتها. لا نرى الدولة على الشاشة، لكننا نلمس آثارها في ضعف القانون، وهيمنة النفوذ، وتحول المدينة إلى ساحة اختبار أخلاقي قاس. يحيى لا يخوض صراعا أيديولوجيا، بل معركة بقاء يومية: كيف يعيش بكرامة في عالم لا يعترف إلا بالقوة والمساومة. الفيلم لا يقدم أبطالا ولا خونة، بل أفرادا عاديين يتخذون قراراتهم تحت ضغط واقع مختلّ، حيث تصبح البراءة عبئا، والحياد خطرا، والاختيار الشخصي فعلا سياسيا دون أن يقال.
لا أحد منهم بطل، ولا أحد منهم خائن، كلهم اتخذ قرارا بناء على ما كان متاحا له، والفيلم لا يحكم، بل يعرض.
هذا الامتناع عن الحكم ليس نسبية أخلاقية، بل فهم مركب للواقع، داوود عبد السيد يرفض الاختزال يرفض أن يقسم العالم إلى أبيض وأسود، لأنه يعرف أن الواقع أكثر تشابكا من ذلك، وأن السياسة الحقيقية لا تفهم من خلال الشعارات، بل من خلال الحياة اليومية.
افلام داود عبد السيد لا تمنح المشاهد موقفا أخلاقيا مريحا، لا تقول له: “أنت الضحية وهم الجناة” لكن تضعه داخل المعادلة وتسأله: أين تقف؟ ماذا قبلت؟ متى صمت؟ وما الذي اعتبرته طبيعيا لأنه ببساطة شائع؟
هذه سينما تحمل المشاهد مسؤولية الفهم، لا ترفيها خالصا، ولا تعليما مباشرا. وفي سوق ثقافي يميل إلى الاستهلاك السريع والرسائل المباشرة، هذا النوع من السينما يعد عبئا أكثر منه مكسبا.
المشاهد الذي يذهب إلى فيلم لداود عبد السيد لا يخرج مرتاحا، لا يجد نهاية سعيدة تطمئنه، ولا عقابا للأشرار يرضي شعوره بالعدالة. بل يخرج بأسئلة أكثر من الإجابات. وهذا بالضبط ما تريده هذه السينما: أن تجعل المشاهد يفكر بعد أن ينتهي الفيلم، لا أن يستهلك الفيلم ثم ينساه.
الإزعاج هنا ليس تقنية فنية، بل موقف فلسفي، داوود عبد السيد لا يؤمن بأن وظيفة السينما هي أن تريح الناس أو أن تقدم لهم حلولا. وظيفتها أن تكشف التشابك، أن تظهر كيف يعمل النظام، كيف ينتج الفساد، كيف يتواطأ الجميع – بما فيهم المشاهد – في استمرار الوضع القائم.
داود عبد السيد لم يصنع سينما تجارية، ولم يسع إلى النجاح الجماهيري الواسع. لكنه ترك أثرا عميقا في كل من شاهد أفلامه بتركيز. أثر لا يقاس بعدد المشاهدات، بل بعمق التأثير. أفلامه تدرس في معاهد السينما، تناقش في الندوات الفكرية، تعاد مشاهدتها بعد سنوات، لأنها تقدم كل مرة قراءة جديدة.
الإرث الحقيقي لداود عبد السيد ليس في عدد الأفلام، بل في طريقة التفكير التي أسسها: سينما لا تكتفي بالحكاية، بل تفكك الحكاية لتفهم بنيتها، سينما لا تكتفي بالشخصيات، بل تربطها بالسياق الاجتماعي والسياسي الذي ينتجها، سينما لا تكتفي بالترفيه، بل تطالب المشاهد بأن يكون شريكا في الفهم، لا مستهلكا سلبيا.
جيل كامل من المخرجين المصريين تأثر بهذا النموذج، حتى لو لم يقلدوه مباشرة. الوعي بأن السينما يمكن أن تكون أداة تحليل، لا مجرد أداة تعبير، هذا الوعي مدين بجزء كبير منه لداوود عبد السيد.
في زمن تتراجع فيه الأسئلة لصالح الإجابات الجاهزة، تظل سينما داوود عبد السيد ضرورة معرفية، لا ترفا نخبويا. ليست لأنها مختلفة، بل لأنها دقيقة، ليست لأنها متمردة، بل لأنها منسجمة مع منطقها الداخلي.
ترك لنا عددا محدودا من الأفلام، لكنها تعمل حتى اليوم كخرائط ذهنية لفهم المجتمع، لا كذكريات سينمائية جميلة. سينما لا تشاهد مرة واحدة، لأنها لا تستهلك، بل تفكر. وفي عالم يميل إلى السرعة والاستهلاك، هذا النوع من السينما يبقى مقاومة صامتة: ضرورية، ومستمرة.