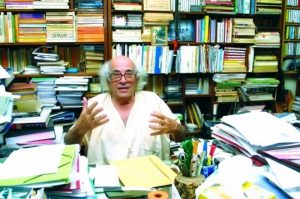أسامة كمال أبو زيد
كان الزمن، في طفولتي وشبابي، شيئًا له جسدٌ وروح: رائحةٌ يمكن تمييزها بين آلاف الروائح، وطعمٌ يُلتَقط من الهواء، ولمسٌ خفيٌّ يمرُّ على الجلد ثم يختفي. كنتُ دائمًا أؤمن أن السنوات ليست أرقامًا، بل كائنات لها وجوه، وأن كل عقدٍ هو مدينة صغيرة نُنفى إليها، نغترب فيها قليلًا، ثم نعود منها ونحن أشدّ غموضًا مما كنا.
لم أعش بياض الستينيات حين كانت الثورة في ذروة نقائها الأولى، ولم أُدرك جرح 67 الذي أطفأ أحلام العالم العربي كطفلٍ نفخ شمعته الأخيرة. لم أسير خلف تابوت الزعيم لأتوارى معه في الغياب الكبير. كنتُ، ببساطة، لم أولد بعد. ثم جاءت السبعينيات، وكانت عيناي ما تزالان عينَي طفلٍ يختبر العالم بخوفٍ صغير: انتفاضة 77 كانت ضجيجًا بعيدًا، ومعاهدة السادات مجرد حديثٍ يمرُّ من نافذةٍ لا أعرف أين تفضي، وطلقات اغتياله لم تكن إلا وميض شاشة بيضاء.. شاشةٌ كنتُ أخشى لمسها كما يخشى العصفور الماء أو المرآة.
لكن كل شيء تغيّر في عام 1990.
ذلك العام لم يكن سنةً عابرة، كان البوابة التي دخلتُ منها إلى نفسي. شممتُ فيه رائحة البارود لأول مرة، ورأيتُ أثر الحرب في عيون الجميع وأنا لا أفهم كيف يختبئ العالم في عيونٍ ترتجف. كان ذلك العام هو لحظة التحوّل الحقيقية: لحظة تعرّفت فيها على قصيدة النثر، ورأيتُ الكلمات تنفض عن كتفيها الخشب القديم وتخرج إلى الهواء الطريّ ككائن يستعيد جلده الأول. كانت القصيدة ـ لأول مرة ـ تشبهني، تكتب مثل روحي، وتمسح عن اللغة مكياجها، لتتركها عارية كأمٍّ خرجت من نهر.
وفي العام نفسه أدركت أن لنا سينما تشبه ملامحنا: عاطف الطيب، محمد خان، داود عبد السيد، خيري بشارة، ثم رضوان الكاشف.. كانوا جميعًا يتنفسون الرائحة نفسها التي كنا نبحث عنها: معنى الوطن حين يتحوّل شارعٌ صغير في القاهرة إلى صدفةٍ بحرية، ومعنى الهواء الذي يمرّ في الحواري الضيقة، ومعنى الجنوب حين يمتلئ بالحنين والقسوة والهدهدة في آنٍ واحد.
وفي الغناء رأيت الإرث الستيني يتراجع خطوة، لا ليختفي، بل ليترك مساحة لتيارٍ جديد جاء به حميد الشاعري من رمال الصحراء، من إيقاع الإبل حين تهزّ الليل بخطواتها البطيئة. كان ذلك الصوت الجديد يحاول تشكيل ذائقة جيلٍ كامل، لكنه لم يفلح في انتزاع عشقي لمنير وفيروز.. فلكل جيلٍ أمّان لا تُنسى.
ونحن ـ أبناء التسعينيات ـ كنّا أول جيلٍ تمنحه الصورةُ أجنحتها.
طفولتنا كانت أمام قناتين، ومراهقتنا أمام أربع، لكننا رأينا أول حرب تُبثّ مباشرة، ورأينا الطائر الأسود الخارج من بترول الخليج، يرفرف مذعورًا كأنه نحن تمامًا: لا يفهم ما الذي حدث، لكنه يعرف أنه قد تغيّر إلى الأبد. رأينا كذلك الدم على الأسفلت في ميدان تيانانمين، وعرفنا أن العالم لم يعد يكترث بإخفاء جراحه. الشاشة صارت أمًّا، ونافذة، وسقفًا، وجدارًا… وباعثًا لكل أحلامنا.
لذلك، كلما وقفتُ الآن وسط هذا الطوفان من الشاشات: التلفزيون، السينما، الدِشّ، الكمبيوتر، الإنترنت، اللاب توب، التاب توب، الموبايل… أعود إلى عام 90. أراه واقفًا على حافة روحي، يلوّح لي كآخر الأجيال القديمة في ألفيةٍ قررت أن تبتلع كل شيء.
ثم جاءت الأسئلة التي وُجّهت إلينا ـ نحن أبناء ذلك الجيل ـ بقدرٍ من السخرية والريبة: ماذا بقي من جيل التسعينيات؟ هل انتهى تأثيره؟ هل سقط مشروعه؟
وأنا، كل مرة، كنتُ أتساءل: كيف يُسأل جيلٌ بهذه الطريقة؟ جيلٌ كتب قصائده الأولى وهو يقف ضد الذائقة السائدة، ضد البلادة، ضد كل من ظنّ أن الشعر يجب أن يُكتب بصوتٍ مرتفع كي يكون شعرًا. جيلٌ وصفوه بأنه “حفنة من الحرافيش”، ثم تحوّلوا بعد سنوات قليلة إلى الثوّار الحقيقيين الذين أعادوا للشعر روحه الإنسانية.
كيف يُسأل هذا الجيل عن أثره، بينما قصيدة النثر ـ التي كانت طفلة يتيمة ـ أصبحت اليوم هي النص المركزي الذي تكتب به أجيال كاملة؟ كيف يُسأل عن سقوطه، بينما نجيب محفوظ نفسه اعترف أن “أصداء السيرة الذاتية” خرجت من عباءة هذا الجيل ومن جماليّاته الجديدة التي لم تشبه أبدًا كتابته الأولى؟
إن جيل التسعينيات لم يكن رفرفة فراشة. كان إعصارًا صامتًا غيّر ملامح الشعر العربي، ثم امتد تأثيره إلى القصة القصيرة، الرواية، السينما، وحتى لغة النقد نفسها. هو الجيل الذي جعل الشعر يخلع بدلته الرسمية ويخرج إلى الشارع، إلى المقهى، إلى البيت، إلى الجسد، إلى المناطق التي كانت محرّمة لعقود.
ذلك هو جيل التسعينيات كما عرفته: جيلٌ لم يكن لحظةً في زمن، بل زمنًا داخل لحظة. جيلٌ لا يُلتقط بالأسئلة، بل يُشمّ… كما تُشمّ رائحةٌ قديمةٌ في يدٍ ترتجف لأنها تلمس نفسها بعد غياب طويل.