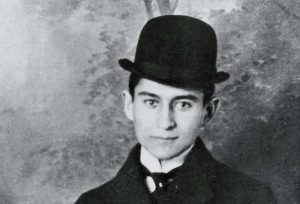فاطمة الخراز
المقدمة:
برزت أفكار ما بعد الحداثة، مُركزة في هجومها على المغالطات العلمية، وتحطيم التاريخ الموسوم ب“المركزية الثقافية”، بحيث تم تجنيد هيئات أكاديمية في العالم تخصصت في تقويض، ومحاربة ما أتت به هذه الأبحاث الجديدة، وفق انتشارها في الفضاء الأكاديمي في سبعينيات القرن الماضي، التي أصبحت من بين الحقول النشطة على مستوى العالم بأسره، وفي مجالات مختلفة (الأدب والتاريخ والعلوم السياسية والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع …الخ) إلى جانب الدراسات العرقية والنوعية. بعد السقوط المدوي للحداثة، وانضواء النقد الأدبي والثقافي بكل مذاهبه تحت مظلة ما بعد الحداثة*، لتطرح قضايا، ما ذهبت إليه أهداف الافتراضات والأكاذيب، التي حيكت زورا حول الحضارات العريقة القديمة، سواء منها الحضارة الآسيوية، أو الإفريقية، أو الأمريكية “الهنود الحمر” وكل بقعة تسلل إليها الرجل الأبيض، في غفلة من أهلها؛ ليمارس ما هدف إليه مسبقا، وخطط له مقدما، من تعنت وتصلب وعنصرية، وغزو فكري، ينزع إلى استلاب كل ما هو “أصلاني“. وما يحمل من الإغراء في خطابه، والإغراق في خطوبه.
* ما بعد الحداثة: في ضوء مبرِرات ولادتها في أرضها الأم بوصفها انعكاسا لهذه الشروط الجديدة، الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.. كرس خصوصية الظاهرة بحكم نشأتها في الغرب تحديدا. في المجتمعات الغربية، وهوما لا ينبغي بالضرورة خضوع المجتمعات الأخرى التي لم تمر بتحولات مشابهة لهذا ومن ثَم لا النظر إلى تلك الثقافة باعتبارها نتيجة طبيعيةً النمط من الفكر الجديد. يجب إذً به الغرب من تناقُضات وانقسامات في الأيديولوجيات الحداثية، لا سيما في علاقة المركز ِ الاستغلال والاستعمار، وغياب المسأو اة، وسيطرة النخبة بالهامش وما نشأ عنها من قيم من الطبيعي أن تنشأ، كنوع من ردة الفعل، اتجاهات مضادة، تنادي … الخ. ومن تطالب بالخروج عن كل بسقوط الأيديولوجيات، والسرديات الكبرى، ونهاية الميتافيزيقا، ومقياس معياري، وترسيخ مبدأ الانتماء الفردي، وربما تشيع أيضا ملمح الثقافة السلعيةُ الاستهلاكية، ورفض مقولات وفرضيات عصر التنوير، وخطاب الحداثة المتمثل في الإيمان).
دروب ما بعد الحداثة، ص11
*الاختلافات والفوارق التي تفصل الفكرة ما بعد الحداثي عن نظريه الحداثي. يصنف ليمرت المفكرون ما بعد الحداثة إلى ثلاث فئات:
أ- الراديكاليون: ليوتار، وبودريار، وإيهاب حسن، الذين يَعتبرون الحداثة شيئً ينتمي للماضي، وأن الوضع الثقافي الراهن لا يَحتمل مقولاتها.
ب- الاستراتيجيون: ميشال فوكو، ودريدا، ودولوز الذين يتخذون من اللغة أو الخطاب أساسا لتحليلاتهم، ويرفضون أيَّة صياغة ملفهوم الجوهر الشامل، والكلية أو القيم الشمولية.
ج- الحداثيون المتأخرون: مثل هابرماس وجيمسون، الذين يتخذون موقفً ا نقديٍّا من الأنساق الشمولية الكبرى،ولكنهم لا يَرفضون مفاهيم الحداثة. نفس المرجع، ص 33
تفجرت الساحة الفكرية بمنعطفات عميقة غيّرت مسار الفلسفة والأدب، وكان من بين أبرز هذه التحولات، ظهور نقدي جديد ما بعد البنيوية، وهوما يعرف بالتفكيك La déconstruction أسسه الفيلسوف الفرنسي المثير للجدل جاك دريدا، الذي لم تكتف دراساته بإعادة قراءة النصوص الأدبية والفلسفية، بل امتد تأثيره ليكتسح الكثير مجالات المعرفية والجغرافية، بما في ذلك التصورات الفكرية العربية. تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على هذا المفهوم الغامض والملتبس، والكشف عن الأسس التي يقوم عليها هذا التيار النقدي. كما تهدف إلى تتبع أثر التفكيكية في استعراض أهم القضايا، التي أثارتها، بجهاز مفاهيمي عزز من ثبوت أركان أهدافها ومقاصدها، بكلمات مفتاحيه اختصت بها، مثال مفهوم “المركزية” وهدم الهيمنة الغربية على الساحة الفكرية العالمية. كما تهتم بأصحاب الأقلام المهمشة،، وغيرها من التيارات الفكرية التي تسعى إلى تغيير الأو ضاع الكولونيالية الإمبريالية. للمزيد من التعمق في الموضوع لا بد من التطرق لأسئلة حول جوانب:
ـ ما هي التفكيكية؟
ـ ما هي الأسس التي تقوم عليها؟
ـ ما هي أهم الرؤى التي تنأو لتها؟
ـ من هم الأعلام العرب الذين تأثروا بها؟
1 ـ ما التفكيكية La déconstruction :
يقول الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمان (شاع استخدام مصطلح ” التفكيك”.. مع أن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند تلقيه، هو التفصيل أو التخليص، بخلاف المقابل الأجنبي الذي يفيد معنى التقويض أو التهديم، والتفكيكيات إجمالا، عبارة عن وجوده كتابة النصوص، وقد اشتهر بها الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا الذي أفاد كثيرا عن أفكار سلفيه: نيتشه وهايدجر، والذي امتد أثره إلى خارج دائرة الفلسفة، فنفذت دعأو يه في الدراسات الأدبية، ولا سيما النقدية منها1).
اشتهر عن التفكيكية بأنها حركة فلسفية أدبية ظهرت في فرنسا في سبعينيات القرن الماضي، من بين التعريفات الأخرى، أنها منهج نقدي يهدف إلى تشريح النصوص، والكشف عن بنياتها الخفية الملتبسة، كونها لا تحمل معنى ثابتا وواضحا، بل هي مليئة بالثغرات والتناقضات، التي يمكن للقارئ أن يكشفها من خلال تأو يلها وإعادة بناءها على خلفية قراءة جديدة. تم تطبيق التفكيك في الكثير من المجالات، بما في ذلك الأدب، والفلسفة، والعلوم السياسية، وقد أثرت بشكل كبير في الدراسات الأدبية والنقدية، حيث ساهمت في تطوير مناهج جديدة لتحليل النصوص وتفسيرها. واجهت التفكيكية العديد من الانتقادات، حيث اتهمها البعض بالغموض والتعقيد، وبالتطرف في نسبية المعنى. كما اعتبرها البعض الآخر، مجرد موضة فكرية لا تقدم إضافة حقيقية للمعرفة.
(بفضل ترجمة سبيفاك ومقدمتها الشارحة، احتدم الجدل ولا يزال حول دريدا الذي غزى نهجه الثوري، في معالجة الفينومينولوجيا والتحليلَ النفسي والبنيوية واللغويات، بل تراث الفلسفة الغربية؛ ووجه النقد عموما. والاسم الشائع لهذا النهج هو”التفكيك” الذي أخذت روحه تتسرب إلى مجالات أخرى لاحقًة؛ كالنقد النسوي والنقد الثقافي ودراسات ما بعد الاستعمار والتاريخية الجديدة2). تتسم التفكيكية بتفرد في الهدف، لكنها في الوقت نفسه، غيرت من مشهد الإنتاج الفكري الغربي، وساهمت في تطوير مناهج جديدة، لتحليل النصوص وتغيير ملامحها ونتائجها. تم التقاطها من قبل تيارات اهتمت بهذا التوجه لاستشكال مباحثها، وإيجاد منفذ من ثغور القبضة المحكمة والمالكة لأحادية المعنى في البعد الكوني.
بعد ما كتب دريدا رسالة لصديقه البروفسور الياباني أزورتو، عمد إلى شرح مستفيض ومختزل لرحلته الطويلة مع التفكيك والتفكيكية، تم اقتباس منها هذه السطور الأخيرة (ما الذي يكون التفكيك؟ كل شيء ما التفكيك؟ لا شيء! أعتقد أن هذه الكلمة جيدة، وهي خصوصا ليست بالمفردة الجميلة، أكيد أنها أسدت بعض الخدمات، لكن في وضعية محددة جدا، وما فرضها في سلسلة من البدائل الممكنة، على الرغم من علوم كفايتها الجوهرية، يستوجب تفكيك وتحليل هذه الوضعية المحددة جيدا، وهذا أمر صعب، ولن أتمكن من القيام به3) في هذه الخاتمة يبين الفيلسوف عن عجزه، في تعريف شامل مانع لمفهوم التفكيك. من هنا نستشف استشكال الأمر على صاحبه، فما بالك بمن نقلوا عنه؟ وهذا ما يثير العديد من التساؤلات حول امتناع دريدا عن الإفصاح عن مشروعه، وإحاطته بهالة الغموض.
(المهم أن الحركة التفكيكية لمسلمات الفلسفة، توسعت وتعمقت ووصلت أو جها في السؤال الراديكالي الجذري: ما الوجود؟ لا وجود الكائنات التي نسميها أشياء، لكن الوجود الذي دونه لا يرى شيء بعدمه، ولا يشرق بصيص من نور، الذي افترضه الأو لون والآخرون دون يدركوا ذاته، ويرى هايدجر أن (الدازاين أو الوجود هنا) طريقا ينهج إلى أانطولوجيا جديدة انبثقت مز تأو يلاتها السطحية أشكال شتى مما راج وماج بعد الحرب العالمية الثانية، هذا التفكيك نفسه، هوالذي فجر دريدا منابعه في صورة جديدة وأسلوب جديد …إن التساؤل في حد ذاته، نوربط بين إشكاليات تجدد المناقشة الفكرية لإتاحة الفرصة للفكر والقذف بها في جدل لا يمكن التنبؤ بنتائجه4).
إن الدراسات التي أقامها دريدا حول الوجود، مكنته من تحديد المعنى الذي لا يستطيع الإنسان بلوغه، وأن لا يوجد هناك حقيقة، وإنما دوائر تأو يلية حسب نيتشه، والوجود ذاته يتخفى في ذاته، لذلك وجب التشكيك وتقويض كل صرح فكري يدعي امتلاك الحقيقة.
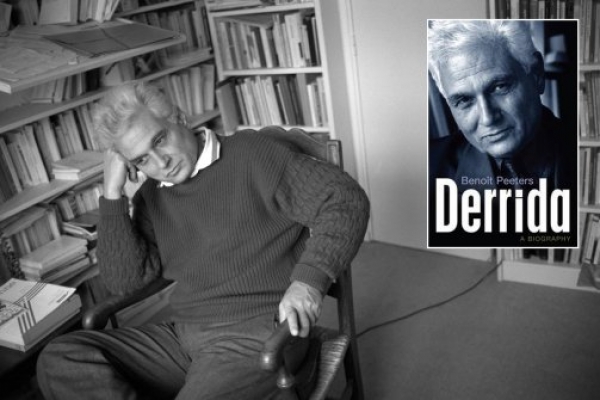
الفصل الأول
2 ـ المبادئ والأسس:
2ـ 1 ـ التركيز على الهامش: تهتم التفكيكية بتحليل الهوامش، والأجزاء الميتة في النصوص، للكشف عن المعاني الخفية التي قد لا تكون واضحة في المتن الرئيسي. ويحتل مفهوم “الهامش” مكانة مركزية في تفكيكه للثنائيات الفكرية التقليدية، يرى دريدا أن الفكر الغربي قد قام على تراتبية صارمة بين المركز والهامش، حيث يحيل إلى المركز، على أنه الأصل والمرجع، بينما يعتبر الهامش مجرد تابع أو نقيض. إلا أن دريدا يسعى إلى قلب هذه المنظومة، وكشف النقاب عن أهمية الهامش في تحديد معنى المركز.
(فهويرى أن الهامش ليس مجرد إضافة هامشية أو ثانوية، بل هو جزء أساسي من بنية المركز، ولا يمكن فهم أحدهما بمعزل عن الآخر. في هذا السياق، يقدم دريدا مفهوم “الاختلاف” أو “الانتشار” (différance)، الذي يشير إلى العلاقة المعقدة بين المركز والهامش. فالاختلاف لا يعني مجرد التباين أو التضاد، بل يشير إلى عملية مستمرة من التأجيل والتأخير، حيث يتحدد معنى كل عنصر من خلال علاقته بالعناصر الأخرى، بما في ذلك، تلك التي تعتبر هامشية أو ثانوية بتصديه للمفهومات المؤسسة للميتافيزيقا الغربية ولمفهوم الأصلl’origine بخاصة يرينا دريدا بمماحكة دياليكتيكية نوعا ما، أن الأصل لا يكون أصلا إلا باستفادة من النسخة التالية له، التي يسود الزعم أنها تأتي لنسخه وتكراره، ضامنة له بذلك حيازة (الأصلي) وهذا لمسار تأتي فيه الآثار المتتابعة لتعدله في أصليته…إذن في البدء كان الاختلاف ! وهذا ما يفسر قول دريدا في التأخر أو الإرجاع الأصلي le retard original الأصل يحيل إلى لاحقه دائما. لدى يكون الإخلاف في حقيقته، مجرد إحالة إلى الآخر، وإرجاء لتحقق الهوية وانغلاقها الذاتي5).
2ـ 2 ـ الإرجاع والإرجاء : يسعى التفكيك يقينا، إلى إيضاح، أن مسألة الرجع، أعقد وأكثر استشكالا مما تفترضه النظريات التقليدية، ولكن الأكثر من هذا (أن التفكيك يتساءل عما إذا كان مصطلح “الإحالة” يفي تماما بتسمية ‘الآخر‘ وهذا الآخر، الذي يتجأو ز اللغة، والذي يستدعي اللغة، قد لا يكون هوالمشار إليهréférent بالمعنى المعتاد … بيد أن يبعد عن بنية المرجع المعتاد… لا يعني القول إنه لا يوجد شيء أبعد من اللغة6) تعتبر التفكيكية أن اللغة ليست مجرد أداة للتعبير عن الأفكار فحسب، بل هي جزء أساسي من تشكيلها، وتسعى إلى تحليل اللغة وكشف آلياتها. وهذا ما جعله يميل للبنيوية في هذه المسألة، فاللغة أصبحت تعبر عن نفسها، وعن بطون نصوصها، دونما تدخل وسيط بينها وبين المتلقي.
أما مفهوم الإرجاء فهو أحد المفاهيم الأساسية في أركان التفكيك، يرى فيه دريدا أن المعنى ليس ثابتا، بل هو دائما في حالة تقلب وتأخير. والكلمات تحمل في طياتها معاني متعددة، تتأجل باستمرار، ولا يمكن حسرها. هناك تشابه نوعي بين المفهومين، لكنهما مختلفتين، تعتبر كل من “الإرجاء والإرجاع” مفهومين متكاملين يعملان معا في اللغة؛ فالإرجاع يسمح لنا بتشكيل مفاهيم عامة عن الأشياء، ولكن هذه المفاهيم، ليست ثابتة ومستقرة بين الدال والمدلول، بل هي دائما في حالة تأجيل وتأخير بسبب الإرجاء. يساهم كلاهما في فهم طبيعة اللغة، والمعنى بشكل فعال. كما يساعد في تحليل النصوص بشكل دقيق، وفي فهم كيف تنحت المعاني وتتغير عبر العصور.
2ـ 3 ـ تفكيك الثنائيات: تقوم التفكيكية على تفكيك الثنائيات المتضادة التي يقوم عليها الفكر الغربي، مثل ثنائية، الخير\الشر،والحقيقة\الوهم، العقل\الجسد،أنثى \ذكر، وتسعى التفكيكية إلى دراسة هذه الثنائيات وكشف العلاقة بينها. وهي نظرية جاءت بها الثقافة العليا. التي شاءت بسط هيمنتها في التمييز العنصري بين شرائح المجتمعات، ما جعل رواد ما بعد البنيوية، نذكر على سبيل المثال أشهرهم: جيل دولوز، ميشيل فوكو، جوليا كريستيفا (إن إخراج دريدا من محيطه الطبيعي اللغوي السيميائي، والدلالي الناقد لميتافيزيقا الحضور، والمقترح لنظرية جديدة في الكتابة هدفها إعادة هيكلة الثنائيات الميتافيزيقية الكلاسيكية، سيفضي حتما إلى صيدلية أفلاطون Le pharmakon de Platon التي فيها من الترياق الشافي بمقدارها من السم الزؤام، إذ سيغادر مجال إبداعه أحادي الدلالة والإحالة، ليلج مجالا خاصا وأشمل تعقيدا، هومجال الهرمنيوطيقا، حيث تعدد المعاني والدلالات بل الدلاليات7).
2ـ 4 – نقد الميتافيزيقا:
تعتبر التفكيكية أن الفلسفة الغربية التقليدية تقوم على ميتافيزيقا ثابتة ومطلقة، وتسعى إلى تفكيكها وكشف تناقضاتها (فظلت الكتابة محكومة بهاجس من المعلوم أن أنكسمندريس هو أول من كتب من بني الفلاسفة ذا كنسخة، وكملحق مقابل للأصل الغرافيكي المنطوق. الميتافيزيقا منذ الحقبة اليونانية، ونظر إليها دوما وامتدت هذه النظرة من أنكسمندريس حتى هايدغر، مرورا بأفلاطون وروسو وهيغل ودي سوسير وليفي سرتوس. ومن هنا محاولة دريدا – في كتاب “في الغراماتولوجيا” – تحرير علم الكتابة من الأفكار الميتافيزيقية التي ترأسه 8).
وعليه فإن دريدا عمل على نسف الحضور الميتافيزيقي في النصوص، أو ما يصطلح عليه الاستشهاد السلطوي، أو الاستشهاد بسلطة صاحب النص سواء كان قديسا أو رئيسا، وقد تكون كرة قديمة عفا عنها الزمن، وما أكثر ميتافيزيقا الحضور في النصوص العربية التي أبت الموت، وتتناقل عبر الكتابة من قلم على آخر (إن السبيل إذن إلى تفكيك ميتافيزيقا الحضور، إلا بوضع مفهوم الكتابة – بوصفه الحامل لكل التاريخ الغريب، موضع سؤال؛ والسبيل إلى التساؤل بصدد الكتابة، إلا بالعودة صوب النصوص الفكرية والفلسفية، التي عملت على تأزم مفهوم الكتابة، والعمل على تفكيكها لكشف قواعد لعبها وتخليصها من رواسب ميتافيزيقا الحضور التي علقت بها9).
من هنا تنصب التفكيكية على إسكات الأصوات المسيطرة بين سطور النصوص القديمة، محاولة نسف التصور الدلالي، الذي عمر طويلا بدون أي مسائلة ولا استجواب، وهذا يحيلنا إلى ما جاء به علم النفس الاجتماعي، وما يصطلح عليه بالأفكار النمطية (تتمظهر في تلك الصور والمعتقدة التي نتمسك بها عن الآخرين، أفرادا كانوا أو جماعات.. قد تكون لها من فوائد إيجابية / سلبية، قد تشوش العالم من حولنا، وتؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة المغالاة في تقدير الاختلافات بين الجماعات، الاستهانة بالبيانات داخل الجماعة، تحريف وتشويه الواقع، تبرير العدوان، أو الاستبداد10) وهذا موضوع آخر فيه تعمق رزين وعميق يتوخى التأمل لما يترتب عنه من ترسيخ للأفكار الميتافيزيقية النابعة عن إيديولوجيات محددة، في اللاوعي الجمعي حسب جوستاف لوبون وكارل يونج، قد يكون المصطلح مختلفا، لكن المضمون مقاربا على قول جيل دولوز الفلسفة هي نحت للمفاهيم.
الفصل الثاني
وعليه، يمكن القول أن التفكيكية تيار فكري نقدي يهدف إلى إعادة قراءة النصوص الفلسفية والفكرية بطريقة جديدة وشاملة، تتجاوز الولاء للأفكار القديمة التي سادت لفترة طويلة. وتهدف لهدم وزعزعة الأسس والثوابت المطلقة، وتغيير المسلمات التقليدية التي تعتبر غير قابلة للنقد. كما عمد العديد من النقاد والفلاسفة المرموقين ما بعد البنيوية، المفكرين الذين ساهموا في تأسيسها أو تبنيها أو نقدها. تجندوا لخلخلة هذه الأفكار بواسطة أدوات نقدية صارمة، تجعل من مفهوم الاختلاف مرفوض، شددت التفكيكية على أهمية الاختلاف والتنوع، ودعت إلى احترام الآخر المختلف.
1 ـ جاك دريدا:
ولد جاك ديريدا 1930 ـ 2004 في الجزائر، التي كانت آنذاك تحت الاستعمار الفرنسي. لعائلة يهودية من الطبقة المتوسطة، كانت تتحدث الفرنسية، وتأثرت بثقافتها، عاش طفولة عسيرة، وشباب قلق، جاك دريدا لم يأت بأفكاره من فراغ، لأنه تعمق في من سبقوه، وتسلح بمعرفة موسوعية، جعلته مميزا يعتبر ديريدا الأب المؤسس للتفكيكية. يرى ديريدا أن النصوص لا تحمل معنى واحدًا وثابتا، بل تتضمن معاني متعددة ومتضاربة، ولا يزال إرثه الفكري حيًا حتى اليوم، ولا تزال أعماله تقرأ وتناقش في الأوساط الأكاديمية والثقافية حول العالم. اقترن اسم هذا الفيلسوف القلق، بفصل دراساته العميقة والرزينة استطاع فك شفرة أفكار حول الوجود. (دريدا مفكر لا تعنيه مشكلة الالتزام، لكنه رجل من أخلص الرجال، لمواقف تشرف الإنسان، لا يخشى فيها لومة لائم، لأنها تنبثق من فكر ولا تصدر عن عبث الأحداث، بما يظهر جديدا عن ملوك الكلام وفاتن الصور؛ لذلك بعلاقة الفلسفة والقوميات اهتماما فلسفيا، بحيث انتبه إلى المشكلات العالمية الكبرى. وحدت من موقفه في سياق فلسفي أخلاقي محض، في أعماقه بلا تردد ولا تساهل11).
ليس من وجه الإعجاب بمكان، ولا من وجه المبالغة، أن نقول أن دريدا بطل شجاع، إذ استطاع التقاط مطرقة نيتشه، وأضاف إليه معوله، ليهدم حصن الفكر الهيكلي (الإشكالية، على ما يبدو أن دريدا بنى كتاب كلاس Glas بطريقة تجعل مثل هذه العلاقة الجدلية dialectique بين النصين مستحيلة عمليا – بحيث يجب على المرء أن يتخلى عنها – وبالطبع، لا يتناول الكتابة أي شيء تقريبًا باستثناء “جنازة الديالكتيك” ودفن “المعرفة المطلقة”، ونهاية طريقة معينة في التفلسف التي يعتبر هيجل بدون أدنى شك الشخصية المثالية فيها12) . إذن نستطيع القول ونحن نقف حيال هذا التحدي الأكبر، الذي أخذه دريدا على عاتقه، في دفن المسلمات مع أفار أصحابها، ونقد الديالكتيك الهيجلي والوقوف عند حدوده، وادعائه أن “روح العصر” حقيقة وحيدة واحدة (يبدو أن التفكيك، بمعنى ما، هو النقيض التام للتأويل. وهكذا يمكننا أن نفهم بشكل أفضل الموقف الكلاسيكي الذي لا يتزعزع الذي يتبناه دريدا في كتابه “Glas”. لا أرى شخصًا آخر، باستثناء مارتيال جيرولت* الذي أظهر، في نفس الفترة تقريبًا، تجاه مؤلفين مثل ديكارت واسبينوزا، نفس الطموح المتناقض لكتابة تعليق شفاف لدرجة أننا لا نرى من خلاله سوى العقيدة نفسها” يُقارن دريدا بجيرولت الذي سعى، في تفسيراته لديكارت واسبينوزا، إلى تقديم قراءة “شفافة” تكشف عن “العقيدة نفسها” للمؤلفين. يبدو أن هذا الطموح يتناقض مع فكرة التفكيك التي تؤكد على عدم وجود معنى واحد ونهائي13 (.
2 ـ غيالي غترافورتي سبيفاك Gayatri Chakravorty Spivak

هي المفكرة الهندية، من مواليد 1942 من أولى أعلام الحركة الديكولونيالية، ولا زالت حية ترزق، التحقت بجامعات أمريكا، وشهرتها، بدأت في ترجمتها لكتاب الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا “عن علم النحو” الصادر سنة 1976 لتنطلق في كتاباتها في كل المجالات النقدية الأدبية، خصوصا في القراءات التفكيكية الماركسية، والنسوية بحيث ركزت على مفاهيم التابع \ المهمش \المختلف، أسهمت في الانخراط في جدل حول التبعيات الثقافية، ومفهوم الهيمنة، والاستعمارية، والطبقية، والجندرية، بالمفهوم الأنجلوسكسوني. في سؤالها المعمق” هل يستطيع التابع أن يتكلم؟” ?Can the follower speak الذي جاء على شكل مقال لا يتعدى 111 صفحة، يضم أربع أجزاء، و89 إحالة، بحيث أراد كشف، وتفكيك الخطاب المركزي، ويعتبر من أهم ما كتبت سبيفاك، لما قدمه ويقدمه من دعم قوي لهذا التيار، الأمر الذي استدعى تسليط ضوء كبير على الكاتبة، وإنتاجاتها الفكرية، وجل منشوراتها الورقية والرقمية، المتاحة في المكتبات وعلى شبكات النت. للتقرب إلى فهمها ومحاولة الغوص في متاهات تفكيرها، ما نتج عن إعادة “تأو يل المقال” وإنتاج نسخا مترجمة لهذا “الفكر\ الفكرة” التي تحاول صاحبتها إيصالها للمثقف الشعبي، وتعدد إعادة كتابته، تعود إلى الأهمية المقترنة بالظرفية التي يعاد فيها تأو يل المقال، أو مبررات منطقية، استدعت القيام بمراجعات وتحولات لإغناء النص. (غاياتري تجلب لساحة النقد أفكار فلاسفة ومؤرخين ومفكرين مشهورين على نحو مكثف قصد فهم علاقات السلطة المعاصرة، ودور المثقف داخلها14).
3 ـ هومي بهابها (بابا) Humai Baba:
هومي بابا (1949ـ) من رواد الفكر التفكيكي، والناقد ذو الأصول الهندية، والمختص في الأدب الإنجليزي والفني في جامعة شيكاغو الأمريكية، المتشبع بتعاليم من قبله، من رواد النقد الثقافي، وما بعد الحداثة، والمناهضين للسلطة الكولونيالية والحداثة، في أهم مؤلفاته “موقع الثقافة” الذي ألفه سنة 1974، يعد من المؤثرين في هذا الخطاب، بمفاهيم استقاها من إدوارد سعيد وفانون، و(جاك لاكان) البروفسور في علم النفس والحاصل على العضوية الكاملة في ‘الرابطة الدولية في فرنسا للتحليل النفسي.
تهدف أطروحة هومي بابا إلى التوظيف للنفس وعلاقتها بالمنظومة السياسية في الخطاب الغربي، والتي أخذها من فانون في دراسته ما بعد الكولونيالية، في مقدمته الأخيرة لكتاب «معذّبو الأرض»، يقرأ بابا العنف الاستعماري باعتباره أحد مظاهر أزمة المستعمَر في تحديد هويّته النفسية حيث يصبح نكران الذنب عارا يولد القمع الاستعماري ذنبا نفسيا عاطفيا عند المستعمر، (يمكن إلقاء المزيد من الضوء على فكر هومي بابا بالإشارة إلى علاقته المتجاذبة مع ذاته مع كثير من المفكرين والتيارات والسياسية التي نركز هنا على الأبرز بينها. وبداية؛ فإن تنظير ما بعد الكولونيالية عموما متأثر أعمق التأثر بأعمال المنظرين الفرنسيين، خاصة ميشيل فوكووجاك لاكان وجاك دريدا[…] حيث يدخل إسهاماتهم في مشروعه الخاص15).
من الواضح جليا تأثير استراتيجية التفكيك بشكل كاسح للمنابر العالمية، وبات يحظى بمكانة رفيعة لدى هومي بابا والتزود (أما دريدا، فأثره واضح على بابا من حيث قدرة دريدا، على إيضاح الممارسات النصية والكتابية والمؤسساتية التي يمارسها الانزياح والإرجاء.. فإن بابا يدعو معنيا بأن يكسو باللحم قول دريدا: بالنسبة للبعض منا، فإن مبدأ التعيين هوما يجعل حرية الإنسان الواعية أمرا قابلا للفهم16). غير أن بهابها، في معرض نقده إدوارد سعيد، أضاف مفاهيم كثيرة، مثل (التجاذب) و(الاختلاف) و(الهجنة الثقافية) و(الفضاء الثالث). ورغم الانتقادات التي وجهت إلى هذا المفهوم الأخير، فإنه يبقى من أهم المفاهيم التي أتى بها، وهو المفهوم الذي ستعتمد عليه هذه الدراسات الديكولونيالية بصفة رسمية، وفي الدراسات الراهنة في مسألة الهوية، كذلك رؤية فانون إلى الثقافة أنها حقل أدائي، كما عمل هومي بابا على تطوير هذه النظرية، فيما يخص التحليل النفسي، والجسدي في أفق منظور، جاك لاكان ونظرياته النفسية، وخاصة في مفاهيم (التمكن) (الآخر)(الأنا) من خلال إعادة نظرية فرويد النفسية، بحيث أنشأ جمعية “دراسة التابع في الهند”، وقلب مدونة التاريخ الهندي المكتوب من قبل المؤرخين الاستعماريين، وما استبعدته من تراث شفهي والصور الحقيقية في الحياة الهندية.
المحور الثاني
1 ـ تأثير التفكيكية في الفكر العربي:
لا يختلف اثنان، أنه من الاستحالة الجواب على هذا السؤال الشائك، الذي طرحته سبيفاك، في بلداننا العربية، لأن شتان بين الفكر الهندي المعاصر، والفكر العربي، يقول المؤرخ الكبير بن خلدون في مقدمته، الفصل الثالث والعشرون:” أن المغلوب مولع أبدا بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده” انصهرت العقلية العربية، وذابت في الثقافة الغربية قلبا وقالبا، في كل الميادين والتيارات، والحال عليه بل ويزيد “التقليد سما” ينهش في البدن العربي. من منظور فكري مغاير، هناك توجد العديد من المصنفات التي نهضت بالفكر العربي الفلسفي. (نحن مدينون لدريدة بفلسفة ارتباط الخير والشر (ينظر للصفحة 9 من هذا الكتاب) لا بمعنى التبرير، لكن بالتساؤل الجندري الذي يحررنا من ربقة اللغة التي سادت الفلسفة وهيمنت على معظم علاقاتنا باللغات التي تطور التساؤل الفلسفي فيها. وقد نال في إطار الفلسفة الغربية، كذلك الفلسفة العربية تنتمي لهذا الإطار، ولا يمكن فهم أرسطو والعلوم اليونانية؛ إلا بالرجوع إلى مراحل الحضارة العربية الإسلامية؛ التي لم تكن مجرد مدرج يفضي لهذه العلوم17).
للتذكير أن البنيوية أكدت على أهمية البنية النصية، ونسقها الشكلي المغلق، والنظام المركزي للدلالة، وهذا ما أدى إلى نعتها الاختزال ورفض كل السياقات، والانكباب على النص المكتفي بذاته حسب ادعاء أنصارها، كل هذه “المزالق” المنهجية كانت سببا كافيا لقيام حركات معرفية في النقد الأدبي على اندثارها، تختلف عنها جذريا، وهوما اصطلح عليه ما بعد البنيوية أو التفكيكية.
قلنا سابقا، من الراجح أن مصطلح التفكيك مطاطي المعنى، فهومن جهة يدل على التهديم والتدمير، وإعادة بناء جديدة؛ إلا أنه من زاوية فلسفية يرقى لمستوى دلالي عميق، ما يرجى ويستحب تطبيق المنهج التفكيكي على النصوص العربية.
(لتمييز خير ما سُمع وأحسن ما كُتب وأشرف ما يُؤثر، فإن أردنا إظهار الفارق بين الفكر الكلاسيكي العربي من جهة، والاهتمامات الحالية من جهة أخرى، لظهر ذلك في الشك بقدرة التمييز الموروثة. وثقتها بسهولة العملية التي تحكم العقل كفيصل عادل قاطع ظاهر يكفي لتأسيس رأي ووضع منهاج لا يظل من تمسك به على سواء السبيل؛ لذلك أرى أن (أو ل) باب يولج إلى المغامرة الفكرية الدريدية، هو التحقق من هذا التساؤل، وتبيان السبل التي تؤدي إلى الاستنطاق الأنطولوجي الهيدجري، و(الثانية) تخترق سؤاله عما انتهت إليه التجارب الفلسفية الحديثة في أسمى عباراتها و(الثالثة) تهتم بما يربط فكر ديريدا وتدخلاته في القضايا العصرية من وجهة الفكر الذي يحاول إظهارها18).
إذا ما أخذنا مثال مفكر عربي جزائري محمد أركون، الذي تغلغل في الفكر التفكيكي، لكن بشكل نخبوي، لا تشم فيه رائحة ثورة المهمش، ولا أي ثورة بين طيات مفرداته المعقدة، في نفس السياق، حيث يقول أن الحداثة أصبحت من التاريخ، وأنه يدفع الفكر الإسلامي إلى ما بعد الحداثة، إلى محو الثنائيات التي تشكل العقل الديني الذي يكره الاختلاف، وهذا العقل دوغمائي القمعي لا يقبل التعدد، وتكون من سماته الأساسية، أركون يشير إلى المسكوت عنه في طيات النصوص الدينية، وما تم “تسميطه” وإخفاؤه وقمعه. يقول أنه اعتمد على الكثير من المناهج النقدية، وكان من بين مناهجه الإبستيمولوجية والتأويل واللسانيات، استوعب أركون التراث الأنثروبولوجي في البحث عن أصول المقدس، ووظفه في أخطر كتبه (الفكر الأصولي واستحالة التأصيل) في هذا الكتاب صدى مباشر لفكرة جاك دريدا التي تقول لا يوجد أصول وهوما اصطلح عليه بالمركزية الوهمية، والهوية الخالصة والمغلقة، والهوية لا تتحدد إلا بالآخر، والسلفية الدينية والثقافية والأدبية والفلسفية، المجبولة على التشبث بقدسية الأصول، وما يسميه سيغموند فرويد بالفكر الطوطمي، البدايات الذهبية التي تتسم بالطهر والنقاء.
من منظور عربي يضيف طه عبد الرحمن ففي مقاربته بين التفكيكية وفقه الفلسفة (أهم ما يتسم به النظر ألتفكيكي، وصفين أساسيين، الاتجاه الأول، هو الانقطاع عن نموذج الإحالة، أي أن الأصوات تحيل بعضها عن بعض في علاقات التوزيع والترابط والتسلسل، ولا تتعدى النص المنظور إلى نصوص سواها، فلا تعدو العلامات المكتوبة كونها أشباحا أو آثارا.، لينفك الخطاب الفلسفي عما علق به من اعتبارات انطولوجية، في التعلق بالعقل والحقيقة وإدراك الوجود …أما الاتجاه الثاني، فهو الاتصال بأفق الأدب، والاتصال بأفق الأدب، ..من أساليبه البيانية للنص الفلسفي، طرقه في التمثيل والاستعارة والتخييل، ما جعل دريدا يقف طويلا عند الاستعارة في تقريب المفاهيم وتبينها19).
والتفكيك في نظر جاك دريدا وبول ديمان* يتجلى في لا نهائية التفسيرات، والعدد اللانهائي للتأويليات، ما سماه بالقراءة الجديدة، وهدف التفكيكية أن يتحدث المؤلف بشيء، والقارئ عن شيء آخر، كذلك القطع مع الترابط والنسق التقليدي، الهدف الأساسي يكون في إعطاء مدلولات تهدم القراءات السابقة، لكن ليس بالضرورة، فهي لا تهدم المقولة الجيدة السابقة، قد تكون موضوعية ورزينة، وفيها من الخير الكثير، من هنا جاءت ما سمي بالقراءة المسيئة / السيئة لذلك تقول هذه النظرية أن الحديث أفضل من القديم.
لكن الجدير بالذكر أن القراءات الجديدة، لا يكون لها وزنا ثقيلا؛ إلا من خلال الإسناد إلى قراءات قديمة، كما كان في أصول التأويل* لدى المفسرين المسلمين، وعليه من الممكن أن تؤدي إلى مجموعة من النتائج والمعطيات تنفع المتلقي والقارئ المحترف.
*بول ديمان ولد بول دي مان البلجيكي الأصل (1919)1983 نشر كتابه ” العمى والبصيرة ” 1971 . كتاب مذهل، أخاذ، نتاج عقل لا يهدأ ولا يرضى أن يقف عند أقل من الامتداد المفتوح لنقد الذات. وهومن الناحية الكتابية يوضح بجلاء أن دي مان قد توصل إلى منطقه ألتفكيكي بطريق مستقلة عن تأثير ديريدا. هذا ما قاله “كرستوفر نوريس”. أما “فولاد غودزيتش”فقد قال: لا يقرأ بول دي مان ليشكل هويته، أو هوية النص، ولا هويقرأ ليصل إلى هوية ما وراء النص. بل هويريد أن يحدد موقع نقطة العمى في النص بوصفها منظم فضاء الرؤية التي يحتوي عليها النص. http://www.4shared.com/document/-yHHU05g/_________.htm .
*انظر كتاب (أخلاقيات التأو يل، الفصل السادس) من أنطولوجيا النص إلى انطولوجيا الفهم، محمد الحيرش
يقول محمد الحيرش لتأكيد الدور التفكيكية في المنهج الهرمنيوطيقي، كيف يحد من الغلو السلطويين لهذه النصوص المتناحرة (لقد تراجعت الحظوة التي ظلت تتمتع بها السلط وطوعت منازعها الاستعلائية، وخفف من غلوائها، لتؤول إلى مجموعة مرنة من الوساطات الاستفهامية… وقد ساعد على هذا التحول، أن الهرمنيوطيقا أضحت في الأفق الفكري الراهن، تكرس يوما بعد يوم، بوصفها ثقافة فلسفية مشتركة… تفيد منها طائفة واسعة من العلوم…فترتب عن ذلك مسالك في النظر والتأمل فيما يدعى اليوم وعيا تأو يليا معاصرا يأخذ على عاتقه مسؤولية تخليص الفكر من من أغلاله الميتافيزيقية الآسرة، وتفكيك بؤر العنف المتخفية فيه، ما يسمح في حياتنا في نبذ العنف والإنغلاق20). ما يؤكد في قوله مساعي الهرمنيوطيقا لتأسيس ثقافة فلسفية مشتركة، تدعو إلى الحوار البناء الذي لا يلغي الآخر، ويعطي مساحة للتعايش الفكري المثمر بين جميع الأطراف المختلفة.
2 ـ التفكيك عند العرب (عبد الكبير ألخطيبي نموذجا):
2 ـ 1 ـ عبد الكبير ألخطيبي:
هومفكر مغربي بارز، (1938ـ 2009) في مدينة الجديدة جنوب الدار البيضاء، بدأ دراسةَ علم الاجتماع والفلسفة في جامعة السوربون، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الأدب ألمغاربي. حصد العديد من الجوائز جعلت منه فيلسوفا يتصدر المشهد الفكري المغربي جنبا الى جنب مع عظماء فلاسفة عصره، اشتهر بمساهماته في مجالات الفلسفة، الأدب، وعلم الاجتماع. عرف بهوسه لكل ما هو تقليدي وتراثي في الفنون الحرفية المغربية. يتميز فكره بالتنوع والجرأة في كتاباته، وقد أثر في المشهد الثقافي العربي. أبرز جوانب فكر ألخطيبي (النقد المزدوج) يسعى إلى تأو يلٍ للوجود، من خلال منظور تفكيك ثنائيات الشرق والغرب، الأنا والآخر. يهدف هذا النقد إلى تجاوز الرؤى الأحادية والتبسيطية، وإبراز التعقيد والتنوع في الظواهر الاجتماعية والثقافية. كان منهج الخطيبي متفردا في العالم العربي، والكتابة بالنسبة إليه مغامرة تقتضي تفكيك الأشياء وممارسة النقد المزدوج للتراث ولمعرفة الآخرين، وتقتضي إلغاء الحدود المصطنعة بين الأجناس الأدبية وبين أنواع الكتابة، كذلك قدم أطروحات نقدية وتصورات فكرية أثارت ردود أفعال متفاوتة، اهتم بتحليل النظم الثقافية المادية والرمزية، وظل يبحث عن الخيوط المشتركة التي بإمكانها توحيد العالم العربي، وكانت صدمته في فشل اتحاد المغرب العربي كبيرة ومؤثرة. قال عنه رولان بارت
(إنني والخطيبي نهتم بأشياء واحدة، بالصور والأدلة والآثار، وبالحروف والعلامات. وفي الوقت نفسه يعلمني الخطيبي جديداً، يخلخل معرفتي، لأنه يغيّر هذه الأشكال، كما أراه يأخذني بعيدا عن ذاتي، إلى أرضه هو، في حين أحسّ كأني في الطرف الأقصى من نفسي21).
وهذا ينم عن اهتمام بين الأطراف الفلسفية، واطلاع عما يروج في الساحة الفكرية المتبادلة بين الغربي والعربي، شغل موضوع الهوية حيزاً كبيراً، حيث سعى إلى فهم الهوية المغربية والعربية في سياق التحولات التاريخية والثقافية. دعا إلى تجاوز النظرة الثابتة للهوية، والاعتراف بالتنوع والتعدد داخلها. وإعطاء فرصة لكل ما حصر في الظل، وكان هذا الفيلسوف يلي اهتماما خاصا لكل مهمش في المجتمع، لديه يقين بأن ليهم من الآراء ما يفوق غيرهم، ومن الأفكار ما يستحق الوقوف والتأمل. اعتبر أن الهامش يحمل في طياته إمكانات للتجديد والتغيير، لم يعتبر الكتابة مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكار، بل اعتبرها تجربةً معرفيةً ووجوديةً، تميزت كتاباته بالأسلوب الرفيع، والعمق الفكري، واستخدمت لغةً شعريةً وفلسفيةً، تجمع بين التحليل والتأمل. وقد ترجمت العديد من مؤلفاته للعديد من اللغات.
2 ـ 2 ـ ألخطيبي مفكر تفكيكي:

كانت علاقة صداقة فكرية عميقة، التقيا في باريس سنة 1974، ومنذ ذلك الحين، بدأت صداقتهما التي استمرت حتى وفاة دريدا، كان كل منهما مفكرا ذا اهتمامات واسعة، تشمل الفلسفة والأدب والنقد الثقافي. وقد جمعتهما رؤى مشتركة حول قضايا اللغة والهوية والاختلاف، كان كل منهما يقدر فكر الآخر ويحترمه، وقد تجلى ذلك في كتابات ألخطيبي عن دريدا، وفي إشارات دريدا إلى أعمال، كانت العلاقة بينهما تتجاوز الجانب الفكري، حيث كانا صديقين مقربين يتشاركان الاهتمامات الشخصية ويتبادلان الزيارات. كانا يتناقشان في الأفكار والقضايا الفكرية، وقد أثر كل منهما في فكر الآخر. التأثير المتبادل تأثر ألخطيبي بأفكار دريدا، وخاصة مفهوم التفكيك، الذي استخدمه في تطوير منهجه النقدي الخاص. وفي المقابل، أشار دريدا إلى أهمية أعمال الخطيبي في فهم قضايا اللغة والهوية في السياق المغربي والعربي. كتب كل منهما عن الآخر، حيث كتب الخطيبي كتابا عن دريدا، وكتب دريدا عن أعمال الخطيبي. كما ساهمت هذه العلاقة في إثراء الفكر الفلسفي والأدبي في كل من المغرب وفرنسا، حيث قدمت رؤى جديدة حول قضايا اللغة والهوية والاختلاف. جسدت هذه العلاقة أهمية الحوار الثقافي بين المفكرين من مختلف الخلفيات الثقافية
2 ـ 3 ـ الهوية المشتركة:
ساهمت في تطوير النقد الثقافي في العالم العربي، حيث قدمت أدوات جديدة لفهم وتحليل الظواهر الثقافية. يمكن القول إن العلاقة بين عبد الكبير ألخطيبي وجاك دريدا كانت علاقة استثنائية، جمعت بين الصداقة الفكرية والإنسانية، وأثمرت عن إسهامات قيمة في مجالات الفلسفة والأدب والنقد الثقافي.
في تحليل أحادية الآخر اللغوية يظهر ذلك الخيط الناظم القوي، المشترك بين دريدا والخطيبي (البعد النوستالجي، أن هذا الكتاب عبارة عن حوار المونولوج بين دريدا الحاضر، وعبد الكبير الخطيبي الحاضر- الغائب، حيث يستحضر أجزاء مشاركتهما في أحد الملتقيات التي انعقدت في أمريكا حول مسألة الآخر. اغتنم دريدا الفرصة السانحة بتدشين حوار مع ألخطيبي، وتحديدا من خلال كتابه “إلهام حب مزدوج”، وانطلاق من هنا يقوم دريدا بممارسة بوح من نوع خاص، حاول أز يفتح خلاله “صندوق العجب” صندوق تشكل اللغة الهوية نقاط ارتكان أولانية لبحث قضية يعتقد دريدا أنه حان الوقت لبحث من هوالمفكر الحقيقي؟ من هوالمفكر الفرانكفاني- مغاربي الأصل؟ إن ما يجمعنا هو أوثق بكثير من رائحة الدم والأرض، إنها اللغة الفرنسية! من هنا أتى سؤال دريدا المحوري (الفكرة المحورية للكتاب) هل يمكن للغة أن تكون أساسا للهوية؟22).
هل يمكن لنا أن نفهم مدى القلق من الضبابية التي تلف مفهوم الهوية بالنسبة لدريدا؟ لكن ما الذي جعل دريدا يقدم نفسه على ألخطيبي، وحامل لقب المفكر الفرانكفوني ـ ألمغاربي؟ قد يتفق معه القارئ، لأنه لربما يكون ذاك الفيلسوف الفرنسي الذي لم يستطع الغرب إسقاطه أو إبعاده من الساحة الفكرية العالمية. (واضح من بين كل المشاركين، هناك مشاركان اثنان، عبد الكبير ألخطيبي، وأنا ذاتي يتقاسمان قدرا واحدا معطوفا على صداقة قديمة تمتزج فيها مؤثرات القلب والذاكرة، ويعيشان “وضعا” خاصا بالنسبة للغة والثقافة، وضعا أقرب منه إلى القانون23). كان البحث المشترك بين دريدا وألخطيبي هو ذاك التنقيب عن الهوية في بطون النصوص واللغة،
(لنفترض أنني في إحدى الملتقيات المعقدة، في مدينة لويزيانا… قمت ودونما نية في أن أجرح عبد الكبير ألخطيبي؟ بتوجيه الإفادة التالية، محملة بكل معاني الود والمحبة، كان مضمونها: عزيزي عبد الكبير، ألا ترى معي بأنني الأولى بلقب الفرانكو- مغاربي؟ وبأنني قد أكون الفرانكو- مغاربي الوحيد هنا؟!.. سأحرص على أن يكون قولي مبررا أيما كفاية 24).
يقول بارت في تمجيده للغة داخل النص، وما تعطي للمؤلف من صلاحيات اللعب بالمفردات والإبداع في إعادة تركيبها وإنتاجها، بمقتضيات المعارف التي توسل بها لتعكي القارئ المثقف لذة فكرية تتولد عليه عند قراءة ذلك النص (فلذة القارئ تبدأ عندما يكون منتجا؛ أي عندما يسمح له النَّص أن يقوم بتشكيل قدراته الخاصة، واستثمارا لهذا الطرح الذي قدمه بارت، طور التفكيكيون، وعلى رأسهم جاك دريدا، إلى فوضى (التفسيري المتمرد) على فضاء التأويل، فقصد المؤلف انتفاء قصدية المؤول، والنَّص نفسه لا وجود له، وفي وجود ذلك الفراغ الجديد الذي جاء، تصبح قراءة القارئ هي الحضور الوحيد، لا يوجد مع موت المؤلِف وغياب النص، تصبح كل مغلق ولا قراءة نهائية، بل توجد نصوص بعدد قراء النَّص الواحد، ومن ثم التفكيك من رفض تصور بارت لفكرة قراءة نصا جديدا مبدعا، وهكذا انتقل اكتمال المعنى، إلى قدرة القارئ على تحقيق المعنى الذي يراه في رؤى لا نهائية عند كل قراءة جديدة للنصوص. في أعماله المتأخرة، مثل (Z/S) 25)
2 ـ 4 ـ تفكيك اللغة الشعبية القمعية:
عرف الفيلسوف ألخطيبي بمؤلفاته الغزيرة والجريئة باللغة الفرنسية، كما عرف عنه الهوس بكل ما هوشعبي وتراثي، فيعمد إلى ترجمة كل كلمة تدخل في خانة التراث الشفهي بما فيها الأمثال الشعبية، والمعاني الثاوية فيها (إن قراءة الثقافة الشعبية عند ألخطيبي توقف منهجي ونظري في مرحلة تاريخية لا تزال تقدس المتعاليات، وتصمت عند حدود ترى أن المساس بها مدعاة للهدم. هذه المرحلة التاريخية هي التي لا يزال الفكر اللاهوتي متمحورا حولها، ولذا فإن كل مقاربة تخشى الحرب الطبقية داخل النص Texte كما تمارسها خارجه، تبقى أسيرة مفاهيم المجال المعرفي التقليدي نفسها، تستند قراءة ألخطيبي للجسم العربي إلى الفرق، وهو قانون أساس من قوانين هذه القراءة. إن الفرق إقرار بالتعدد، ويستحيل الوصول إلى الكشف عن غور الاسم العربي الجريح من دون إعطاء الاعتبار لتعدد اللغات التي تم بها صوغ هذا الجرح. حديث الكتب عن الكتب هو في بعد من أبعاده حديث المركز عن الهامش، حديث الوحدة عن التعدد حديث الغياب عن الحضور، وبالتأكيد فإن لهذا الحديث طابعا قمعيا، يرى ما حوله مواتا لا نطق فيه ولا ارتجاج حتى متى يمكننا إلغاء هذا التعدد المحرك للتاريخ؟ إن الفرق الفاعل المحرك بالنسبة للخطيبي، هناك فرق طبقي، فرق لغوي، فرق تاريخي، فرق جغرافي، فروق لا نهائية عمدت الثقافة العربية الحديثة، أكانت سائدة أم في طريقتها للسيادة، إلى قمعها26).
إن العطب الموروث في اللسان العربي الشعبي ذا البعدين “الديني والأنثروبولوجي” المتعالي وما سماه ألخطيبي بالنقد المزدوج، وعليه فقد استطاع هذا الطرح، الفصل بين الجسد الفيزيولوجي الملموس (المحرم)، وبين الجسد الذي أسست مفاهيمه تلك الثنائية المتعالية، تتناقل الكتب والأجيال، وتصمت عند وقوفها على حافة وضع اليد على مكامن الخلل، خشية سقوطها، وتخشى أي مقاربة داخل النصوص، قد تثير الجدال العقيم كما هو خارجها، فتظل حبيسة المجال المعرفي التقليدي، ما يجعلها مركزية صلبة، والمقاربة الخطيبية، في تحدي منها، تستند إلى زحزحة ذلك المحرك للفرق الطبقية بما فيها (اللغوية والتاريخية والجغرافية وعرقية ولاهوتية ..) هذه الفروق هي نواة استلاب الإنسان العربي المعاصر، والمحركة لكل ما مستبد ومسيطر، في نفس السياق، يقول لولان بارت، وهو يستشكل صعوبة اللغة الشعبية في الشعب الغربي، ويعلن عدم قدرته عما ذهب إليه هذا المفكر المغربي ونوه على شجاعته في تفكيك وإعادة قراءة الجسم العربي بعين نقدية متفحصة
(إن ألخطيبي معاصر، يساهم في هذه التجلية التي تنموبدخيلتي… فهو يقوم بمعنى ما بالشيء نفسه لحسابه الخاص، إنه يساءل الأدلة التي ستجلي له هوية شعبه، لكن ليس شعبي الذي لم يعد بصورة هوية، التي لم تعد سوى مادة متحفية…وما بسائله ألخطيبي هو إنسان شعبي كلية…إذا أصالته ساطعة بدخيلة عرقه، صوته متميز حتما، فهو متفرد، لأن ما يقترحه، يشكل هو استرجاع الهوية والفرق في آن.. من هنا يمكن لغربي مثلي أن يتعلم شيئا من ألخطيبي، إننا لا نستطيع أن نفعل ما يفعله، ليس أساسنا اللغوي واحدا27).
أما تأثير جاك دريدا على النقد الأدبي الأمريكي فقد بدأ منذ خروج كتابه التأسيسي للتفكيكية، وهو
في علم الكتابة De la grammatologie أصبح دريدا مرجعا في النقد الأدبي الأنجلوسكسوني، وعزز هذا التمكين والإقبال عليه، كون التفكيك لا يسعى إلى التحول لإرث منهجي، ولا إلى نزعة سلطوية ويفجر ينابيع الفكر التي أسست للقارئ دستورا يقيه ضربة الثنائي “النص والمؤلف” ويصبح بفعل التفكيك يتحلى ببصيرة قوية حسب دي مان، حيث شكلت بنية قوية في المتن الفلسفي الأمريكي المعاصر(يرى ريتشارد رورتي أن شهرة دريدا لم تأتِ من الفلاسفة، بل من نقاد الأدب الأمريكيين الذين وجدوا في التفكيكية أداة جديدة لقراءة النصوص وتجاوز الفهم التقليدي للتاريخ الفكري. وقد كان هذا اللقاء بين دريدا والنقاد الأمريكيين حاسمًا في تشكيل مكانة التفكيكية كأحد الاتجاهات الهامة في النظرية الأدبية المعاصرة. التفكيكية كمدرسة نقدية أصبح دريدا، رغمًا عنه، رائدًا لمدرسة فكرية في الولايات المتحدة، وهوما لم يكن يسعى إليه28). يمثل النص الفكري الغربي سلطة مرجعية شديدة البروز في إنتاج العرب الفكري طيلة العصر الحديث، وقد بلغت من التكاثر حدا يجعلها جديرة بالدراسة والفحص واقتفاء الدلالات، ظاهرة كفيلة في حد ذاتها بإعادة العديد من الأسئلة والافتراضات، ظل النظر في القراءات العربية للفكر المغربي لدراسة مستقلة تتناول مستويات المعالجات المنهجية (وهذه القراءات تعرفنا عن كثب على المصادر التي أسهمت في توفير أجيال من قراء الفكر العربي ومنتجه. إن المتن الذي تمنح منه مقاربة القراءات المتعددة لجاك دريدا وتيارات التفكيك في الفكر النقدي العربي الراهن، واسع ومنفلت، ينتشر في فضاء تداولي متداخل، يصب فيه الأكاديمي والصحفي والإبداعي، يتوزع على دراسات ومقالات وحوارا ومؤلفات يصعب حصرها 29).
لنعتقد فرضا أن التفكيك ما هو إلا تشريح ومساءلة و”محاكمة” كبرى، يخضع لها النص، كيف ما كان جنسه ودلالات تركيبه. يمكننا القول كذلك، أن التفكيك هدم “شرعي” يميط اللثام على الوجه الحقيقي للأفكار التي تعشش في أدمغة المتشددين والنمطيين، وكارهي البحث والتجديد…
ليقول قولته الشهيرة جيل دولوز (الفلسفة ما هي إلا نحت للمفاهيم)، وكقول جوليا كريستيفا في مفهوم التناص الذي يحيل على نصوص سابقة، وأخرى جديدة تجعل من بنية النص تنزح للتكرار والاجترار دون طائل يذكر، لا يجرؤ على التزحزح من نقطة الانطلاق والوصول، دائرة مغلقة تجتر ما قيل بإضافات محتشمة، لا تسمن ولا تغني من الجوع شيء. ويستمر العود الأبدي النيتشوي في دورته اللامتناهية في تلقف المعرفة دون نقد.
يقول حسن حنفي في هذا المجال (أن هوسرل أراد أن يجد للفلسفة أساسا لا يرقى إليه الشك…ويقول يوسف كرم في تاريخ الفلسفة الحديثة، أن الفينومينولوجيا نقد جديد للمعرفة، يقصد توخي الدقة أكثر مما فعل ديكارت ولوك وهيوم وكنط، فتأخذ على نفسها أن تصف الظواهر بكل دقة وترتبها بكل إحكام، ويقول هايدجر التلميذ البارز لهوسرل في تعريف للظاهرة (Phénomène) ما يلي : الشيء يظهر، ودراسة الشيء تقتاده إلى الضوء، المجموع يعطي الظاهرة30) انتهي الاقتباس.
الخاتمة:
بعد هذا الطواف السريع حول مفهوم التفكيك، أو التفكيكية، لرائدها جاك دريدا، ومن أخذ بطرحه، ومن أتى من بعده، يتضح جليا أن الموروث الفكري بصفة عامة، سواء منه الغربي أو الشرقي؛ لهو بحاجة ماسة إلى التوسل ب”اسراتيجية” هدم النص السلطوي، والخطاب المركزي، الذي حصر بين كلماته حدود المعرفة. لاحظنا كيف استطاع الغرب أن يتخلص من القيود الوهمية المبثوثة في أعتا النصوص المنيعة توضيحا وتعقيدا. والمجندة بمسلمات القدسية السلفية، كما جاء في مأثورة الإمام أبو حنيفة النعمان “هم رجال ونحن رجال” قول يوضح أن لكل عصر مفكروه، وعلماؤه وقضاياه وانشغالاته.. من المتعارف عليه، أن الفكر الغربي مر بمنعطفات كبرى، بعد التنوير جاءت حمولة الحداثة وتقديس العقل، الذي أدى بالإنسانية إلى السقوط في خنادق المنهج، وحصر العلوم، وربطها بعلوم الفيزياء، التي شيئت الوجود والموجود، بما فيها العلوم الإنسانية، استباحت السيطرة على العالم، بكل ترسانة الصناعة الفكرية، والإمبريالية الاستعمارية، هذا الغلواء أدى إلى اشتعال ثورات فكرية مضادة، زهاء النصف الثاني من القرن العشرين.
فترة النقد المضاد، أدت إلى إلتآم الجرح الإنساني من جديد، لكن السؤال يظل عالقا: هل بمقدور هذا التصدي المبهر، أن يصمد في وجه السلطة المركزية؟ وذلك من منطلق، النص وليد سياقه اللغوي بوصف اللغة بيت الوجود كما جاء في قول هايدجر، وتعاقب النصوص يكون يتم في تباعد المفاهيم والأفكار. كما يتم قراءتها قراءة جديدة، بموجب فكرة التأو يل بصفة النص حمال أو جه، ونحن نبقى منتجات اللغة، والعالم منتج رمزي صامت أمام اللغة، والتفكيك لكل ذلك المدعاة الحقيقة المطلقة…
15\02\2025
…………………………..
*كاتبة وباحثة من المملكة المغربية
(1) طه عبد الرحمن. فقه الفلسفة1(الفلسفة والترجمة) المركز الثقافي العربي، ط1، 1995، الدار البيضاء.ص 42
(2) كلارك تيموثي. (التفكيك والأدب). سلسلة دروس التفكيك. ترجمة حسام نايل، الناشر مؤسسة هندأو ي، 2017، ص7
(3) جاك دريدا (الكتابة والاختلاف) ترجمة كاضم جهاد، تقديم محمد علال سيناصر، سلسلة المعرفة الفلسفية،ط2، دار توبقال الدار البيضاء، 2000، ص 63
(4) المرجع نفسه، 16
(5) (الكتابة والاختلاف) مرجع سابق ذكره ص 16
(6) المرجع نفسه، ص 30- 31
(7) جاك دريدا (أحادية الآخر اللغوية) ترجمة عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط 1، 2008 بيروت، ص 19
(8) عمر التأو ر (إستراتيجية التفكيك عند جاك دريدا الهدم والبناء) جريدة التبين، العدد 29
(9) المرجع نفسه
(10) أحمد زايد (سيكولوجية العلاقات بين الجماعات)، عالم المعرفة، العدد 326، 2006، الفصل السادس، الأفكار النمطية، ص 127- 129
(11) الكتابة والاختلاف، مرجع سابق ذكره ص 16
(12) ”Derrida -Hegel dans Glas (le dégel)”
Charles Ramond
HAL Id: halshs-00923405
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00923405
Submitted on 2 Jan 2014 . p2
(13) Ibid. p 5
*مارتيال جيرولت (1891-1964) في باريس، هو فيلسوف فرنسي ومؤرخ للفلسفة، معروف باهتمامه واشتغاله غلى أعمال الفيلسوف الهلندي قديس الفلسفة باروخ سبينوزا.
(14) ينظر إلى مقدمة المترجم، غاياتري سبيفاك، هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ ترجمة خالد حافظي. الطبعة الأولى2020
(15) هومي ك . بهابها (موقع الثقافة) ترجمة ثائر ديب، الناشر المجلس الأعلى للثقافة، ط 1، 2004، القاهرة، ص19
(16) المرجع نفسه، ص 20
(17) الكتابة والاختلاف، مرجع سابق ذكره، ص 10
(18) الكتابة والاختلاف، مرجع سابق ذكرهن ص 7
(19) فقه الفلسفة1، مرجع سابق ذكره، ص 42- 43
(20) محمد الحيرش (أخلاقيات التأويل) من أنطولوجيا النص إلى انطولوجيا الفهم، ط 2، الفاصلة للنشر، طنجة 2019 ص 78
(21) عبد الكبير ألخطيبي الموسوعة المغرب الجزيرة، 3/3/2015
(22) جاك دريدا (أحادية الآخر اللغوية) ترجمة عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الإختلاف، ط 1، 2008 بيروت ص 9- 10
(23) المرجع نفسه، ص 34
(24) المرجع نفسه، 37
(25) عبد الكبير ألخطيبي(الاسم العربي الجريح) ترجمة محمد بنيس. منشورات الجمل، ط1، 2009، ص 156
(26) المرجع نفسه،ص 7
(27) المرجع نفسه، ص 15-16
(28) دراسات (التفكيكية وقراءة الأدب العربي القديم، عبد الفتاح كيليطونموذجا) سامي محمد عبابنة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 42، ملحق 1، 2015، ص 1077
(29) البنكي أحمد محمد (دريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي) ط 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2005، ص 15
(30) سرو محمد (المعرفة العلمية، مقاربات وإشكالات). باب الحكمة، ط 1، ص 256
المراجع والمصادر
المصادر الورقية:
1ـ التفكيك والأدب، كلارك تيموثي، سلسلة دروس التفكيك. ترجمة حسام نايل، الناشر مؤسسة هنداوي، 2017 ـ
2 ـ الكتابة والاختلاف، جاك دريدا، ترجمة كأضم جهاد، تقديم محمد علال سيناصر، سلسلة المعرفة الفلسفية، ط2، دار توبقال الدار البيضاء، 2000
3 ـ سيكولوجية العلاقات بين الجماعات، أحمد زايد، عالم المعرفة، العدد 326، 2006، الفصل السادس (الأفكار النمطية).
4 ـ هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ غاياتري سبيفاك، ترجمة خالد حافظي. الطبعة الأولى2020
5 ـ موقع الثقافة هومي . ك . بهابها ترجمة ثائر ديب، الناشر المجلس الأعلى للثقافة، ط 1، 2004، القاهرة
6 ـ فقه الفلسفة 1(الفلسفة والترجمة) طه عبد الرحمن. المركز الثقافي العربي، ط1، 1995، الدار البيضاء
7 ـ (أخلاقيات التأو يل) من انطولوجيا النص إلى انطولوجيا الفهم محمد الحيرش، ط 2، الفاصلة للنشر، طنجة 2019
8 ـ دروب ما بعد الحداثة، بدر الدين مصطفى هنداوي للنشر، 2017
9 ـ أحادية الآخر اللغوية جاك دريدا ترجمة عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط 1، 2008 بيروت
10 ـ (المعرفة العلمية، مقاربات وإشكالات). سرو محمد، باب الحكمة، ط 1
11 ـ (دريدا عربيا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي) البنكي أحمد محمد، ط 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2005
المراجع إلكترونية:
12 ـ إستراتيجية التفكيك عند جاك دريدا الهدم والبناء، عمر التاور، جريدة التبين، العدد 29
13 ـ عبد الكبير ألخطيبي، موقع الجزيرة الموسوعة المغرب، 3/3/2015
14 ـ دراسات (التفكيكية وقراءة الأدب العربي القديم، عبد الفتاح كيليطو نموذجا) سامي محمد عبابنة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 42، ملحق 1، 2015،
المراجع الأجنبية:
15 – ”Derrida -Hegel dans Glas (le dégel)”
Charles Ramond
HAL Id: halshs-00923405
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00923405
Submitted on 2 Jan 2014