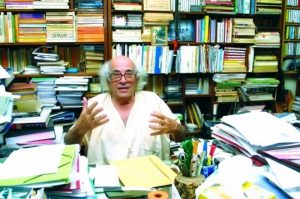مرزوق الحلبي
يظهر لنا الشعرُ (القصيدة) بأشكال عديدة ويُطالعنا مُختلفا قليلا أو كثيرا ويظلّ شعرًا. فنظرة سريعة على الشُعراء الذين تحظى شاعريتهم بإجماع واسع أو أقلّ سعةً، سيدلّنا على وجود أنواع شعرية وأساليب شعرية وخاصيات شعرية في القصيدة. لكلّ من محمود درويش ونزار قبّاني ومحمد بنيس وأنسي الحاج وسركون بولس ونزيه خير وغادة السمّان وغسان زقْطان وشوقي بزيغ وقاسم حداد ولانا راتب وعلي قادري وعبد المُعطي حِجازي وآلاء فودة وممدوح عدوان وأمل دُنقل والسياب وعبد الوهاب البياتي وفاطمة ناعوت وبيان حامد ـ والقائمة أطول بكثير ـ لكل واحد وواحدة، أسلوبه وطريقته في الشعر والقصيدة لكن ما مِن أحد يستطيع أن يُنكر عليهم شاعريتهم، هذا أكثر، وهذا أقلّ قليلًا. القاسم المُشترك بينهم هو الشاعرية الطالعة من النصوص. والأمر ذاته يُقال عن شعراء الماضي الوسيط والبعيد. لأصحاب المعلّقات وسِواهم ممن تمّ تدوين نصوصهم شاعرية وللمتنبي شاعريته وبروزه وكذلك لأبي العلاء أو أبي النوّاس. وهكذا حتى آخر القائمة. وهناك الشعر الغنائي والشعر الصوفي المتأمّل وشعر الحِكم والشعر السردي والشعر المكثّف الخاطف والشعر الملحميّ والشعر الذاتي الحالم ـ وهكذا حتى آخر الموضوعات. كما أن هناك “أشكال” متعددة للشعر، داخل عروضه وفي عباب بحوره، على الشواطئ وفي رؤوس الجبال وفي الصحاري والواحات وضمن إيقاع وخارجه، في المُرسلِ المنثورِ الحُرّ. بل إن التطور التاريخي للشعر جاء من العروضِ المُحكمِ نحو العروض الشفيفِ الخفيف إلى المُرسلِ المنثورِ تماما. لأن ثقافة العربي ـ كثقافات أخرى ـ ذهبت من المسموعِ إلى المقروءِ، ومن الموقّع المُجلجلِ، إلى المنصوص المكتوب الذي يُمكِنْ مطالعتَه. وهذا الانتقال خفّف من مركزية الإيقاع الشعري لصالح اللغة الشعريةِ، ومنَ العروضِ الكاملِ إلى التفعيلةِ التي تمّ استثمارها استثمارا مُبدعًا وخلّاقا، ومن التفعيلة إلى الشعر المنثور.
هذا لا يعني إسدال الستارة على العروضِ أو الشعرِ الموقّع لأن أذن العربي ـ كغيره من خلق الله ـ ظلّت هناك ناهيك عن ارتباط الشعر في الذهنيّة العربية بالإيقاع وبالشاعر الذي يُلقي قصائده على الجمهور وفي المناسبات والمنابر. ومع هذا نفترض أن العودة الراهنة إلى العروض لا تأتي من زاوية إحيائه أو استثماره بقدر ما هو العزوف عن جوهر الشعر إلى إطاره الشكليّ ومن شروطه الضرورية إلى شروطه غير الضرورية. ففي “الفوضى الشعرية” التي نشأت عن التجريب وعن ترسيخ الثقافة المكتوبة (على حساب المسموعة)، وولادة تيارات مُنفتحة على التيارات الشعريّة والأنواع الكتابية في ثقافات أخرى لا سيّما الغربية الأكثر تأثيرا على ثقافة العرب ـ نشأت رغبة في العودة إلى “ذروة شعرية” مُتخيّلة متجسّدة في العروض ولزوميّاته. وممّا عمّق هذا الاتجاه هو خضوع الثقافة العربية لتأثيرات ما بعد الحداثة التي تقول بانتفاء وجود “حقيقة شعريّة واحدة” و”نموذج شعريّ واحد”. وهي حركة، أفضت، في حقل الإبداع الكتابي إلى تضعضع اليقينيّات والثوابت الشعريّة التي سادت ردحًا غير قصير من الزمن. وهو ما بدا أن تيّارات النقد العربيّة لم تستطع الإحاطة به وتبويبه والإمساك بفوضاه وفهمه. في هذا المنعطف أثّرت التيارات الصاعدة ـ من فلسفات وعقائد وأفكار في الثقافة العربيّة والغربيّة بمفهومها الواسع لا سيما تلك الداعيّة إلى استلهام التُراث وما فيه من موروث ـ على حقول الإبداع لا سيما الشعر. وظهرت أوساط تشدّ به نحو العروض المتشدّد بدعوى إنقاذ الشعر أو تخليصه ممّا التصق به من تشويهات وتخريب. وهي تتزامن مع الدعوات الصريحة والمبطّنة إلى العودة للإسلام الطاهر النقيّ، أو إلى نظام كان فيه العرب “أعلى” من غيرهم إبان “الفتوحات” العظيمة وعصر التنوير العربي في بغداد والكوفة. وهنا شهدنا حركة نكوص عروضيّة تدّعي إجحافا ومُجافاة للحقيقة أن لا شعرَ خارج العروض، وأن مَن لا يُجيد العروضَ ولا يُتقنه ليس بشاعرٍ أبدًا ـ ما من نقاش أخوضه أنا أو غيري حول هذه المسألة إلا وطالعنا “الأذكياء” من عارفي أسرار العروضِ بهذا الادّعاء المُستعلي! هذا، علمًا بأن غالبية الشعراء المُبدعين العرب في العقودِ الأخيرة لم يكتبوا شعرًا عَروضيًّا بمعناه الكلاسيكي بل أن الألمعيين بينهم، إما أنهم اكتفوا بالتفعيلة الحرّة، أو أنهم كتبوا شعرًا منثورًا أو مُرسلا.
لا نُغالي إن قُلنا إننا أمام مشهد ظهرت فيه “سلفيّة شعرية” تكتفي بإجادتها فنّ العروض للفوز بتاج الشعر. وهي تدقّ بأرجلِها إيقاعًا أشبهَ بإيقاعِ رجليّ وأنا في السجن حيث كنتُ أُجْبرُ على المشي مكاني لمُدَدٍ طويلة مع إحداث إيقاع بحذاء ثقيل يُعيق هربي في حال سوّلت لي نفسي. إنه الإيقاع الخاوي تماما. لُعبَة توهِم صاحبها أنه بلَغَ ذروة الشعر بينما هو في القاعِ لا يعرف من الشعر سوى مُفردات يصفّها في الطوابير ويسيّرها كأنها ألوية صلاح الدين نحو فتح شعري لم يسبقه إليه أحد! ومن هنا ادِّعائي أن غالبية ما يُكتب في هذا الباب هو شعر عاقر ليس بسبب العروض أو بحوره بل بسبب الاعتقاد المُشار إليه ـ من إن العروض شرط الشعر الضروريّ. ما أن تنتظم مفردات ويستوي الإيقاع حتى يولدُ الشعر! وهذا الاعتقاد بالتحديد يُفضي إلى العزوف عن شروط الشعر الأخرى ومكوّناته الضروريّة كما سنبيّن لاحقًا. ولو فرضنا توفّر الشعر الخالص ضمن الحالة العروضيّة، فهل هذا ينفي وجوده في حالة الكلام المُرسل أو المنثور؟ وهذا ما يقودني إلى الاستنتاج العياني ـ بناء على متابعة المشهد الشعريّ في راهنه وفي إرثه التاريخي ـ باللغة العربية والإنجليزية على الأقل ـ هناك تعدّدية شعرية أو “حقائق شعرية” متعدّدة لا “حقيقة شعرية” واحدة! وهو ما يرفض قبوله أباطرة العَروض الذين اكتفوا بدراسة الأوزان وعرفوا العوم في البحور. كأن المعرفة العينيّة هذه تصنع الشاعر وليس الشاعر هو الذي قد يستثمر هذه المعرفة أو لا يستثمرها، يلجأ إليها أو لا يلجأ البتّة في قصيدته أو تجسيد شاعريّته وموهبته الإداعيّة. وتعدد “الحقيقة الشعرية” هنا هو نقيض تام للسلفيّة الشعريّة كما يعبّر عنها النكوص العَروضي أو اعتبار العروض ذروة الشعر التي ينبغي أن تُستعاد كي يستوي الكون وينتفي الخلل العام في الشعر وتنتهي فوضاه فيسير إلى يقين وطمأنينة! وهُم بهذه الفرضية إنما يشطبون عقودا من الشعر العربي الحرّ المرسل والمنثور ومُبدِعاته ومُبدِعيه.
من معضلات تعريف الشعر!
هُناك مَن يُضيف إلى صعوبة تعريف الشعر حينما ينتقل في تعريف الشعر من المُبدع إلى المُتلقي. فيقول قائل مثلا (وهو هنا متلقٍّ): الشعر هو الكلام الذي يهزّني أو يحرّك مشاعري أو يُدهشني. أو هو ذاك النص الذي إذا قرأته هتفتُ على الفور “هذا شعر”! فالشعر وفق هذه الأطروحة ليس الذي يقول عنه كاتبه أنه شعر بل الذي يعرّفه القارئ المتلقّي على أنه كذلك. الشعر، هنا، يُعرّف من خارجه، من الذي يتلقّاه لا من الذي يكتبه ولا من الوسيط ـ الناقد أو الناشر. لكن في حال كتب الشاعر لنفسه ولم يتخيّل جمهورا ينتظره على الضفّة الثانية ـ فلن يكون معنيًّا أبدا بوجهة نظر المتلقّي لأنه غير قائم بالنسبة له. الشعر بوصفه إنتاجًا إبداعيًّا قد يقوم بحضور الشاعر وحده أو بتصديق من الناقد إذا وُجد، وقد يكتمل حضوره بتلمّس الحاجة إلى متلقٍ. ولنفترض أن الشاعر يكتب لجمهور ولناقد مُفترضيْن، فالسؤال هو ما هي الذائقة الفنيّة ومستوى الثقافة الشعريّة لهذين الشريكيْن؟ هل هي متطوّرة مُتابعة للحركة الشعريّة الخاضعة للتحديث الدائم؟ ما هو مستواها الثقافيّ الدراسيّ خاصة عند النُقاد، وما هي أدوات قياس الشعر من عدمِه؟ ما هي العُدّة النقديّة أو أدوات الحُكم على النص الشعري عند الناقد أو المتلقي؟ هل ذائقة المتلقي/الناقد منفتحة على التجريب والجديد، مستعدة بنيويًا أو عقائديًا لقبول المختلف شعريًّا والمغاير والمتحدّي، أم أنها مفطومة على الشعر الكلاسيكي العامودي ولا ترى في غيره شعرًا أو ما يُقارب؟ هل هي مأخوذة بالإيقاع كليًّا أم بالمُفردة ودلالاتها، مشغولة بكليّتها على المشاعر وشحنات العاطفة والتماثل العاطفي والتهييج ومخاطبة الغرائز المكشوفة والدفينة والعصبيات الهُويتيّة، أم أنها تتحرّك، أيضًا، ضمن منطق العقل المفكّر السائل، والباحث عن الجميل وعن الفكرة المُشرقة؟ ما هو “الجميل” و”المُدهش” في الحُكم عند المتلقي وما هو “الفنيّ”؟
نسأل هذه الأسئلة ليس طمعا في المتلقّي المثالي بل للإشارة إلى أن المتلقّي ليس واحدًا ولا الناقد، أيضًا. فهناك متلقّون عديدون ونُقّاد عديدون متفاوتون في ذائقتهم وثقافتهم الشعريّة وأحكامهم. وهو ما يؤكّد ما ذهبنا إليه لجِهة التعدديّة في الشعر وتعريفاته. فمنهم مَن هم أكثر انفتاحا على “حقائق شعرية” وتعدد القصائد أو أكثر انغلاقا على “حقيقة شعرية واحدة” و”قصيدة واحدة” تفترض وجود نموذج مثاليّ واحد، ونوع واحد ونص واحد لا شعر بعده! ونعرف أن الواقع يشهد نماذج مختلفة للنقّاد والمتلقّين، متفاوتين في وجهات النظر. وما يسري في الفن الشعري يسري في الفنون الإبداعيّة الأخرى بالنسبة للمتلقّي ومستوى ذائقته. فإذ سلّمنا بأن تعريف الشعر ليس محصورًا في المُبدع وشلّته بل هو من حقّ المُتلقّي والناقد ـ فسيكون الشاعر الشاعر معنيًّا أكثر بناقد ومُتلقٍ يتمتعان بذائقة راقية وبثقافة أدبيّة فنية أرفع. والعكس صحيح ـ فإن الأقلّ شاعريّة أو العديم الشاعريّة سيُراهن أكثر على الأقرباء والمعارف والـ”لاياكات” من أفراد شلّته. وسيعتبر ذلك استفتاء شرعيًّا في تتويجه ملكًا لناحية شعريّة أو قضاء أو إقيلم شعريّ يزكّيه بصفة “دولة شعرية” كاملة أو بصفة مراقب في هيئات الأمم الشعرية!
محورية الموضوع الشِعري!
الموضوع في القصيدة هو من أهمّ ما يوصل بين الشاعر والمتلقّي أو بين الشعر وقارئه. بل يُشكّل محورًا أساسيًّا في تعريف المتلقِّي للشعر. خاصة إذا كان الموضوع الشعريّ قضيّة عامّة تتصل بحالة نضاليّة مثلا، أو كأن تتحدّث القصيدة باسم جماعة أو تُصيب عصبًا هُويتيًّا وتَتَقمّصه. أو كأن تعبّر القصيدة عن قضيّة عادلة وعن حقّ. أو أن تحكي القصيدة عن مكان أو مجموعة لها صلة بالمتلقّي (بلده مثلا) أو أن تعبّر عن موقف يعتمده أو عقيدة يعيش مُتيّمًا في هواها. هذه حالات يتماهى فيها المتلقي مع القصيدة ويتمّ تفضيلها بسبب موضوعها لا بسبب فنّيتها أو بصرف النظر عن فنّيتها. من هنا تصير الطريق أقصر إلى اعتبارها شعرًا خالصًا حتّى لو لم تكن. هذه الحالة تدلّنا على إشكاليّة الاعتماد على القارئ في الحُكم على النصّ الشعريّ. فإذا أضفنا هذه الواقعة ـ العلاقة بين المتلقي والموضوع الشعريّ ـ إلى نزعات وأهواء غير معياريّة ولا هي أدبيّة فنية لدى المتلقّي لوصلنا إلى استنتاج أن تعريف الشعر بأيدي المتلقي وحده مسألة إشكاليّة. وأن الحُكم على الشعر من خارجه قد يكون أكثر اقترابا من “حقيقة الشعر” في حال كان الحُكم لنقّاد من المركز الأكاديمي المُتخصّص المحتكم لمعايير الكتابة الإبداعية الذين يرون إلى الإبداع الشعري بكُلّيته ومكوّناته كافّة ـ أو هكذا يُفترَض. فالنصّ في نهاية الأمر ليس موضوعه، رغم أهمّيّة الموضوع، بل هو معنى وأسلوب ومفردات وتراكيب لُغوية وتقنيّات كتابية ودلالات أبعد أو أقرب ورموز وإشارات و”لغة” تشي بالإبداع، تُحيلنا من النص إلى سواه، ومن الراهن إلى التاريخ، ومن الأدب إلى غيره.
إذا سألنا “ما الذي يجعل نصًّا ما شعريا في نظرك؟” سنتلقّى العديد من الإجابات ومنها، إن الفكرة الألمعية في متن النص، أو الحالة التي يصفها النصّ الشعريّ أو لُغته السلسة أو تصوف النصّ وكثافة دلالاته، ذاك الإيحاء الذي يترك للقارئ أن يتأمّل ويحاور النصّ، معرفة كاتب النصّ شخصيًّا، مدى عثور المتلقّي على نفسه بأفكاره ومشاعره في النصّ أو مدى عثوره على الساحر والمُدهش ـ كلّها عوامل تدخل في تشكيل العلاقة بين المتلقّي وبين النصّ الشعري، وتُسهم في رفع شأن النصّ وتصنيفه في خانة الشعر. من هنا يحصل أن “الغُربة” بين النص وبين المتلقّي قد يؤثّر باتجاه عكسيّ لجهة نزع شعريّة النصّ عنه وإخراجه من التداول باعتباره أنه غير قريب من القلب أو من ذائقة المتلقّي. طبعا، إن هذه الحالة واقعيّة تمامًا وتحصل كل يوم ونسمعها في ادعاءات البعض من أن النص غامض تمامًا ومنغلق وبالتالي لا قيمة شعريّة له. أو أنني أحببت النص من أول قراءة ونشأت بيننا هرمونيا كاملة. أو إن النص قريب من القلب أو إن النص غريب عن القلب!
أزمة نصوص أم أزمة تلقّي؟
وهنا، تُطالعنا مُعضلة أخرى، تتصل بالغموض واستعصاء النصوص على مُتلقّيها ـ ادّعاء حاضر في كلّ حديث عن أدونيس وشعره، مثلا ـ والسؤال الذي يأتي منها وهو هل هي أزمة النصّ أم أزمة المُتلقِّي. والإجابة على هذا السؤال صحيحة مرّتيْن تِبعًا للحالة. فقد تكون الأزمة أزمة النص الغامض تمامًا غير المفهوم أو المفكّك حدّ الضياع أو الذي لا معنى له مهما قلّبته أو داريته أو الخشبيّ في طَقْطَقَاته أو ركاكتهِ البيّنة. عندها، لا بدّ من الإقرار بأن الأزمة فيه. أمّا عندما يكون النصّ فلسفيًّا أو فكريًّا أو وجوديًّا لكنه فنيّ بامتياز بينما المتلقّي كسول لا يعرف الشاعر ولا يُريد أن يبحث أو يجتهد كي يعرفه ويفكّ شيفرة نصوصه، فإن الأزمة حينها أزمة مُتلقٍّ. وهي أزمة قد تكون نابعة من فارق الثقافة والمعرفة عمومًا والأدبيّة الشعريّة خصوصًا بين مُبدع وبين متلقٍّ. وقد تنبع من كسل المتلقّي نفسه وإحجامه عن الدراسة والبحث لفكّ أسرار النصّ وكاتبه. ناتج عن القراءة بدون عدّة قراءة. هذا صحيح بوجه خاص إذا تعاطينا مع الإبداع الشعريّ (والأدبي عموما) على أنه فعل جاد يستدعي الاجتهاد والدراسة وليس مُنتجًا استهلاكيا أو وجبة سريعة ينبغي أن تكون “شهيّة” وغير مُكلفة. أقول هذا وفي الخلفيّة حالات تذمّر لقرّاء من نصّ لم ينفتح لهم من أوّل قراءة بل من الثالثة أو الرابعة، أو من قصيدة تستدعي جهدًا معرفيًّا غير عاديّ بالشاعر وبيئته وتجربته وظروف حياته وقضيّته وما إلى ذلك. وأنا على اعتقاد راسخ بأن النصوص الشعريّة أنواع عديدة منها ما هو سهل الإدراك والتعقّل وواضح الجماليّة، يُحبّ من أوّل نظرة، ومنها ما يستدعي الدراسة والتأمّل والتعمّق ومعرفة سابقة بشيء ما من التاريخ أو الأديان أو الفلسفة أو أسرار الفنون الإبداعيّة الكتابية. وكثير من النصوص تحضر بين هذا وذاك ملآى بالشعر من هذا الباب أو ذاك. ومن هنا فإن يُسر النصّ أو استعصاءه ليس من مقاييس الشعر أو عدمه. هناك شعرٌ في نصوص بسيطة متيسّرة للقارئ العاديّ وهناك شعر في نصوص مركّبة وأكثر تعقيدًا.
لا ينفصل التنظير للشعر وفيه، عن التنظير الفلسفيّ في الحقول الأخرى. ولا تقفز التيّارات الفكريّة التي تشهدها الثقافة العربيّة عامة عن الحقل الأدبيّ والإبداعي عمومًا كالفنون التشكيليّة والمسرحيّة والموسيقى وما إلى ذلك. فهو ساحة من ساحات عمل هذه التنظيرات والأفكار. فعندما ازدهر التحليل النفسيّ عموما في الثقافة العالميّة دخل هذا التحليل عالم الأدب بقوة واستخدمته المدارس النقديّة في قراءة الأدب والنصوص. وعندما جاءت الماركسية بقوّة بديلًا للفلسفات المثاليّة انبثقت عنها تنظيرات كثيرة في الأدب لجهة تأكيد جمالية المذاهب الواقعيّة. وعندما برزت مدرسة ما بعد الاستعمار والتفكيك، انتشرت التنظيرات بهذه الروح. وهكذا، عندما انتشرت المدارس الألسنيّة المشتغلة باللغات والدلالات، استخدمتها المدارس النقديّة المُشتغلة بالأدب وتنظيراته. ومن ثمّ حصل ما حصل بعد تهافت الحداثة ونشوء تنظيرات ما بعدها وانزلاق المشهد الفلسفي إلى خانة “المعلومات الملفّقة” و”الحقائق المُختَلَقَة” وهم كا سمّي بـ “ما بعد الحقيقة”. وهي حقبة ضاعت فيها كلّ المعاني وتسطّحت تماما وفي الحقل الشعريّ والأدبيّ عمومًا، أيضا. وقد تعمّقت هذه الأجواء مع طغيان قوى السوق ونشوة الرأسمالية التي تسطّح الكون وكل ما فيه وتحوّل كل شيء “سلعة” تسوّق أو لا تسوّق”. فكلّ ما يُكتب اليوم يُمكن تسويقه على أنه “أدب” أو “فنّ” حتى لو كان في حقيقته تافهًا ومبتذلًا وبذيئًا إلى آخر القائمة. وهكذا، كلّ مَن يكتب نصّا، شاعر هو أو أديب. بل زاد عدد الأدباء والشعراء “المُصطنعين” بقوة التسويق عن أولئك الأصيلين أو زاد عدد مُنتَحِلي الأدب والشعر عن عدد “الشعراء” و”الأدباء” الحقيقيين. وهم ما يحصل في حالات الندرة من الشيء. فالحليّ التي هي “تقليد للذهب” أكثر بكثير من الحليّ الذهبيّة فعلًا. وحالات توهّم الحبّ أكثر من حالات الحبّ الحقيقيّة!
إن السيولة النقدية/المالية في مرحلة ما، بحسب ماركس، يُمكنها أن تسطّح القيمة وتُسوّيها. فإذا كانت الشهادة تُشترى مثلا واللقب الأكاديمي، أيضا، فلِماذا لا يُشترى لقب الأديب والشاعر؟ ولماذا لا تساوي عمليّة النشر بين كتاب يستحقّ وكتاب لا يساوي حبره أو غلافه؟ ولماذا لا تستضيف صالونات “الثقافة” بروفيسورَ فذّا أفنى عمره في الدراسة والبحث والتأليف يوم الجمعة، وتستضيف في اليوم الذي يليه كاتبة شبه أمّية! يحتفي بصدور بحث أدبي مُحكم في أوّل الأسبوع، ثم يتلوه باحتفاء أكبر بصدور مطبوعة مليئة بنصوص معلّبة أو بلاستيكية! وهذا مثال يومي لفُقدان القيمة ولعملية التسطيح التي تمّت في حقل الشعر والأدب كما حصل في سائر الحقول. وهو أكثر من غيره يستدعي تدخّلا ممن يهمّهم الأمر. وكما أسأل: على مَن تقع عليه حماية اللغة والأدب والشعر والإبداع من أولئك الذين يعبثون به أو يُسطّحون معناه؟ سؤال ملحّ في ضوء حصول حالات أن هؤلاء “الشعراء” و”الأدباء” يشترون لأنفسهم حضورًا في أمسية أو مهرجان أو تظاهرة ثقافيّة.
أحسنت الأكاديميات العربية صُنعًا خاصة في المغرب العربي عندما شاركت في الجهد الإنساني العام وانبرت تقرأ الأدب العربي بأدوات التنظيرات كلّها والفلسفات على مدارسها، وتتأثّر بما يحصل في ثقافات أخرى. أغنى هذا التلاقح تحديدا الثقافة العربية وفاعليها خاصة فيما يتّصل بالنقد الفني والإبداعي. ورغم انحصار هذه العلوم النقدية الجديدة والمتداخلة في طبقة أكاديمية متخصصة إلا أنني أفترض دخول قسمٍ من هذه العلوم وهذه التنظيرات إلى حلقات التداول عند المتلقّي العربي فوق المتوسط. وأفترض أيضا، أن هذا المتلقّي شرع يقرأ النص الشعري وغيره من خلال ما تأتّى له من أدوات ومعايير. وسأفترض في الوقت ذاته أن قسمًا من المتلقين العرب لا عِلم لهم بهذه التنظيرات أو هم غير معنيين بها، ومع هذا فهم يقرأون ويتابعون ويستمتعون ويحكمون على ما يقرأون. وفي الحُكم كما في الحُكم قد يُصيب ويُنصف وقد يُجحف ويظلم. ومن هنا أهمية مُصدر الحُكم على الشعر أو غيره. ربّما أقلّه إجحافا هو ما يصدر “الخبير” “الأكاديمي” المتخصّص في النقد وفي التواسط بين الأدب والجمهور. لكن هنا، أيضا، لن ننجو تماما من نزوة نقدية كهذه أو كتلك. فقد يُسقط الناقد القارئ نظرياته على النصّ المقروء عنوةً. وكنتُ شاهدا مرات عديدة على نُقّاد جعلوا من شاعرة مبتدئة آن ساكستون الأمريكية، وألبسوها كل أثواب الإبداع المُمكنة حتى تساءلتْ هي في ردِّها إذا كانت هي المقصودة في كلامهم! وفي أمسية احتفاء برواية شاب يافع، تحدث أحد النُقّاد كأننا أمام ظاهرة عبد الرحمن منيف جديدة. بمعنى، أن هذا الانحراف المعياري في النقد قد يحصل ويحصل فعلًا لدى الناقد المتخصّص، أيضا، لأسباب لا حصر لها. وهذا ما يُحيلنا إلى نقاشات في طبقات أعمق حول دور المركز الأكاديمي ومقاصده وغاياته في إنتاج المعرفة ونوعيتها، أو طبيعة العلاقة التي تربط صاحب النص بالناقد.
الشِعر بالشِعر يُحكى!
إذن، لا مفرّ من المتاهة حينما نتحدث عن الشعر ونقده وتعريفه، أو محاولة الإحاطة به والإمساك بـ”حقيقته”. أو بكلام أدقّ لا مفرّ من الإقرار بصعوبة التوافق على تعريف واحد له. وهي الصعوبة التي تنسحب لدى حديثنا عن هوية الذي يحقّ له أن يُعرّف. وتنسحب، أيضا، على حديثنا عن جدارة الناقد وكفاءاته النقديّة باعتباره وسيطا بين الشاعر والجمهور. وفي حمأة السجالات التاريخيّة والراهنة يُمكننا أن نتّفق على بعض نقاط ارتكاز. أولها ـ إن الشعرَ الشعرَ عاش ويعيش في العروض، وعاش ويعيش خارجه حُرًّا مُرسلًا ومنثورا. ثانيها ـ إجادة عِلم العروضِ والعومُ في بحوره لا يؤهّل أحدًا أن يكونَ شاعرا، وبالتأكيد لا يطوّبه شاعرًا. قد يكون العروض شرطا لحضور الشعر لكنه ليس الشرط الضروري. ثالثهاـ هناك أشكال شعرية عديدة وقصيدة متعددة في بنيتها وإيقاعها ولُغتها. وهناك أساليب شعرية متباينة وشعراء مختلفون عن بعضهم في كل شيء إلا في الشعر. رابعها ـ لا شعر بدون استعارة على أنواعها أو مجاز، ولا شعر بدون الصورة الجميلة والفكرة المُشرقة التي تولد من زفاف المفردات وجِماعها وعلاقات حميمة ساحرة التي يصيغها الشاعر. خامسها ـ الشاعرية هي إتقان المجاز والاستعارة والتشبيه الشفيف البسيط غير المتكلّف ولا الإنشائي البلاغي. لأن الاستعارة والمجاز والتشبيه في أشكالهما الدلالية أساس اللغة الشعرية (وهذه أهمّ ألف مرة من الموسيقى والإيقاع والعروض). سادسها ـ إذا أردتَ أن تختبر شاعرا فاقرأ نثره (نزار قبّاني مثلا ومحمود درويش وأدونيس) فالنثر دال على الشاعر. ويبدو في الأمر مفارقة إذ يعرّف الشاعر بنثره، لكن في كلّ مرة جرّبتُ هذا الامتحان تبيّنت مصداقيته كمعيار. سابعها وأخرها ـ لا يُمكن الكتابة عن الشعر إلا بلُغة الشعر. الأمر الذي يُبقى الباب مفتوحًا للإضافة ولأقوال أخرى فيه أو لدلالات غير بيّنة من القراءة الأولى للنصّ.
النقاط المذكورة تساعدنا في قراءة النص وتتبّع خطوات الشعر وحضوره أو غيابه. ففيها من الاتّساع ما يحتوي التعدّد الشعري الراهن وفيها من الدقّة (النقطتان الرابعة والخامسة) والجرأة في الحُكم على النصوص وعدم التردّد في نفي صفة الشعر عن نص وتثبيتها في نصّ آخر. وكثيرا ما ألجأ إليها في تحديد موقفي واختيار كلماتي في التعليق على نص أو كتاب. لا أتردد في وصف نصوصا طويلة على أنها مجرد سمك مسموم صفّته حركة الموج الخجول على رصيف الميناء. ولا أرتدع عن وصف بعض الشعراء كجنرالات يدارون المفردات كجنود في الطوابير العسكرية. ولا أتردّد في وصف نصوص ومجموعات كاملة على أنها كتابة خشبية لا نسغ فيها ولا روح ـ أي ليست شعرًا قطعا. ولا أخشى لومة لائم في اعتبار ما يكتبه هذا أو ذاك مجرّد إنشاءات بلاغيّة وكلام مبتذل مِن ألفه إلى يائه. إنها القاعدة التي أنطلق منها لفرز الشعر على مستوياته من اللا شعر وتسميته علنا.