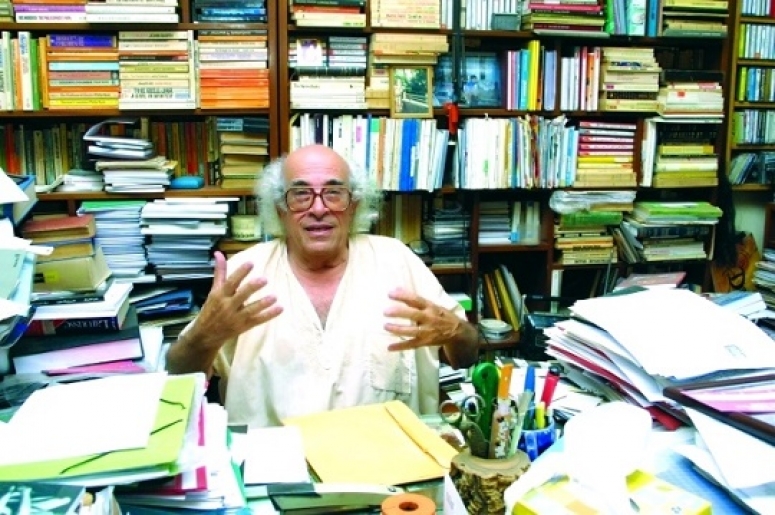أسامة كمال أبو زيد
لم يكن إدوار الخراط يوماً مجهولاً، لكنه ظلّ غريباً.
غريباً مثل من يمشى في درب يعرفه قلبه ولا يراه أحد.
منذ أن صدرت مجموعته الأولى «حيطان عالية» عام 1959، بدا وكأنه يكتب من وراء جدارٍ لا يسمع من ورائه أحد.
كان حاضراً بين المبدعين، مترجماً نجيباً، قارئاً شرهاً للغاتٍ كثيرة، وصاحب ذائقة لا تشبه أحداً، لكنه اختار الطريق الوعر: طريق التجريب المطلق، حيث الكلمة لا تستكين إلى شكل، ولا المعنى يذعن لِسُلطةٍ نقديةٍ أو أيديولوجيةٍ قائمة.
في ذلك الزمن، كانت الواقعية هي النشيد الرسمي للأدب.
الكتابة العالية الصوت التي تخاطب الجماهير وتلهب الشعارات.
كانت الكلمة تُطلَق مثل بيانٍ سياسي، وكان النقاد والسلطة الثقافية واليسار جميعاً على خط واحد، يحتفون بكل ما يرفع راية “الناس” ويصوغ الحكاية فى صورة مباشرة وواضحة.
هناك كان يوسف إدريس، وصلاح جاهين، وعبد الرحمن الشرقاوى، وجموعٌ من الأصوات التى استقرت فى الذائقة العامة، بينما ظلّ الخراط واقفاً فى ركنٍ قصيّ، يحمل نصوصه كمن يحمل لغزاً لا يُقال.
لم يكن الخراط مغموراً، لكنه كان مُهمَّشاً.
كان الذين يقرأونه يشعرون بالدهشة أكثر من الإعجاب، وبالغربة أكثر من الفهم.
كتب عنه فؤاد دوارة كلاماً يشبه الاعتذار أكثر مما يشبه النقد، كأنه يقول: “هذا الأدب جميل لكنه ليس من هنا”، ثم أغلق الباب.
لم يدركوا أن هذا الغريب الذى يكتب من سردابه اللغوى العميق، كان يحفر مجراه الخاصّ فى صخر الأدب العربى.
كانت “حيطان عالية” أول صرخة لذلك الحفر.
قصص لا تسير فى طريق الحكاية المألوفة، بل تفتح باباً على الداخل الإنسانى، على الحيرة والوحشة، على الجسد الذى يُعذَّب بالحبّ، والروح التى تبحث عن نجاتها فى اللغة.
قيل له يومها: غيّر النهاية، اجعل بطلك يركل حجراً فى الشارع علامةً على الثورة.
لكن إدوار الخراط لم يركل حجراً، بل ركل فكرة النهاية نفسها.
ترك بطله غارقاً فى صمته، لأن الصمت عنده كان أكثر ثورةً من الهتاف.
كانت القصة الواقعية – كما أحبها إدريس – تبحث عن الهدف، عن الغاية، عن النتيجة الملموسة،
أما الخراط فكان يبحث عن الشكل الذى لا يستقر، عن الموسيقى الخفية فى الحروف،
عن اللغة حين تتحول إلى جسدٍ ينبض من تلقاء نفسه.
كتب صفحات كاملة تبدأ بحرفٍ واحد وتنتهى به، يصوغ منها نغماً داخلياً لا يسمع إلا فى الصمت.
كان يؤمن أن التجريب هو الطريق الوحيد للصدق، وأن الجمال لا يُقاس بوضوحه بل بقدر ما يثيره من غموض.
ولأن زمانه لم يكن مستعداً لذلك الغموض، تأخّر مجده كثيراً.
ظلّ محجوباً خلف ستارٍ من سوء الفهم، حتى انفتح الباب فجأة فى السبعينيات مع جيلٍ جديدٍ من الكتّاب.
فى «غاليرى 68» بدأ الخراط يمارس حضوره النقدى والإبداعى معاً، يفتح الطريق لمن تجرأوا بعده: يحيى الطاهر عبدالله، محمد المخزنجى، وآخرين ممن وجدوا فى التجريب خلاصاً من بلادة الحكاية الواقعية.
هناك، بدأ النقد يلتفت إليه متأخراً، مثل من يسمع صدى أغنيةٍ قديمةٍ بعد أن خفتت الأصوات العالية.
لم يكن إدوار الخراط ضدّ أحد، ولا حتى ضدّ يوسف إدريس الذى اختلف معه فى الجوهر لا فى النوايا.
كان يرى أن القصة عند إدريس تنتهى بمعنى واضح، بينما الفن الحقيقى لا ينتهى بل يتوالد.
الغاية عنده موت الفن، والغموض هو حياته.
ربما لذلك ظلّ إدوار الخراط يعيش فى منطقةٍ لا ضوء فيها إلا ما يصدر من كلماته،
كأنه يكتب ليُنقذ نفسه من العالم الذى لا يفهمه،
حتى صار بعد رحيله أحد أعمدة الحداثة العربية، وواحداً من الذين تأخر اعتراف الزمن بهم، لا لأنهم جاءوا متأخرين، بل لأنهم جاؤوا مبكرين جداً.
لقد كان الخراط أشبه بنبوءةٍ وُلدت قبل وقتها.
لم يكن غريباً أنه كتب عن الجدران العالية، فقد عاش خلفها.
لكن الجدران التى حجبت صوته أول الأمر، هى نفسها التى ردّدت صدى صوته بعد أن رحل.
ولأن الكلمة الصادقة لا تموت، عاد الخراط متوجاً فى الذاكرة الأدبية،
يبتسم كمن يعرف أن الزمن – مهما تأخر – لا بد أن ينحاز فى النهاية إلى من كتبوا بدمهم، لا بحبر الواقعية.