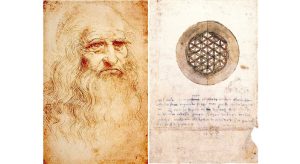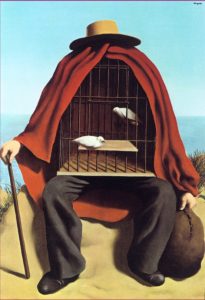د. إلياس زيدان
إطلالات تربويّة من شبابيك الوطن – 15
كلثوم عودة وفتحيّة العسّال – تمرُّد وانتصار
“طِلْعت بِنْت”!
“مصائبُ” مُشترَكةٌ حلّت بكلتا الأُسْرَتَيْن، أُسْرَة الطّفلة المولودة كلثوم عودة (1892-1965) وأُسْرَة أختها فتحيّة العسّال (1933-2014). نَعَمْ، هما أختان رغم فارق السِّنّ والدِّين ومكان الولادة، فكلثوم من مواليد النّاصرة الفلسطينيّة، وفتحيّة من مواليد القاهرة المصريّة. إذًا، ما المشترك في المصائب، وكيف تكون الأُخْتِيَّةُ بين البنتين؟ يبدو لي أنّ “مصائب” أُسرة عودة كانت أشدّ هولًا من “مصائب” أُسرة العسّال. كانت كلثوم الخامسة بعد أربعٍ، وكانت فتحيّة الرّابعة بعد اثنتين وواحدٍ. وصيغةُ التّأنيث أو التّذكير مصيريّةٌ، فهي المِعيار الأساس الّذي اعتَمَدَتْه كلتا الأُسرَتَيْن في الحُكم على الموقف بعد ولادة طفلٍ/ةٍ في فلسطين وفي مصر. “مصيبةٌ” في النّاصرة و”مصيبةٌ” في القاهرة. أتَتْ هاتان البنتان إلى العالم من دون دعوةٍ من أحدٍ. فالأهل أرادوا صبيًّا هنا وصبيًّا هناك. تكتب كلثوم في هذا السّياق: “لقد استقبل ظهوري في هذا العالم بالدموع وكل يعلم كيف تستقبل ولادة البنت عندنا نحن العرب وخصوصًا اذا كانت هذه التعسة خامسة اخواتها وفي عائلة لم يرزقها الله صبيًا”.[1] أمّا فتحيّة فتكتب أنّه بعد ولادة أُخْتَيْها وأخيها حسني أراد والداها صبيًّا آخر: “[…] بعد ولادة حسني بتلات سنين أنا خيبت ظنهم وشرفتهم وفرضت نفسي عليهم وجيت.. والمصيبة إني طلعت بنت.. وهما خلاص مش عايزين بنات.. ولا إيه”.[2] “نحن العرب” كان المقام المشترك البسيط أو الخطير بين الأُسْرَتَيْن، الأولى أُسرةٌ عربيّةٌ مسيحيّةٌ، والثّانية أُسرةٌ عربيّةٌ مسلمةٌ. فتحيّة وكلثوم أختان في “نحن العرب”، وهذا كافٍ للحكم من طرف الأُسْرَتَيْن.
لم تقفْ “وقاحة” الأختين، كلثوم وفتحيّة، عند حدّ قدومهما إلى هذا العالم من دون دعوةٍ من أحدٍ. فما زاد الطّين بلَّةً أنّهما كانتا “قبيحتين” من وجهة نظر أُسْرَتَيْهما والمحيط. “المصيبة” مضاعفةٌ في النّاصرة وفي القاهرة. تقول كلثوم: “وزاد في كراهة والدتي لي زعمها أني قبيحة الصورة”.[3] وتكتب فتحيّة أنّه لم يَكْفِ أنّها وُلِدَت بنتًا، فهي “كمان سمرا. واخواتي كلهم بيض. لدرجة إني زمان كنت أسمع الناس تقول لماما. ولادك كلهم بيض اشمعنى فتحية جبتها سمرا. تقول لهم وكأنها تعتذر.. هيه سمرا آه. بس مسمسمة ودمها خفيف”.[4]
في الأُسْرَتَيْن كانت الرّسائل واضحةً بدونيّة الفتاة، وخاصّةً “القبيحة”، وكانت أساليب التّعنيف متشابهةً في بعضها ومختلفةً في بعضها الآخر. كلثوم شعرت بكُره أهلها لها، وهي تكتب: “وهذه الكراهة رافقتني منذ صغري فلم اذكر ان والديّ عطفا يومًا عليّ”.[5] لا بل بلغ الأمر أكثر من ذلك، فقد كانت أمّها تُسْمِعُها طيلة الوقت: “مين ياخدك يا سوده. بتبقي كل عمرك عند امرأة اخوك خدامة”.[6]
أمّا فتحيّة فقد عانت الأمرّين، فتكتب: “[…] حسيت إني فعلا جيت زيادة عدد ما حدش كان دريان بيه. كنت دايمًا أحس إني على هامش الأسرة. مما يدل على كده. إنهم عمرهم ما اشتروا لي فستان جديد غير في العيد”.[7]
في عيد ميلادها العاشر، وبدل أن تحصل على هديّة من والديها، كان يوم “الدّبح”. تروي فتحيّة بمرارة: “كنت صغيرة والدنيا لسه قدامي منورة. في يوم صحيت من أحلاها نومة لقيتهم أخدوني وكتفوني، وانا باصَّة لهم وجوايا رعب الدبيحة وهي متكتفة، والغجرية بتسن سكينها وانا بصرخ. لا. لا. وفضلت أصرخ.. وأصرخ.. لكن السكين كان أعلى من صرختي، قرب من بين فخادي، ودبحني.. قطع لحمي، وسيَّح دمي.. وانا اتقسمت اتنين.. بقيت نصين. نص بيشلب دم.. والتاني على حد السكين”.[8] كانت الوالدة صاحبة القرار في هذا الموضوع. اتّخذته رغم معارضة الوالد الشّديدة. كان هذا اليوم كما تجاهر فتحيّة: “أصعب يوم في عمري […]”.[9]
لم تنته معاناة هذه الطّفلة عند هذا الحدّ، فقد توجّه مدرِّس أخواتها “شكيب أفندي” كما يروي والدها: “بيطلب القرب مني في فتحية”[10] وهي لم تبلغ إحدى عشرة سنةً بعد. وكان على الأب معاقبة صغيرته بسبب خطوة الأستاذ شكيب! في هذا اليوم اتَّخذ والدها قرارًا بأنْ تَتْرُك ابنته المدرسة. لم تُجْدِ استعطافات والدتها وأختها نجيبة له. نجيبة الّتي أخرجها والدها من المدرسة وزَوَّجها وهي في سنّ الثّالثة عشرة، وقد تطلّقت وهي في سنّ السّادسة عشرة. أصدر الوالد أوامره إلى زوجته بخصوص فتحيّة قائلًا: “من بكره يا زينب تحضَّري بنتك للجواز، علميها إزاي تبقى ست بيت. لأني هاتفق مع شكيب أفندي بعد سنتين نعمل خطوبة”.[11] كانت فتحيّة في تلك اللحظات في غرفتها تختلس السّمع إلى حديث والديها، وهي تشهد على نفسها أنّها: “لساني طويل وحجتي جاهزة.. وأي أوامر تصدر لي كنت أسأل ليه.. وعشان إيه؟”.[12] لم تعجب هذه الصفات والدها “اللي دايمًا يقول عليَّة، مصيبة وجاتني”.[13] وتقول إنّها بعد سماعها ما أمر الوالد أمّها به: “(وبكل قوتي دفعت باب الأوضة وفتحته ودخلت أصرخ في وش بابا) – أنا لا حاتجوز، ولا حاسيب المدرسة، أنا لسه صغيرة”.[14] وكيف تعامل الأب مع هذا الوقف؟ تروي فتحيّة: “(فجأة لقيت قلمين نازلين على وشي سودوا الدنيا قدامي)”.[15] وعندها وجّه الأب كلامه إلى أختها نجيبة وإلى والدتها اللتين حاولتا تغيير رأيه، لكنّ محاولتهما باءت بالفشل، وقال: “شايفة يا نجيبة.. عاجبك يا ست زينب. بنتك اللي عايزاها تخرج وتروح المدرسة، عشان لسانها يطول أكتر من كده. البنت دي مالهاش غير الحبسة في البيت، لحد ما تتجوز”.[16] ولكي يكون جهاز المراقبة على حبيسة “قفص الحريم”[17]، كما أسمته فتحيّة، أكثر نجاعة، تقول: “بابا نصب حسني يبقى راجل البيت في غيابه، وهو الحاكم الآمر”.[18] قام حسني بهذه المهمّة بكلّ سرور وعلى “أكمل وجه”! يا للمفارقة! تكتب فتحيّة أنّ والدها كان من غواة “الضحك والأكل والستات”.[19]
سأتعلّم وأنطلق مهما كلّف الأمر!
رَفَضت كلثوم فكرة أن تصبح خدّامة لدى امرأة أخيها المستقبليّة. تكتب: “وصرت افتكر كيف اتخلص من هذا المستقبل التعس”.[20] أصبح التّعليم شغلها الشّاغل، ودخلت مدرسة الجمعيّة الأرثوذكسيّة الرّوسيّة الفلسطينيّة للبنات. تؤكّد كلثوم في هذا السّياق: “يا له من عبءٍ ألقي على كاهلي في وقت مبكّر! كنتُ في الخامسة من عمري ومع ذلك كنتُ أشعر بأنّني راشدة في أفكاري. في أماسي الشّتاء كان الكثير من النّساء يجتمعن في بيتنا وفي حوزتهنّ أشغالهنّ اليدويّة، ويجلسن حول قنديل الكاز الموضوع على منضدة عالية، ويستمعن إلى القصص الّتي كانت أمّي تجيد روايتها”.[21] وتضيف: “أمّا الأطفال فكانوا يجتمعون حول عمّتي وهي تشوي الكستناء فوق النّار، وكان حَبُّ الكستناء حين ينفجر يطير عاليًا في الهواء ويسقط هنا وهناك، فتعلو الضّحكات والصّرخات من شدّة الفرح”.[22] وبخصوصها، فهي تؤكّد: “أمّا أنا فكنتُ أجلس على صندوق تحت قنديل كاز آخر مثبّت على الحائط، وأدرس دروسي. وكثيرًا ما كنتُ أستيقظ في سريري بعدما نقلتني إليه عمّتي الحنونة من فوق الصّندوق بعد أن غفوتُ”.[23]
كانت مَدْرَستها “تُعَدُّ مدرسة نموذجيّة. وكان قد تخرّج آنذاك أوّلُ فوجٍ من معلّمات دار المعلّمات في بيت جالا؛ وكانت هؤلاء المعلّمات ملمّات بعلم التّربية وبأساليب التّدريس، ومتحمّسات لعملهنّ. وكانت كبيرة المعلّمات لبنانيّة تجيد العربيّة، تلقّت تعليمها في بيروت […] وقد أسعدني أن أتعلّم على يد هذا الفريق الممتاز من المربّيات”.[24] تؤكّد كلثوم في هذا السّياق: “لم أرَ بابًا للفرج الا بالعلم ولم يكن سوى مهنة التعليم في ذلك الوقت تباح للمرأة”.[25] لكنّ مهنة التّعليم لم تكن متاحة لمعظم البنات في ذلك الوقت. كانت كلثوم “محظوظة” في هذا السّياق، فتؤكّد: “المدهش حقًّا أنّ اللاتي اتّجهن إلى مهنة التّعليم كنّ بالفعل فتياتٍ لديهنّ نوع ما من عاهة جسديّة أو شديدات القبح. بكلمات أخرى: الّتي لا تتزوّج ولا تنجح في شيءٍ آخر – تُدَرِّس”.[26] تؤكّد كلثوم في هذا السّياق: “وتشاء الظّروف أن تكون مديرة الرّوضة عرجاء، وأن يكون وجه المعلّمة الصّغرى مغطّى بالبثور، وأن تكون كبيرة المعلّمات – اللّبنانيّة – عرجاء أيضًا”.[27] تقول كلثوم إنّها كانت تتذكّر كلام أمّها كلّما كانت تنظر إلى معلّماتها، وتؤكّد: “فقرّرت أن أتعلّم مهما كان الثّمن! وأن أكون معلّمة مثلهنّ”.[28] كم هي محظوظة هذه الطّفلة، فـ”معيار” “القُبْح” ينطبق عليها و”يؤهّلها” لنيل العلم ولممارسة مهنة التّعليم. ما أجمل “القُبْح”! لكن، هناك معيارٌ آخر لا يقلّ أهمّيّة. لغرض تحقيق طموحها في أن تصبح معلّمة، كان على كلثوم أن تتفوّق في دروسها، فقد قُبِلت التّلميذات المتفوّقات لدار المعلّمات في بيت جالا التّابعة للجمعيّة المذكورة أعلاه. تفوّقت كلثوم وقُبلت للتّعلّم مجّانًا في القسم الدّاخليّ في دار المعلّمات. تؤكّد كلثوم: “[…] عكفت على العمل وبلغت مرادي”.[29] لكنّ أمّها كانت بالمرصاد، فتقول: “والفضل في هذا لوالدي اذ ان والدتي المرحومة قاومت بكل ما لديها من الوسائل دخولي المدرسة”.[30] لم تكتفِ هذه الطّفلة الرّاشدة بفكرة ألّا تكون خدّامة، وتكتب: “كنتُ أريد أن أصبح معلّمة، كان هذا حلمي من الصّغر، أن أعمل وأكسب لقمة عيشي بنفسي […]”.[31]
وصلت كلثوم إلى دار المعلّمات في بيت جالا عام 1900، وهي في سنّ الثّامنة فقط. قضت في هذا المعهد ثماني سنوات، وأحبّت العيش والتّعلّم هناك، إذ كانت الظّروف المعيشيّة أفضل بكثير ممّا كانت عليه في بيتها، وفي بيوت بقيّة الطّالبات، إذ كان لكلّ فتاة سرير وخزانة وطقم خاصّ من الشّراشف والثّياب. كما كان للمعهد مزرعته الخاصّة وكرم زيتون صغير جميل، درجت الطّالبات على التنزّه فيه يوميًّا، إضافة إلى حديقة زهور جميلة. كانت كلثوم وقريناتها محظوظات في مدرستها في النّاصرة وفي بيت جالا على مستوى مناهج التّعليم أيضًا. كانت مناهج التّعليم في هذه المدارس، كما تقول: “تختلف اختلافًا جوهريًّا عن مناهج المدارس الأوروبيّة الأخرى الّتي كانت تضع اللّغة الأوروبيّة في المقام الأوّل. أمّا في المدارس الرّوسيّة، فبعد تعليم الدّين “كانت الدّرجة الأولى للّغة العربيّة[32] والحساب، والثّانية للجغرافيا والتّاريخ، والثّالثة للّغة الرّوسيّة”.[33] ومن كان أستاذها للّغة العربيّة في بداية طريقها في دار المعلّمات؟! صحيح، إنّه الأستاذ خليل السّكاكيني الّذي كان له كبير الأثر على طالبته.[34] تروي كلثوم أنّها بعد انتهاء السّنة الثّانية من وجودها في دار المعلّمات تركت المديرة المُسِنّة عملها وعُيّنت مكانها مديرة شابّة، وبدأت فورًا بإصلاح المناهج التّعليميّة، “فأدرجت فيها الهندسة والفيزياء والكيمياء وتاريخ الخِلافة. وكان هذا الموضوع الأخير فضلًا خالصًا للمديرة”.[35] تكتب في هذا السّياق أنّها بعد سنوات طويلة فهمت مدى أهميّة هذه الشّخصيّة، وظلّت ممتنّة لها ومعترفة بفضلها طوال حياتها. وتذكر كلثوم معلّمتها إليزافيتا الّتي “عرّفتنا – نحن الفتيات العربيّات – بتاريخ العرب، […] لقد سَعَت – شأنها شأن جميع معلّماتنا ومربّياتنا – إلى غرس حبّ لغتنا وأدبنا وشعبنا فينا”.[36] وتضيف: “ها أنا بعد أكثر من نصف قرن أنحني إجلالًا لذكراها”.[37] لكن، تعترف كلثوم أنّها لم تكن هي والمديرة الجديدة على وفاق، وتكتب: “كانت دائمًا ترغب في أن يتمّ استقبالها بحفاوة والانحناء لها”.[38] وكلثوم تنحني إجلالًا بدافعٍ داخليٍّ وعن طيب خاطر، وتتمرّد على الانحناء المفروض عليها! تلخّص كلثوم الموضوع بخصوص مديرتها بقولها: “احترمتُها لعنايتها بتعليمنا، لكنّني لم أكن على استعداد لإظهار الحماسة الزّائدة لها، لذا كنتُ دائمًا ضمن قوائمها السّوداء”.[39]
تخرّجت كلثوم من دار المعلّمات سنة 1908، وهي في سنّ السّادسة عشرة، وعادت إلى النّاصرة، وحقّقت حلمها في أن تصبح معلّمة في المدرسة الّتي تخرّجت منها. تعبّر كلثوم عن سعادتها بقولها: “ان تذليل المصاعب لبلوغ المراد هو من اكبر عوامل السعادة فاذا اقترنت هذه بسعادة من يحيط بنا ايضًا فهناك هناء العيش حقًا”.[40] أَسعدت كلثوم طالباتها وتؤكّد: “قضيت خمس سنوات بين تلك البنات اللواتي كنت اعلمهن وقد احببتهن حبًا ساعدني على ان أعيش مع كل واحدة منهن بعيشتها الصغيرة وان اساعدهن على قدر طاقتي”.[41] والحبّ يُقابل بالحبّ، فتكتب عن طالباتها: “وقد قابلنني بالمثل فكنت دائمًا أرى وجوهًا باسمة ضاحكة وكن يرافقنني في كثير من تنزهاتي”.[42] لم يتوقّف عطاء كلثوم عند هذا الحدّ، ففي أوقات فراغها كانت تزور الفلّاحين في القرى المحيطة بالنّاصرة لتقديم العلاجات للأطفال. تكتب: “[…] كان قلبي يتقطع ألمًا عندما أرى تلك العيون الملتهبة بالرمد فأغسلها بمحلول حامض البوريك وبعد تنظيفها انقط محلول الزنك عليها”.[43] وتحدّثنا كلثوم عن “تلك السعادة التي كنت اشعر بها عندما كنت أرى بعد أيام تلك العيون سليمة صافية وتلك الايدي الصغيرة تطوق عنقي”.[44]
تمرّدت كلثوم مرّة أخرى على الرّغم من الثّمن الباهظ الّذي دفعته. تقول عن ثمن تمرّدها هذا: “الامر الذي طالما تألمت منه فذرفت دموعًا غزيرة”.[45] وعلى ماذا تمرّدت هذه المرّة؟ ولماذا ذرفت الدّموع؟ تروي كلثوم عن تلك الفترة: “كنت اعيش اذ ذاك مع رفيقة “متمردة” مثلي في العمارة الروسية حيث كانت مدرسة البنات والسبب هو اننا كنا قد خرجنا على عاداتنا فرفضنا لبس الحجاب واضطررنا لمغادرة منازل أهلنا […]”.[46]
في سنة 1910 زار المدرسة المستشرق الرّوسيّ العلّامة إغناطيوس كراتشكوفسكي[47]، الّذي كان مهتمًّا ببوادر النّهضة الأدبيّة العربيّة. تقول كلثوم: “لم افكر اذ ذاك بان الاقدار ستطوح بي وترميني فيما بعد في الشمال النائي وان معرفتي به ستبقى الى يوم وفاته”.[48]
استطردنا في الحديث عن كلثوم وأختها فتحيّة في الانتظار. تَذْكر فتحيّة أنّه عندما سكنت العائلة في الفيّوم، بسبب عمل والدها، التحقتْ بمدرسةٍ ألمانيّةٍ هناك. وبعد أن عادت وأسرتها إلى القاهرة دخلت الصّفّ الأوّل في مدرسة عمارة البابلي، حيث بدأت تتعلّم “ألف، به.. لحد آخرها”.[49] خلال أسبوع واحد نجحت فتحيّة في تعلّم ألف، به. وتكتب في هذا الخصوص: “وعمري ما هانسى أبله صفية لما لقتني حفظت الف، بسرعة، أخدتني بعد الحصة وقالت لي: بصي يا فتحية إنتي باين عليكي شاطرة وذكية […]”.[50] وتضيف: “طبطبت علي وقالت: لو اتعلمتي هاتبقي “أبله” زيي كده”.[51] وتؤكّد فتحيّة: “من فرحتي، اول ما روحت البيت.. قفلت علي باب أوضتي وحطيت الألف، بيه قدامي.. وابتديت اعلم نفسي بنفسي.. إزاي اكتب فتحية […]”.[52] وتلخّص تجربتها في ذلك اليوم قائلة: “من اليوم دا حسيت اني حطيت ايدي على كنز اسمه التعليم. كنت اول ما ارجع من المدرسه اقفل علي الباب، وامسك الكتاب، واعمل الواجب مظبوط. عشان الصبح ابله صفية تشوفه وتفرح بي”.[53] وتؤكّد بخصوص حكم والدها عليها بحبس البيت: “وأفظع وأبشع حكم كان حرماني من التعليم”.[54] ماذا تفعل الطّفلة فتحيّة وقد قضت في المدرسة العربيّة شهرين فقط، وأمّها، كما تقول: “ما اتعلمتش غير سنة واحدة في مدرسة الزامي”.[55] جاءها صوتها الدّاخليّ كما تؤكّد: “ولقيتني باردد جوه نفسي – اللي اتحرمت منه، لازم اعوضه”.[56] وأصرّت: “ليه لأ؟ ابله صفية قالت إني شاطرة وذكية، يبقى ليه ما اتعلمش؟!”.[57] وأصبحت فتحيّة معلّمة لفتحيّة، وانطلقت في مسيرة التّعلّم الذّاتيّ. تكتب: “وعشت حلم التعليم، وابتديت كل يوم بعد ما اخلص شغل البيت، من كنس.. لمسح.. لطبيخ.. ادخل اوضتي واقفلها علي.. واعيش اصراري اللي شرنقت نفسي جواه. وامسك القلم وهات يا مذاكرة”.[58]
في إحدى الليالي دخل الوالد غرفة فتحيّة ووجدها تكتب، وتقول: “لقيت بابا بيطبطب عليّ. خلاص. ما دام مصممة تتعلمي. ها اساعدك”.[59] فرحت فتحيّة وسألت: “ها تعمل ايه يا بابا. هاترجعني المدرسة؟”.[60] وكان جواب الوالد “لا. لا. مش للدرجة دي، لكن هادور في المكتبات على الكتب اللي اتعلمك في البيت”.[61] وتروي: “وفعلا بابا ماكدبش خبر. وحقق وعده، وجاب لي كتب سنة أولى ابتدائي.. فيها صور.. وكلام تحت الصور”.[62] وبعدها أصبح يحضر لها جورنال “المصري” ويجلس معها: وتضيف: “وأصبحت على موعد دائم مع بابا.. […] في الأيام دي اصبح بيني وبين بابا حوار دائم حوالين الموضوعات اللي باقراها في جرنال “المصري” ومجلة “الاتنين” […]”.[63] إلى جانب توسيع ثقافتها بدأت فتحيّة بكتابة “كل اللي بيحصل حوالي.. […] وأول حاجة كتبتها كانت قصة نجيبة أختي”.[64] وتضيف: “كتبت الحكاية، واديتها لبابا. قراها. بص في اعجاب وقالي: واالله يا بت يا فتحية انت تنفعي كاتبة”.[65] أجابته: “ايوه يا بابا. بس انا سبت المدرسة”.[66] قال والدها: “العقاد ما كملش دراسته وبقى اكبر الكتاب في بلدنا”.[67] إذًا، على درب العقّاد… اقتنعتْ فتحيّة بأنّ في إمكانها أن تصبح كاتبة. تؤكّد: “وقلت لنفسي ليه لأ؟”.[68] وتروي: “وقررت ان كل حاجة بتحصل حولي وحصلت قبل كده، وهاتحصل بعد كده.. اكتبها”.[69] وكانت الوِلادة. ولادة الكاتبة الواعدة فتحيّة العسّال.
“السوده” اختارت… و”السمرا” كمان…
ما أجمل حظّ كلثوم مع الرّوس! فقد وصل طبيب روسيّ إلى النّاصرة وإلى المدرسة اسمه إيفان فاسيليف. تعارف كلثوم وإيفان وأحبّا بعضهما البعض وقرّرا أن يتشاركا الحياة ويتزوّجا. لكنّ أسرتها وعائلتها كانتا في المرصاد، وعلى وجه الخصوص الوالد الّذي عارض هذا الزّواج بشدّة، خاصّة وأنّ إيفان أجنبيّ. استمرّت المحاولات ثلاث سنوات من دون جدوى، كما تروي ابنتها فاليريا.[70] بل أكثر من ذلك، ووصل الأمر بأحد أفراد عائلتها أن “طلب من احد الصبيان ان يدفعها من اعلى سطح البيت عندما تعتليه فتقع على الأرض وتموت وتستريح العائلة منها ومن عارها، فذهب الصبي واعلمها بالقصة لتاخذ حذرها”.[71] لم تخضع كلثوم لإرادة والدها وعائلتها. ستَمْتَثِل لحبّها. أصرّت على الزّواج من حبيبها إيفان مهما كلّفها الأمر. وحقّقت ذلك، إذ وقف ابن عمّها نجيب عودة إلى جانبها، فرافقها وإيفان إلى القدس، رغم معارضة عائلتها، وعقدا قرانهما هناك في إحدى كنائسها.[72] تشدّد قائلة: “[…] هربت من البيت واقترنت بطبيب روسي وبعد العناء سامحني المرحوم والدي الذي لم يرد هذا الزواج قط […]”.[73]
أمّا فتحيّة فقد كانت قصّة زواجها أشبه بمسلسل دراميّ. في المرّة الأولى خُطِّبَت لـ “شكيب أفندي” رغم معارضتها. بعد سنتين من تخطيبها أبلغ الوالد الأسرة بأنّ “شكيب أفندي” قد مات إثر حادثة. تقول فتحيّة: “في اللحظة دي فرحت وزعلت في الوقت نفسه.. حرام إن شاب يموت في عز شبابه.. لكن الحمد لله مش هاتجوز وانا صغيرة”.[74] اعتقدت فتحيّة بعد هذه الحادثة أنّها ستعود إلى المدرسة، “فطمأنتها” أمّها بأنّها لن ترجع، وقالت لفتحيّة: “[…] نصيبك كده”.[75] وجاء ردّ فتحيّة مُجَلْجِلًا: “لا. لا النصيب ده انا هااغيره.. هااغيره”.[76] وتضيف: “وفجأة حسيت بقوة العالم كله جوايا. وكأن طاقة ونورت قدامي”.[77]
في سنّ الثّالثة عشرة ونصف خُطِّبَت فتحيّة لمهندس ضابط. في زيارته الأولى إلى بيت فتحيّة، أخبرهم العريس بأنّه كان خاطبًا وفسخ خطوبته من عروسه بسبب شكوكه فيها والّتي تبيّن أنّها خاطئة. استفسرت فتحيّة: “طب ما دامت مظلومه، مارجعتلهاش ليه؟”.[78] أجابها: ” “أنا أتف تفة، ما ألحسهاش تاني”.[79] تقول فتحيّة: “انتفضت من بشاعة الرد”.[80] وقرَّرَتْ على الفور فسخ الخطوبة، ووافقها أبوها وأمّها الرّأي. تروي فتحيّة: “بعد فسخ الخطوبة.. رجعت تاني لحياتي اللي كنت عايشاها. القراية والكتابة هم كل حاجة في حياتي”.[81]
رُبَّ صدفةٍ… في أحد الأيّام اتّصلت أختها الحامل نجيبة بوالدتها وقالت إنّها تعبانة. طلبت الوالدة من فتحيّة، ابنة الرّابعة عشرة، أن تذهب للاطمئنان على أختها. كانت هذه فرصة سانحة لفتحيّة للخروج من “سجن البيت” وحدها. وكانت فرصة ثانية في الطّريق إلى بيت أختها في الإمكان تسميتها “فرصة العمر”. مشت فتحيّة “لحد محطة الترماي”، وتكتب: “لقيت شاب ابيض، وشعره اصفر، وعينيه جميلة وكأنها الوان الطيف كلها جواها”.[82] وتضيف: “بص لي، وابتسم.. من صدق الابتسامة كنت ها ابتسم. لكن كتمتها بسرعة. دي اول مرة اخرج فيها لوحدي. معقول أبص لشاب، وكمان أبتسم له. لا. عيب”.[83] في ذلك الصّباح صَبَّحَ عليها هذا الشّابّ، فردّت عليه “يسعد صباحك”.[84] كتب لها الشّاب رسالة في السّر جاء فيها عن إجابتها “يسعد صباحك”: “هذه الكلمة حفرت مجرى الحب في أعمق الأعماق […]”.[85] لم يكتب اسمه في رسالته إليها، ورغم أنّها لم تعرف اسمه فهي تقول: “حاسة إنه خطف قلبي […]”.[86] وبدأت فتحيّة تُبدِع في إيجاد الأسباب للخروج من البيت لهدف رؤية أو مقابلة هذا الشّاب المجهول الاسم. في لقائهما الثّاني، عرّف الشّاب بنفسه: “عبد الله الطوخي. من المنصورة قرية ميت خميس. وفي سنة أولى حقوق. جامعة القاهرة”.[87] وأضاف: “وانت اسمك فتحية محمود العسال. عرفت كل حاجة عنك من عم احمد المكوجي، لاننا بلديات”.[88] واتّخذ الشّابّ من محلّ عم أحمد المكوجي نقطة استطلاع وانطلاق استراتيجيّة، وتحوّل “عم أحمد المكوجي” بمثابة “مكتب بريد” للرّسّائل السّرّيّة بين الحبيبين. صارح عبد الله فتحيّة بحبّه لها، وقال لها إنّه يودّ أن يخطبها “بعد اربع سنين. لما اتخرج انشاء الله”.[89] وتكتب: “عشت أيام وليالي خايفة ومرعوبة أحسن يجيني عريس وبابا يصمم ويجوزني. […] دي تبقى مصيبة”.[90] وفعلًا، حلّت المصيبة على وجه السّرعة، كما تقول: “وللأسف.. المصيبة حصلت وجاني عريس صديق لحسني أخويا”.[91] كان العريس عبد الحميد ابن مليونير، و”طبعا العيلة كلها فرحت بالعريس اللقطة.. الغني”.[92] وهكذا خُطِّبَت فتحيّة للمرّة الثّالثة لهذا الشّابّ ولمّا يبلغ الثّامنة عشرة من عمره، وكان من دون عمل ومبذّرًا ومدلَّلًا، وكانت أمّه تناديه باسم الدّلَع “تيتا”. بعد سنة من الخطوبة لم تستطع فتحيّة هضم خطيبها، وقالت: “أنا اللي يهمني ماأسيبش النصيب يتحكم في”.[93] وصارحت والدها قائلة: “اعمل إيه.. مش حاسة بمستقبلي معاه”.[94] فكان جواب الوالد: “اطمني يا حبيبتي. تيتا لسه صغير. ولما يستلم أمواله هايحس بالمسئولية”.[95] ليس من العدل أن تقع كلّ المسئوليّة على عاتق فتحيّة في تغيير نصيبها! على عبد الله أن يتحرّك! وتحرّك! بعد مرور سنتين على خطوبة فتحيّة من تيتا دقّ باب بيت الأسرة صبيّ يعمل عند “عم أحمد المكوجي” وأعلمهم بأنّ هناك شخصًا “عايز يقابل البيه الكبير”.[96] وكان البيه خارج البيت. بعدها عاد الصبيّ وقال: “طيب ممكن يقابل البيه الصغير؟”.[97] وكان هو الآخر غائبًا. يقول المثل: “الثّالثة ثابتة”، وهكذا كان. هو يريد “مقابلة الست الكبيرة”.[98] دقّ جرس الباب، فطلبت الأمّ من فتحيّة أن تدخل غرفتها. تقول فتحيّة: “من فضولي بصيت أشوف مين الراجل اللي مصمم يقابل حد من أهل البيت.. لقيته عبد الله بدمه وشحمه”.[99] صارح عبد الله الوالدة بقوله: “عايز أخطب الآنسة فتحية”.[100] وخلال الحديث قال لها: “محتاجين وقفتك معانا”.[101] و”معانا” هذه تعني أنّه يتحدّث باسم فتحيّة أيضًا. طلبت الوالدة من عبد الله أن يعود لزيارتهم بعد عودة الوالد، بعد أسبوع. طمأنت الأمّ فتحيّة بأن تصارحها بطبيعة العلاقة مع عبد الله، وتقول: “بصت لي أمي في حنان، اترميت على صدرها، وانفجرت في العياط: أنا محتاجاكي يا أمي”.[102] قالت الأمّ: “يعني الشخص اللي كان هنا دا، اللي اسمه عبد الله الطوخي لو اتجوزتيه.. حاترتاحي وتريحينا من ناحيتك؟”.[103] فأجابت فتحيّة: “هو دا يا ماما اللي حا أعيش سعيده معاه العمر كله”.[104] قالت الأمّ: “بصراحة يا بنتي، ما خبيش عليكي… أنا كمان ارتحت له”.[105] وتؤكّد فتحيّة: “وفي اللحظة دي حسيت ان قلبي من جوه بيزغرد”.[106]
صارحت الأمّ الوالد في الموضوع، ومن بين ما قاله الوالد لأمّها: “بنتك شخصيتها قوية يا زينب، ومش سهله، واديكي شفتي لما صممت تتعلم اتعلمت. لا وإيه، من كتر القرايه دماغها اتفتحت. دا أنا ساعات كتيرة باحب اقعد أتكلم معاها في اللي بتقراه. باحس انها ذكيه وفاهمه وواعيه لكل حاجة بتحصل”.[107] وأضاف الوالد: “المهم دلوقتي. احنا نفكر ازاي نفسخ الخطوبة”.[108] وهنا طمأنت الوالدة الوالد قائلة: “ما تحملش هم. هيه قالت هاتتكلم معاه بصراحه”.[109] حسمت فتحيّة الأمر مع تيتا. تؤكّد: “استنيت تيتا في ميعاده […] وشحنت نفسي بكل الشجاعة اللي جوايا عشان أقدر أواجهه”.[110] وتقول بخصوص اللقاء: “بصيت له بحسم: احنا ماننفعش لبعض يا تيتا. […] حاولت أحبك.. ماقدرتش.. وأنا مش باحب الكذب”.[111] كان عمرها سبع عشرة سنة.
وجاءت زيارة عبد الله إلى بيت الأُسرة: “وكان الميعاد يوم السبت 30 يوليه سنة 1950 […] وفي اليوم ده ومن صباحية ربنا، وأنا حاسه أني مركبة جناحين، وعايزه أطير بيهم في الكون كله، وأقول بعلوالصوت: أنا سعيدة.. سعيدة..”. [112] رحّب الوالد بالشّاب، لكن اشترط عليه أن تأتي والدته معه لطلب يد فتحيّة كما تنصّ العادات. أخبر عبد الله والد فتحيّة بأنّ والدته تعارض خطوبته قبل تخرّجه من مدرسة الحقوق. فكان موقف الوالد حاسمًا بأنّ الخطوبة ستتمّ عند حضور الوالدة. يبدو أنّ عبد الله كان مقتنعًا بأنّ والدته لن تأتي. تصف فتحيّة الموقف: “خرج عبد الله ولمحت في عينيه خيبة أمل، انعكست عليَّ أنا كمان”.[113] مرّت الأيّام والأسابيع ولم تسمع فتحيّة من عبد الله ولم تتلقّ أيّ جواب منه. استسلم عبد الله للأمر الواقع، وكَتب[114]: “بعد تفكير عميق.. قررت أن أخرج فتحية من حياتي نهائي. لأني حسمت الموقف. […] حقا أنا أحببتها. ولكن تعنت أهلها […] ساعدني على اتخاذ القرار”.[115] لَكَ كلّ الحقّ أن تحسم الموقف أيّها الشّابّ، لكنّ فتحيّة أيضًا حسمت الموقف! هي ما زالت مصرّة على تغيير نصيبها بنفسها، لن تتنازل عن حبّكما. تحرّكت فتحيّة الكاتبة الشّابّة الواعدة وكتبت لعبد الله جوابًا على هيئة قصّة. تقول: “وكان المضمون اللي جوايا إن أجمل شيء في الوجود هو الأمان وإحساس الإنسان بالثقة في نفسه مهما يحصل”.[116] وقد بدأت رسالتها بطرح السّؤال عن أجمل شيء في الحياة. وكان جوابها: “وهو عش يرفرف عليه الأمان والثقة والحب بين زوجين عاشقين”.[117] يقول عبد الله عن فتحيّة بعد قراءته الرّسالة القصّة: “لقد بدت لي حينذاك مثل ذلك الجان او العملاق الذي كان محبوسا في قمقم، ثمّ واتته فرصة الانطلاق […] سيمكنها فعل المعجزات”.[118] وجاءت المعجزة! بعد أيّام قليلة من قراءته لقصّة هذا الجانّ العملاق وصل عبد الله ووالدته وأخوه البِكر إلى بيت أهل فتحيّة لطلب يدها. استجابت والدة عبد الله لطلب ولدِها على مضض. خلال لقائها بوالد فتحيّة كان لها شروطها، وكان لوالد فتحيّة شروطه، واتّفقا في نهاية الأمر. وعلى وجه السّرعة تلاشت شروط الاتّفاقيّة بين والد فتحيّة ووالدة عبد الله، فلا شيء يقف أمام الحبّ وأمام القرار بتغيير النّصيب. و”بلا طول سيرة” تزوّج العاشقان، فتحيّة وعبد الله، وسكنا في شقّة صغيرة أسمياها “عشّ حبّنا”.
تطول المسيرة
ما زلنا في المراحل الأولى المبكّرة من حياة هاتين الأختين-الإنسانتين. إنّها محطّات الانتصارات التّأسيسيّة الأصعب والأهمّ؛ التّمرّد على عقليّات وعادات وتقاليد الأسرة – مُمَثِّلَةً للمجتمع، أيضًا – الّتي اعتُبِرت “قدس أقداس”، وبالتّالي اعتُبِر الخروج عنها من المحرّمات، وقد يكلّف الصبيّة/المرأة أثمانًا باهظة، تصل حدّ المخاطرة بحياتها. سأكتفي هنا بتسجيل النّقاط التّالية:
بعد هذه الانتصارات التّأسيسيّة لم يردع الأختان، فتحيّة وكلثوم، أيّ شيء. استمرّت الأختان في الطّيران والتّحليق عاليًا وعلى جميع المستويات – الإنسانيّ والشّخصيّ والأُسريّ والعائليّ والاجتماعيّ والسّياسيّ والمهنيّ. فتحيّة من وطنها الأمّ مصر، وكلثوم من وطنها الثّاني روسيا، ولاحقًا الاتّحاد السّوفييتي. وكما هي حال فتحيّة الّتي قالت وهي طفلة: “[…] النصيب ده انا هااغيره.. هااغيره. وفجأة حسيت بقوة العالم كله جوايا […]”،[119] أكّدت كلثوم: “فانا ولا مبالغة كنت في جميع أطوار حياتي سعيدة أشتغل راغبة لا ملزمة ولا أجد الراحة إلا عند تذليل المصاعب متمتعة بحريتي الشخصية التي هي من أعظم أسباب السعادة”.[120] وتضيف: “[…] ان ينبوع الحياة فينا فاذا قدرنا ان نروي جميع مظاهر حياتنا به صارت حياتنا وردة زاهرة تتغلب برائحتها العطرة وجمالها على الاشواك التي هي كثيرة جدا في طريقنا”.[121] وما أكثر الأشواك الّتي اعترضت لاحقًا طريق كلتا الأختين، سواء على مستوى الأُسرة أو المجتمع أو السّياسة… نعم، تمرّدت الأختان وحطّمتا عقليّات وعادات وتقاليد أُسريّة-اجتماعيّة، لكنّ هذا لم يَعْنِ التّنازل عن الأُسرة أو قطع العلاقة معها. بقيت كلثوم وفتحيّة على علاقة بأُسرتيهما، لا بل عملتا جاهدتين على الحفاظ على هذه العلاقة وتحصينها. لم تَجِد روح الانتقام سبيلًا للتّعشيش في قلب وكيان أيّ منهما. لقد عشّش وانطلق ينبوع فيّاض بالحياة والحبّ داخل هاتين الإنسانتين المتمرّدتين المنتصرتين، وقد يكون هذا أحد أسباب السّعادة.
أخلصت كلّ منهما لأسرتها الجديدة (عشّ حبّنا)، ولقضايا المرأة والفئات المضطَهَدَة الأخرى، وللأمّة وللوطن العربيّ الصّغير والكبير. وصل الأمر حدّ أن ذاقت الأختان طعم “التّخشيبات” والسّجون. أصبحت فتحيّة، الكاتبة الكبيرة، عضوة مجلس إدارة اتّحاد الكتّاب ورئيسة جمعيّة الكاتبات المصريّات وأمين عام اتّحاد النّساء التّقدّميّ. وكلثوم الّتي انطلقت مع زوجها في رحلة إلى روسيا سنة 1914 داهمتهما الحرب العالميّة الأولى وهما على متن السّفينة، فتغيّر مسار سفينة حياتهما تمامًا، وانتهى بها الأمر في روسيا. صار لكلثوم وطنان وأمّتان. تكتب: “وإذ وجدتُ نفسي مصادفةً في روسيا، اتّخذتُها وطني الثّاني […].[122] جدّدت كلثوم علاقتها بالمستشرق كراتشكوفسكي، وأصبح معلّمها ومرشدها وقدوتها. برعت في البحوث والتّرجمة بين اللّغتين العربيّة والرّوسيّة، وفي التّدريس، وارتقت في علمها حتّى أصبحت البروفيسورة الفلسطينيّة، ولربّما العربيّة، الأولى في الاتّحاد السّوفييتي. بَنَتْ كلثوم جسورًا للحوار والتّواصل الثّقافيّ بين العالم العربيّ وشعوب الاتّحاد السّوفييتي، من خلال بحوثها العلميّة والتّرجمة وتأليف كتب تعليم اللّغة العربيّة لطلّاب المعاهد العليا السّوفييت، وعرّفتهم على العشرات من الأديبات والأدباء العرب.[123]
وفي العودة إلى “نحن العرب” الّتي ذكرتها كلثوم في بداية إطلالتنا، تكتب في هذا السّياق – في العام 1927 – أنّها بعد بدئها بمزاولة عملها مع العلّامة كراتشكوفسكي، وانكشافها وفهمها المعمّق لشعبها وتاريخه وإنجازاته: “[…] زاد حبي لوطني وزادت سعادتي اذ اني صرت آملة بانه لا بد لنا نحن العرب من مستقبل لا يقل مجدًا عن الماضي”.[124]
لا بُدَّ لنا…
ألقاكم/نّ بخير.
………………………………………
[1] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1927، 1 سبتمبر). كيف يعيش المرء هنيئا في هذه الحياة. الهلال. ص 1043.
[2] . العسال، فتحية. (2002). حضن العمر: السيرة الذاتية. القاهرة: الهيأة المصرية العامة للكتاب. ص 56.
[3] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1927، 1 سبتمبر). كيف يعيش المرء هنيئا في هذه الحياة. الهلال. ص 1043.
[4] . العسال، فتحية. (2002). حضن العمر: السيرة الذاتية. القاهرة: الهيأة المصرية العامة للكتاب. ص 56.
[5] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1927، 1 سبتمبر). كيف يعيش المرء هنيئا في هذه الحياة. الهلال. ص 1043.
[6] . المصدر السابق. ص 1044.
[7] . العسال، فتحية. (2002). حضن العمر: السيرة الذاتية. القاهرة: الهيأة المصرية العامة للكتاب. ص 57.
[8] . المصدر السابق. ص 23.
[9] . المصدر السابق. ص 21.
[10] . المصدر السابق. ص 40.
[11] . المصدر السابق. ص 43.
[12] . المصدر السابق. ص 67.
[13] . المصدر السابق. ص 67.
[14] . المصدر السابق. ص 44.
[15] . المصدر السابق. ص 44.
[16] . المصدر السابق. ص 44.
[17] . المصدر السابق. ص 5.
[18][18] . المصدر السابق. ص 69.
[19] . المصدر السابق. ص 57.
[20] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1927، 1 سبتمبر). كيف يعيش المرء هنيئا في هذه الحياة. الهلال. ص 1044.
[21] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1965)، نظرة إلى الماضي. К. В. О д е – В а с и л ь е в а. (1965) Взгляд в прошл. Палестинский сборник. ص 174.
[22] . المصدر السّابق. ص 174.
[23] . المصدر السّابق. ص 174.
[24] . المصدر السّابق. ص 174.
[25] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1927، 1 سبتمبر). كيف يعيش المرء هنيئا في هذه الحياة. الهلال. ص 1044.
[26] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1965)، نظرة إلى الماضي. К. В. О д е – В а с и л ь е в а. (1965) Взгляд в прошл. Палестинский сборник. ص 171.
[27] . المصدر السابق. ص 174.
[28] . المصدر السابق. ص 174.
[29] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1927، 1 سبتمبر). كيف يعيش المرء هنيئا في هذه الحياة. الهلال. ص 1044.
[30] . المصدر السابق. ص 1044.
[31] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1965)، نظرة إلى الماضي. К. В. О д е – В а с и л ь е в а. (1965) Взгляд в прошл. Палестинский сборник. ص 171.
[32] . في دار المعلّمات، كانت اللّغة العربيّة في المرتبة الأولى خلال السّنوات الثّلاث الأولى، وبعدها أصبحت اللّغة الرّوسيّة في المرتبة الأولى.
[33] . المصدر السابق. ص 173.
[34] . محاميد، عمر. (2004). بروفيسور كلثوم عودة: من الناصرة إلى سانت بطرسبورغ. بيت بيرل: مركز أبحاث حوار الحضارات.
[35] . المصدر السّابق. ص 176.
[36] . المصدر السّابق. ص 176.
[37] . المصدر السّابق. ص 176.
[38] . المصدر السّابق. ص 176.
[39] . المصدر السّابق. ص 176.
[40] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1927، 1 سبتمبر). كيف يعيش المرء هنيئا في هذه الحياة. الهلال. ص 1044.
[41] . المصدر السابق. ص 1044.
[42] . المصدر السابق. ص 1044.
[43] . المصدر السابق. ص 1044.
[44] . المصدر السابق. ص 1044.
[45] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1951، 1 يوليو). تذكراتي عن العلامة كراتشكوفسكي. الأديب. ص 13.
[46] . المصدر السابق. ص 13.
[47] . إغناطيوس كراتشكوفسكي (1883-1950).
[48] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1951، 1 يوليو). تذكراتي عن العلامة كراتشكوفسكي. الأديب. ص 13.
[49] . العسال، فتحية. (2002). حضن العمر: السيرة الذاتية. القاهرة: الهيأة المصرية العامة للكتاب. ص 103.
[50] . المصدر السابق. ص 103.
[51] . المصدر السابق. ص 104.
[52] . المصدر السابق. ص 104.
[53] . المصدر السابق. ص 105.
[54] . المصدر السابق. ص 59.
[55] . المصدر السابق. ص 105.
[56] . المصدر السابق. ص 106.
[57] . المصدر السابق. ص 106.
[58] . المصدر السابق. ص 106.
[59] . المصدر السابق. ص 108.
[60] . المصدر السابق. ص 108.
[61] . المصدر السابق. ص 108.
[62] . المصدر السابق. ص 108.
[63] . المصدر السابق. ص 109-110.
[64] . المصدر السابق. ص 111-112.
[65] . المصدر السابق. ص 115.
[66] . المصدر السابق. ص 115.
[67] . المصدر السابق. ص 115.
[68] . المصدر السابق. ص 116.
[69] . المصدر السابق. ص 116.
[70] . محاميد، عمر. (2004). بروفيسور كلثوم عودة: من الناصرة إلى سانت بطرسبورغ. بيت بيرل: مركز أبحاث حوار الحضارات.
[71] . المصدر السابق. ص 13.
[72] . المصدر السابق. ص 13.
[73] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1927، 1 سبتمبر). كيف يعيش المرء هنيئا في هذه الحياة. الهلال. ص 1043.
[74] . العسال، فتحية. (2002). حضن العمر: السيرة الذاتية. القاهرة: الهيأة المصرية العامة للكتاب. ص 101.
[75] . المصدر السابق. ص 102.
[76] . المصدر السابق. ص 102.
[77] . المصدر السابق. ص 102.
[78] . المصدر السابق. ص 131.
[79] . المصدر السابق. ص 131.
[80] . المصدر السابق. ص 131.
[81] . المصدر السابق. ص 134.
[82] . المصدر السابق. ص 145.
[83] . المصدر السابق. ص 145.
[84] . المصدر السابق. ص 147.
[85] . المصدر السابق. ص 147.
[86] . المصدر السابق. ص 148.
[87] . المصدر السابق. ص 151.
[88] . المصدر السابق. ص 151.
[89] . المصدر السابق. ص 151.
[90] . المصدر السابق. ص 153.
[91] . المصدر السابق. ص 153.
[92] . المصدر السابق. ص 154.
[93] . المصدر السابق. ص 170.
[94] . المصدر السابق. ص 170.
[95] . المصدر السابق. ص 170.
[96] . المصدر السابق. ص 174.
[97] . المصدر السابق. ص 174.
[98] . المصدر السابق. ص 174.
[99] . المصدر السابق. ص 174.
[100] . المصدر السابق. ص 176.
[101] . المصدر السابق. ص 177.
[102] . المصدر السابق. ص 180.
[103] . المصدر السابق. ص 181.
[104] . المصدر السابق. ص 181.
[105] . المصدر السابق. ص 181.
[106] . المصدر السابق. ص 181.
[107] . المصدر السابق. ص 187-188.
[108] . المصدر السابق. ص 188.
[109] . المصدر السابق. ص 188.
[110] . المصدر السابق. ص 189.
[111] . المصدر السابق. ص 190.
[112] . المصدر السابق. ص 192.
[113] . المصدر السابق. ص 197.
[114] . تقتبس فتحيّة هنا ما كتبه عبد الله الطوخي (1926-2001) في مذكّراته “سنين العمر والسجن“. صفحة 51.
[115] . العسال، فتحية. (2002). حضن العمر: السيرة الذاتية. القاهرة: الهيأة المصرية العامة للكتاب. ص 200.
[116] . المصدر السابق. ص 199.
[117] . المصدر السابق. ص 201.
[118] . المصدر السابق. ص 201.
[119] . المصدر السابق. ص 102.
[120] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1927، 1 سبتمبر). كيف يعيش المرء هنيئا في هذه الحياة. الهلال. ص 1046.
[121] . المصدر السابق. ص 1046.
[122] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1965)، نظرة إلى الماضي. К. В. О д е – В а с и л ь е в а. (1965) Взгляд в прошл. Палестинский сборник. ص 176.
[123] . شرباتوف، غريغوري. (1961). الاستعراب في الاتّحاد السّوفييتي: اللغة والأدب، 1917-1961. نقله إلى العربيّة محمّد المعصراني. موسكو: دار نشر المطبوعات الشرقية.
[124] . عودة-فاسيليفا، كلثوم. (1927، 1 سبتمبر). كيف يعيش المرء هنيئا في هذه الحياة. الهلال. ص 1046.