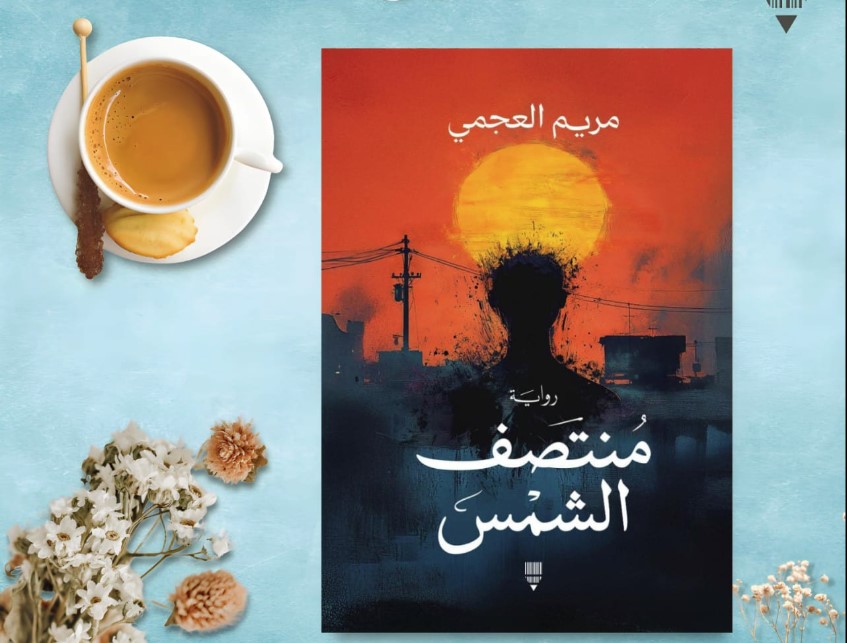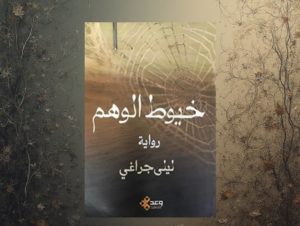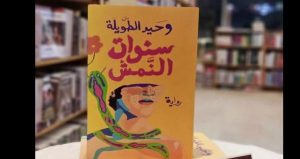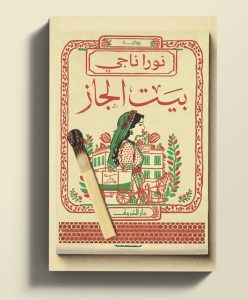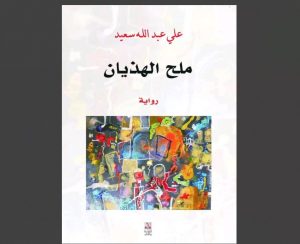الحروب لم يوثقها التاريخ وحده، وإنما استلهمها الأدب، واستخلص منها الروائيون في مختلف أنحاء العالم، أعمالًا استثنائية، تجاورت فيها الحقائق إلى جانب التخييل، بهدف واحد هو الكشف عن قبح الحروب، ومناهضتها.
في رواية “منتصف الشمس”، الصادرة عن دار المحرر، تؤطِّر مريم العجمي أحداث روايتها بحربي 1967 و1973، إذ تشكِّل واحدة منهما نقطة إنطلاق الحدث الرئيس، وتشكَّل الحَربان معًا الخلفية الثابتة لكل السرديات الثانوية والقصص الفرعية، وبالرغم من ذلك، فهي ليست رواية تاريخية بالمعنى المتعارف عليه، إذ أنها تسرد القصص الإنسانية وراء الانتصارات والهزائم الحربية، وتبحث عما حدث على أرض الواقع، لا تعني بنتائج ممارسة السلطة، لكنها تقف كثيرًا عند المعاني الإنسانية العميقة.
هي إذًا ليست رواية عن الحرب، بل عمَّا يختبىء خلفها. وإذا وضعنا في الإعتبار أن هذه الرواية نتاج ورشة عمل عن أدب الجريمة، فمن الجائز تصنيفها كرواية بوليسية، ولكنها ليست كذلك بشكل حرفي. لذا، لا يمكن تصنيفها بشكل حاد وقاطع، لا سيما أن الأدب بعد الحداثيّ قد تجاوز فكرة التصنيفات، فقط ما يمكننا تأكيده هو أنها رواية أجيال، وهي تدور فى أكثر من زمن، عبر اكتشاف فى الحاضر يجعل البطل يبحث في الماضي القريب والبعيد، فيكتشف ذاته ويعيد اكتشاف الآخرين.
من عتبات الرواية، يحمل العنوان “منتصف الشمس” دلالة رمزية قوية، فالشمس تشير إلى الكشف، إلى الحقيقة، إلى قوة الضوء، وإلى تفتُّح الوعي وإنجلاء البصيرة.
أيضًا البداية الافتتاحية هي أهم أجزاء النص الروائي، بل قد تكون أعقد أجزائه؛ لأنها واجهته الشفافة التي تدفع القارىء إلى الاقتراب أكثر من النص، فقد كُتِبَ الكثير عن “لغز الجملة الأولى” في الروايات، والهوس بها والقلق منها، إذ لكل جملة حكايتها التي توازي حكاية الرواية أحيانًا، وتتعدد التفسيرات لهذه الظاهرة، لا سيما أن بعض الجُمل صارت مثل أقوال مأثورة أو قاعدة للحديث عن الروايات.
ونخلُص إلى وصف المُفتتح الروائي بالجسر الذي يَشرَع القارىء عبره بالانتقال بخطوات بطيئة أو قد تكون سريعة، وفيه يتم عقد ميثاق بين المتلقي والنص لتحديد شكل التلقي وكيفية الدخول لبداية التخييل الروائي. قد تصيب الجملةُ المفتاحيةُ القارئَ بالصدمة أحيانا، ويكون ذلك التأثير أشبه بضربة لا يفيق منها إلا في الصفحة الأخيرة.
وفي هذه الرواية، برعت مريم تمامًا في انتقاء جملتها الأولى، إذ تصدم وعي القارىء بعبارتين مفتاحيتين في غاية الأهمية، ضمَنت بهما الجذب التام لانتباه القارىء، المتشوق لما سيلاقيه، فالأولى حُلم مُبهم، والثانية لغز :
“حلمت أن غرابًا يأكل من قلب عمي عامر”
“عيار ناري لسلاح خفيف روسيّ الصنع، لا يحمله إلا جنود المشاة، هل قُتِلَ عمَّك بيدٍ مصرية؟!”
لقد وضعتنا مريم أمام الحدث، بل في قلبه، منتصفه، “منتصف الشمس”، حيث الرؤية مشوشة، لكنها ستتضح شيئًا فشيئًا مع تصفح الرواية، وكأنها قطع بازل يتم تجميعها، لنتبيَّن في النهاية الصورة كاملة.
تدور أحداث الرواية في إحدى قرى مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وفيها تكشف الروائية عن الوجه الحقيقي للريف، حيث تلعب الخرافة والقوى الخفية والجن والغيبيات دورًا محوريا فى حياة الناس، يل كانت المحرك الأساسيّ لحكايا الرواية الممتدة من الماضي؛ من الجد الأكبر “عزيز”، والجد “التهامي”، والابن “عامر”، إلى أن نصل إلى الحفيد “محمد”، بطل الرواية. نجد أيضًا أمراض الريف المتركزة في اضطهاد المرأة: سواء بحرمانها من الإرث، أو بتزويجها في سن الطفولة، أو رفض طلبها للطلاق.
بين ماضٍ محاط بالألغاز، وحاضر مُحاصَر بالماضي، يعيش بطل الرواية “محمد التهامي عزيز”، حياته بين المدرسة المملة والزملاء معدومي الأحلام، يُكمِلون الناقص بالوهم والخرافة، وقد أسقط عَمدًا اسم والده، مفضِلًا الانتساب لجده، فظل الأب بطول الرواية، شخص مجهول، من دون اسم، وكأنه يُعاقبه على معاملته القاسية وسلوكه العنيف معه بالتجهيل.
يمتلك البطل عينين تشبهان عدسة الكاميرا، تَظهَر في دقة التفاصيل التي يَسرد بها عملية هدم المنزل المقابل له، تلك العين الحساسة، الدقيقة، التي تقتنص اللقطة الاستثنائية الخاطفة حين تَعلَق الأشياء بين الأرض والسماء:
“يقف عامل البناء على السقف يرفع المطرقة المربعة لأعلى بكل عزمه، ينزل بها عليها، أتابع الضربات المتتالية بإيقاعها البطيء الحريص، تُحدِث شقوقًا تتضاعَف وتتسع، إلى أن تسقط الكتلة الخرسانية مفتتة من الأحجار والرمال”. “أتابع الطرقات، أحدد وقت سقوط الحَجَر، في اللحظة المناسية ألتقط صورة الحَجَر معلقة بين السقف والسقوط، وأحتفظ بتلك اللحظة النادرة، التعلق بين مستويين، أن يقفز أحدهم، وقبل أن يصل إلى الأرض، تكون لقطتي”.
تلك العينان لم تكن سوى رمز له هو، إنه الشخص العالق دومًا بين حقيقة الأرض ووهم السماء، تلك السماء التي يعتقد بأن نجومها تُخبِره بالقادم وتكشف له عن المخبوء.
محمد الذي يحلم بأن يكون مصورًا وصحفيًّا لامعًا، لم تُمكِّنه أحلامه سوى من أن يكون أخصائي صحافة في مدرسة إعدادية، وفي الليل مصور أفراح! إنه رمز لجيل ضائع، عالق في المسافة بين الحلم وتحقيقه، بين الحقيقة والوهم، والذي حين يتعجَّل الوصول، ينظر إلى منتصف الشمس، فتتشوش رؤيته، ويضل طريقه، لذا نجد في نهاية الرواية تلك النصيحة التي تأتي لمحمد على لسان حبيبته منى: “أفكر في أثر الشمس ولا أنظر في منتصفها كما تفعل أنتَ، فلا تقوى على إطالة النظر، وتتعثَّر رؤيتك”.
البطل هنا لم يكن فقط مكبَّلًا بهزيمة الوطن المتمثِّلة في حرب 1967، بل بالهزائم الشخصية المتمثلة في إرث عائلي ضخم محمول على الأكتاف. لذا، هو حينما يجتر حكايات أسلافه، تلك الحكايات الصغيرة لــ”صلوحة”، و”عزيز”، و”التهامي”، والتي قد تبدو فرعية، وربما ليست بأهمية السردية الكبرى (الحرب)، إلا أنها في الواقع ترسم حاضِره ومستقبله، وتؤثر عليهما بشكل كبير، وهي المحور الأساسي الذي تفرَّعَت وتناسلت منه بقية الأحداث. ولذا تنصحه منى: “أعيشُ لحظتي يا محمد، لا ألتفت إلى الوراء”.
تضعنا الرواية أمام مفهوم البطولة، وذلك حين تطرح إحتمالية أن يكون التاريخ البطولي لـ”عامر” مجرد زيف، استثمرته العائلة وتكسَّبَت منه! فنحن أمام شاب كان مفتونًا في طفولته بلعبة الحرب، يظل يضع – بطول عمره – عمه، شهيد حرب أكتوبر، نُصب عينيه، متباهيًا به أمام الجميع، حتى يضعه سؤال في تعليق على صورة الرصاصة التي وضعها على صفحته بالفيسبوك أمام مأزق رهيب، فيبدأ بالبحث عن حل للسؤال-الفخ، وفي رحلة البحث تلك يتعرَّف على أصدقاء قُدامى لعمه، كما سيعرف جوانب جديدة للعم، وسيعرف الكثير من كواليس الحرب وحكايات الجبهة، والمعارك، والبطولات، لكنه سوف يصطدم أيضًا بحكايات مسكوت عنها، لم يرها في الأفلام ولم يقرأها في الكتب، حكاية تتعلق بخيانة أحدهم، وأخرى عن جنود تخاذلوا عن تنفيذ أمر قائد فرقتهم، فما كان منه إلا أن قتلهم عقابًا على تقاعسهم، الذي يعني في جبهة الحرب: خيانة!
في هذه الرواية، يبدو وكأن البطل يدفع ثمن إخفاقات لا تَخصُّه: هزيمة 1967، وقتل عمه عامر في حرب 1973، يحصد خيبات الماضي، ويطمح في أن يكون بطلًا بحساب زمنه، بطلًا ليس على الجبهة في مواجهة العدو، بل بطل في حصد الإعجاب والتفاعلات على صفحة الفيسبوك خاصته.
هناك طغيان للسرد الداخلي، وتداخل بين الحاضر والذاكرة، كما أننا أمام رواية متعددة الأصوات، إذ نجد عدة رواة،: الراوي الأساسي “محمد”، وهناك آخرين مثل “شاهين” و”سبيلة”، كما تراوح الضمير في السرد بين ضمير المخاطَب وضمير الغائب.
أيضًا نجد مقاطع طويلة من الصور، و الرموز، وأحيانًا الهلاوس، تُشبه تيار الوعي. وتتمثَّل الرموز في:
1- عملية الهدم والبناء في البيت المقابل: هي دعوة لتفكيك الأسطورة، وهدم الثوابت، والبدء من جديد.
2- الرصاصة: رمز للخذلان الوطني والانهيار الداخلي. والمفارَقة في كونها “رصاصة مصرية” تفتح جُرحًا في أسطورة البطولة، وتعيد تعريف من هو العدو: هل هو من الخارج أم من الداخل؟ كما أن تكرار الصورة الفوتوغرافية للرصاصة، يجعل منها رمزًا للحقيقة المؤلمة التي لا تُحتَمَل.
3- الفأر العملاق في مشهد الكاميرا: رمز للعبث والخوف الذي لا تفسير له. ربما يمثل السلطة غير المرئية، أو اليد الخفية التي تعبث بالمصائر.
4- الكاميرا والتصوير: التصوير هنا ليس فنًا، بقدر ما هو محاولة لفهم العالم وتثبيت معناه.
5- سقوط الطفل مصطفي: رمز لسقوط البراءة وزمنها.
6- وحين نتأمل رمزية شخصية منى، فهي تُمثل الشجرة المحرَّمَة، في زمن تُحَرِّم فيه السلطة الدينية والوصاية المجتمعية كل شيء، وقد أصبح الحب فيه مستحيلًا.
7- وأخيرًا يرمز عنوان “منتصف الشمس” إلى تشوش الرؤية المستقبليَّة لجيل حَمَلَ على عاتقه هزائم أسلافه حتى تآكلت روحه، فأصبح لا يرى أي مستقبل أمامه.
لجأت مريم في أكثر من موضع لاستخدام الأحلام في نصوصها. فكانت أحيانًا بمثابة تحذير وأحيانًا أخرى بمثابة زف بشرى. وهي تكتب الرواية بروح وتقنيات القصة القصيرة، ربما لهذا نجد حكايات منثورة هنا وهناك، لكنها في النهاية تصنع سرديتها الكبرى. ولا يمكن إغفال التكنيك السينمائي الذي استخدمته في هذه الرواية: اللعب بالزمن؛ تقديمه وتأخيره، وكذلك تقاطُع المشاهد.
تمتلك مريم مصداقية الكتابة؛ فهي حين تتحدث عن الحرب، نجد أنفسنا في قلب المعركة، نسمع صوت طلقات الرصاص، ونرى الدماء والأشلاء المتناثرة، وحين تتحدث عن التصوير، فتبزغ أمامنا العدسة، والزاوية، والمشهد المُلتَقَط، وحين تتحدث عن المدرسة والمدرسين، نجد أنفسنا بداخل حوش المدرسة، نحضر طابور الصباح ونسمع الجرس.
اللغة عند الكاتبة حِسيَّة وشفافة، وبرغم شاعريتها، إلا أنها تُشبه نصل سكين حاد يحفر في الجُرح والذاكرة الجمعية، تُشبه شظايا الحرب التي تقول عنها أنها تشطر الشخص نصفين، تشبه الأنين الذي كان يصدر عن “سَبيلة”، لغة تُكَبَّل بها قرائها، كما كبَّل “شاهين” زوجته بالأغلال والقيود، تكبلهم كي يتماهوا مع أبطال روايتها المُثقَلون بالأغلال.
تلك الرحلة الممتدة بين الماضى والحاضر، والتي يقبع البطل في منتصفها تمامًا، تُذكرنا بحياة جِدّه “التهامي” الذي اختار العمل في النسيج، فكانت حياته تُشبه تَسَحُّب خيوط النول من الأعلى والأسفل، وكذلك هي الرواية التي يتأرجح السرد فيها بين الأمس واليوم، وهي حياة أي فرد يقبع في المنتصف بين حاضره وماضيه.
بين ثنائية الماضي والحاضر، الحقيقة والزيف، الواقع والحلم، تضعنا مريم في المنتصف، وتترك لنا الخيار، مع توصية بعدم الإلتفات إلى الوراء، والمضي قدمًا، كخيار وحيد للتحرر من الأسر المجتمعي، وإرث الخيبات العائلية التي نحملها دومًا على كاهلنا دون أن ندري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدرت الرواية عن دار المحرر 2025، المقال نقلاً عن بمجلة الثقافة الجديدة