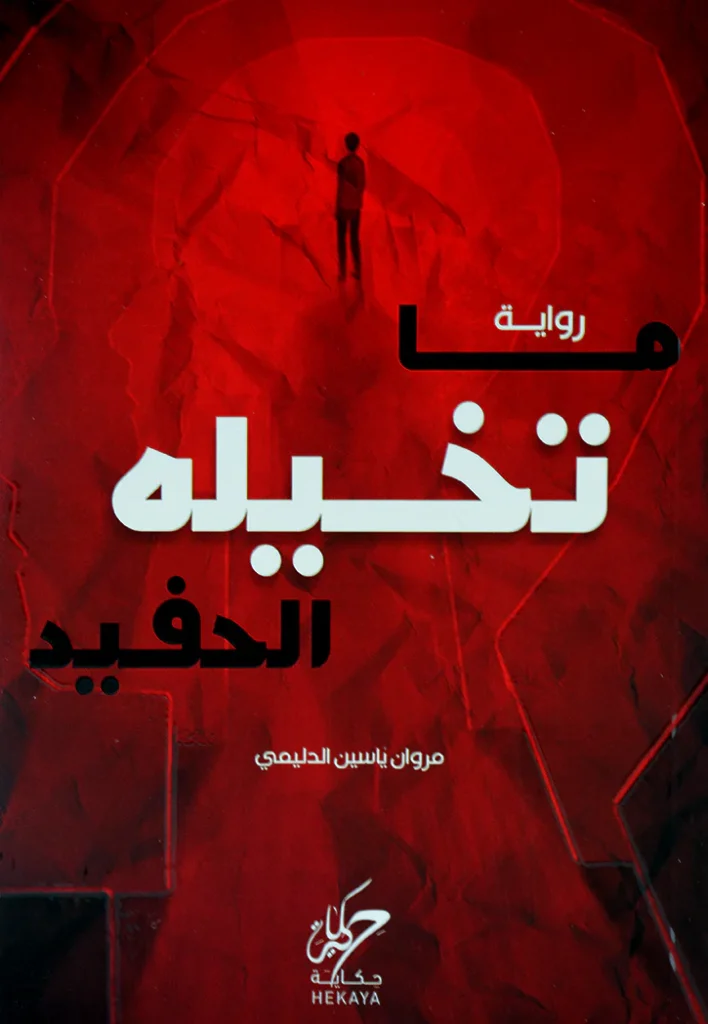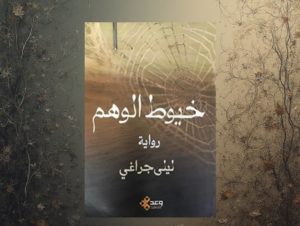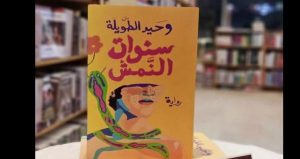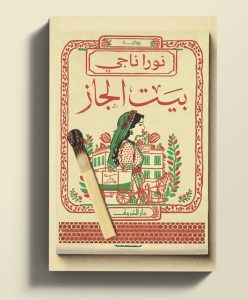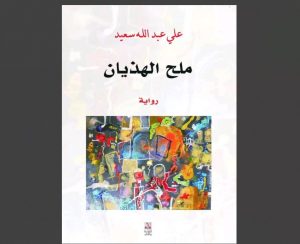بولص آدم
رواية «ما تخيّله الحفيد» للروائي العراقي مروان ياسين الدليمي، الصادرة عن دار حكاية للنشر والتوزيع في الكويت، تمثّل عملًا سرديًّا ثانيًا للمؤلف بعد «اكتشاف الحب» (دار نينوى، دمشق). غير أن هذا العمل لا ينخرط في قالب روائي تقليدي، بل يشيّد عالماً داخلياً معقّداً تتشابك فيه الذاكرة بالحضور والغياب، والتاريخ العائلي بالتخييل الذاتي.
ليست هذه الرواية مجرّد تأريخ لعائلة، وإنما محاولة للقبض على المسكوت عنه والمهمّش، وتحفيز الأصوات التي بقيت خارج السرد. وفي مركز هذا الفضاء، يبرز صوت الحفيد، لا كراوٍ تقليدي، بل كذات تعيد ترتيب العالم بما يعيد وصل ما انقطع بينه وبين ماضيه، وبين التجربة الحيّة وما تم كتمانه.
صوت الحفيد والسرد بوصفه مقاومة
يتقاطع الزمن الشخصي مع الجمعي في هذا العمل، ويغدو السرد أشبه بلوحة تتشكل من شذرات وتداعيات. تتسلل خلاله شخصيات الأب المتوفى، الجد الكاريزماتي، الأم الغائبة، وأشباح بيت قديم، أبرزها شخصية أمينة، التي تضيء بوميضها الخافت أكثر المساحات ظلمة في الرواية.
الرواية تغوص في عمق مجتمع رقابي كما تصوره فوكو، حيث لا تقف السلطة عند حدود الجسد، بل تمتد لاختراق الذاكرة وإعادة إنتاج السرد. وبيت “أمينة” ليس مجرد مكان، بل سجن ناعم، يُعبّر عن قمع لا مفر منه. في حين أن شخصية “شكيب” تجسّد نموذج الضحية المركّبة، واعتقاله دون تهمة يكشف هشاشة المؤسسة والخذلان الأسري معاً.
أمام هذا القمع، تظهر محاولة لمواجهة الخوف عبر الحب، لكن “سليمان”، الذي تَشرَّب الخوف، يهرب من حب “آمال”، الفتاة الكردية التي لا تهاب. في تلك التضحية العاطفية يتكثف المعنى: ليس حباً يُعاش، بل يُستبعَد، تماماً كما تُستبعَد الكرامة أحياناً لتقليل الخسائر.
الحفيد لا يكتب بحثاً عن استعادة، بل كمن يقاوم النسيان ذاته. يتلمّس أثر الأب، يعيد تشكيل الذاكرة الممزّقة، حيث يصبح يوم “الاثنين” رمزاً للذلّ والتكرار والانتظار أمام السجون. ليس الهدف إنقاذ أحد، بل تخليد ما يُخشى ضياعه. فشخصيات الرواية: أمينة، شكيب، سليمان، آمال، وغالب، ليست محض أسماء، بل صور متكسّرة لجراح وطن، تنبعث في الحفيد الذي يكتب لا ليبرأ، بل ليبقى الأثر حيّاً.
أمينة: بلاغة الصمت وحراسة الذاكرة
أمينة في الرواية ليست شخصية تقليدية، بل مركز جاذبية هادئ، رمز تتكثف حوله طبقات المعنى الأكثر حساسية. المرأة التي تسكن البيت القديم، تحرسه بصمت لا ينبع من خضوع، بل من موقف وجودي يمارس المقاومة دون صراخ. في عالم مكتظ بالكلام، تصبح أمينة درسا في بلاغة السكوت.
نفسيًا، تمثل نموذج المرأة التي حملت أعباءً ثقيلة دون صوت، تنتمي إلى جيل تعلّم التماهي مع الألم. لا تُصنَّف ضمن الضحايا المباشرين، لكنها تظل شاهداً على جراح لم تُلتئم. صمتها ليس فراغاً، بل درع دفاعي يُخفي هشاشة دفينة. لغتها تُشعَر أكثر مما تُنطق، وحضورها ينبثق مما لم يُقل.
اجتماعيًا، أمينة واقفة عند تقاطع زمنين: الماضي الجامد والحاضر المتشظي. بيتها لم يعد مأوى، بل مرآة للعزلة، بابه مغلق على زمنٍ غابر. لا تنتمي إلى الحاضر، لكنها تحتفظ بمفاتيح زمن سقط من الذاكرة الجمعية. هي الذاكرة التي لا تجد من يرويها، لكنها لا تنطفئ.
فلسفيًا، تمثّل أمينة تعبيراً عن الزمن المعلّق، الحيز الرمادي بين ما كان وما لن يكون. وجودها لا يُعرّف بالفعل، بل بالصمت، الصمت الذي يُنير لمن يُنصت. من خلال هذا الحضور الهامشي – والجوّاني – تصير أمينة مرآة هشاشة الحفيد، وأثر أمومة ضائعة لم تُفكّ شيفرتها بعد.
الرواية كمرآة لما لم يُحكَ
العلاقة بين أمينة واللغة تُقدّم مفتاحًا تأويلياً للرواية: اللغة عندها ليست أداة تواصل، بل وسيلة للصمت العميق. لا تحكي القصة، لكنها تُروى فيها. وجودها ليس شخصيًا فقط، بل رمزيًا، يمثل ذاكرة نسائية جماعية تم محوها من السرد الرسمي.
الحفيد يكتب من جهته بحثًا عن أصل مهمل، متتبعًا أثراً أنثويًا خافتًا في قلب التاريخ الذكوري. ليست أمينة مجرّد جدة نُسيت، بل سرديّة مغفَلة، تحوي هشاشة لم تُمنح اعترافاً يوماً.
في تحليل الشخصية، يتضح تفاعل أمينة مع ثلاثة أبعاد: البيت، الغياب، واللغة. البيت ليس مسكناً فقط، بل وعاء رمزي للمشاعر المكبوتة. الغياب لا يعني فقط اختفاء الأشخاص، بل تغييب المعنى ذاته. أما اللغة، فهي حالة وجودية معلّقة، صامتة، لكنها ثقيلة بالدلالات. في تقاطع هذه الأبعاد، تظهر أمينة كمعضلة الرواية المعاصرة في تمثيل النسوي والمقموع والهامشي.
تُجبر أمينة السرد على إعادة ترتيب أولوياته، تمنح المركز للهامش، لا تكتب، لكنها تُجبر الكتابة على أن تمر من خلالها. لا تحتجّ، لكن حضورها يخلخل النظام السردي من الداخل.
من الحفيد الذي يسعى إلى توازن ما، إلى الجدة التي لا تملك سوى الصمت، تنسج الرواية عالمها بين الصوت والصدى، بين ذاكرة مُغفلة ونسيان ثقيل. وفي زمنٍ يغرق في الضجيج، تبقى أمينة – بصمتها المُزلزل – شاهدة على أن بعض الحقائق لا تُنطق، بل تُشعَر.
تتجلى رمزية “أمينة” في أوسع صورها، لا كمجرد أم أو جدة، بل كقوة صامتة تقف بوجه نظام لا يرحم. حين عادت من زيارة ابنها المعتقل “شكيب”، قررت أن تمشي على قدميها بدلًا من الركوب، لا لسبب عملي، بل لأنها بحاجة إلى وقت أوسع للتفكير فيما يمكن أن يحدث. هذا القرار البسيط يلخّص الكيمياء الداخلية للرواية: حين يصبح الخوف مادّة، والمشي وسيلة لتأخير المصير. في وصف دقيق لحالتها النفسية، يقول السارد:
“كان عليها أن تجد أجوبة تخرس الهواجس المرعبة التي اشتعلت في داخلها، لكنها كانت تدرك أن الوقت بات ضيقًا جدًا، وربما ستنقطع سبل النجاة قبل أن تعثر على سلّم الخلاص من المتاهة التي سقطت فيها”.
بهذا تنتقل الرواية من الخوف الفردي إلى الرعب الجماعي. ليس الخوف تجربة ذاتية، بل مصيدة عائلية، بل وطنية.
رواية “ما تخيّله الحفيد” عن عائلة عراقية اجتاحها العنف السياسي، وهي انعكاس لمجتمع كامل غرق في القمع، وفقد الحنان، وسعى للنجاة في التخييل والحنين والذاكرة. إنها شهادة على ما لا يُقال، وما لا يمكن نسيانه.
في المحصلة، الرواية عمل متماسك، جريء، لا يمنح البطولة لفرد، بل يعرض شظايا أم وأب وأبناء وسجون، ومدينة تُمحى تدريجيًا. في هذا العمل، لا أحد يُنقَذ، ولكن الجميع يُروى. أمينة، سليمان، شكيب، آمال، وغالب، لا يتجسدون كأشخاص فقط، بل كعلامات حية لعراق مكسور، رآه الكاتب بصدق، وعبر عنه بجدارة سردية.