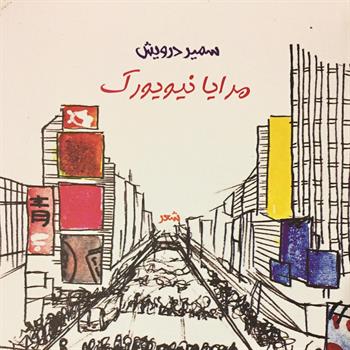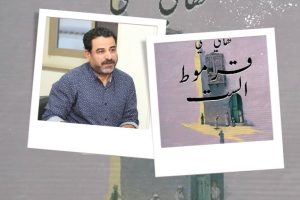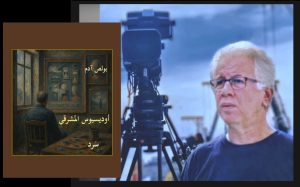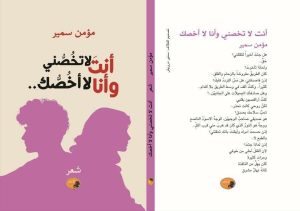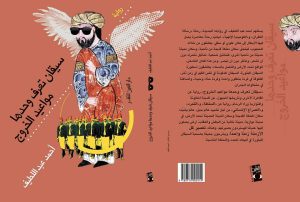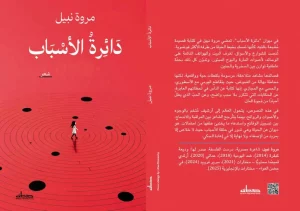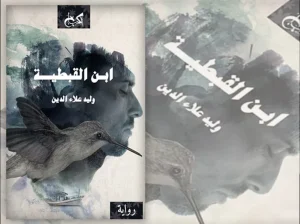د.محمد زيدان
الفكر الملحمي:
هل من قبيل المصادفة أن تكون القصيدة الأولي في نصوص “مرايا نيويورك” بعنوان “قبر ستالين”؟ وبخاصة عندما أعمد إلي اختيار المدخل الملحمي للقصائد التي تقدم تحولًا معنويًّا وشكليًّا في السرد الشعري المعاصر يسمح بتحويل وجهة النظر بين الراوي والمتلقي من إطار الواقع إلي إطار الملحمة. ليس في التشكيل الخارجي الخاص بالفكرة الملحمية ولكن في تشكيل الفكرة، والدلالات التي تتمحور حولها المعاني في النصوص، هذه المصادفة المخطط لها تقدم الطرح الأساسي في هذه القراءة، بداية من التأسيس الملحمي للقصائد إذا اعتبرنا أن الشاعر المعاصر يقدم مغامرة فكرية فريدة وسط هذا الكم الكبير من المظاهر المادية الطاغية، هذه المغامرة هي ما تجعله يتحرك بروح الملحمة، والتي تقدم تفسيرًا مبدئيًّا لحياة ما قبل التاريخ، حيث المواجهة الحتمية بين الإنسان والقوي التي تطارده، وهو في هذا الصراع المرير يقدم نفسه مخلصًا للآخر أحيانًا، أو لذاته أحيانًا أخري، هذا إذا لم يكن هو منقذ العالم من وجهة نظر القوى المصاحبة، وهنا تتحول رؤية الشاعر من مجرد فكرة تعبر عن حالة لغوية خاصة، إلى منظور يعبر عن حالة سياقية عامة، وبالسرد الذي يتضمن وجوده وجود الراوي والفضاء الممثل للحالة، حيث ينشأ ما يسمى بالسياق النصي في مجاز يمكن أن نملأ به أي ثغرة موجودة في النظام الذي يبني عليها الفعل داخل النص(1).
والراوي عند “سمير درويش” يتماهى مع السارد الفعلي في القصائد، وهو ليس الناقل العليم بالفكرة كما يشيع في النظرية السردية التقليدية، إنما هو الراوي الفاعل لحركة النص، أو هو الذي يقدم المنظور الحكائي لسرد يشبه فكرة الملاحم، وذلك عندما تتحول الذات إلى كيان يساوي الدلالة المصاحبة، حتى يقدم المقارنة المستحيلة بين روابط سردية تصلح أن تبني المنظور من أول جملة في السرد الحكائي الخالي من الحدث المكمل للفكرة السردية، ويمكنه في ذات الوقت ربط العامل الرئيسي في سياق جديد يؤسس لفكرة الملحمة كما أفهمها، كما يحاول السارد أن يقدم التصور الملحمي في إطار من الواقع الافتراضي الذي أصبح يسيطر على ملامح الأسلوب الشعري عند جيل كامل من كتاب القصيدة الجديدة.
يقول الشاعر:
القطاراتُ التي تطلقُ أدخنةَ الفحمِ،
التي في صدارتها نجمةٌ حمراءُ،
تلك، تحملُ فقراءَ،
وعمالَ مناجم،
وجثثًا،
وجنودًا بأرديةٍ ثقيلةٍ ووجوهٍ غائمةٍ،
وضباطَ أمنٍ منفيينَ،
هؤلاء الذين يتحيَّنونَ فرصًا ليسبُّوا “ستالين”،
وهم مخمورونَ تمامًا(2).
المنظور في القصيدة يقدم فكرة الملحمة من واقع الروح التي يحملها سياق يمتلئ بالمتناقضات الاجتماعية والإنسانية، ولا ننسي أن قصائد “مرايا نيويورك” تبدأ بنص عن “قبر ستالين”.
* فهل يحمل ذلك شيئًا من منظور المفارقة الفكرية؟
* وهل يحمل شيئًا من منظور المفارقة الثقافية والاجتماعية؟
* وهل الانبهار الذي حدث لموطن ستالين يشي بانبهار مماثل لموطن القصائد؟
هنا يمكن الخروج من دائرة البحث في السياق إلى دائرة البحث في الحركة التي يقدمها الشاعر ليعبر الطريق أمام سرد في مجمله يخلو من المجاز التصويري، ولكنه في الوقت نفسه يحمِّل المجاز الفكري عبء الخروج من التقرير اللغوي إلى الارتكان للروح الملحمي، وكل جزء في المنظور (وليس الصورة)، قطارات الفحم، والعمال والجثث والضباط المنفيين والمخمورون، ما هي إلا إشارات لما أسميه بـ”المجاز الفكري” الذي يمكن أن يكون مدخلًا أساسيًّا لبلاغة جديدة تؤسس لمنظور سردي جديد في الشعر العربي المعاصر.
فالشاعر وهو يحاول التقاط الإشارات الدالة على السياق النصي يفعِّل الصور الصغيرة التي تتحكم في الدلالة، ويقدمها في أشكال عدة لا تخرج عن كونها مدلولًا وليس دالًّا(3).
حكاية الملحمة:
ما يجعل النص عند “سمير درويش” أقرب إلي التصور الملحمي، هو هذا الرابط الخفي بين سطوة الدلالة في عنوان المجموعة الشعرية، وسطوة العناوين الفرعية للقصائد، حيث يتحول العنوان الرئيسي إلى رابط مكاني ودلالي يجوز التعويل عليه في فهم العلاقات اللغوية والمجازية، وهذا يمنح المنظور الحكائي أبعادًا ملحمية بعيدة عن ذات الإطار السابق، وتبقى الذات هي الشاهد الأقوى على هذا الرابط المعنوي الخالي من التشبيه التقليدي في العلاقات الاستعارية والكنائية والمنتمي بقوة إلي مجاز الأفكار الذي يتلاقي بسطوته داخل الراوي ليقدم السرد الحكائي مرة وهو يعتمد على تشكيل علاقات تنتمي إلى إطار التشكيل الفكري للملحمة، ويخرج بها لأثر دلالي أكثر قربًا من الذات، ففي العناوين الفرعية نجد “مطرب العواطف” والإشارة فيها إلى تسعينيات القرن الماضي تنسبه للواقع، وقصيدة “عيون بهية” والإشارة فيها للحكاية التراثية المصرية في علامات الجسد، والثياب، وحتي حركة المشي، وانتهاء بالمظاهر المنقرضة في الريف المصري، وإلى أن يأخذنا إلى قصيدة “قلب جوبلز” وزير الدعاية في حكومة هتلر.
يقول الشاعر:
لو أنني وزيرُ الدعايةِ في حكومة النازيِّ،
لن أكونَ بعيدًا ممَّا أنا عليهِ الآنَ:
أحبُّ البقاءَ طويلًا في غرفةٍ مقفلةٍ،
وأنظرُ من الشرفةِ كل حينٍ باحثًا عن مشهدٍ يأسرُني:
فتاةٌ، أو طائرٌ، أو عرَّافةٌ،
وسوفَ أركبُ الطائراتِ كي تحملَني
إلي مكانٍ أعرفُني فيهِ،
وربَّما سأحبُّ أن أكونَ فوضويًّا أكثرَ،
وأقلَّ دمويةً مما أراهُ داخلي(4)..
“سمير درويش” يقدم المنظور الذاتي للمكون الملحمي الذي يتحدث عنه، وحتى يعتمد على سرد يخلو من الأفعال، فهو يرتد إلى داخل الذات ليقدم المنظور الحكائي المرتبط بالهيمنة النفسية للفكرة، واستخدم في سبيل ذلك أسلوب “الأنا” ولكنها تساوي استخدام أسلوب “الهو”، لأن الفكرة هي التي يشكل بها دلالة السطوة التي تحملها مدينة مثل “نيويورك”، لينتقل إلى السطوة التي تحملها الفكرة الشعبية والحركة الشعبية في مواضع كثيرة، حتى يصل إلي سطوة المنظور الفكري –البصري- في هيمنة الذات على نفسها كبداية لتخلي الآخر عن دوره، وإذا كانت الفكرة شائعة الاستخدام، أن تتحدث باسم الآخر/ المهيمن، الآخر/ المنكوس، إلا أن الشاعر يحاول تغيير المسار المتعارف عليه في السياق، ليكون المنظور، منظور الراوي في التعبير عن التشكيل الملحمي الذي يسيطر على المجتمعات الأوروبية الآن،
فهم: الآلهة في مقابل الآخر البشري.
والصراع الطويل الذي يختصره الراوي وينهيه في حكاية عن الملحمة بصورة أكثر رومانسية من ذي قبل وهو إحساس يسيطر على أجيال معاصرة تنتشر في بقاع الدنيا، الإنسان الخالي من الدموية والذي يشبه الماء حين تغمر الرمال الظامئة.
أمَّا التحول الأكثر إلهامًا في “مرايا نيويورك” فهو الصورة الملحمية الذاتية التي يجعل منها الراوي صورة موازية للتشكيل الملحمي القديم، حيث تتحول الأفكار إلى أيقونات مادية، أو معنوية ليصنع منه الشاعر ملحمة خاصة يكون هو المحرك الوحيد لحركة الصراع في داخلها، وهو المرجو الوحيد لعوالمها، يظهر ذلك في القصائد التي تقدم الآخر الملحمي المنتمي إلى ذاكرة سردية الذهن فيها هو المكون لحركة السرد.
يقول الشاعر في قصيدة “الأحمر الشفاف”:
لماذا أحبُّ الأحمرَ حينَ يداهمُ امرأةً،
تبدُو شفافةً، وليِّنةً، ملساءَ، وأيقونةَ حزنٍ،
وعاشقةً كلاسيكيَّةً، وأستاذةَ فقهٍ لغويٍّ، ورؤومًا؟
أو ربمَا أحبُّ المرأةَ التي تداهمُ الأحمرَ،
حينَ يكونُ مستكينًا في خزانتِهَا،
كي تبدوَ نمرةً، أو غزالةً، أو سورةً من القرآنِ،
أو حصانًا بريًّا لم يفلحْ تاريخُ الرجولةِ في ترويضِهِ؟(5)
حوار العلاقات المكونة للنص يعطي فكرة الملحمة سطوة ظاهرة على التشكيل الفكري للمجاز في السرد الشعري، وهنا تصبح قراءة العلامات اللغوية أكثر قربًا من قراءة الجملة حيث البحث عن المكونات الجمالية للقصيدة، فنرى:
– الفكرة المجردة هي التي تؤسس للظاهر المجازي.
– تحويل المرأة من مجرد علامة للدلالة إلى حسٍّ ملحمي.
– الإضافات الموصوفة توازي بين ما يمكن أن نسميه العلاقة بين الإشارة الدالة على مفردة واحدة في المنظور إلى ما يشير إلى عالم من الأفكار والمجازات التي يعتمد عليها الشاعر في تحويل الأفكار العادية إلى أفكار ملحمية، كما يصف المرأة بأنها “سورة من القرآن”. وهنا تتداخل المفاهيم الدالة على حركة النص لتحدث وقفة مع المعنى الخاص لفكرة وصف المرأة بهذا الشكل، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يحاول الراوي تقديم العوالم الافتراضية الجديدة في صورة ملحمية، كما يفعل في قصيدة “الخبز الحافي” والتي تشير إلى رواية المغربي محمد شكري حيث سطوة البيئات العربية الأكثر عنفًا وقسوة في تحويل الذوات إلى أقل من مرتبة الحيوان وهي تبحث عن حياتها في فترة الاستعمار في المغرب أو في أي دولة عربية، وهي إشارة ملحمية أيضًا، أو تحويلية في جذب المعني السائد حتى مع البيئات العربيَّة المعاصرة إلى منظور القصيدة يحول المجاز فيها من مجاز الشكل إلى مجاز الفكر أيضًا. أما الإشارة المباشرة إلى الحركة الملحمية فيمكن أن تتجلي في قصيدة “عروس البحر”، والتجلي هنا هو التجلي الفكري الباعث علي جذب الدلالة وليس التجلي من داخل الملحمة الأسطورية، والدلالة هنا هي دلالة الخروج من الإطار الفكري المباشر الضيق للأشياء إلى الإطار الذي يعتمد على التخيل كمذهب واقعي، والخروج أيضًا فكرة ملحمية، تبدأ من الخروج من الجنة للإنسان الأول ومرورًا بسفر الخروج في العهد القديم، وحتى آخر خروج للشعب الفلسطيني من أرضه، والشعوب العربية الأخرى، أما الدلالة الأكثر شيوعًا في هذا التحول المعنوي تجاه صنع ملحمة ظاهرة المفردات فيمكن أن نجده من منظور القصيدة بشكل واضح عند “سمير درويش”، ففي “عازفة الجيتار” يحول المرأة أيضًا والتركيز عليها بادٍ في النصوص إمَّا بالشكل المباشر، أو بالشكل الإشاري من صورة مادية الجسد فيها هو سيد الإشارات إلى صورة ذهنية، الصراع هو سيد الموقف الفكري والسردي في آن واحد.
يقول الشاعر:
الأنبياءُ يتناوبونَ السهرَ حولَ قوائمِ سريري
والطيورُ تبيضُ، والعناكبُ تغزلُ أعشاشهَا
والثعابينُ تدخلُ الشقوقَ
والسحرةُ مربوطونَ من خلافٍ
لأنَّني قررتُ أنْ أنغمسَ في النغماتِ الإسبانيةِ
ومراقصةَ حورياتِ العينِ
وتدجينَ الأوزِّ البريِّ
(اقرأْ)
ثمَّ ضوءٌ ساطعٌ ينفلتُ من فتحاتِ القميصِ
ونغماتٌ تتمشَّي على سجادةِ الأرضِ
(اقرأْ)
كيف ينفتحُ البابُ من تلقائهِ يا ربُّ
وكيفَ تساقَطَ الأوزُّ بغتةً من فتحةٍ بالسماءِ
(إني قد آنستُ نارًا)(6).
السرد يتنقل من الذهنية الخاصة بالراوي من أول الحديث عن الأنبياء، وحتى قوله “إني آنست نارًا”، والمنظور بينهما يمر بعدد من التحولات في الفكرة الملحمية وارتباطها بفكرة الواقع وحركة الإنسان المنغمس في واقع افتراضي، وحركة الأشياء من حوله صورة ملحمية للواقع ذاته، والتحول إلى “إني آنست نارًا” بمباشرة من الأنا.
وهذا التحول جذري في الخروج من الحالة الملحمية إلى الدخول في حالة التوحد مع حالة النص القرآني في جو طور سيناء والله يتجلي لموسى في ذات الوادي، وكانت علامة التجلي هي النار التي يتحول موسي بعدها من الطبيعة البشرية إلى الطبيعة النبويَّة، وهي مرحلة لها مفرداتها في النص القرآني، إذا قورنت بمفرداتها في النص الشعري، يقول “بول فاليرى”: “إن الشاعر في رأيي يعرف ما يبيحه لنفسه من حريات وهو في هذه الحالة يختلف عن بقية الناس ويقضي على القيود التي تحد من حركة الناس، إنه يفهم ويذوب داخل الحالة التي يتحلي بها”(7).
وهذا ما يقدمه الراوي حينما يحول الحالة الإنسانية التي تبدو في الظاهر عادية إلى حالة ملحمية تضع مفرداتها في سياقها الخاص، وإذا حاولنا المقارنة بينها من المراحل التي مرت بها الملاحم، فلن نجد إلا الطرح الفكري الذي يحتوي ذاكرة الإنسان.
التفكير بالروح الملحمية:
يقول الشاعر:
وأنتِ تعاركينَ أمواجَ البحِر كجنيٍة تحبُّ الموسيقى
تذكري أنني أجلسُ علي كرسيٍّ منعزلٍ
أراقبُ الأطفالَ وهمْ يتقاذفونَ الكرةَ
ويحفرُونَ آبارًا ضحلةً..
وأنت تمشينَ نحوي بقدمينِ حافيتينِ
سيكونُ ثمةُ معني لخوفي الفطريِّ
كي يحتفظَ البحرُ بانفعالاتِ جسمكِ(8)
الدخول إلى النص بالمفردة الخارجة من إطار الفكرة الملحمية يحول الصورة كلها إلى صورة ملحمية حتى وإن حاول الراوي ربط مفردات الحركة في السرد الشعري بفضاء واقعي، والعلاقة الخفية التي تربط بين العالمين هي جزء من مكونات الذاكرة الحديثة كما يشكلها الشاعر في علاقاته بهذا العالم الملحمي الذي يقدمه في صورة قريبة من بعضها ليجعل الدلالة في النهاية دلالة متشابكة، الفاعل فيها هي الذات الراوية، والروح فيها هي الملحمة المصنوعة من فكر الواقع، ومن مجاز التفكير السردي في عالم من الانتصارات الشكلية، والانهزامات الخفية للإنسان المعاصر، وهو في هذه الرحلة لا يتخلى عن ترسيخ الفكرة الأكثر سيطرة علي الدلالة.
إن ثمة عالمًا افتراضيًّا يجب أن يعيشه الإنسان، سواء في التصور، أم في الغناء، أو التوحد به، فمن قصيدة “يلضم المجرات” التي يحدد فيها صورة واقعية بحسٍّ ملحمي لم يستخدم فيه إلا القليل من الحركة، إلى قصيدة “حور العين” التي ينتقل فيها من عالم الشهود إلى عالم الغيب، وكل العوالم التي استأنس الراوي بها في هذه الرحلة هي عوالم غيبية، وإن كانت تشي في الظاهر بأنها عوالم شهود، تتجلى سطوة هذا الغيب في بداية النص حينما يقول الشاعر:
قلتُ لحبيبتي إنني أريدُها معي في الجنةِ
سوفَ أطلبُهَا من اللهِ رفيقةً
وأنا في الخطوةِ الأخيرةِ
من السراطِ المستقيمِ
الذي يحفُّه ملائكةٌ وشياطينْ
قلتُ لها إنني سأكونُ خفيفًا كطائرٍ
شفيفًا كضوءٍ
التحول بالصورة من عالم إلى آخر تحول بالفكرة من مستوى إلى مستوى آخر يوازي به عالمه غير المرئي، وهذا يتعدى بذاكرة الراوي إلى تحديد العالم الجديد، الذي يتعالى عن كونه مجرد عالم افتراضي ليقدم الصورة على النحو الآتي:
– الإضافة الملحمية إلى الذات.
– المكون الجمالي لعالم الغيب.
– التصور الفكري ينحاز إلى عالم الإيمان.
– المفردات واقعية تشير إلى مكونات ترتبط بالذات.
وبالحسِّ الملحمي ذاته ينتقل الشاعر بين المفردات الحكائية التي تبني سردًا شعريًّا أقرب إلى صنع الحكاية الذاتية، وتشكيل عوالم لواقع افتراضي يخرج من ذهنية الراوي إلى مادية تطغى أحيانًا وتغيب أحيانًا عن الصورة الظاهرة.
إن النص الشعري عند “سمير درويش” يتجاوز الصورة الشعرية التقليدية إلى المتطور السردي القائم على تشكيل مجازات صغيرة وكبيرة من الفكرة، وتحويل المادية الظاهرة إلى عينية محتملة، وفي إطار من التشكيلات الملحمية التي تقوم على مبدأ الصراع بين ذات وأحوال كثيرة متعددة تتردد أصداؤها في عوالم الذاتية الحاكية والمحكي عنها.
الهوامش:
1- د.محمد فكري الجزار. البلاغة والسرد، القاهرة: الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة 2013، ص345.
2- سمير درويش، مرايا نيويورك، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب 2016، ص7.
3- د.محمد زيدان: حكاية الراوي في النص الشعري. الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2016، ص99.
4- المصدر نفسه، سمير درويش، ص14.
5- المصدر نفسه، سمير درويش، ص15.
6- المصدر نفسه، سمير درويش، ص56.
7- بول فاليرى، الرؤية الابداعية، ترجمة أسعد حليم، الهيئة المصرية العامة للكتاب 2012، ص31.
8- المصدر نفسه، سمير درويش، ص84.