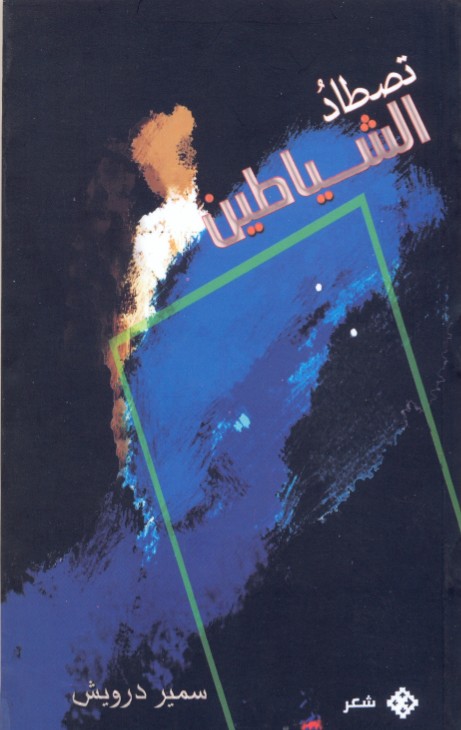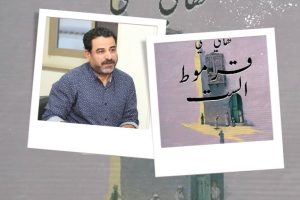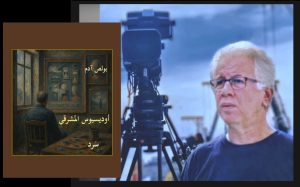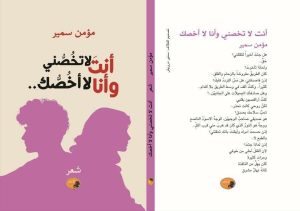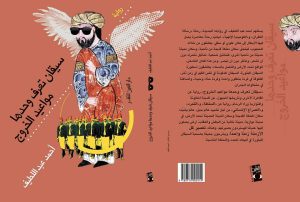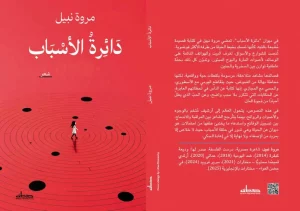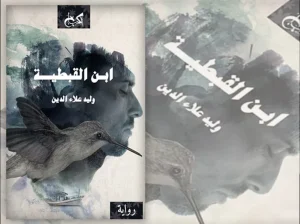د.نزيهة الخليفي
على سبيل التقديم:
يتسم ديوان تصطاد الشياطين للشاعر سمير درويش بكونه ينبني جوهريًّا على نزعة تجريبية تهدف إلى تأسيس حدث الكتابة على نحو جديد في الثقافة العربية. ذلك أنه يشكل سيرة الشاعر الذاتية وقد صاغها في قالب نص شعري يلخص تجربته مع المرأة وتناقضاتها المتقلبة والمتنوعة، مستوعبًا بذلك كل خبراته وعلاقته بالمرأة الرمز. ولعل هذا الديوان يحمل نبرات كثيرة، وينبني على أصوات متعددة ومتداخلة، توهم في أكثر من موضع بأنها حشد كبير من القصائد تعطل تصاعد النص، ولكنه في الحقيقة قصيدة كبرى هي قصيدة النثر في ثوبها الجديد، تصور صراعًا وحوارًا بين الشاعر والمرأة في صورها المتنوعة والمتعددة والمتقلبة.
I- تصطاد الشياطين وقصيدة النثر:
يعد ديوان “تصطاد الشياطين” قصيدة كبرى تحكي قصة مطولة عانى الشاعر عذاباتها عبر الكتابة وعبر شخصية المرأة في حوارية تقوم على المتناصات والرموز والصور والأساطير وعلى تحرر اللغة وانفتاحها على الأشياء، إنها لغة اللعب الحر حيث لا قواعد سوى التي تنشأ في سيرورة اللعب. إنها القصيدة الحديثة القائمة على الخلق والابتكار “يقدم فيها الشاعر للمتلقي ما لم يعرفه من قبل في بنية شكلية جديدة”(1). والحداثة ليست الانفعال أو تقديم تجربة الشاعر الشخصية، إنما هي اندماج عناصر القصيدة في بنية فنية متكاملة، يتكامل فيها البناء مع الدلالة، إنها بناء آخذ بعضه برقاب بعض، فيه تحيلنا الألفاظ إلى بعضها البعض، ويحملنا الدال إلى دلالة تقودنا بدورها إلى دفق من الدلالات الجديدة. ولعل هذا ما جسدته قصيدة النثر مع سمير درويش، والتي “حررت الشاعر من الأساليب الموروثة وأفهمته أن الشعر ليس هو الكلام الموزون المقفى، بل هو التعبير الشخصي الفريد عن رؤيا الشاعر الشخصية الفريدة، فالشاعر وإن كان يعيش لأجل الآخرين، فإنه يموت عن نفسه ولنفسه”(2).
وهو ما دفع سوزان برنار إلى تحديد المكونات اللغوية والنصية لقصيدة النثر في ثلاثيتها القائمة على الوحدة العضوية المستقلة والمجانية والإيجاز. وهي مكونات عدتها من الشروط المشكلة لقصيدة النثر. ذلك أنها ألغت بمقتضى المكون الأول، كل النصوص التي كتبت في إطار أعمال ونصوص أخرى لم تكن غايتها موجهة بقصد الكتابة الشعرية في قصيدة النثر. وبمقتضى المكون الثاني، تستبعد برنار الأعمال ذات الغاية النفعية أو البيانية أو السردية رابطة المجانية بما سمته بـ”اللازمنية”. وتقصد بالشرط الأخير ألا يكون لقصيدة النثر هدف أو تركيب تطوري وتعاقبي كما في الفنون الزمنية. إذ ليس في قصيدة النثر-في رأيها- ديمومة كديمومة الرواية، وفي هذا المجال تقول: “إن الرواية تتطلب ضرورة تركيبية لكي تنتظم في ديمومة ولكي تعرض في شكل جريان زمني، كما في الروايات الحقيقية حيث نستطيع أن ندرك فيها تقدمًا ونميز مراحله. أما القصيدة، فتعرض في شكل كتلة وتركيب لا يتجزأ”(3). أما الشرط الثالث، فقصدت منه برنار إبعاد النثر عن قصيدة النثر، وتعزيز فعالية الوحدة والمجانية فيها. إذ لكي تكون قصيدة النثر غير ذات غايات نفعية وتفسيرية وسردية وبيانية، لا بد لها من أن تكون بالغة الإيجاز والكثافة، تقول في ذلك: “على قصيدة النثر أكثر من قصيدة الوزن، أن تتجنب الاستطرادات وما ماثلها، وكذلك التفاصيل التفسيرية، وكل ما يقودها إلى أنواع النثر الأخرى، أو يضر بوحدتها وكثافتها”(4). ولعلنا بهذا المعنى ندرك أن سوزان برنار لم تقم باختلاق هذه الشروط وفرضها على قصيدة النثر، بل لم تصل إليها إلا بعد تهيؤ عدد من المعطيات لم يقف عندها التعريف العربي.
غير أن أدونيس يعتمد مقولات برنار هادمًا بعضها ببعض، حيث يحتفظ منها بازدواجية مبدأ الهدم والبناء رابطًا مفاهيم الشعر باحتمالات وضرورات التغيير والتجاوز. وأول ما عرضه أدونيس للهدم، مقولة الوحدة العضوية والإيجاز، وبدل ذلك يتحدث عن التنوع والحرية واللاشكل. وفي خطابه هذا تتجاور أربعة مصطلحات تنويعية Générique متشاكلة في إفادة صيغ للعبور النوعي وهي:
1- نوع الكتابة: ويقصد به الشكل الذي يتداخل فيه النثر والشعر والقصة والمسرحية.
2- القصيدة -الدفقة الكيانية أو القصيدة- الرؤيا الكونية: ويقصد بها حسب تعبيره: “قصيدة تنمو في اتجاه الأعماق، في سريرة الإنسان ودخيلائه وتنمو أفقيا في تحولات العالم”.
3- القصيدة المنفتحة ذات الشكل المنفتح: وهي التي ينتفي فيها الشكل المنغلق مستبدلًا بالآخر “المنفتح الكثير اللانهائي الذي بواسطته يتجاوز الشعر حدوده النوعية القديمة”.
4- القصيدة الكلية: وتتداخل فيها الأنواع التعبيرية المنثورة والموزونة والغنائية والمسرحية والملحمية والقصصية وحدوس الفلسفة والعلم والدين(5). غير أنه يستحسن التعامل مع قصيدة النثر تعاملًا مرحليًّا إجرائيًّا يتجاوز إشكالاتها الكبرى إلى تمظهراتها الجزئية النصية باعتبارها “نوعًا شعريًّا ملتبسًا ومتحركًا، لا يتحدد إلا من خلال التعدد والانشطار، لا من خلال الوحدة.”(6). ولعل هذا ما دفع أنطونان أرتو إلى القول: “لم أحتمل قط عزف نصوص الشعراء (..) النصوص الشعرية لا تُفسر”(7). إن قصيدة النثر بهذا المعنى، تقوم على التنوع والتعدد على مستوى البناء والدلالة، أي على مستوى الأساليب والصور ومعانيها، وتقوم أيضًا على التفكك والتجزؤ، وهو مظهر من مظاهر التجريب في الشعر العربي الحديث. لذلك سنعوِّل -في ديوان “تصطاد الشياطين”- على الإصغاء إلى صوت النص ورصد اندفاعاته في سكناته وحركاته، وتمكينه من الإخبار عن كيانه وعن دلالاته الثواني الثاوية طي اللغة المعتمة، والقائمة على الرموز والانزياحات الدلالية. وهو مبحث توسلنا له سبيل المرأة الرمز في قصيدة النثر من خلال الديوان، مجالًا نسعى عبره إلى الكشف عن ذلك الماوراء الذي ترتاده القصيدة فيما هي تتشكل ومحاصرته وكيفية توظيفه في بنية القصيدة وتوظيف بنية القصيدة نفسها بوصفها رمزًا. ذلك أن المرأة الرمز لا تتضح صورها إلا باستنطاق مكامن النص بناء ودلالة والوقوف على رمزيتهما في تشكيل صورة المرأة. باعتبار أن ديوان “تصطاد الشياطين” يعد من الأعمال الشعرية الهامة التي تتناول الحديث عن المرأة العربية واجتياز مناطق الجسد الأكثر تعتيمًا ومحاصرتها والبحث فيها. وهو عمل يطمح عن جدارة إلى إضاءة صعبة لأشد مناطق المرأة عتمة، إنها محاولة لمحاصرة تلك اللحظة التي يمثل فيها الشاعر في حضرة المرأة، وتأتي المرأة لتتراءى كالمخاتلة، تمثل في حضرة الشاعر وعدًا لا يمكن الإمساك به. وهي لحظة متميزة، متفردة، إنها لحظة الميلاد العظيم.
ولكن كيف يفك مغاليقها ويمزق جدار صمتها؟ كيف يرصد حركاتها وسكناتها؟ وكيف يلملم شظاياها والحال أنها تتمرأى في النص في صور متعددة وفي دفق من الدلالات والأبعاد المتنوعة والمتحولة؟
II-المرأة الرمز:
تعد صورة المرأة في الشعر العربي الحديث من أشد المناطق عتمة وأعمقها تسربلًا بالغموض نظرًا لقيام النص الشعري على الرموز والإيحاءات والانزياحات الدلالية، وما يحتويه من تصريحات واضحة وإخفاءات ضمنية، تترك به فجوات يقتضي البحث فيها قارئًا يقوم بملئها والمضي على دروب الكشف ومعاناة الفهم. ذلك أن النص الشعري له طاقة كبيرة على التدلال، وقدرة فائقة على إخفاء المعاني وحجبها والتعمية عليها. فالمعاني لا تتمرأى عارية ولا تهب نفسها لقارئها منذ الوهلة الأولى، بل تتأبى عليه وتستعصي عنه. ولعل ديوان “تصطاد الشياطين” يعد محاولة شاقة دائبة أفلح في إضاءة المشهد الرمزي المشكل لصورة المرأة عبر مختلف المراحل والطرق إلى حد جعل منها فضاء للتفكير والتساؤل والبحث عن إثبات كيانها في النص الأدبي عمومًا والشعري على وجه الخصوص.
1- دلالات العنوان: “تصطاد الشياطين”
ورد العنوان من جهة التركيب، جملة فعلية فعلها “تصطاد” وفاعلها مقدر يعود على المؤنث ويمكن أن نفترض فيه المرأة، ومفعولها “الشياطين” الدال على شخصيات غير حقيقية تعيش في عالم لا مرئي. ومن ذلك ندرك أن التركيب اللغوي في العنوان العام للديوان ينشد إلى الحذف والتقدير واللامعقول، ويستدعي جهدًا تأويليًّا يملي ضرورة البحث في المقدر والمغيب وكيفية تعامله مع اللاعقلاني وهو ما يفترض إمكانية الحراك الدلالي. وأما من جهة الدلالة، فلا تتضح إلا بضرب من التأويل، مما يدرج عنوان الديوان ضمن العناوين الغرضية الإيحائية التي تستعيض عن وضوح المعنى بالرمز والإشارة. فــ”تصطاد الشياطين” عنوان يجمع بين ثنائيات عديدة منها: الحقيقي والخيالي، المطلق والمقيد، المنفتح اللانهائي والمحدود الآتي، الواقعي واللامعقول.. فمن خلال العنوان الرئيسي نقف على عتبات الرمز التي تنطوي على أسرار وهواجس وتأملات تسكن الذات تأسيسًا للفوضى داخل النظام ما دامت الكتابة عند “سمير درويش” خرقًا دائمًا لمنطق الأشياء ومعقوليتها. إنها تأسيس للامنطق وكسر لأنساق المعرفة العقلية بحثًا عن كائن رمزي جديد لا تتحدد سماته وعلاماته، كائن يروم الحياة من خلال الموت ويروم الموت الذي به يتجدد. لهذا جاء العنوان مكثف برمزية التناقض (المحسوس والمجرد/ المرأة/ الشياطين) الذي يشكل وحدة الرؤيا، فوارة بجدل الحركة والثبات وحوار الأشياء تنمو وتتوالد، تتجسد وتتحنط، تموت وتنقضي في حركة لا تني. والعنوان في صياغته المختزلة لا يوحي داله بمدلوله، ولا يحيلنا مدلوله على النص وإنما هو تعبير عن مشهد، عن موقف، عن لوحة تختزن دلالتها خارج عنوانها وداخله في آن.
هكذا يظل العنوان مشهدًا رمزيًّا ومفتاحًا رمزيًّا يثوي داخل مكونات النص. ويغدو العنوان بما يحيل عليه من دلالات مدخلًا لتفكيك عالم الشاعر الرمزي الذي ينهض على خاصية الغموض، وما البناء أو أشكال الكتابة إلا وجه من وجوه الأسلوب الرمزي الذي يمكن أن يفضي إلى تنوع الدلالات الرمزية.
أليس العنوان بوابة تحمل القارئ إلى مجهول النص؟ ويظل العنوان يخفي أكثر مما يبوح ويحجب أكثر مما يُظهر فيغرينا بالرحيل إلى عالم القصيدة الذي ينير ما طواه العنوان من دلالات.
2- المرأة/ العشق:
يوظف الشاعر العديد من المتناصات ليرسم صورة المرأة ويجعل منها رمزًا مفتوحًا لإمكانات التحقق الكينوني. فهو دائم التحول من سياق فقد وغياب شطره الضائع من كينونته، إلى سياق حضور هذا الشطر، مرموزًا له بالمرأة. إذ ما ينفك ينفذ إلى عالم المرأة لينتشل عبرها وضعه الكينوني من خطر السقوط في هاوية الفراغ والعدم، والشعور بالفقد والغياب، ليس فقط فقد وغياب المرأة/ الرمز، وإنما فقد وغياب كل ما ترمز له المرأة. أو لنقل إن الشاعر ما فتئ يسعى، من خلال رمزية المرأة، إلى الكشف عن ذاته، والكشف عن إمكاناته في القول المختلف المجسد حضوره في آفاق الفعل المختلف. لذلك يتناص مع العديد من النصوص الشعرية والنصوص الدينية ليرسم صورة المرأة الرمز عبر صيرورتها التاريخية. إذ نلفيه يتناص مع شعر محمود درويش إثر قوله: “يجب الذي يجب”(8) وهي لازمة تكررت في قصيدة مديح الظل العالي من ديوان الأعمال الكاملة:
“وأَنا التوازُنُ بين ما يَجِبُ:
يجبُ الذهابُ إلى اليسارْ
يجبُ التوغلُ في اليمين
يجبُ التمترسُ في الوسطْ
يجبُ الدفاعُ عن الغلطْ
يجبُ التشكك بالمسارْ
يجبُ الخروج من اليقينْ
يجبُ انهيارُ الأنظمةْ
يجب انتظارُ المحكمةْ”(9)
وتحيل هذه اللازمة على الوجوب وضرورة الفعل، ففعل “يجب” يتوغل داخل فضاء السطر الشعري تاركًا فضاءً يوحي بتطور الحوار مع الشاعر. مما يعطي الإحساس بإمكان تحقق الحلم عبر تداعي المصادر من ذلك (الدفاع- التمترس- انهيار- انتظار..) المحيلة على التحقق وكسر القيد وإن هو لم يتحقق بعد. وهو حلم تواصل ليتحقق مع “سمير درويش” إثر قوله:
“كعادتِكِ انزويتِ..
قُلتِ: “يجبُ الذي يجبُ”
وضعْتِ محاذيرَ الجَداتِ أمامَ انْدِفَاعَاتِي..
أنا: مشعلُ النارِ
واهبُ البهجةِ الذي ليس كمثلِهِ أحدٌ
وواضعُ اللبِنَةِ الأخيرةِ في الجدارْ.(10)
نلاحظ أن مواجهة الشاعر تتم عن طريق الحوار مع المرأة، إذ لم يعد خائفًا متحفزًا من مواجهتها، ولم تعد الأفعال تحتشد وتتوالى صوتيًّا ودلاليًّا ولغويًّا لتعكس حالة التوتر المتصاعد، بل حلت محلها أسماء الفاعل (مشعل- واهب- واضع..) حيث نجد فضاءً إيقاعيًّا متحركًا متنوعًا راقصًا فيه يتحقق الحلم، وذلك بإخراج المرأة من صمتها بعد أن ظلت تعيش لحظات محجبة، متكتمة على نفسها متسترة في غاية التستر لا تخبر عن ماهيتها ولا تقول خباياها إطلاقًا. ولكن ألا يعد ذلك مظهرًا من مظاهر التأله ومعانقة المطلق؟ أليست المرأة هي الرمز المطلق في الديوان؟
ويتناص الشاعر أيضًا مع قصيدة الملوح بن يزيد في قوله: “ألمْ تجمعِ الشتيتيْنِ بعدما ظنا ألا تلاقَيَا؟”(11). وأصل البيت هو: “ألم يجمع الله الشتيتين بعدما/ يظنان كل الظن أن لا تلاقيا” وهو في حد ذاته تناص مع القرآن الكريم وخاصة سورة الممتحنة في قوله تعالى: “عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة”(12). وهو ما يعني أن الشاعر قد عانى مخلفات الصراع والرحيل نتيجة الصد والتمنع الذي ظلت تعيشه المرأة ولكنه صراع يعقبه تصالح ولقاء.
وفي جانب آخر من الديوان يصور الشاعر المرأة راسمًا ملامحها ليدحر بذلك سلطان الصمت الذي ظل يلفها ويجعلها في حضرة الخفاء والتكتم. وذلك من خلال وصفها الوصف الدقيق نافذًا بذلك إلى أعماق نفسيتها وتصوير ما يداخلها من خلال قوله:
فطَفِقَ الدمُ يخرجُ من عُرُوقي ليُلامِسَ أناملَهَا،
وانفتحتْ على مصراعيْهَا عظامُ قفصِيَ الصدري
ليكتُبَ النبْضُ خلجاتِهِ على كفهَا قصيدةً:
مفتوحةً على كل حالاتِهَا
ومغلقةً على حالةٍ سأظل أسيرًا بها.”(13)
إن هذه الصورة قد حولت المرأة إلى متنفس يحيى به الشاعر أوان إنصاته لنبض خلجاته وعلى وقعها أخذ في الكتابة والرسم بالكلمات على جسدها ونفسها موغلًا في أدق تفاصيل خباياها، باعتبارها من المناطق الضرورية التي يجب ارتيادها أوان نهوض حدث الكتابة، ذلك أن الشاعر نفسه يعجز أحيانًا عن الوصف والإخبار عن أدق تفاصيلها، وأحيانًا يتسلل إلى خبايا نفسها ويصف لنا تلك اللحظة وما الذي يحدث فيها. فتبدو المرأة لديه كما لو أنها منشغلة بذاتها مستقلة عن الشاعر، مفتونة بكيانها عن القارئ ولا شيء يعنيها غير هديرها واندفاعاتها، كما في قوله:
سحبتْ كفهَا بتأنٍّ
كي لا ألمَحَ النارَ التي تغزُوَهَا
رسمتْ نظرةً لا مُباليةً على وجهِهَا
وقالتْ: ماذا؟
مجردُ قلبٍ ينبضُ!
..
العاشقاتُ لا يَقُلْنَ الحقيقةَ..
دائمًا!(14)
بهذه اللامبالاة والتمنع والغرور تبقى المرأة سرًّا مقفلًا حتى يتنزل في رحاب ما لا يقال، ولعل الشاعر بذلك يظل ماثلًا في حضرة المرأة أسيرًا يطلب الحرية، وقد اختار من الزمان زمن الليل والظلمة باعتباره زمن السكون والهدوء والبوح بالأسرار المقفلة والمناجاة ومع الصمت ينتهي العالم لتبدأ الحكاية.. يقول الشاعر:
“المصباحُ الصغيرُ المُعلقُ فوقَ السريرِ
ينحتُ تفاصيلَ جسدِكِ بالضوْءِ والظل.
أحب جسدِكِ حينَ يكونُ منحوتًا بالضوْءِ والظلْ.(15)
ويتلاشى الزمان والمكان لتتحاور الرموز والدلائل وتتبدد قتامة الظلام ليضاء الجسد، “بمصباح صغير ينحت تفاصيل الجسد”، حينها يتحول الجسد رغبة واستيهامًا فـ”أن أختار لحظة الرغبة لأدشن العالم كل مرة، ذلكم حقي”(16). وهو ما يدفعنا إلى القول بأن الرموز المتصلة بالمرأة تعد رموزًا ليلية لها صفة العمق والغور والظلمة، وترتبط بالخصوبة والأرض المنجبة. ذلك أن بنية الرموز وإيحاءاتها لا تكتفي بإيحائها النوعي، بل تحيل أيضًا على الحضور الرمزي للطرف الآخر في السيرورة حيث إن لعبة الحضور والخفاء تنقضي لتشمل المعنى والمجاز والتثبيت والإضمار والدليل والأثر. فالشاعر لا يسعى إلى التغزل بالمرأة أو التغني بها وبمفاتنها وإنما غايته هي البحث عن المعنى الأعمق للعشق إيغالًا في أسراره كحال وجدانية ووجودية، وتعد المرأة بالنسبة إليه رمزًا متعدد الدلالات والمعاني إنها رمز للكائن المتعدد في الزمان والمكان، إنها رمز للأرض/ الوطن.
3-المرأة/ الأرض:
تتواتر في الديوان العديد من العناصر المحيلة على الأرض من ذلك نذكر: الأرض- الأشجار- الليل– الفراشات- الماء- الرياح- التراب.. وهي عناصر تضافرت مجتمعة لتشكيل صورة المرأة/ الأرض، حيث شبه الشاعر المرأة بالفراشة وهي صورة تتكئ على بنية التكرار، تكرار لفظة “الفراشة” التي تنتشر بين ثنايا القصيدة للدلالة على تأكيد قيمة المرأة وأهميتها لدى الشاعر تارة، وللدلالة على الرحيل واللااستقرار سواء في ذهن الشاعر أو في المطلق تارة أخرى. ذلك أن الفراشة هي نوع من الحشرات ذات أجنحة وألوان زاهية وقد اقترن اسمها بالجمال والرقة كما كانت رمزًا للخلود(17) عند أفلاطون، وقد استثمر الشاعر إيحاءاتها في بناء عدد من صوره الشعرية يقول في ذلك:
“أنتَ منحتَهَا رهافةً
كخريرِ ماءٍ يحتضنُ الصخورَ في اندفاعِهِ
نحتَّها فراشةً، ونفختَ فيهَا من روحِكَ
فحومتْ حول العرشْ!
أنت خلقْتَهَا فراشةً يا اللهْ
وخلقْتَهُ ناقصًا
تهفُو روحُهُ إلى الفراشاتِ
يطيرُ في فضائِكَ
ويرسُمُ السماواتِ نقيةً.. والأشجارَ!
لمَاذَا ـ إذنْ ـ أخرجْتَهُ من جنتِكَ
حينَ أرادَ أنْ يكتملْ؟!(18)
وهي عناصر تواترت في القصيدة لتشكل لوحة طبيعية ممزوجة بالرهافة والشفافية والنقاء والرقة جعلها صورة في منتهى الكمال حتى لكأنها الفردوس الذي أخرج منه الآخر/ الرجل، وهي صورة تعيدنا إلى بدء التكوين، إلى قصة آدم عليه السلام حين أُخرج من الجنة بسبب خطيئته الكبرى. وفي هذا المستوى تأتي الحركات الداخلية والعلاقات بين الألفاظ عبارة عن حركة كبرى بموجبها تتوحد المرأة بالأرض، بل هي في الواقع مستقر الفعل البشري المغير أو كل تلك المفاهيم مجتمعة، وهي عملية تقوم على إفراغ الدوال من معانيها المتعارفة وشحنها بمعان جديدة، باعتبارها من قوانين الكتابة الشعرية في القصيدة الحديثة.
وهكذا غدت المرأة تماثل الأرض تماثلًا أسطوريًّا، وغدا الحب استرجاعًا للحنين الأول، الحنين إلى الأرض الغائبة، وهو في وجه من وجوهه حنين إلى الأم التي ترمز إلى بداية التكوين. وارتبطت الصورتان (الحبيبة والأرض) واحدتهما بالأخرى ارتباطًا حلميًّا حتى أضحت الأولى صدى للثانية والثانية للأولى. وهو ما يتضح لنا من خلال هذا المزج بين الدنيوي والسماوي، بين الإنسان والملائكة ويكون اللقاء في الصحراء في قوله:
“أن يغرس أظفاره في الصحراء
لِتُنْبِتَ أطفالًا بيضًا وملائكةً.”(19)
ويتحول النص بهذا المعنى، إلى قداس ابتهالي ينشد في حضرة المرأة– الأرض- الكلمة- المقدس، فتأتي موغلة في الغموض، ويعد النفاذ إلى دواخلها قضية في غاية الدقة. فتبدو من خلال الأوصاف المسندة إليها والأفعال الموجهة نحوها بمثابة الوجه الآخر للأرض، ومن هنا تصبح العلاقة بها مركزية هامة، وتصبح مؤشرًا ينبئ ببداية ولادة جديدة، لأن الانفتاح على المرأة هو بداية انفتاح على بقية عناصر الكون، والحوار الجسدي معها خطوة تؤدي إلى الخروج من سجن الأنا والانفتاح على الآخر.
وهكذا تبدأ العلاقة بالمرأة، شأنها شأن العلاقة بالأرض، من لحظة البدء المقدس، ثم تتقدم متحفزة لتصل إلى ذروة المعاناة، لاسيما وأنها علاقة صراع مصيري مشروط في جوهره بنوع من الاستمرارية والدوام. لكنها تبدو في الآن نفسه محكومة بمفارقة جوهرية: إذ كلما تم الاتصال صار الارتواء حلمًا وتوهجت الرغبة من جديد. كما أنها تقوم على صراع مصيري يصب في لحظة التيه (جسد التيه والضياع). إلا أن التيه لا يعني التلاشي والضياع، بل هو احتضان للمجهول يقود إلى اكتشافات جديدة، باعتباره مؤشرًا ينبئ بلحظة البدء، لحظة الشروع في رحلة الاكتشاف من جديد.
4-المرأة اللغة:
“واللغةُ انسابتْ كما تشاهدينَ
نسجتْ نفسَهَا قصائدَ تخلدُ نزواتِنَا”(20)
على مستوى اللغة نلاحظ أن الفعل هو ركيزة الديوان الأولى، (تخرج- تلصق- تجري- تجعل- تتحكم- اقترفت..) بل أصبح الرابط الذي يشد جميع عناصر بنيته. لذلك ينبغي على القارئ أن يفك دواخله وتوجهاته وشبكة علاقاته للتمكن من النفاذ إلى عالم القصيدة المتسربل بالغموض. حيث نلاحظ كثافة الأفعال باعتبار أنها تلعب دور المولد الإيقاعي الأساسي. تلتقي عنده جميع عناصر البنية فيسحب عليها خصوصياته ثم يوحد بينها.
يقوم الفعل أولًا بإقامة ترابط عضوي جدلي بين الأشياء والذوات، ومن ثم يدفع حركة الجدل وما يعقبها من تغير إلى الأمام. فيؤسس المرتكز الذي يقوم عليه ذلك الترابط. ويقوم ثانيًا بالنفاذ إلى دواخل العلاقات ويرصد الفروقات القائمة بينها: يطرأ على الفعل نوع من التوالد الذاتي فيستدعي أفعالًا تتوافق معه من حيث الصيغة وتختلف معه اختلافًا طفيفًا من حيث الدلالة. القصيدة تحاول عبر تتالي أفعالها وتوالدها الدائم أن تنفذ إلى دواخل حالة ما أو فعل ما كالوصف الجسدي مثلًا، وتستقرئ جميع تفاصيله حتى تستوعب الأشياء الدقيقة التي لا تُرى ولا يمكن التعبير عنها. ووحدها القصيدة هي التي تحتضنها عند احتدامها. فتصبح مسرحًا للعلاقات آن صيرورتها وجدلها الراجع إلى ما تنبني عليه الأفعال المتوالدة من تكامل وتضاد. وأما الزمن فهو زمن تصاعدي خطي تتتالى فيه الأفعال وتتتابع بصفة منطقية معقولة.
كما تنهض صورة المرأة في الديوان على توظيف الجمل الوصفية سواء بتكثيف النعوت والصفات (شفتيْكِ الشبِقَتَيْنِ) أو بإقامة التشبيه بمختلف أنواعه.. كما في قوله:
كأن رموشَكِ تفترشُ الأرضَ
وشفتيْكِ الشبِقَتَيْنِ تروِي المشردينَ
السائرينَ على غيرِ هُدَى!(21)
وهي صور تقوم على النعوت والتشابيه يؤاخي عبرها الشاعر بين النثر والشعر ويصهرهما في بوتقة واحدة هي بوتقة اللغة العاشقة أو المؤنثة، ويكشف من خلالها النقاب عن عوالم المرأة في متاهات رحلتها القصية بين بواطنها المستورة، ومكاشفاته نحوها، حتى لكأنه مصاب بالمرأة حتى الرميم، ثم يمعن بك في إصرار، فيكاشفك بما حسبت أنك قد ظفرت به ظفرًا، فإذا غادرت منطقة المجاز، وتخلصت من أسرار اللفظ الشعري اللعوب أدركت أن الشاعر قد حول اللغة مرآة لا تنفذ إلى خبايا الأنثى، إلا بقدر ما تنفذ إلى خبايا الرجل، فتبحر في أدغال عوالمه، وإذا الرجل البطل الذي كان يتأبى قد فاز بها، ولم يمس إلا وهو أسيرها.
وبهذا المعنى حول اللغة الشعرية إلى مرايا متناظرة، استوى من خلالها الشعر مرآة ترى فيها المرأة صورة من أحاسيسها حيال الرجل، وصورة أحاسيسها حيال نفسها. وإن كانت المرأة هي التي تحفظ أنوثة اللغة فإن اللغة بدورها هي التي تحفظ أنوثة الأرض. اللغة تعكس المرأة والأرض تسكن اللغة من كونها لغة مؤنثة أي لغة ثنائية متوحدة في ثنائيتها. الشاعر لا يحقق صورته المثلى كشاعر عاشق إلا في فعل التأنث الذي ينضاف إلى ذكوريته من غير أن يلغيها أو تلغيه.
هكذا تفتح الكتابة مجراها مع “سمير درويش” لتضعنا أمام نتائج تغري بالمواصلة وتغري بالمضي على درب المحاولة من جديد والتورط في ضنى الكتابة من جديد. إن الشاعر يحاول دحر الصمت فيشرع النص في التأسيس ثم يحتمي بالصمت من جديد مغيرًا بذلك طرائق الكتابة المتعارفة في الثقافة العربية، باعتبار أن الكتابة نظرة للعالم وطريقة في الحضور فيه، وهو ما جسده من خلال تجربة رموز المرأة التي تتضمن أبعادًا أخرى محجبة عبر تجربة جسدها المنتشي بموسيقية الخطوط، حيث سيحمل النص نبوءته الممتحنة، يصدم العين والأذن والحساسية. فالجسد يفسح للعين مجال الرؤية، وتكتب العين تاريخ الجسد، كل منهما يتبادل مع الآخر لعبة إدراك الموجود والموجودات، وتمارس الكتابة افتضاض المألوف السائد، المغلق، المعتاد، هذا الافتضاض الذي جرب قساوته ونشوته كبار المبدعين، إنها قلب المداليل والدلائل. وبهذا المعنى تظل المرأة مدخلًا لفهم الشعري وفهم شعر “سمير درويش” بوجه خاص باعتبارها دالًّا على “سمير درويش” الفنان ووظيفة المرأة في ديوانه، وتتنزل ضمنه منزلة محورية في عملية الإبداع الشعري، لا باعتبارها شيئًا أي جسدًا للذة، بل باعتبارها اسمًا وقولًا في المرأة وفضاءً للإنشاء والإبداع يصنعه الخيال وصورًا ورموزًا مجسمة لعالم معقد من الرغبات المتعالقة، رغبات الحس ورغبات الفكر ورغبات الكتابة، تعبيرًا عن الوجود وتوقًا إلى المنشود.
5- المرأة/ المقدس:
يستدعي الشاعر رموزًا دينية مضفيًا على شخصية المرأة مسحة أسطورية تجعلها متفردة، محوِّلًا صراعه معها إلى صراع الإنسان عامة، وتتحول الأرض إلى مقدس والعلاقة بها إلى طقوس تصل إلى حد ذوبان العابد في المعبود، وتصبح المرأة بدورها عنصرًا من عناصر المعبود، بل هي تجل révélation من تجلياته، والعلاقة بها شكل من أشكال الاتحاد بالمعبود، وهي ظاهرة تكشف عن رؤية صوفية حلولية واضحة تقوم على تهادن المتناقضات وتنبني على اتحاد الإنسان بالأشياء مطلقًا.
ولعل الاحتفاء بالجسد من خلال الكتابة باعتباره تفجيرًا شهوانيًّا أو مناجاة من النمط الصوفي، وبما هو تحوير وانحراف عن السائد، مما يساهم في تشكيل أزواج استعارية ويفتح القول الشعري على إمكانية معانقة المطلق من خلال انخراط الشاعر في تقصي جزئيات الجسد.. يقول في ذلك:
هل قصدتُهَا أُنْثَى؟
أمْ كونًا أتعبدُ في أركانِهِ
ما حييتْ؟(22)
يحقق الجسد باعتباره واقعة اجتماعية ومن ثم واقعة دالة(23)، دلالات توليدية وتحويلية متعددة. فهو يدل باعتباره موضوعًا ويدل باعتباره حجمًا إنسانيًّا ويدل باعتباره شكلًا(24). ولعل هذه الأبيات تحيلنا على بعد صوفي يتمثل في ظاهرة الحلول، وهو ما يعني أن المعرفة بلا محبة لا تكتمل، فمن لم يحب شيئًا ما تجلى له ذلك الشيء ولا عرفه حق المعرفة. وهو ما أحدثته ظاهرة الحلول الصوفي لديه، فقد أحبها حد العبادة، والعارف المحب إنما يتمرأى مع كل الذوات، ويعشق كل حسن وجمال، بل هو يستحسن كل شيء، وهذه حال من أسكرته محبة وبلغ أقصى درجاتها”(25). فالعاشق مع “سمير درويش” يغيب عن نفسه ولا يدرك سوى معشوقته، وهي مرحلة من مراحل الفناء الذي هو قوام العشق.. يقول الشاعر:
لا أعبدُ سواكَ يا الله،
لكننِي أكتبُ بعضَ أسمائِكَ الحُسْنَى
فوقَ جسدِهَا الفرعوني
وأسمعُ تراتيلَ مقدسةً في هذيانِهَا
وألمَسُ ثمارَ الجنةِ
حينَ تنامُ أنامِلِي على صفحةِ بطنِهَا.
..
أعرفُ يا اللهُ
أنك تتبدى في بعضِ مخلُوقاتِكَ
لذلكَ.. أتتبعُ نورَكَ
كمُريدٍ
أضناهُ البحثُ طويلًا
حتى آبَ إليكْ.(26)
مما يفسر أن العاشق في القصيدة يعيش حقيقة الفناء والحب الأبدي في معشوقته، وقد ارتبط الجسد لدى الشاعر بالحب وهو مظهر من مظاهر التصوف، يحن إليها للآخر/ الحقيقة الصوفية باعتبارها الذات العليا حيث يهيم بها شوقًا وتحرقًا لكنها صعبة المنال. ونلمس في العلاقة بالجسد، في جانب اللذة منها، ما يفتح أفقًا للمتعة بعيدًا عن الرغبات الزائلة المحصورة بالجسد. فالمحب مستغرق في من أحب حد ضياع كل الموجودات واختصارها فيه.
وبهذا المعنى، سعى الشاعر عبر ديوانه إلى تجريد الجسد من عوامل العبث والتشويه ومقاومة منطق القوة والرغبة في محوه. ليجعل منه علامة ارتكاز للإدراك والإنتاج المتجدد للقوة الأنثوية التي تتخذ أشكالًا فريدة لا نهائية دون تحديد.
وهكذا انحاز الشاعر إلى تعرية الجسد تعرية تتجاوز الحياء الأخلاقي إلى التعرية باعتبارها وسيلة لاكتشاف العالم وقراءته وتجاوزه للبحث عن الحقيقة التي ينشدها وهي الحقيقة الصوفية والتي يصعب الوصول إليها، لذلك يمثل الجسد عالمًا رحبًا وتجربة فريدة قادرة على المنح والاكتشاف والتأويل، تصل في الديوان إلى القداسة وأحيانًا إلى التأليه.
الخاتمة:
يسعى ديوان “تصطاد الشياطين” إلى الإخبار عن أسرار مقفلة كامنة في ذات المرأة، فهي المرأة الرمز المتعدد بكل أبعاده ودلالاته. ويعد محاولة أيضًا لأنه يفضل عنت الحيرة على دفء الاطمئنان، لذلك يبتعد عن جاهز اللغة، يقصيها ولا يقارب بها النص، مسافرًا في المجهول، هو النص الشعري ذاته، ليجيب عن حشود من الأسئلة كانت تؤرقنا منذ أمد، ولعل أهمها: كيف تصبح الكتابة فعلًا جسديًّا؟ كيف يمكن للجسد أن يكون موضوعًا لكتابة شعرية جديدة تجعل القارئ أمام مسؤولية جديدة تضعه دائمًا في أفق الاحتمالات؟
ويبقى ديوان “تصطاد الشياطين” قصيدة حاملة للقاح الملحمة الشعرية الجديدة المكسرة للنمطية والمقيمة لذائقة جديدة معبأة بالحيرة والتساؤل والسعي إلى التحرر من التقديس والتابو الكتابي.
الهوامش:
1- أدونيس، مقدمة للشعر العربي، بيروت- لبنان، دار العودة، 1979، ص125.
2- يوسف الخال، الحداثة في الشعر، بيروت- لبنان، دار الطليعة، ط1، 1978، ص81.
3- Suzane Bernard، Le poème en prose، de Baudelaire jusqu’à nos jours، Paris، librairie A.G. NIZET، 1994، p.442.
4- Ibid، p.15.
5- أدونيس، مقدّمة للشعر العربي، بيروت- لبنان، دار العودة، ط2، 1975، ينظر مقدمة الكتاب والفصل الأخير منه.
6- رشيد يحياوي، قصيدة النثر العربية أو خطاب الأرض المحروقة، المغرب، أفريقيا الشرق، 2008، ص156.
7- je n’ai jamais pu supporter qu’on tripote les vers d’un grand poète(…) les vers ne s’expliquent pas. A. Artaud، œuvres complètes، T.XI، 1945-1946، Gallimard، 1974، P190.
8- سمير درويش، تصطاد الشياطين، مصر، دار شرقيات، 2011، ص27.
9- محمود درويش، الأعمال الكاملة، قصيدة مديح الظلّ العالي.
10- المصدر نفسه، ص27.
11– م، ن، ص35.
12- القرآن الكريم الآية 7 ص550.
13– المصدر نفسه، ص14.
14– م، ن، ص13.
15– م، ن، ص12.
16- عبد الكبير الخطيبي، الذاكرة الموشومة، الدار البيضاء، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص70.
17- Nadia Julien: Dictionnaire Marabout des symboles- Ed Marabout – Belgique: 278.
18- م، ن، ص17.
19- م، ن، ص10.
20– م، ن، ص14.
21- م، ن، ص8.
22– م، ن، ص41.
23- سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، سورية، دار الحوار للنشر والتوزيع، 2005، ص191.
24- المرجع نفسه، ص216.
25- علي حرب، الحبّ والفناء: تأمّلات في المرأة والعشق والوجود، بيروت- لبنان، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، 1990، ص111.
26- المصدر نفسه، ص40.