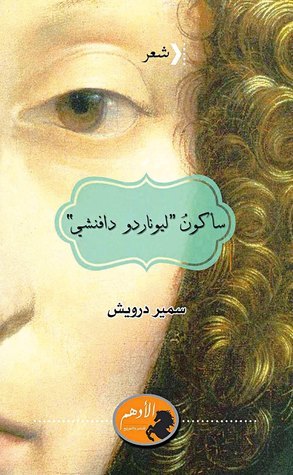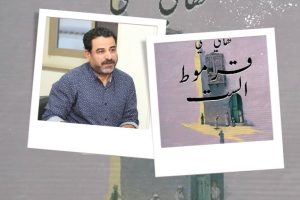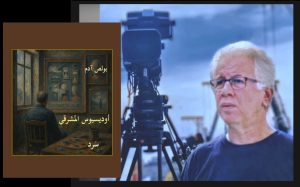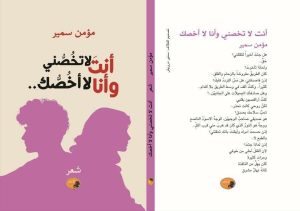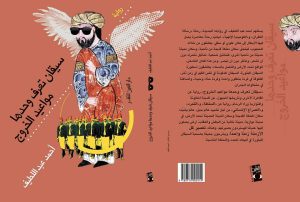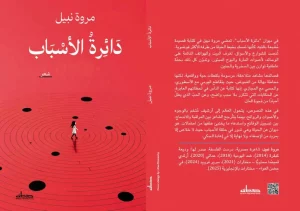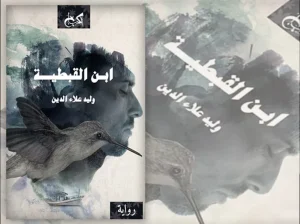د.صديق عطية
الخطاب الشعرى فى ديوان “سأكون ليوناردو دافنشي” معادلة مدهشة حقًّا: الجسد = الروح، وهو في سبيل تحقيق هذه المعادلة أو الفرضية يصنع عمقًا لقصيدته من خلال تأسيس الشعرية أو الجمال على المعرفة، فإذا كان الجسد فى موروثنا الديني مصدرًا للخطيئة فإنه يحوًّل هذا الجسد إلى انفعال أو تجربة، ومن شأن هذه التجربة أن تعيد النظر فى شأن حواس الجسد؛ فإذا كان تاريخنا المعرفى عنها يؤكد عجزها عن مدِّنا بالمعرفة اليقينية فإن هذه التجربة تؤسس على هذه النهاية بداية لمغامرة مطلقة قوامها لغة الشاعر، لتخلق من الجسد معرفة أو شعرية، أقول: (أو)؛ حيث إن المعرفة –هنا- تتحول إلى شعرية خالصة؛ إذْ إنها تتشكل من انفعال جمالي وموقف عرفاني خاص.
والملاحظ فى الديوان استعمال مفردة “الجسد” لا الجسم؛ إذ الجسم يمثِّل الكثافة بأبعادها الثلاثة: الطول والعرض والعمق، أما “الجسد” فإنه يمثل الخلاص من المادة وأدرانها، لكن الخلاص هنا ليس بمجاهدات، يمارس فيها المترقي ألوانًا من القسوة والحرمان على الجسد، إنما باعتبار الإلهي والجسدي فى مركب واحد، الجوهر والمظهر واحد، القديم والمحدث.
فقصة صلب المسيح -بعيدًا عن المعتقد الإسلامي والمسيحي- صارت رمزًا للوحدة بين اللاهوت والناسوت؛ ففي السيد المسيح تحقق هذا الاتحاد الكامل بينهما، صار الجسد إلهًا والإله جسدًا، من هنا يفتش شاعرنا عن طاقات في الجسد لم يتم اكتشافها بعد، يبحث عن الإلهي داخل الجسد.
لذا فهو حين يعلن -في أول الديوان– رغبته في الموت، كأنه يحيي قولَ أفلاطون: “مُتْ بالإرادة تحيا بالطبيعة”، فالأمر مرهون بإرادته كي يحيا بالطبيعة/ الجسد، والإرادة –هنا– ليست قَمع هوى النفس، إنما هى القدرة على تفجير طاقات مخبوءة فى الجسد:
ليسَ للسنواتِ منْ معنًى الآنَ
تلكَ التِي تمرُّ، مخلفةً خطوطًا علَى الوجهِ
وثلوجًا تتخلَّلُ الأحاسيسَ، وشعرَ الرأسْ.
ربَّمَا لحظةَ لمستُ أصابعَ ابنةِ الجيرانِ
أو تلصَّصْتُ علَى نهديْهَا العابثيْنِ
خلفَ قماشِ ثوبِهَا المنزليِّ،
أوْ دقيقةً شربتُ فيهَا ماءَ الأرضِ
منْ كفِّ حبيبتِي
التِي غافلتْنِي وماتَتْ،
دونَ أنْ تقولَ لِي موعِدَ موتِهَا!
أوْ ساعةً تسبقُ نطقَ اسمِي منغَّمًا
قبلَ أنْ تنطلقَ العصافيرُ الساخنةُ مغردةً.
ليسَ للسنواتِ منْ معنَى
حينَ أقرِّرُ أنْ أموتْ! (ص5)
فهو حين يقرر أن يموت يسقط معنى الزمن المحدود، السنوات التى تمر مخلفة آثار الشيخوخة على الوجة والرأس، راغبًا فى فتح الزمن من خلال الجسد، فطلب الموت إدراك لمحدودية الحياة الأولى، هو رغبة الذات الملحة في الخلاص، لا من الجسد، بل بالجسد، ورفضُ الزمن (السنوات المعدودة) رفضٌ للمحدود فاقدِ المعنى، واستثناء لحظات التوحد بالحبيبة –من هذا الزمن المحدود– لأنه قبضَ فيها على المعنى (الذى تفلَّت من بين أصابعه سريعًا)، فهما في لحظة التوحُّد يتجاوزان المقيدَ إلى المطلق، فالجسد هنا وسيلة للحياة اللامحدودة، غير أن الموت الأول استشراف آفاق الخلود، والثاني اكتفاء بالمحدود، وقناعة بالفناء، لذا نرى الذاتَ تلِحُّ في طلب الموت الأول، لأن الثاني لا يغري بالبقاء، يقول:
يداكَ فارغتانِ
ليسَ ثمَّ ما تحملانَهُ غيرُ وجهٍ
لا يغرِي المراكبَ بالتوقفِ
ولا يعطِي التائهينَ قبسًا من نارٍ (ص11)
فذلك التائه الباحث عن الخلود تدفعه رغبته في البقاء؛ فيطلب الموت بحثًا عن ذلك القبس الذى يطلقه من محدوديته:
حينَ أموتُ:
لا تغلقْنَ الأبوابَ أبدًا
فالروحُ التي تغفُو في سريرِ اللهِ قليلًا
تهبطُ كيْ تتمرَّغَ
في الأسرَّةِ الناعمةْ! (ص10)
إن هذا الموت الخاص يتيح له الرحيل أو السفر، إنه موت به يمارس المشاهدة والمعرفة الباطنية، هو وسيلة الخلاص للذات من واقعها المرفوض، وبه تتخلص المادةُ من كثافتها وتتجول إليها وفيها الذات وقتما تشاء.
المرأة الطريق:
حين يعجز العقلُ عن تلَمُّسِ الطريقِ، يلجأ صاحبُه إلى وسائل أخرى خارج أفكار الكتب ومعطيات العقل، حينها ربما يتلمس الصلةَ في شجرة أو جماد، فيكون بهما أكثر حضورًا، عندها يدرك أن المعرفة فى الوحدة العميقة بين جسدين لا بين فكرتين، وأن الحقيقة لا تأتي من خارج (علم عقلي أو شرعي أو أعراف)، وقتها يرغب في تجسيد المجرد من الأفكار والعلوم، وفي أن يصير –هو- جسدًا خالصًا يصبو إلى الوحدة مع جسد آخر، يمارس التجربةَ من داخله، متلهِّفًا إلى الوحدة الجسدية لا التجريد، إذ الله –لا شك– حالٌّ في الجسد، في هذه اللحظة يوقن أن الموضوع المناسب لهذه الممارسة هو المرأة، فبالحب الذى يجمعهما يصيران الواقعَ والمطلقَ، ويصير كلٌّ منهما روحًا للآخر وتجلِّيًا له، فيرتفع شاعرنا بالمرأة إلى مستوى الرمز الإشراقي فارًّا من خيانة العقل؛ إذ إن أجوبة العقل تحدِّد، وتحديد الأشياء نَفْيٌ لها، لأن في تحديدنا لها نحصرها فنحرمها ونحجبها عن المطلق.
أما العِلَّةُ الثانية في انجذابه إلى المرأة فلأن اللغة عاجزة عن إطلاقه، يقول:
لستُ سوَى بقعةِ ضوءٍ لا ثِقَلَ لهَا:
جذعُهَا يتمرَّغُ فِي ترابِ أجسادٍ متشظِّيَةٍ
وفرعُهَا هائمٌ علَى وجهِهِ فِي السماءِ
حينَ تصطَدِمُ بقِمَمِ الأعينِ الصلبةِ
تنهمِرُ ماءً دافئًا وموسيقَى.
بقعةُ ضوءٍ موزَّعةٌ بعنايةٍ بينَ المضارِبِ
لمْ يخلقِ اللهُ لغةً تلَمْلِمُهَا بعدُ
تجسِّدُهَا طائرًا ملَوَّنًا بجناحيْنِ خفيفَيْنِ.. لأطيرْ! (ص76)
هو يرغب في الطيران إلى المطلق، واللغة عاجزة عن لمِّ شتاته، تعجز عن تحويل جسده الكثيف إلى فكر محلًّق، لكنه –ربما– يعثر على طاقة تحويلية حين يتوحَّدُ بامرأة:
لا يجتمعُ قلبانِ فِي صدْرِ رجُلٍ
فلماذَا إذَنْ
يتكوَّرُ نهدَانِ علَى صدْرِ امرأةٍ؟
..
علمُ الطبيعةِ ظالمٌ! (ص67)
فهو ينجذب إليها، حيث تملك نهدين/ قلبَها وقلبَه، وحين يتوحَّد بها –حتمًا– سيدرك عدلَ علم الطبيعة؛ إذ هو –أيضًا– يملك قلبَها وقلبَه، فكلٌّ منهما يتجلى في الآخر.
فبالمرأة الاكتمال، لا باللغة، إنها أيْسَرُ الطرق وأقصرها إلى الوصول:
لكنَّنَا لا نحتاجُ كتابةَ قصيدةٍ مشتركةٍ،
بلْ صناعةَ تاريخٍ غائرٍ
عَلَى صَفَحاتِ أجسادِنَا.
أحتاجُ امرأةً، لا ديوانَ شِعْرٍ،
وتحتاجينَ رجلًا،
فكفِّي عن محاولةِ استخراجِ كلامٍ مريحٍ
منْ باطنِ معجمِ العشقِ
فالكلامُ لا يريحُ العاشقينَ!
علينَا أنْ نخترعَ طرقًا توصِّلُنَا إليْنَا
دونَ كثيرِ كلامٍ..
ودونَ منٍّ..
ودونَ نزفِ مشاعرِنَا معًا. (ص22)
فالمرأة وما تملك وسيلته إلى الاكتمال، وهو يرى فى ممارسات الجسد بلاغة تفوق بلاغة القول:
ربَّمَا تكمِلُ لوحَتِي امرأةٌ عربيَّةٌ
مدَّدَتْنِي عَلَى براحِ بطنِهَا. (ص44)
فالمرأة ليست جسدًا للجسد، أو محلًّا لإطفاء جذوة الشهوة فحسب، بل هى طريق لاكتمال الرجل، وكذا الرجل طريق لاكتمالها:
أنْ تراودَ امرأةً عنْ نفسِهَا
أسهلَ منْ أنْ تُصْلِحَ حروفَهَا المبعثرَةَ.
أنْ تشكِّلَ ملامحَهَا لغةً..
أو تسكبَهَا نارًا علَى الرُّخَامِ (ص50)
والنار هنا هى نار التكوين، هى العودة إلى الفطرة الأولى التي من أجلها أدْخَلَها ودخل معها التجربة:
حينَ ألقمَتْهُ صدرَهَا الصَّلْبَ، لينْجُوَ
ظلَّ يلهجُ بالدُّعَاءِ للَّذِي زرعَ كرمَ عنبٍ
بينَ فخذيْهَا المُتَوَتِّرَيْنِ، (ص65)
فالرضاعة هنا عودٌ إلى الفطرة الأولى، وامتصاص الحكمة التى بها ينجو من الفناء والقيود وسجن المادة المعتمة:
صوتُ البيانُو يفتَحُ مسامِّي
لتتوغَّلَ.. تتوغَّلَ..
بقميصٍ ورديٍّ يفضَحُ الرغبةَ
يفتحُ الطريقَ إلَى النبعِ
ويضعُ أبجديةَ تلاشِي جسديْنِ نورانيَّيْنِ (ص66)
فالوصال بين الجسدين –إذًا– (رغبة) فى سلوك “الطريق إلى النبع”، إلى الفطرة الأولى، إلى تحويل الجسدين المعتمين إلى التلاشي، إلى نور شفيف، إلى المطلق.
وهنا.. هنا فقط تستمد اللغةُ وجودَها من هذه الطاقة المتفجِّرةِ، فتصير اللغةُ أنثى، والأنثى لغة:
اللغةُ التِي استوتْ أنثَى بفعلِ الرِّياحِ
تتحرَّكُ بينَ حروفِهَا الحُبْلَى بتثاقلٍ
تتحسَّسُ الماءَ بأصابعِ قدميْهَا هاتينْ
الغارقتينِ في دمِ الرَّغْبَةِ،
مرَّةً.. مرَّتينِ..
لكنَّهَا تنزلقُ تاركةً طلاءَ شفتيْهَا القُرمزيَّ
نهبًا لتواريخِ الحرمانِ الطويلةِ.
اللغةُ الوجلَى تدفنُ جسدَهَا الأبيضَ
كنعامةٍ، فِي شعرِ صدرِكَ
ترشفُ ماءَ الطيرانِ من كأسٍ ملأتْهُ لكَ
قبلَ أنْ تصيرَ كأسًا مملوءةً بالشِّعْرِ
تهتزُّ، ترتجفُ، تنتفضُ، تنفجرُ
تتشكَّلُ أُنثَى بفعلِ العواصِفِ
وتقولُ: هيتَ لكْ! (ص21)
فهذه اللغة ما اكتملت وصارت مطواعة إلا بالوحدة بين الرجل والمرأة، وبالوحدة بينهما ترقَّى شاعرُنا إلى المطلق، لم يَقُلْ للغة: كنْ، بل هي التى جاءت طوعًا– إليه- لتقول: هيت لكْ، وبالوحدةر–أيضًا– تتحقق السعادة التي هي مطلبُ كلِّ حي:
حين تبتسمُ؛
توقن أن الله منحها سرَّ التكوينِ،
وحدَهَا،
وحينَ تحزَنُ،
تتوغَّلُ الشتاءاتُ فِي عينيْهَا عميقًا.
حينَ تُقْبِلُ،
عليكَ أنْ تجمَعَ حواسَّكَ لتحيطَ جمالَهَا
وحينَ تُدْبِرُ،
ألقِ وصيَّتَكَ علَى طفليْكَ،
ونمْ! (ص14)
فالمرأة تمتلك سرَّ التكوين، وبالتالي إعادته إلى الفطرة الأولى، حيث السعادة المطلقة، لكن سعادتها وحزنها حالتان هو يسقطهما عليها، فما تحققت السعادة إلا حين تدوزن فى داخله فانسجما معًا، وما كان الحزن والشتاءات في عينيها إلا حينما افتقد هذا التوازن فانفصلا، فالحزن انفصال والسعادة اتصال.
الجسد برزخ:
شعرية الديوان تُحَوِّلُ الموضوعَ إلى ذات، والأرضَ إلى سماء، أو توحِّد بينهما؛ فالجسد موضع اللاشعور، وبالتالي يقودُ أحكامَ القيمة، والذاتُ جسدٌ، والجسدُ بكُليَّته يفكر، هو وعيٌ من خلال ما يصل، فإذا كان الفكر عَرَضًا من أعراض حالات جسدية، فجوهرُ الذاتِ هو الجسد، لذا فشاعرنا حين يدخل إلى موضوع الجسد فإنما يتخطاه من أجل خلقٍ جديدٍ؛ كائنٍ وعالَمٍ جديدين.
وإذا كان المتصوفةُ يرون في الشريعة والعقلانية حجابًا، فشاعرنا هنا بعرفانيتة يفتح في الجسد طريقًا للمعرفة وآفاقًا للحرية الخالصة التى لا تأبه بالأعراف الاجتماعية، أو القيود التي أُلصِقَتْ بالخطاب الديني وليست من جسد الدين في شيء، والحرية هى جوهر الإنسان، وبالتالي فهي الجوهر الخفي في الجسد.
إذن.. فالجسد فيه شيءٌ من اللانهاية به يمكن إنارة كل شيء، والمُطْلقُ يفصح عن ذاته عبر الجسد، أو عبر برزخ اللاشعور في الجسد، وشاعرنا يؤمن أولًا بقدرات خارقة للحواس، عن طريقها يندمج مع الطبيعة/ الجسد، فالمعرفة المتعددة التى تأتينا عن طريق الحواس عن الشيء الواحد إنما بسبب اختلاف الناس في الْتِقاط الصور، وسبب الاختلاف نقْصٌ في المستقبِلِ، لكن حين يكون الحاسُّ ناضجًا تنفتح حواسُّة لتوحِّد الصور في صورة واحدة، هي الحقيقةُ أو المطلق، أو اللامحدود، وبالتالي فهو لا يفصل بين عالم الحواس وعالم الفكر، لكنه يقلب الهرم فيجعل من الجسد ذروة للروح، من أجل خلق نوع من التماهي؛ به يصير جسدُ المحبوب كالقول الإلهي، أو بمعنى آخر يصير الجسدُ روحًا، مطلقًا.
فهنا ولادةٌ لمقول شعري عرفاني جديد: “مَنْ عَرَفَ جسدَه عَرَفَ ربَّه”، فشاعرنا ينحت بعرفانيته الخاصة سبيله الخاص إلى المطلق، فوسيلتُه في الترقي ليست مجاهدة رغائب الجسد وإيلامه، إنما اللذة الجسدية، عن طريق الحواس التي تعمل بكفاءة تستطيل بفعل الرغبة في الصعود، فترى العينُ ما هو أبعدُ من المادة، وكذلك الأذن واللمس وسائر الحواس، بهذه العرفانية الخاصة للحواس تصيرُ الممارساتُ الجسديةُ ليست خالصةً للجسد، إنما للوعي والجسد معًا، لذا نجد شاعرَنا في حديثه عن علاقته بالجسد يطرحُ الأسئلة:
ولا يكفُّ عنَ طرحِ أسئلتِهِ علَى الأجسادِ
علَّ واحدًا يملأُ فراغَ الفستانِ الأحمرِ
أوْ دهشةً تخرجُ منْهَا
تعيدُ الاعتبارَ لشلالاتِ الماءِ، والزبدِ،
وللحشائِشِ التِي تنمُو علَى إسفلتِ القُلُوبِ،
ولخاتمةِ الأطلالِ:
“لا تقل شئنا
فإن الحظ شاء”! (ص57)
فمتعةُ الجسد بالجسد تُنْتِجُ الروحَ والجسد، إنه من خلال هذه العلاقة الجسدية يتغيا خلق واقع بديل، فيه تكون الذاتُ متحررةً من قيودها الأرضية، قاصدةً تكوينَها الأول، لذا فهو يطرح أسئلتَه على الأجساد، علَّ واحدًا منها يملأ الفراغ، والفراغُ خواءُ الروح والجسد معًا، عوزٌ إلى الوجود المطلق، أو يعيد واحدٌ منها الاعتبارَ لشلالات الماء، يحوِّل الذاتَ الشاعرةَ من الموات إلى الحياة؛ الحياة بمعناها المطلق.
فالجسد يمتلك قدراتٍ خارقةً تحجبها قيودُ العقل والشَّرْعِ والعُرْفِ والمجتمع وغيرها، لكنَّ الذات حين تمتلك الإرادةَ والقدرةَ على تفجير الثورةِ أو الرغبةِ تفتح الجسدَ على المطلق، وشاعرُنا بتجربته الحياتية والشعرية قادرٌ على التحرُّرِ من تلك القيود التي تُحِدُّ من حرية الإنسان داخله فتتحقق معرفةُ الذاتِ والوجودِ في آن:
خُذِ المرأةَ منْ خزانَةِ الذِّكْرَيَاتِ، لليلةٍ
فُكَّ عقدةَ لسانِهَا وبرودةَ نهْديْهَا
..
خُذِ القصيدةَ منْ خزانَةِ اللَّذَّةِ
مكثفَّةً كقُبلةٍ،
ووارفةً كالجِمَاعِ،
..
حتَّى إذَا دانَتِ اللغةُ، فانْهَلْ.
إنَّا أعطيناكَ الكوثَرْ. (ص83)
فالجسدُ وسيلةُ الفيْضِ المعرفي، وسيلة الوجود في قلب الوجود، فاللغةُ لسانُ الطبيعةِ والذات، وهي الجسرُ إلى المطلق في كماله ولا محدوديته، لكنَّ اللغةَ –هنا- ليست الأصواتَ الإنسانيةَ والإشارات المتعارف عليها، إنها المعرفةُ الخامُ التي تتفجر في الذات، أو الموسيقى التى يعبِّر بها الشاعر عن الصلة بين الذات والمطلق:
حينَ تعودِينَ للحظةِ ميلادِكِ
دونَ أسمالٍ ولا لغةٍ ولا هواءٍ صَدِأٍ
ستَتَفَجُّر موسِيقَى منْ أَثَرِ اقتحامِ الصَّحَارِي
فتفيقُ أنهارُ العسلِ منْ ثُبَاتِهَا، وتتعمَّدِينَ أُنْثَى! (76)
إنه بالجسد يعود إلى الفطرة الأولى، إلى الموسيقى، وامرأتُه –كذلك– تتعمَّد أنثى، هي الأنثى الأولى التي بها يكتمل الرجلُ الأول، لكنَّ هذا لن يتحقق إلا بعد تحطيم قيود الجسد، لتتفجر طاقاتة؛ ولْنقرأْ ما يقوله شاعرُنا سمير درويش عن قصيدته الأنثى، أو أنثاه القصيدة:
المسكونةُ بمردةٍ وأساطيرَ
تفُكُّ قيدَ جسدِهَا المتفجِّرِ، ليتوزَّعَ بإحكامٍ
بينَ أوتادِ الأرضِ، ونيازِكِ السماءْ.
تفرشُ ملامحَهَا غيمَةً حُبْلَى
تنذِرُ بشتاءٍ مثمرٍ وطريٍّ،
ترصُّ أحاسيسَهَا حروفًا
لا تتكئُ على حمُولاتِهَا الموروثةِ
ولا ترضَى سوَى باختراقِ السياجِ الهشِّ
..
وشفتاهَا المنفرجتانِ قليلًا،
تتحركانِ بتوتُّرٍ يمكنُ رؤيُتُهُ
كأنَّما ستبوحَانِ
الآنْ! (ص12)
فامتلاكُ القدرةِ على القول فيضٌ لا يتحقق إلا بتسلق الجسدِ إلى المطلق؛ بتفجير القيود والأحاسيس، ومغايرةِ الحمولات الموروثة، واختراقِ الأسيجة؛ هنا تسكنها المردةُ والأساطيرُ، وتتبدل طبيعتُها من المحدود إلى المطلق، ومن الأرضي العاجز إلى السماوي الخارق.
من هنا كان رفضه للجسد المحدود، الذى لا يُعْطِي أكثرَ مما يعطي الاعتياديون:
ليسَتْ سِوَى صورةٍ حُبْلَى:
لا تغنُجُ، ولا تفتِنُ توحُّشَ الأمطارِ
نهدَاهَا ليسَا غيرِ مساحاتِ ضوءٍ وظلٍّ
لا ينزفانِ عسلًا لزِجًا لوْ خلعتُ عنْهُمَا الألوانَ
ولا يتحرَّرَانِ من إطارِهِمَا الشِّعْرِيِّ
فلنُمارِسْ كِذْبَنَا.. إِذًا. (ص66)
جسدُها لا يُغْري الفذَّ، وعُرْيُها عارٍ من الفتنة، ونهداها ليسا سوى خواء، مساحات ضوء وظل، لا يعطيان من عسل المعرفة أو الكشف، هى بالأحرى ليست سوى أكذوبة، إنها لا تَصِلُه بالمطلق؛ مجردُ ممارساتٍ أنثويةٍ أو بلاغية، دون بلوغِ فيضٍ، أو دخولِ سماء:
تتوغلُ فِي ثَنَايَا كتَابِي وهْيَ منغلقةٌ
دونَ ثمةُ أرقٍ وجوديٍّ،
كعصفورٍ يتنقَّلُ بينَ سماواتِ اللهِ
دونَ صلاةٍ واحدةْ! (ص64)
فالغاية من الجسد -إذن- تحويلُ الجسدِ أو الانسانِ إلى كائن نوراني، وفاعلية سحرية بين الأشياء ومفردات اللغة، بحيث تصير الأشياءُ واللغةُ جمالًا وشعرية؛ لا أنْ تصيرَ اللغةُ وسيلةً لطَرْحِ أفكارٍ، ووَصْفِ شعور.
خيوط العرفانية:
إن نسيج الشعرية داخل الديوان ليس مجرد توظيف للعرفانية من أجل إنتاج الشعرية، بل هو مزيج من البشرية وغير البشرية، الأرضي والعلوي، لذا وجدنا في تحوُّلات الجسد كائنًا جديدًا نورانيًّا، وما كان ليتحقق هذا إلا بالوحدة بين الذات والموضوع، الجسدي والمطلق، وهذا النسيج الجمالي يمْكنُ رصْدُ عرفانيته من خلال خيوطة المتعددة؛ منها:
(1) الرمز الصوفي: فقد انتشرت الرموز الصوفية داخل خطابه الشعري فرأينا:
أ- التفاح: الذي يرمز للخطيئة والغواية كما في قوله:
الشيطان يزرع التفاح بين سيقان البنات (ص93).
ب- الشوق: الذى عبر عنه بالتشققات فى مثل قوله:
ويجمعنا رائحة تشققاتٍ
وصوت مطر! (ص23).
ج- الغرام: وعبَّر به عن الشوق كذلك:
الغرام الذى تفتَّح على حواف أحاسيسنا
ليس من وسيلة إلا المزيدِ من التورط فيه (ص 77).
د- الدم: الذى يشير إلى الجهد وبذل النفس فى سبيل الوصول:
فقط تشرب كأسها الوحيد من دمي
وتنام! (ص70).
هـ- الخزائن: وهي تشير إلى الأسرار الباطنية:
خذ القصيدة من خزانة اللذة (ص83).
و- الروائح: التي تشير إلى الجذب الإلهي، وكذلك البحر الذي يرمز إلى المطلق، كما في قوله:
يدَا البستانيِّ هرمَتَا من الفقدِ
وأنفُهُ لا يلتقطُ الروائحَ
ولا يعبِّئُهَا في زجاجاتٍ شفَّافاتٍ
ليرسلَهَا للبحرْ! (ص9)
ح- الموسيقى: رمز الاتصال بالمطلق:
قالتْ لِي: أنَّي يكونُ لِي غلامٌ وأنَا حزينةٌ
لمْ يلمسْ فضاءَ حنينِي سوَى المُوسيقَى
والدُّخَانِ
والدماءِ المحبوسةِ خلفَ جفونِي؟! (ص48).
ط- الشجرة: التي ترمز إلى إنقاذ الذات، كما في قوله:
تُعْطي للهواء رائحةَ جلدِها
فتصيرُ شجرًا (ص 48).
ي- الصلاة: رمز الخضوع للمطلق:
تبكي بفرحِ طفلةٍ تقيمُ صلاتها الأولى (ص68).
وغيرها من الرموز كالتلاشي: ص63، ويشير إلى الوحدة بالمطلق، والطير: رمز الأفكار المحلِّقة ص43، والموت الذى يرمز إلى الخلاص ص5، والجُبِّ: الذى يشير إلى السقوط الأرضي ص46، وغيرها من الرموز.
(2) التناص:
نسيج سمير درويش الشعري مفتوحٌ على الموروث الديني والشعري والتاريخي والصوفي، لكنه –غالبًا– في استدعاءاته لا يستدعي من أجل نسيجه العرفاني ما سبق إليه المتصوفة، بل يقوم بشحن ما يستدعيه بطاقات عرفانية؛ يُجري في عروقها دماءَ نَصِّه ليفجِّرَ فيها طاقاته كما يفعل بالجسد، فمن تناصاتة القرآنية:
قالتْ لِي: أنَّي يكونُ لِي غلامٌ وأنَا حزينةٌ
لمْ يلمسْ فضاءَ حنينِي سوَى المُوسيقَى
والدُّخَانِ
والدماءِ المحبوسةِ خلفَ جفونِي؟!
قلتُ: كذلكَ قالَ ربُّكِ! (ص8)
ومن تناصاتة الشعرية:
تزرعُ أسئلَتِي بينَ نهديْهَا ولا تلمَسُ يَدِي
ترسمُ لوحةً يغلُبُ الأحمرُ عليْهَا ولا تلمَسُ يَدِي
تُغنِّي مَعِي: “أراكَ عصيَّ الدَّمْعِ” ولا تلمَسُ يَدِي
وحينَ نزعْتُ يَدِي وزرعْتُهَا فِي أرضٍ ثلجيةٍ
مَاتَتْ! (ص54).
(3) تضخُّم الذات:
إن لحظات التوحد التى تصل إليها الذاتُ الشاعرةُ السالكةُ تخلقُ لها نشوةً طاغيةً تُكْسِبُ الذاتُ قدرًا عظيمًا من التضخُّمِ، به يفرضُ سلطانه على الوجود، نراها في مثل قوله:
أمشِي علَى الحافَّةِ دونَ أنْ أنزلقَ
لأنَّنِي صرتُ هواءً شفَّافًا
تمتصُّنِي الصُّدُورُ جميعُهَا بعمقٍ
بعدالةٍ غرامِيَّةٍ
دونَ أن ينفَدَ مخزُونُ عطائِي! (ص84).
أو قوله حين يصل إلى الوحدة بالمطلق:
كانَ أطفَالُنَا يعبِّئون ذاكرتَهُم
بقصةِ امرأةٍ تهفُو إلى البحرِ
ورجلٍ يقولُ للموجِ كنْ
فيكونْ! (ص16)
كأنَّمَا أرادَ تنظيفَ سمائِهِ مِنْ نَزَقِي
منْ رغبتِي في حرقِ المسافةِ بينَ غايتيْنِ،
كأنَّهُ حينَ أرادَ، قالَ للجُبِّ كُنْ،
وأمَرَ شياطينَهُ أنْ يتشكَلْنَ ملائكةً،
وتفاحًا محرَّمًا،
(..)
لقدْ أرادَ أنْ يكونَ وحيدًا هناكَ..
فجعلنِي وحيدًا..
هاهُنَا! (ص46).
أو قوله:
كيف سيبرِّرُ فعلتَه حين يُنْفَخُ في السورِ؟
وحين يَفْضَحُ اللوحُ المحفوظُ سبْقَ إصراره؟ (ص47).
لكن هذا التضخم مرتبط بالوقت الصوفي الذي يزول بزواله، يقول:
كأَنَّهَا تفتحُ أبوابَ صدْرِي، وكأَنَّنِي أفرَحُ
أغسلُ الشَّمْسَ بالثلجِ،
وأُوقِدُ شموعًا علَى وجهِ القمرْ
لكنَّنِي لا أنْسَى أنَّ (كأنَّ) ساريةٌ لليلةٍ واحدَةْ! (ص93)
شعرية الروح:
يحاول الشاعر سمير درويش -في هذا الديوان- نسْجَ شعريةٍ على غيرِ مثال، وليس المقصود هنا شعريةَ الكتابةِ التي غايرَتْ الشعرية الشفوية التراثية، فهذا قد تمَّ منذ سبعينيات القرن الماضي، وتبنَّته قصيدةُ النثر على وجه خاص، لكن الذي أعنيه هو محاولةُ نسْجِ لغةٍ لا تتوسل بالبلاغة أو الرؤى المُنْتَجَةِ قبله، بل تَدَرَّعَ بكشفه الروحي الخاص، الذي يجعل من نسيجه قطعةً من جمالٍ خالصٍ لا يمكن تفكيكُها إلى أفكار وبلاغة وإيقاع، إنما هى شعرية عرفانية وإن خالفت التراثَ الصوفيَّ في أساس بنائه، إذ يعْمَدُ المتصوِّفُ إلى تنقية الجسد والنفس من الرغبات، أو ما يسمى بالتخلية، لكنَّ النصَّ الذي بين أيدينا يتوجَّهُ إلى الجسد على أنه شيءٌ مطلق، جسدُ الروحِ الأعظم، فيه من اللانهاية الكثير، وله من القدرات الخارقة على تطهير النفس الكثير، فهو يطهر النفسَ بالجسد، إذْ أدرك إمكاناتِه وفتوحاتِه، وكشفَ عنها.
فهذا المسلكُ الذي سَلَكَهُ الشاعرُ كان وراء غموض اكتنف معظم عرفانية قصائد الديوان، حيث نَقَضَ عادةَ القولِ الشعري، أو الجمالية العرفانية التي اعتادتها الذائقةُ، وهذا المسلك يطلبه الشعر دائمًا من مرحلة ذوقية لأخرى، كي يظلَّ مجاوزا للعادي، مغايرًا وجديدًا.
من هنا كانت عرفانية الديوان مغايرةً تبعًا لمغايرة الوعي الذى لم يفصل بين الظاهر والباطن، وبين الموجود والوجود، فالوجودُ والموجودُ واحد، والأشياءُ -ومنها الجسد– صفاتٌ له؛ فالشمسُ هي ذاتُ ضوئها، والموجاتُ التي يرسلها البحرُ هى البحر، والصورةُ نورٌ تكثَّفَ بقدرةِ المعنى/ الله؛ لكي يُمْكِنُ الاهتداءُ بها إلى الذات، وإذا كانت الصورة/ الجسد حجابًا لنور المعنى؛ فهي -كذلك- طريقٌ تؤدي إليه؛ فحين يشف الكثيفُ ينكشف اللطيف، وهذا ما كان يغازله الديوان.