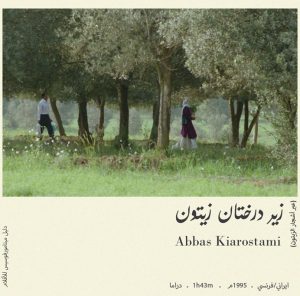أميرة بدوي
قراءة في تمثيل الصعلوك والخائن والفنان: حمزة العيلي في مسلسل “النص”
تلك النافذة التي اعتبرتها جزءًا مني أوقعتني في الفخ. في بيتنا القديم، داخل غرفة التليفزيون وماكينة الخياطة، كنت أفنّد الناس والمشاهد والصور وأنا جالسة خلفها، لا أحد يراني، فقط من يريد الصعود إلى الطابق التالي يستطيع ملاحظتي. أجلس على درجات السلم، الساعة تتك على مستوى نظري، والعالم يدور، يدخل الناس ويخرجون، يضحكون ويبكون، وأنا أجلس هناك، أضم أصابعي كالنظارة المعظمة، وأرى ما لا يستطيع أحد غيري رؤيته.
لكن تلك المرة، لم يحالفني الحظ. كل من في الغرفة يضحك بسعادة، وهناك رجل يرتدي قبعة ويمسك عكازًا، لديه شارب مضحك ومشية مميزة لكل حدث منفصل. يبدو فقيرًا وأحيانًا لا يملك بيتًا أو طعامًا، والأغرب من كل ذلك أنه لا يستطيع الكلام!
فكرت أن أجرّب حيلتي التي حسبتها في غاية البراعة، ولما قربت عدستي المتخيلة أدركت الحزن الذي يملؤه، والمأساة الملفوفة على هيئة كوميديا. بالطبع شككت بنفسي، وخفت. لكن لاحقًا رأيت المشهد تمامًا كما وصف في أحد مقابلاته: الحياة تراجيديا حينما تراها عن قرب، وكوميديا عندنا تراها من بعيد!
نعم، أنتم محقّون.إنه تشارلي شابلن!
الرجل الذي لم يكن بحاجة للكلام ليحكي كل شيء. ذاك الصعلوك الأبدي، الذي صار رمزًا عالميًا للانكسار النبيل، والكوميديا التي تمشي على عكاز وسط أنقاض العالم. بقبعته الصغيرة، وشاربه المثير للضحك، وعينيه اللتين تخبئان وحدته في جيب معطفه!
“The Tramp”
كلمة تبدو للوهلة الأولى مرادفًا للهامش، للفقر، للتيه. لكنها في الوعي الإنساني كائن هجين: الشاهد والمُدان، الضحية والساخر من مأساته. ظهر في الحكايات الشعبية، في الشعر العربي القديم، في المسرح، في السينما، وحتى في السيرك.
وكما لم يكن “الصعلوك” حكرًا على تشارلي، ولا حكرًا على القصائد الجاهلية، فقد ظلّ يتنقّل من ثقافة لأخرى، ومن زمن لآخر، كل مرة بحلة جديدة، لكنه بذات الروح: رجل يقف على الهامش، يضحك والناس تبكي، أو يبكي والناس تضحك. رأيناه في روبن هود، اللص الذي يسرق ليُنصف الفقراء. وفي الرونين الياباني يجوب الطرقات بلا سيد، لكنه لا يتنازل عن شرفه. وفي الشنفرى، الذي قال مفتخرًا: “وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى! شخصيات تنتمي لعوالم متباعدة، لكنها تطرح أسئلة عميقة: هل يحتاج كل مجتمع إلى صعلوكه؟ هل “الصعلوك” مجرد أداة للضحك، أم أنه، كما رأيته من نافذتي القديمة، عين المجتمع الفقير على نفسه؟ هل يمكن للصعلوك أن يكون الضمير الذي لا يمتلك رفاهية المنبر، فيكتفي بالشارع والصمت والكوميديا المرتعشة؟
مسلسل النص رمضان 2025
ربما لم يتوقع أحد أن تجيب الدراما المصرية على تلك الأسئلة، أو على جزء منها، نظرًا لاتخاذها منحى مختلف على مدى السنوات الأخيرة. أتحدث هنا عن مسلسل “النص” الذي عرض في رمضان 2025، من تأليف شريف عبدالفتاح، وعبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إخراج حسام علي، وبطولة أحمد أمين وأسماء أبواليزيد وحمزة العيلي وباسم قهار وصدقي صخر ودنيا سامي وميشيل ميلاد وغيرها من الأسماء المميزة، مع حفظ الألقاب لهم جميعًا.
استوحى العمل أحداثه من كتاب “مذكرات نشال” للباحث أيمن عثمان. ويحكي قصة نشّال القاهرة القديم عبد العزيز النُص (أدّاه أحمد أمين)، الذي يتحول إلى قائد مقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي، بمشاركة عدة شخصيات أو دعونا نقول نشالين أو طامحين في الحلم والحياة.
قد يتصور البعض أنني سأتحدث عن شخصية عبد العزيز النُص باعتباره الصعلوك المختار، فهو من انتقل من النشل إلى النضال، ومن هامش الجريمة إلى قلب الفعل الوطني، وهي شخصية مميزة بالطبع، لكن الحديث هنا عن شخصية أخرى. مع المشاهدة وجدت نفسي أتذكر الحيلة القديمة، أصابعي المضمومة ونظاراتي المكبرة، الضحكات والعيون الحزينة، الأغنيات، الشارب الصغير والقبعة. فعلت ذلك مجددًا، أمام الشاشة لا النافذة، وفي اللحظة التي بدا الجميع مشغولًا بالحكاية الكبرى، رأيته. رأيت درويش.
ظلّ صامتًا في الخلفية، يهتزّ صوته كأنه يستأذن الحزن، يتكلم فيتعثر صوته، يحلم ويركض ويغني ويسرق ويسأسئ ويحب ويغار ويُرى صغيرًا ويستهزءون به، لكنه لم يتوقف عن المحاولة.
قلت في سري، دون وعي: أيها الصعلوك، أهذا أنت؟
لم يكن مجرد تشابه في الهيئة – القبعة، الشارب، لغة الجسد- بل في ذلك الحزن الخفي الذي يطل من بين تفاصيل الكوميديا، في تلك المحاولة البائسة للضحك رغم كل شيء.
حمزة العيلي لم يكن يؤدي دورًا، لكنه استحضر صعلوك ذاك الزمن، الذي بكيت وأنا أراه يضحك في طفولتي، كأنه قام في هيئة مصرية، بلحم ودم، ليهمس لي: أنا لم أمت بعد.
لم يكن درويش مجرّد صورة باهتة لصعلوك تشارلي شابلن، كلاهما يقف على الهامش، يطارد حلمًا بالفن والحب والاعتراف، ويتعثر في الفشل والخذلان، لكن درويش لم يكن صامتًا مثل شابلن، كان يحاول أن ينطق، أن يغني، أن يثبت وجوده، حتى ولو بتلعثم. تشابهت ملامحهما: القبعة، الشارب، الجسد الذي يتكلم أكثر من اللسان، وحتى الحزن الذي يتخفّى داخل الضحك.
الأمر المثير أن درويش كان أكثر عُريًا، أكثر انكشافًا أمام الكاميرا. لم تُخفِه الكوميديا، بل كشفت هشاشته. صعلوك تشارلي يهرب من العالم، بينما درويش يحاول الانتماء إليه: بالتمثيل، بالغناء، بالغيرة، وحتى بالخيانة. وربما في تلك الخيانة تحديدًا، تكمن لحظة الفلسفة. اللحظة التي نفهم فيها أن درويش لم يكن شريرًا، بل كان في مفترق أزلي بين الأمل والانكسار، بين أن يكون أو يُنسى.
هنا، تبدأ الفلسفة في التسلل إلى الحكاية. درويش، في لحظة خيانته لصديقه عبد العزيز، لم يكن شريرًا كلاسيكيًا، بل حالة وجودية مُعلّقة. ما فعله لم يكن قرارًا بسيطًا بين الخير والشر، بل انعكاسًا لما يسميه جاك دريدا “الأبوريا” – المأزق الأخلاقي الذي لا مخرج واضح منه.
هل يخون كي يُرى؟ كي يشعر أنه موجود في العالم؟ كي يثبت لنفسه أنه ما زال قادرًا على الحلم؟
تلك الأبوريا لا تمنحه عذرًا، لكنها تخلع عن الخيانة معناها المتعارف عليه، وتكشفها كألم داخلي، كصرخة غير مسموعة.
أما فوكو، حين يتحدث عن “المشكلة” problematization، فهو لا يقصد العقبة أو الأزمة التي نواجهها، بل الطريقة التي نعيد بها صياغة واقعنا كأسئلة تُشغلنا وتعرّفنا. الإنسان، عند فوكو، لا يكون فقط ضحية لظروفه، بل فاعلًا في تحويل هذه الظروف إلى مشكلة، إلى سؤال وجودي يبحث له عن معنى.
وهكذا درويش. لم يكن فقط فقيرًا، ولا مهمشًا، ولا حتى مظلومًا كما قد نتصوّر في البداية. بل كان، قبل كل شيء، رجلًا يطرح على نفسه سؤالًا مزمنًا: “لماذا لا يراني أحد؟”، “ما الذي يجعلني موجودًا بالفعل”.
لم يرد أن يكون فنانًا لأن الفن حلم جميل. بل لأنه، في نظره، الحل الوحيد لمعضلته الوجودية. أن يضحك الناس؟ نعم. أن يُصفقوا له؟ ربما. لكن الأهم: أن يعرف أنه موجود، وأن له صوتًا لا يتلعثم، وحضورًا لا يُختصر في ظلّ أحد.
وبهذا المعنى، لم يكن درويش ضحية. بل كان هو من صنع مشكلته، ومنحها أبعادًا أكبر من مجرد الفقر أو الفشل. هو الذي حوّل جُرحه إلى سؤال، وسؤاله إلى أداء.. فصار الخائن، والضحية، والفنان أيضًا.
مونولوج درويش في السوق
لكن درويش لم يُسدل الستار على حكايتِه بالخيانة. بل انتظر، بصبرٍ غريب، حتى اللحظة التي يستطيع فيها أخيرًا أن يبوح.. أن ينفجر، أن ينهار.
في السوق، حيث لا خشبة ولا ستائر حمراء، وقف كأن العالم كله صار مسرحًا مؤقتًا لعرضه الوحيد. لم يكن أمامه جمهورٌ يصفّق، ولا كلماتٌ موزونة تُقال. كان هناك فقط: صوتٌ متهدّج، ودمعٌ يهرب من العين، وصرخةٌ خرجت من جوف رجلٍ حاول أن يكون فنانًا، ففشل، حاول أن يكون صديقًا، ففشل، حاول أن يكون مرئيًا، فقط، مرئيًا… فخان.
ذلك المشهد – مشهد السوق – ليس مجرد ذروة درامية في المسلسل، بل لحظة تجلٍ مسرحي خالص. مونولوج لا يُلقى أمام الكاميرا، بل ينبع من عمق شخصية تهشّمت حتى لم تعد تعرف إن كانت تبكي أم تؤدي.
وفي السوق، حين هبط “درويش” بجسده المُنهك وصوته المتكسر ومظهره الرث، تجوّل مخاطبًا نصفه الآخر، صديقه الذي خانه، يلومه، يتودد إليه، يلعن الأشخاص الذين سرقوه، ثم يبكيه. كل ما نطق به أشبه بـمونولوج جنوني مرتجل، لا يحتاج إلى خشبة أو جمهور، فقط إلى وجع قديم انفجر دفعة واحدة. في جملة واحدة يهمس: “أنا وهو كنا واحد مقسوم نصين”، ثم يغني، ثم يصرخ، ثم يبكي. وأخيرًا، يقولها كأنها وصية أو نشيد هزيمة: “روحي فدا يا نص”.
في تلك اللحظة، صار درويش فنانًا. لا لأنه امتلك شيئًا، بل لأنه فقد كل شيء. لا لأنه قرأ نصًا مكتوبًا، بل لأنه كتب بألمه نصًا لا يُنسى. المونولوج لم يكن مشهدًا عابرًا، بل خلاصة حياة كاملة: خيانة، غيرة، حب، فشل، طرد، رقص، بكاء، وصمت. حضر فيه الفن لا بوصفه عرضًا، بل بوصفه انكشافًا، تشريحًا للروح العارية التي لم يعد لديها ما تخسره، سوى قناع المهرج.
هل هذا الكلام يعني أن حمزة العيلي كان يقلد تشارلي شابلن؟
لا. المسألة أعمق بكثير. حمزة العيلي لم يُقلّد تشارلي شابلن، بل لمس الروح الإنسانية نفسها التي عبّر عنها شابلن، وأعاد تشكيلها بلغته وجسده وتلعثمه ومرارة الواقع المصري. لم يكن يحاكي شخصية، بل يستنطق ذاكرة مشتركة، فيها الضحك المجروح، والانكسار المتماسك، والعين التي تدمع في منتصف الإفيه.
لقد أعاد حمزة العيلي، بمساعدة المخرج حسام علي وفريق العمل، تشكيل الحزن الكوميدي لا كأيقونة بصرية، بل كحالة وجودية محلية. وربما لهذا السبب وصل الدور بهذا الصدق؛ فـحمزة العيلي بدأ مسيرته الفنية ممثلًا مسرحيًا. وحين انتقل “الصعلوك” من زمن إلى زمن، ومن بلد إلى بلد، ومن السينما الصامتة إلى الدراما الناطقة، كان لا بد أن يعبر هذا التحوّل من خلال وسيط يتّسع للتجربة الإنسانية العارية: المسرح.
ومن هناك، عبر درويش إلينا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناقدة وروائية مصرية